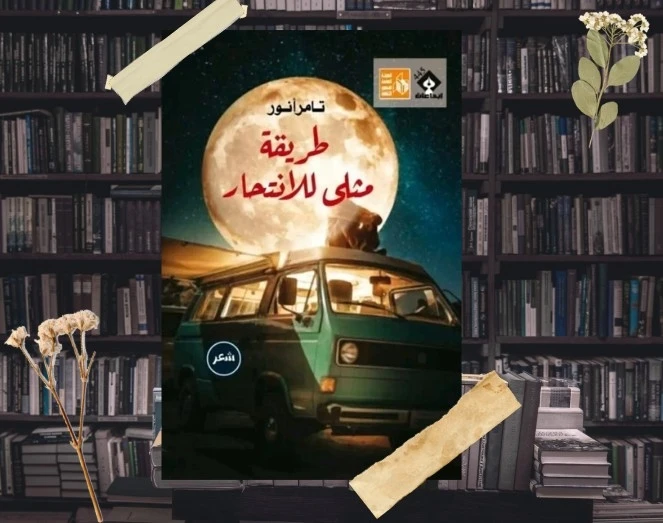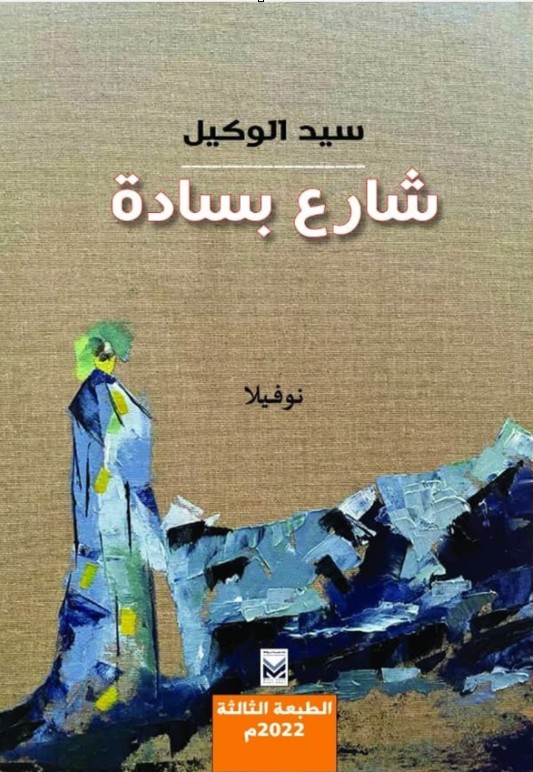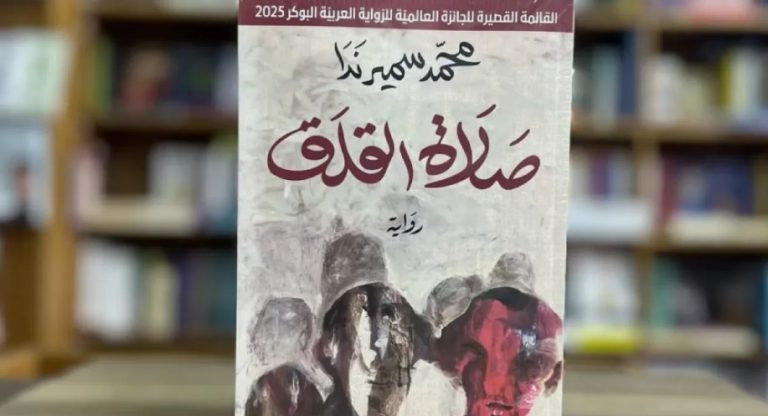أفين حمو
تقول كتب علم النفس إن المنتحر، قبل أن يُقدِم على فعله، يترك إشاراتٍ صغيرة لمن حوله: رسائلَ غير مكتملة، كلماتٍ زائدة عن معناها، اعترافاتٍ تُقال في غير وقتها، كأنه لا يريد أن يموت حقًا، بل يريد أن يُرى.
في هذا المعنى، يمكن قراءة ديوان “طريقةٌ مُثلى للانتحار” لا بوصفه مشروع موت، بل بوصفه سلسلة رسائل استغاثة متأخرة، كتبها شاعر يعرف أن أحدًا لن ينتبه، ومع ذلك يترك إشاراته واحدةً تلو الأخرى، لا طلبًا للخلاص، بل كاختبار أخير لجدوى الصوت في عالمٍ أصم.
الانتحار هنا ليس فعلًا، بل لغة.
لغة من لم يجد من يسمعه، فكتب.
ديوان “طريقةٌ مُثلَى للانتحار” للشاعر تامر أنور هو صرخة وجودية مُركّبة ونقد لاذع للعالم والذات، يتجاوز الانتحار الحرفي ليصبح استعارةً لـ “موت المعنى” وانهيار اليقين في عصرنا.
يبدأ الشاعر تامر أنور رحلته بإهداء استفزازي وعميق يضع القارئ والذات في دائرة الاتهام والسؤال:
“إلى مَن سوَّلَتْ له نفسُه القراءة… / إلى تامر أنور… / لماذا لا تصمُت فحسب؟!”
هذا الاعتراف بالعبثية يحدد نبرة الديوان كلها، حيث تبدو القصائد وكأنها وُلدت رغماً عن الشاعر، نتيجة فشله في تحقيق الخلاص الأبدي المتمثل في الصمت، وكأن الكتابة هنا ليست اختيارًا بل اضطرارًا وجوديًا يُمارَس كي لا ينطفئ الصوت نهائيًا.
في قصيدة “علامة” تتأسس رؤية الشاعر على ما يمكن تسميته بـ لعنة النبوءة والاغتراب التأسيسي.
فهو الطفل الذي لم يبكِ عند ولادته، وحُكم عليه منذ اللحظة الأولى بأن يكون إما “المسيخَ الدجَّال… أو شاعرًا!”.
هذا الربط بين “الفتنة الكبرى” و”الشعر” يضع الشاعر في خانة المرفوض والمختلف، ويُتوج لاحقاً بإنكار الشعراء له:
“عندما بكيتُ أنكرني الشعراء وقالوا: ‘ملعون'”.
هنا تنقلب الرموز الدينية رأسًا على عقب، فالشاعر لا يظهر كنبيٍّ يحمل الخلاص، بل كنبيٍّ مقلوب، مطرود من المعنى، خارج الكنيسة الشعرية، لا رسالة له سوى اعترافه الدائم بالخذلان.
ويكتمل هذا الاغتراب من خلال رموز الأبوة والأمومة، حيث يظهر الأب كمصدر للحرمان المادي وغياب الدعم (القطار الذي لم يُشترَ)، وتظهر الأم كشريك في الحكم الأولي باللعنة والانتظار السلبي.
أما الجدة، فتمضي إلى “سكّة اللي يروح… ما يِرجَعش”، تاركةً الشاعر ليواجه حقيقة أن كنوز الأساطير قد سُرقت وذهبت إلى “بنوك سويسرا”، مما يؤكد فشل الميراث الثقافي والروحي في منح العزاء، وانقطاع السلالة الرمزية التي كان يُفترض أن تحمي الروح.
المرأة في هذا الديوان هي النقطة الحدّية التي تلتقي عندها اللعنة والخلاص.
هي من تملك حق “الطعنة الأخيرة” في القلب (كما في قصيدة العنوان)، وهي التي تُصوّر كقاتلة تستغل الشعراء (تُعيد طلاء شفتيها بِدَمِ شاعرٍ)، وهي التي تجلب الموت بالقبلة في مفارقة أسطورية حادة:
“كُلَّما قبَّلتُ امرأةً، ماتت!”
ومع ذلك، تظل المرأة هي مفتاح الحياة وشرط الوجود والبطولة:
“أنا رجلٌ ميِّتٌ فحسب / وأنتِ امرأةٌ / تحمل في عُنُقِها مِفتاحَ الحياة”،
لكنها قد تكون أيضًا مجرد “حُلْمًا ناتجًا عن نَقْصِ النقود / وسوءِ التغذيةِ”، لتتحول من خلاصٍ محتمل إلى وهمٍ اقتصاديّ وجسديّ، يعمّق مرارة الوجود بدل أن يخففها.
أما لغة الديوان، فهي لغة التمزيق والسخرية السوداء. يعتمد الشاعر على الجمل القصيرة المتقطعة التي تحاكي حالة التوتر والقلق الوجودي، رافضاً الإنشاء الكلاسيكي المُطوَّل.
هذه البنية الإيقاعية لا تُنتج موسيقى، بل تُنتج تشنّجًا عصبيًا.
القصائد تتنفس كمن يحتضر، وتُكتب على هيئة نوبات، لا على هيئة أناشيد.
ويمزج تامر أنور بين السخرية من الوباء الاجتماعي والبيولوجي (كمامات، “توم وجيري”، “جاءنا البيانُ التالي”) وبين المأزق الفلسفي (نيرڤانا، أليس)، فيصنع لغة هجينة تهزأ من الخراب بدل أن تفسّره.
يظهر هذا المزج في الهجوم على الزيف الثقافي والطبقي في مقطوعات “تَنَمُّر”، حيث يُسخر من الشاعر الذي ترك فأس الفلاحة ليصبح “فصيحًا” متشدقاً يدعي المعاناة.
الحقيقة المطلقة الوحيدة للشاعر، كما يلخصها في “نيرڤانا”، مرهونة بالألم:
“- أنا أتألَّمُ، إذًا أنا أكتبُ، إذًا أنا موجود -“.
هكذا يتحول الديوان إلى مرثية حديثة لا تُرثي ميتًا، بل ترثي الذات وهي ما تزال تمشي. الشاعر لا ينتظر موته كي يُرثى؛ بل يكتب رثاءه وهو حي، لأن الكتابة نفسها هي شكل وجوده الوحيد.
وتتجسد “الطريقة المُثلَى للانتحار” في النهاية عبر “المرآة”، لأن الفقير لا يملك ثمن سمّ غير منتهي الصلاحية، ولأن المرآة تكشف الطعنة الداخلية الأخيرة التي لا يراها أحد. الديوان إذن هو إعلان عن أن العالم قد “انتهى بالفعل”، وأن الشاعر الملعون، الكائن الفضائي، يكتب مرثيته كشاهد أخير، وقوته الوحيدة هي أن
“يُبعَثَ بعدَ كُلِّ طعنةٍ / لِيُطعَنَ مِنْ جديد”.
“طريقةٌ مُثلى للانتحار” ليست دعوةً للموت، بل شهادة على استحالة النجاةمن هذا العالم القاسي.
هنا لا ينجو الشاعر، ولا يُخلِّصه الشعر، ولا تمنحه المرأة خلاصًا نهائيًا، ولا تعيده العائلة إلى جذوره الأولى. كل ما يبقى هو فعلٌ واحد يتكرّر بلا نهاية: أن ينظر في المرآة، ويرى نفسه كما هو بلا بطولة، بلا قداسة، بلا أملٍ مُقنع ثم يكتب.
لا ليعيش، بل ليؤجّل اختفاءه لحظةً أخرى.
فهذه المرثية لا تُكتب بعد الموت بل تكتب بدلاً عنه.
.