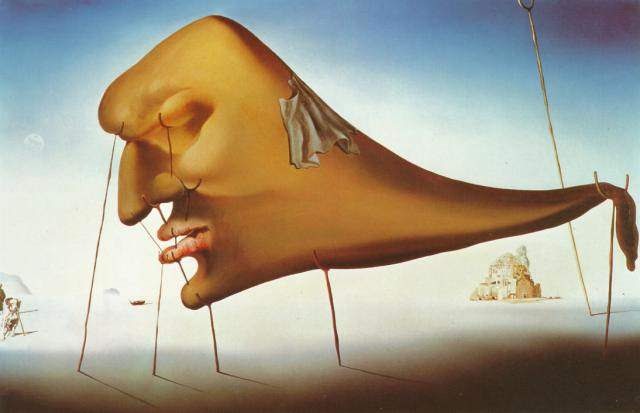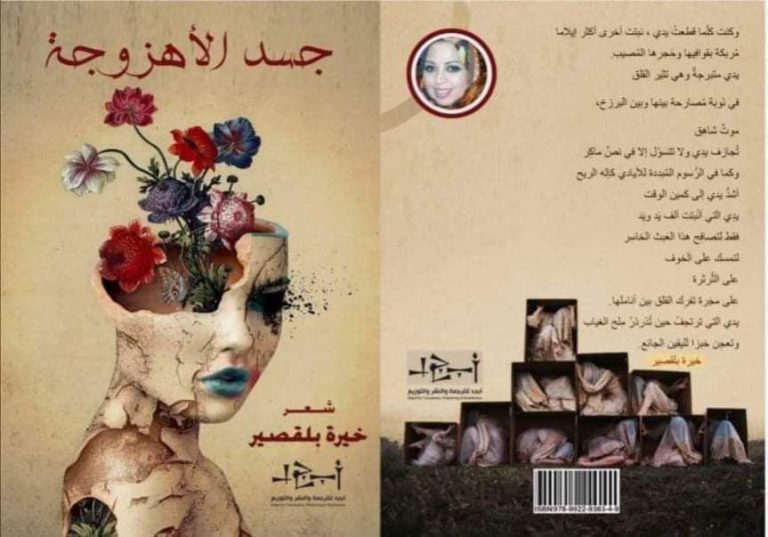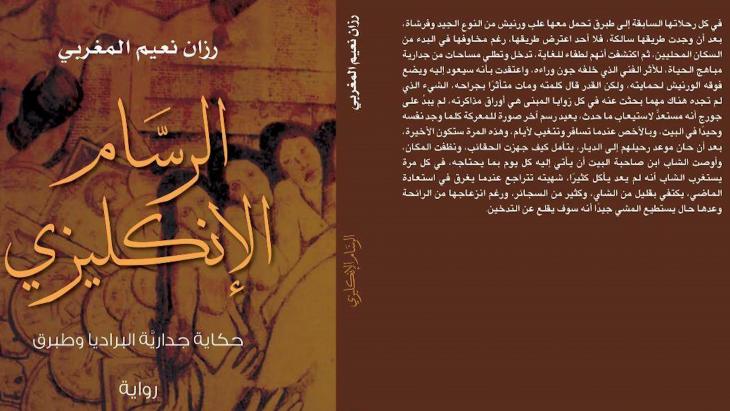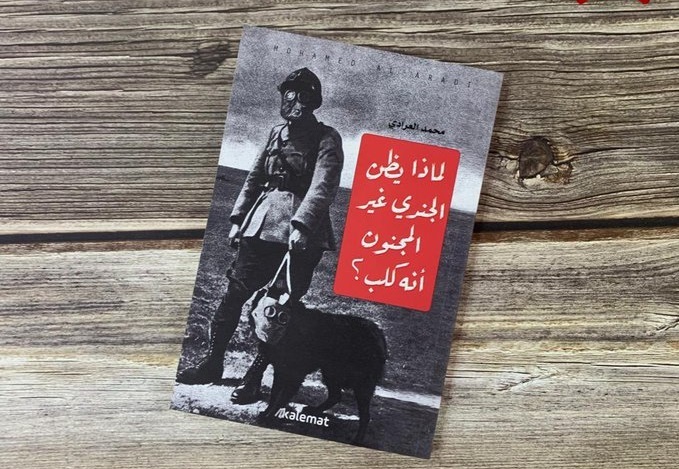د.سلوي جودة
يدخلنا وحيد الطويلة في روايتهِ (كاتيوشا)2022 واحدا من عوالمهِ المُتعددة والنشطة، فعوالمه لا تكف عن الحركةِ والتدفقِ, وكذلك الهدوء والسكون, ثم المعاودة إلى الحركة والجريان، ولا يتوقف عن إدهاشِ قارئه وجذب انتباهه من أولِ عتبةٍ في النصِ، فَنحن أبناء الصراعاتِ الكبرى تَربينا على نشرةِ أخبار يومية تحمل أسماء الصواريخ والقاذفات التي يتباهى بامتلاكِها والتهديد بها أقطاب العالم، وأن يحمل النص هذا العنوان (كاتيوشا) والذي ثبت في الذاكرة بكونها القاذفات المتعددة الصواريخ التي أرعبت الألمان والتي تتميز بالقدرة على توصيل كمية مدمرة من المتفجرات إلى المنطقة المستهدفة بطريقة أسرع، فهو يستدرك القارئ إلى تصور صراع كوني مدمر سيحرك أحداث النص، وإذا ما دلفنا إلى الإهداء سنجده موجهاً
( إلى النساء، إلى منى وفيروز وليلو)، ليس ذلك فحسب بل سيزداد شغفك عندما تجده يستشهد بمقولتين واحدة لمارلين مونرو: (العاشق الحق هو الذي يثيرك ولو بمجرد لمس رأسك أو بابتسامة في عينيك، أو بمجرد التحديق في الفراغ) والثانية لضى رحمي: (أود أن أحبك من دون ذاكرة ،إلا تلك التي تحفظ حبكَ) فتتحول بؤرة الشغف، ويتنبأ القارئ بأن الصراع إنساني وفلكه المرأة، وهي ليست امرأة واحدة بعينها بل ربما تخوضه العديد من النساء، ثم يكتشف القارئ أن “كاتيوشا” هو تصغير لاسم “كاترينا” أحد أكثر الأسماء الإناث شيوعاً وانتشاراً في روسيا والمُرجح أنه يعود إلى أغنيةٍ روسية شهيرة تحمل نفس العنوان، فكاتيوشا فتاة جميلة، ذهب حبيبها إلى الحرب ضد النازية فتعاهده حبيبته بأنها ستبقى بانتظاره وفية له إلى أن يعود، نسي الناس اسم السلاح، وتذكروا الأغنية وصاحبتها، لم تصل أغنية كاتيوشا إلى حبيبها المحارب فقط بل انتشرت في كلِ أنحاءِ العالم، تُغنيها كُل حبيبة في انتظارحبيبها، وتيمة الأغنية حاضرة في كل الثقافات وفي الأزمنةِ المختلفةِ، فإنسان هذه المجرة واحد والصراعات لا محال حاضرة وباقية في تاريخة على المستوى الجغرافي والسياسي والإنساني أيضاً وربما الأخير أعظمهم تعاسة وإنهزاماً وتراجيدية، والمأساة في ملمحها العام كما صورها الفكر اليوناني الأرسطي واستمرت في الضمير الأدبي لقرون طويلة، والذي عانى من ثبات منهجي حتى العصر الرومانسي وتحولاته، كانت تدور حول الخديعة والخيانة والتي كانت تنتهي في أغلبها بالخلاصِ من محركِ الصراع، حمايةً وتطهيراً للأرض وإنسانها وجميع مخلوقاتها.
(كاتيوشا) وحيد الطويلة من الممكن تصنيفها بأنها تراجيك كوميدي في ثوبها الحداثي، ترويها إمرأة فاجأها زوجها الروائي الشهير وهما في طريقهما إلى المطارلتودعه، فلقد كانا في إجازة من عملهما في دبي واتفقا فجأة على البقاء، على أن يعودان لحياتهما مرة أخرى في القاهرة، و كان على أحدهما أن يسافر لتقديم الاستقالة، بأنه يحب غيرها: “أحب واحدة غيرك” “قالها بتصميم واضح، ضغط على كل حرف، ليتأكد أنها وصلتها وأنهما عند خط النهاية، عند مفترق يأخذ كل واحدٍ منهما في طريق”، ولم يكتفي بذلك، فالقذيفة الكاتيوشية الأولى لم تُصب الهدف كاملاً فأرسل عبوة أخرى بطبقة الصوت نفسها التي وضع بها لغمه الأول:” أحب صديقتك” “نطق بها دفعة واحدة، قالها بوجه صلد” وفي خلال ستة عشر فصلاً يبرع الطويلة في رسم مسارات التمزق والتشتت والتشظي والحيرة ووجع السؤال والألم الذي عانت منه الزوجة حتى ولو “أن المسيح مر من هنا وشاهد ما حدث لبكى من أجلها”، وهي التي لم تتمالك نفسها، صرخت فيه، صرخة مشروعة جمعت كل ما عانته المرأة منذ الخيانة الأولى التي سجلها التاريخ الإنساني والذي صورها بأنها “الغاوية الأولى” رفيقة الشيطان التي أخرجت آدم من فردوسه، تعاركا وانقلبت السيارة على ظهرها مرتين وأصيب ودخل في غيبوبة طويلة قد تمتد لسنوات كما أخبرها الطبيب : “أربت عليه بيد فتقرصني يدي الأخرى، أدعو بجملة وألعنه بأخرى”، والرواية تحمل ألاف التساؤلات من الزوجة/الراوية التي تحترف الكتابة أيضاً، فاعتراف الزوج/رشيد لها لم يكن الأول في تاريخ هذا الكوكب ولن يكون الأخير فالقلوب تتقلب وتتبدل ولا أحد يعلم تحديداً كيف يحدث ذلك ولما: “جملة واحدة صفعني بها على وجهي، أحسستها في قلبي كرمح، أمامي رجل لي ولغيري، طعنني بجرعة سامة من الخسة”، هي
في الحقيقة لحظات فارقة في حياة الزوجة المغدور بها تنعكس فيها حركة عقارب الساعة ويرتبك المد والجذر وتتجه سفن الحقيقة إلى القاع، أي قاع، فالقيعان كثيرة وكما قال تولستوي في افتتاحية (آنا كارينينا )1877 أن “كل العائلات السعيدة تتشابه، لكن لكل عائلة تعيسة طريقتها الخاصة في التعاسة”، لحظة واحدة كفيلة بأن تتحول فيها حركة دوران الأرض حول الشمس وحول نفسها فتدورالأرض بالضحية وحدها، تتقاذفها بين القطب والقطب، وربما تلقيها خارج المجرة، على أرصفةِ الكواكب المعتمة، أو ترطمها بصخورِ صحراءٍ معزولةٍ لم تعرف الحب بعد، وتهرسها رحى المغفلين والحمقى أمثالها، فالحياة لا تحمي المغفلين: ” أنا الآن ضائعة في صحراء لا حدود لها، ليس فيها نبع ماء واحد، مثل كذبة نما لها قدمين، انتشت في حبك، ثم سقطت فجأة في متاهة عميقة”.
وليست هذه في الحقيقة القضية الوحيدة التي حضرتني وأنا أعيش أجواء الرواية وأحوال شخصياتها، ولكن ما لفتني هو قدرة الكاتب/الرجل على فهم ومعايشة أغوار أنثاه التي لا تكتمل أركان قصيدته بدونها وبكل هذه التفاصيل الدقيقة، فهي فلك كل الفنون ومصدر كل الانجذابات وربما تغيرات الطبيعة وتقلباتها تُستمد من طاقتها، وهي ربة الإلهام والخصوبة والموسيقى وفي الأساطير القديمة هي رمز الأرض، وهي الموجودة بفعل الطبيعة بداخله ، فهو لا يقرأ أنثاه ويتخللها فقط بل يعيشها ويكتبها بكل ما أوتي من منطق وخبرة وفراسة فهو يدرك أن:” حزن النساء عميق وجروحهن غائرة والرجل الذي يسعد امرأة حزينة كأنما قتل الحزن كله في هذا العالم كما قال مكيافيللي”، وإذا أخفينا اسم الكاتب عن القارئ لاعتقد أن الرواية كتبتها “امرأة” تلك التي عانت ما عانته من خيانة زوج عشقته وأعلن حبه لغيرها ، هذه هي الخيانة العظمى التي لا تغفرها المرأة والتي تفقدها الثقة ليس في الرجال فقط بل في قدرة العالم على احتوائها وحمايتها فهي” تحمل وجعها معها طوال العمر، ينتقل بين جسدها وروحها مثل فيروس لا يستطيع طبيب الإمساك به، كل قطعة تتألم لنفسها، يمتد ذلك لعمرٍ كاملٍ حتى آخر نفس”، وهي خيانة تشبه في قسوتها ولكن بمستوى أخر تلك التي عانتها “نورا” في كلاسيكية هنرك إبسن 1828 (بيت الدمية) 1878 والتي أدركت ، ربما متأخر قليلاً، أنها تعيش في بيت لا يقدرها ولا يثق فيها كما ينبغي وأنها تحيا على هامش عالماً يعاملها كدمية من يد أب إلى يد زوج، ليس ذلك فحسب بل شعرت بالتعاسة لعدم ثقة الرجل الذي منحته حبها وحياتها في حكمتها وقدرتها على الفهم والقيادة ، وكان لزاماً عليها بعد هذا الإدراك أن تتحرر من جميع سلطات القهر التي شرذمتها مع الأقليات المضطهدة وحرمتها التفاعل والالتحام مع الخبرات الحياتية بل وأقنعتها بضعفها وعدم قدرتها الطبيعية على مواجهة التحديات، وهنريك إبسن الكاتب البارز في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان من الرواد الأوائل الذين “كتبوا” المرأة وأعادوها إلى واجهة الحياة، فلقد كان يؤمن بأن المرأة لا يمكن أن تكون هي نفسها في المجتمع الحديث مع قوانين يضعها الرجال ومع المدعين والقضاة الذين يقيمون السلوك الأنثوي من وجهة نظر ذكورية، وبين هنريك إبسن ووحيد الطويلة قرابة قرن ونصف من الزمان وما زال الرجل يبحث في أغوار الأنثى ويتحدث باسمها ومن أجلها كأنها قضيته الوحيدة، فرحلة “نورا” في (بيت الدمية) تستكملها “مشيرة” في (كاتيوشا) وقد أصبحت كما صورها وحيد الطويلة قادرة على التعبيرعن نفسها والدفاع عنها بعد رحلة تاريخية خاضتها المرأة في سبيل ذلك، وربما لسان حال المرأة التي تابعت أحوالها التاريخية المتأزمة مروراً بهنريك إبسن ووصولاً إلى وحيد الطويلة يقول : نشكركم على دعمكم وتعاونكم.
هذا وتتطابق براعة وحيد الطويلة في النبشِ في نفس الزوجة والتعبير عما يعتريها من مشاعر الغضب والحيرة ودوافعها ومبرراتها، مع نظرية كارل يونج عن الأنيما والأنيموس والنماذج الأصلية، فطبقاً ليونج ثمة امرأة داخل كل رجل يسميها >>الأنيما << anima, وثمة رجل داخل كل امرأة يسميه >>الانيموسanimus << , وأنه لدى كل رجل خبرة لا شعورية أولية نموذجية خاصة بالمرأة, ولدى كل امرأة خبرة لا شعورية أولية نموذجية أيضا خاصة بالرجل، هذا وترتبط الأنيما / الأنيموس بحياتنا الداخلية أو الروحية، ليست الروح كما تُفهم في المصطلحات الميتافيزيقية كشيء يعيش على ما وراء وجودنا المادي بل الروح كما هو الحال في القوة الداخلية التي تحيينا، فالنفس هي التي تحتوي على المؤنث والمذكر وتحتضنه، إنه كيان مزدوج بطبيعته بغض النظر عن جنس الشخص المادي، هذا وتأخذ الشخصية بشكل طبيعي الدور الجنساني الذي ولدت له جسديًا، ليس دائمًا ، كما نعلم ، ولكن هذا هو الاتجاه الافتراضي العام، تأخذ المرأة دورًا وشخصية أنثوية ويأخذ الرجل دورًا وشخصية ذكورية وهذه النماذج الأولية العليا كما أشار يونج هي تعبير عن قوى روحية كامنة في اللاشعور الجمعي، وهي أيضاً تصورات واجه بها الإنسان الكون والطبيعة والمجتمع والطبيعة البشرية البيولوجية، وهذه الأنماط هي لا شعورية يمارسها البشر الطبيعيون في حياتهم اليومية، والأديب لا يكشف هذه الأنماط الأولية الكبرى، لأنه أصلاً خاضعاً لها من دون أن يشعر بذلك، فهو يتحرك في جغرافيتها، وفي حالة وحيد الطويلة هي الجغرافيا التي رسمها ودعمها الخيال الأدبي، وكلما لمع هذا الفهم لهذه الحبكة البشرية المدروسة سماوياً والمدعومة بالمنطق البشري كلما زاد حيز التسامح والموائمة والتفاهم بين الجنسين، وفي قول كارل غوستاف يونج، عالم النفس السويسري، أن في داخل كل ذكر «أنيما»، وداخل كل أنثى «أنيموس»، يفسر كيف أن وحيد الطويلة عندما يكتب بصيغة المؤنث فإنه لا يتقمّص أنثى أخرى لا يعرفها، فهي ليست دخيلة عليه فهي (هو) في صيغة أخرى ، والأمر باختصار هو أن «الأنيما» التي تسكنه تنادي وتصرخ على «أنيموس» أنثى ما، وعندما يكتب بصيغة الأنثى فإن جانبه الذكوري الطاغي يخاطب أنثى ما، فهو في الحقيقة وطبقا للرؤية اليونجية ينتمي إلى الاثنين، لأن كلاً منهما يُمثّل ظلّاً ساكناً داخله، وما فعله هو أنه جعل الظلّين يتكلّمان بصوت عالٍ.
(كاتيوشا) وحيد الطويلة هي رحلة نفسية مفتوحة النهايات، لم تخل من رومانسية، في قلب أنثى خاضتها في معترك شكوكٍ شرسة وصراع داخلي بين حبها لزوجها وصدمتها من حبه لغيرها و في سياقٍ واقعيٍ مُؤلم، اختبأ فيه الرجل/ رشيد خلف ظلها وترك البطولة الكاملة والسيطرة على الأحداث وتحليلها وتأويلها إلى أنثاه التي لا تكتمل سعادته بدونها.