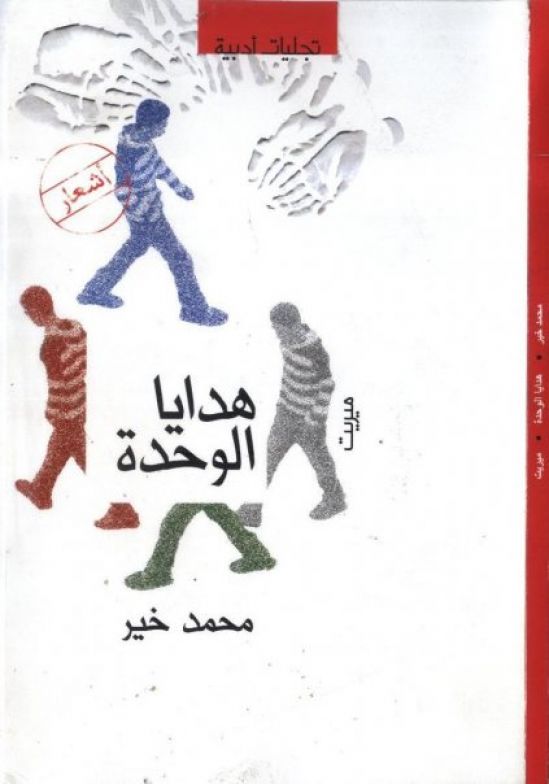كيْفَ يَكونُ جـِذعُ العُزلةِ بَديلي؟
قالتْ نخلةٌ
أسْنَدتُ حَيـْرةَ الـْمَرأةِ إلى غـَيْر جـِذعِها
في شـَذرةِ هَذا الصَّباحْ.
جذعُ نَخلةٍ ، فارعة ٍ
وخَلاءٌ فـَسيح،
وامرأةٌ عَجوزْ
تـَجْترُّ ذِكرى’ آصِرةْ
ربَّما هَذا ما تـَحْتاجهُ شَذرةٌ
لـِتكْتبَ عُزلتَـَها
في بَوارِ الكلِماتْ .
أسْتَـثني الـِّريح
في عَرْضِ هَذا الصَّباحْ
هُبوبُها لا يَعـْنيها
يُساقِطْ عليْها عَراجينَ بَلـْوى‘
تِلكَ المرأةُ التي ..
اسْتطابَتْ عُزلة المَـلِكاتْ.
أرسُم عـُزلتـَها، كـَما أشاءُ..
مِن جـِهات ٍ شتى
قد لا تـَعـيها؛
وتـَبْقى ، هِي، بكامِلِ أ ُنْسِها
عِندَ جذعِ النـَّخلةِ
اِمرأةً اقتَعَدتْ مَكاناً قـَصِيـًّا .
ربَّما ، كانتْ مَحْض كـَلمات ٍ
تُنَوٍّعُ عُزلتـَها
قدْ لا تـَحـْتاجُها المرأةُ التي..
ألِـفـَتْ شُموخَ النـَّخـْلة ِ..
في عـِزٍّ الخَلاءْ.
28.02.2018
………..
*شاعر من المغرب