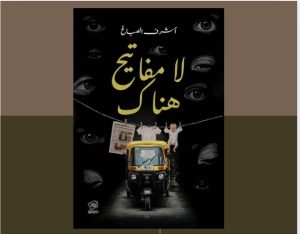إبراهيم فرغلي من الأصوات الروائية الراسخة في المشهد المعاصر، ينتمي إلى كتاب التسعينيات، راكم منجزا روائيا وقصصيا لافتا ومتميزا،
وهو من الروائيين الذين يمتلكون تصورا واضحا ومحددا لمفهوم الكتابة السردية، متكئا في ذلك على ثقافة رفيعة وعميقة في معظم حقول ومجالات الإبداع الإنساني هذا من جانب، ومن جانب آخر ينطلق فرغلي في مجمل مشروعه الأدبي من موقف نقدي حاسم من أشكال الكتابة السائدة سواء المعاصرة له أو السابقة عليه، وهو في هذا يشترك مع معظم أبناء جيله في هذا التوجه النقدي المباين والمفارق لمفهوم الكتابة بشكل عام والرواية بشكل خاص لدى من سبقهم من الكتاب.
وفي هذا السياق، يبدو فرغلي متميزا بالتعبير عن هذه التصورات في العديد من الحوارات والمناقشات والتعليقات التي راكمها على مدار السنوات الماضية، وبما يشكل مادة ممتازة تكشف عن وعي الكاتب وثقافته وملامح رؤيته النقدية، وبما يجعلها عنصرا محوريا في تشكيل تجربته الإبداعية ككل. أيضا وفر لنا فرغلي كذلك مادة رائعة من خلال الشهادات التي كتبها ونشرها في مناسبات عدة، أو تعليقا على قضية من القضايا التي تشغل مجتمع الكتاب والروائيين في العموم.
لا تسعى هذه القراءة لأن تقدم تحليلا وافيا لمجمل التصورات النظرية التي تشكل مفهوما واضحا للكتابة/ الرواية، أو حتى الزعم بأنها ترقى إلى مستوى “الدراسة”، لكنها لا تطمح إلى أكثر من استكشاف بعض الملامح وإلقاء الضوء على بعض الأفكار البارزة في هذه التصورات، من خلال قراءة أولية لما كتبه فرغلي خارج دائرة الإبداع، المادة التي وفرتها شهاداته الروائية وبعضها مبثوث أيضا في حواراته وتعليقاته النقدية أو في القراءات النقدية التي قدمها فرغلي لأعمال روائية تنتمي إلى تيارات ومواقف كتابية مختلفة.
ومن ثم تتيح هذه القراءة إمكانية مستقبلية لفحص هذه التصورات وتحليلها والنظر في مدى تحققها أو تجسدها إبداعيا في مجمل أعمال إبراهيم فرغلي الروائية والقصصية.
وأزعم من خلال استقراء هذه المادة أن لإبراهيم فرغلي موقفا واضحا من شكل وتأثير الكتابة في الأجيال المختلفة (السابقة عليه أو اللاحقة له) بشكل واع وقدرة نافذة على التحليل والفرز، كما أنه يتبنى موقفا نقديا حاسما من كل الأشكال الكتابية التي لا يتحقق لها شرطها الإبداعي “الشرط الأول لأي كتابة هو امتلاك لغة خاصة وأسلوب يقترب من أن يكون رفيع المستوى”؛ هذا الشرط الذي استخلصه من قراءاته الواسعة للرواية، وأيضا استطاع تجسيده عمليا في إبداعاته الروائية وفق مفهوم خاص للتجريب ألحّ عليه كثيرا ومارسه بتنويعات مختلفة.
كما يظهر من خلال هذا الشرط الإبداعي موقفه القاطع الرافض لكتابة “البيست سيللر”، التي هاجمها مرارا وانتقدها كثيرا، بل انتقد بشدة حتى من تعاملوا معها بقدر من التسامح أو اللين، وله في هذا كتابات عدة جديرة بالقراءة والتحليل.
يتبدى هاجس البحث عن السؤال الإشكالي “ما الكتابة؟ وما جدواها؟” ملحا وفي فترة باكرة خلال ممارسة فرغلي للكتابة قبل ما يقرب من عشرين عاما “كلما استعدت فكرة قراري أن أصبح كاتبا في يوم من أيام عام 1986 وحتى اليوم، يؤرقني السؤال حول معنى الكتابة وجدواها في عالم كعالمنا” (من شهادة روائية منشورة بجريدة الشرق الأوسط تحت عنوان «في مأساة أن تكون كاتبا عربيا!»، 10 أبريل 2013).
ويبدو أن الوعي هنا كان في حالة استنفار دائم، لا يقنع بإجابة مريحة ولا جاهزة، ولا يقبل باستدعاء إجابات مكررة ونمطية بل سعى وعي الروائي، ومنذ لحظة التأسيس الأولى، ومنذ أن طرح السؤال إلى ضرورة البدء في خوض رحلة طويلة ومستمرة ومتجددة لتشكيل ملامح رؤية خاصة وبلورة مفهوم محدد للكتابة يقوم على ثلاثة عناصر متضافرة ومتراكبة معا؛ تتلخص في الآتي:
أولا: البحث عن تصور للفكرة الأدبية في ذاتها (يؤكد فرغلي دائما على ضرورة تحرر هذه الفكرة الأدبية من الأطر الضيقة وتخليصها من رواسب الأيديولوجيا والربط التعسفي بين رؤية الكاتب والمجتمع والإخلاص لمعناها الإنساني الشامل)، بمعنى تحديد الهم المؤرق الذي يشغل الكاتب ويلح عليه كي يصوغ سؤاله جماليا في عمل روائي.
ومن هنا يبدو فرغلي واعيا بضرورة اتخاذ موقف نقدي واع من أشكال الكتابة السابقة عليه تحديدا من مجمل التجربة المحفوظية وحتى كتابة الستينيات، وصولا إلى الكتابة الرائجة “البيست سيللر” أو ظواهر الكتابة الجديدة التي يغلب عليها الخفة والابتذال والركون إلى الاستسهال، وسيتضح أن لفرغلي موقفا محددا وقاطعا تجاه هذه الأشكال من الكتابة.
ثانيا: البحث عن جوهر المعاناة الإبداعية في الصياغة الجمالية للعمل الروائي، وهو الذي حدده فرغلي في “امتلاك لغة خاصة وأسلوب يقترب من أن يكون رفيع المستوى”، وهو ما ترتب عليه إضافة قيمة جديدة للكتابة “تحاول أن تميز بين نبرة الصدق الفني والافتعال، وتؤسس لأن تكون الكتابة مركبة لكنها غير مفتعلة، وعميقة بلا ادعاء، كاشفة للسطحي والمبتذل“.
ثالثا: اختطاط مسار للتجريب يقوم على الوعي باللحظة المفارقة لاستيلاد نص إبداعي، متميز بسؤاله ولغته وجمالياته الفنية.
في ظني أن هذه العناصر الثلاثة تشكل جوهر رؤية فرغلي للكتابة وما يحوم حولها من قضايا وتفريعات، ولعل هذا يتضح من قوله “فكرة الكتابة تحولت إلى فعل لأول مرة حين انبثقت من التأثر بموقف إنساني رأيته وانفعلت معه وقررت صياغته بشكل فني. لكني حين شعرت بأن موضوع الكتابة ليس مجرد نقل لمواقف من الحياة، خصوصا أنني كنت مولعا بقراءة الروايات العالمية منذ صغري، وأعرف أن هناك تراثا رهيبا من النصوص التي تعتلي قمم الاحتراف الأدبي. كان عليّ أن أتحرر من موروثات كثيرة لتحقيق فكرة الكتابة، التخلص من نبرة محفوظ التي كنت متعلقا بها ومقلدا في تلك القصة الأولى التي كتبتها، وأن أفهم أن نقل الواقع ليس هو المعنى الحقيقي للكتابة، وإنما إعادة كتابة واقع فني مواز، وهو ما اقتضى سنوات من الكتابة التجريبية، أنجزت فيها نحو 50 نصا، مزقتها كلها تقريبا لاحقا. فقد كنت أبحث عن صوتي الخاص، ومعجم خاص، ونبرة خاصة للكتابة، واستلزم ذلك جهدا طويلا“.
يبدو هذا النص على كثافته كاشفا عن وعي مؤرق بضرورة استيعاب “التراث الرهيب من النصوص التي تعتلي قمة الاحتراف الأدبي” كخطوة أولى في عملية الإعداد والتكوين للكاتب، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن هذه الخطوة لن تكتمل ولن تكون ذا فعالية دون أن تتلوها خطوة “التحرر من موروثات كثيرة لتحقيق فكرة الكتابة“.
يحقق فرغلي هذه الخطوة عمليا في مكابدة التخلص من نبرة محفوظ، والتي في ظني جاءت متجسدة في «أبناء الجبلاوي»، فرغلي لم يقتل محفوظ بل احتواه واستوعبه وقرر إعادة تشكيل منجزه (الذي يعلم يقينا أنه أهم منجز روائي عربي في مسيرة الرواية العربية) ليخلق تجربة روائية فريدة تستحق أن يفرد لها كتاب نقدي كامل وشامل وليس مجرد دراسة محدودة.
لم يكد فرغلي يتخلص من “نبرة محفوظ” حتى استبان له ومن واقع قراءة عميقة ومستوعبة لأعمال كتاب الأجيال التالية “الستينيات”، ضرورة التخلص أيضا من إرث هذه الكتابة لا بتجاهلها أو التغاضي عنها أو إهمالها بالكلية لكن بقراءتها نقديا بصورة تثير الإعجاب.
في مناقشة مفتوحة عبر الواقع الافتراضي قبل عدة سنوات، سجل إبراهيم فرغلي حزمة من الأفكار والانتقادات لكتابة الستينيات، وتأسيسا على هذا الانتقاد بنى فرغلي تصوراته للكتابة كما يرتأيها، ففي نظره أن “مشكلة جيل الستينات أنه اختزل الثقافة في فكرة واحدة هي فكرة (الوطنية) وهذا في الحقيقة لا علاقة له بالفكرة الأدبية في معناها الإنساني الشامل. وهذا على وجه التحديد ما جعل أفق أعمالهم تضيق، وهذا أيضا أهم اختلاف لجيل التسعينيات عن جيل الستينيات“.
يبدو فرغلي واعيا بشدة بفكرة التباين بين مفهوم للكتابة يركز على الحس الوطني وهموم وقضايا المجتمع وينضح بالأيديولوجيا ودماؤه السياسة، وبين مفهوم متحرر يسعى للتخلص من هذه الرواسب ويقارب الفكرة الأدبية في معناها الإنساني الشامل من حيث الاحتفاء الشديد بالفردانية والإعلاء من حرية الفرد وتمجيد التعدد والتنوع والبحث عن الاختلاف وخلق النبرة الخاصة بكل كاتب على حدة.
وعلى هذا يأتي تساؤله في هذا الإطار “ما هو إنجاز جيل الستينات عالميا في منتج الإبداع العالمي؟ ولماذا دارت النصوص في حقل الحواديت، والحكايات، ولماذا اقتصرت النصوص على النظرة المحلية الشيفونية المغلقة على ذاتها وعوالمها التي لا تشترك مع الهم الإنساني العام كما هو شأن المنتج الأدبي العالمي الذي نقرأه مبهورين كل يوم؟”.. لا بمنطق طلب الإجابة أو البحث عنها، بل بمنطق طرح الإجابة من خلال السؤال على طريقة “الحدق يفهم“.
وربما تكون عبارته القاطعة المانعة “نحن جيل فردي لم يمتلك قاطرة سياسية تدفع به كما كان شأن جيل الستينيات”، هي المجسدة لما أراد الانطلاق منه والوصول إليه لكي يؤسس لمفهومه الخاص بالكتابة (ويشترك معه عدد كبير من كتاب التسعينيات)، يقول “في الكتابة الجديدة أحب أن أفرق بين تجارب التسعينيات وبين كتابة جيل ما يطلق عليه ما بعد الألفية والذي يعيش حالة من العبث وتصدير الإحساس أنه لا يعبأ بشيء ألبته وغير مكترث بأي قضايا من أي نوع. أما كتاب التسعينيات فهم على العكس تماما لهم مشروع فني واضح فالموضوعات بالنسبة لهم تكأة للتجريب وتأسيس أشكال جديدة في الكتابة“.
ويستشهد فرغلي في هذا السياق بتجارب مجايليه مصطفى ذكري ومنصورة عز الدين وياسر عبد اللطيف وياسر عبد الحافظ وحمدي الجزار ويوسف رخا. ويشدد على أن الإضافة المهمة لهذا الجيل تتركز في تأكيد أن الأدب همه فني أولا، وإنساني ثانيا، والوطنية قد تكون جزءا منه وليست كل شيء.
ويزيد فرغلي هذا المفهوم جلاء ووضوحا بإشارته إلى أنه قرأ عددا من الأعمال التي “جعلتني أشعر أننا في مصر ابتعدنا تماما عن مسار فكرة الرواية بالشكل الذي تطورت به مسيرتها في الغرب، وزاد الطين بلة أن ظهرت بعض التجارب التي جسدت الارتداد بالرواية مرة أخرى إلى “عصر الحدوتة”، ولاقت جماهيرية جعلت البعض يتصورون أن مثل تلك الظواهر انتصار للخفة والبساطة“.
هكذا يبدو المفهوم واضحا وحاسما ومحدد المعالم، في إطار تصور نظري ناضج ومؤسس على حوار عميق بين الذات والموضوع واستجلاء تجارب الكتابة في الأجيال السابقة واللاحقة على السواء.
وإشارة فرغلي إلى ما أسماه “كتابة جيل ما يطلق عليه ما بعد الألفية”، لم تأت من فراغ ولا باستقراء قاصر، فإبراهيم فرغلي من الكتاب الذين يمارسون النقد العملي، وهو نفسه قد أشار إلى هذا الدور الذي راكم فيه قراءات غزيرة ومتنوعة لعدد كبير من النصوص، يقول “مارست دورا في الكتابة عن الكثير من الأعمال لأجيال مختلفة، وقدمت نقدا لكتابات كثيرة من البيست سيللر، في وقت كان الكثير يفضلون التحسس أو الدعم غير المباشر لمثل هذه الكتابة وخصوصا كتابة علاء الأسواني ويوسف زيدان، ومع ذلك وكما أقول دائما أن الكتابة عن أعمال أدبية من قبل الصحافة الثقافية اليوم ومنذ سنوات، في الصحافة المصرية واللبنانية هو محاولة لتعويض غياب النقاد الأكادميين والمتخصصين“.
هذه مجرد إشارات، محاولة أولى تطمح إلى لفت الأنظار إلى أهمية البحث عن التصورات النظرية القارة في وعي/ ولا وعي الكاتب المعاصر، لتأسيس معرفة ضرورية ولازمة بجانب من جوانب الإبداع الروائي والنقدي معا. ولعل تجربة إبراهيم فرغلي هنا من أكثر هذه التجارب ثراء ووفرة وتعكس الجوانب المتعددة لثقافة الروائي المعاصر حينما يكونُ “المثقفَ” بألف لام التعريف، وليس “مثقفا” فقط.