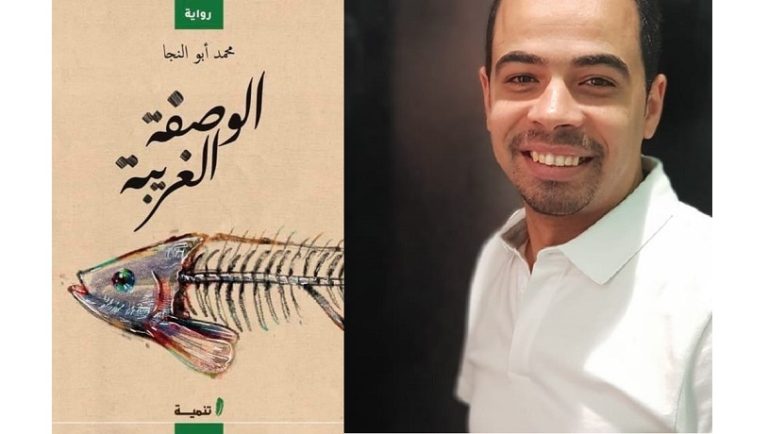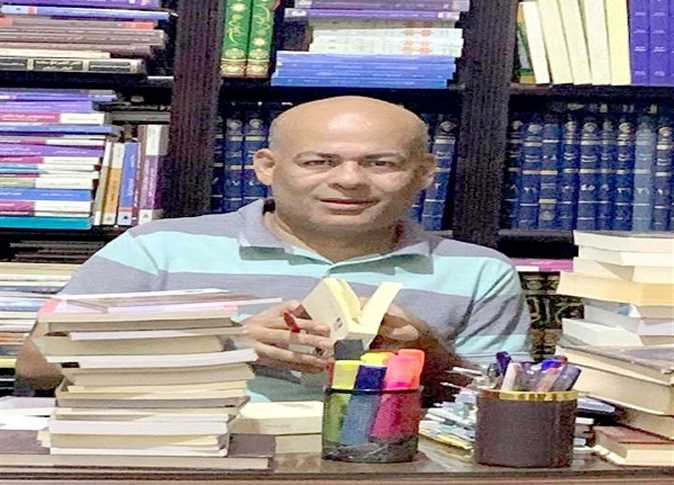أحمد ثروت
1- صرخات متتالية تقطع صمت الصباح الباكر، يجيبها مواء قطة متلاحق حاد. لقد استبدل انذار السيارة” البيجو القديمة، مثل كل شيء تم استبداله فيها أكثر من مرة، اختفت علاقتها بفرنسا وبشركة” بيجو” تماماً، من زمن لا يتذكره. عمرها يفوق الخمسين عاماً، وهو يقودها منذ أربعين عاماً، ينظفها و يحميها و يحبها. قضى اليوم السابق جائلاً بين ورشة” الميكانيكي” و”المخرطة” و مخازن قطع الغيار المستعملة. يروح و يشتري و يستبدل و يعاون
“الصنايعية” في انهاء عملهم؛ حتى لا تزيد الخسائر، ويضطر لايقاف عمله يوماً جديدا. لكن “صبياً” من صبية صديقه الميكانيكي، قد عبث في جهاز الانذار أمس؛ فزاد حساسيته، حتى أنه انتفض لمجرد عبور قطة جوار السيارة العجوز، هذا مبرر الصوت الوحيد، فلا مخلوق يجروء على الاقتراب من السيارة، الساكنة أمام بوابة المنزل تماماً، المنزل المضاء ليل نهار، الضاج بالأطفال اليقظين طوال الوقت، و النسوة اللاتي يمارسن زعيقاً كملحمة يومية. لكنه لم يترك نفسه لشك ولو ضئيل يقلقه الساعة القادمة حتى ميعاد استيقاظه، ارتدى طاقية صوفية ثقيلة وسحب مفاتيحه، ثم نزل ليطمئن على محبوبته و رفيقة أيامه. حين وجدها ساكنة في موضعها ربّت بكفه الغليظ على” كبّوت” السيارة ناظراً إليها بحنان أبوي، بنظرة عاشق لمحبوبته الغارق في عينيها و عالمها، لكنه لم ينس أن يجهر بعدائه للشارع و مَن به مِن” شوية بهايم”.
ارتبكت البداية بسبب الانذار الناعق و المواء الحزين، حوصر بنوم متقطع لا يحبه، لكنه يستمر في ممارسته، علّ النوم يشفق عليه مرة، فيطيل زيارته أو يؤبدها. لم يمارس خطوات استيقاظه المحسوبة فانزعج، لكنه حتماً صعد سريره مرة أخرى، مكث خمس دقائق تامة يتأمل البرواز الضئيل المتكيء على مسمار كزاوية قائمة، تمعن في الآية القرآنية المكتوبة بخيط ذهبي، ثم أعاد بدء صباحه كما يبدأه يومياً فأغلق المنبه و لبس “الشبشب” المنزلي المتآكل، ثم اتجه للحمّام بتثاقل معتاد. أكمل طقوسه.
لحظة فتحه الباب، ظهرت زوجه تكرر عليه لزوم واجباته آخر الليل، كان يتأفف بلا صوت، عاقداً حاجبيه، كأنهما اتصلا بأنفه، نزل سلمتين فقط، فتح البوابة، ثم ألقى نفسه طالباً الراحة في عربته العتيقة .
استغرق وقتاً أكثر مما اعتاد يستمع للمحرك الزاعق دون حركة، يُطمئن نفسه على سلامة كل أجزائها، قبل المضي في مساره اليومي، يتنصت لصوت سيارته، يحلله، و يكاد يتذوقه و يشمه، بسمل و حوقل، رافعاً صوت المذياع بالقرآن، نخر و بصق في الشارع القذر، و سُمع صوت عجلات محتكة بالأرض ببطء.
2- الوقت يعدو و لا تظهر عربة واحدة، تذكرت خبراتي هذه المرة فخرجت باكراً بفترة كافية، لكن التمشية أو ركوب الميكروباص لن يزيداني إلا إرهاقاً، و لن يُنقصان مني إلا وقتاً متاحاً أفقده. إن وصلت متأخراً خسرت نقطة. ربما يتم رفضي أساساً. حينها سيضحك أبي ناظراً لي بجانب عينه، جامعاً كل سخرية العالم موجهةً نحوي. لن أتحمل ذلك مرة أخرى، فقد اكتمل غيظي، وزال تحملي، ولن يخرجني من سلطانه، سوى عمل يمنحني أجراً أعلن به استقلالي. الميزة الكبرى أجر يومي.
لمحت السيارة المتهالكة كرأسي تتأرجح من بّعد، لم أتردد، أشرت للسائق، ترسم خيالاتي سيارته تنقذني،
و تمنحني مستقبلاً أرنو إليه.
لا أعرف من أي ناحية تأتي نظرات ثقة السائق، عجوز كسيارته، تبدو كسيارة يتم تحميلها “بالنفر”، صوت الموتور مرتفع يتردد كالصدى، المقعد يئز و يزّن من كل اتجاه، لكنها الأمل المتاح. لا وقت لدقة الاختيار. حين سألني عن وجهتي أجبته تفصيلياً، فانطلق مختاراً بداية غريبة، نبهته أن اختياره لا يؤدي لوجهتي، لكنه ابتسم مومئاً..
– لا تقلق، أحفظ مداخل و مخارج المدينة كأصابعي، سأوصلك قبل موعدك بفترة.
3- دُهش السائق العجوز من ردة فعلي، إجابتي مفحمة. لم ينطق ثانية، بينما استمر في النظر نحوي كلما سنحت له الفرصة و خلى الطريق أمامه، كان يسمعني منتظراً؛ ليُتبع إجابتي بفيض من الأسئلة، أو بنصائح واضحة عن الاستفادة بالوقت في حياتي قبل مرور الزمن. غالباً سيحاول أن يحكي لي انحرافه عن الصراط شاباً، و كيف اهتدى لصواب الطريق. لم أمنع عنه فقط الاستمتاع بالحكي و اسداء النصائح، بل أوقفته إجابتي تماماً عن التفكير في تطوير حرفته لوعظ الركاب، حين خاب تخمينه أنني مجرد تائه، ينتظر الوصول لدعائمه المستقرة في بيت والد أو مأوى صديق، كان ينظر إلى وجهي لحظة، ثم يعيد بصره نحو الطريق، غارقاً في أفكاره المتتابعة، (ماذا يفعل هذا” الطفل” بي.. كيف حبس أفكاري ووأد ابتكاري فجأة؟)، أما أنا فلم أكن ألتفت نحوه، أُظهر اهتمامي بالطريق، بينما سيجارتي في يدي اليمنى، معلقة بين إصبعيّ خارج النافذة، لا أدخنها و لا أطفئها، حيث اكتفيت بإجابتي عن سؤاله المعتاد المضطرب بإجابة أعددتها بتأن و ابتكار حذرين..
– بتدخن ليه ؟
– مرقعه ..
مضت ثوان حسبتها سنوات، سيجارتي المدلاة في الخارج أشعلتها، حتى لم يتبق منها سوى اسفنجة صفراء قاحلة، وضعتها بين شفتيّ، سحبت نفساً قصيراً حاداً، رميتها موقناً يقيناً غرائبياً بعدم دهسها حتى تمام احتراقها. كنت مستعداً للنزال من لحظة ركوبي التاكسي المتهالك، فالشعر الأبيض المتناثر، و الحاجبين الملتقيان عند نهايتهما أعلى الأنف، القميص المكرمش، المختبيء في البنطلون القماشي الباهت، كل هذا كان يُحيل ذاكرتي لشخص طالما قهر روحي و طمس شخصي. كنت مستعداً تماماً للثأر.
كان الكهل جاهزاً كعادته هو و فصيله لاصطياد الطرائد أمثالي، كان الكهل ينتقم من الحياة، التي يُحمّلها عدم نجاحه في أي اختبار أو سباق شارك فيه، أو شاهده، كان يرى فيمن يماثلونني طبعةً من طبعات الحياة التي حاربها فهزمته، حين يرانا نحتضنها و نُقبّلها و نحلم بها، تنهار روحه التي اعتادت العراك من لحظته الواعية الأولى، كان يراها عدواً واجبٌ أن تحاربها، و إن لم تسطع هزيمتها. بينما كنت أراها حبيبة تمنحني الكثير، كل ما تطلبه مني تمنحه لي مرة أخرى في أمثلة متباينة، فأحببتها و استمتعنا حتى بهزائمنا، لا يشغلني أطالت رفقتها لي أم قصرت، ففي كل لحظة سعادة تتحقق و حلم يبدو.
كانت إجابتي على السائق الخمسيني قد وضعته أمام روحه و حياته فوراً.
** أيهزأ الصبي مني، أم يهزأ من نفسه؟ أيهزأ من أنفسهم غير الخاسرون؟ أسعى كل لحظة مكافحاً في الملكوت ليهزأ مني هذا الرضيع، أأعجز عن طرح هذا الطفل – ذو الشعر الأضخم من رأسه– أرضاً؟ هل أطرده من السيارة؟ سيحسبني ساعتها ضعيفاً مهتزاً أهاب عراكه، سيثق في نفسه أكثر، ويلاحقني بضربات متتالية لا أستطيع معها صداً ولا رداً، هل أفاجئه بسؤال آخر لا يستطيع معه نطقاً، ماذا لو استفزني مرة أخرى بإجابة كالسابقة؟ لم أنسحب من معركة يوماً، لم أهتز أمام خصم، رغم خسارتي كل حروبي لكنني ما استسلمت أبداً، ولن أستستلم لهذا الحالم بحياة مُتخيلّة، سأوقظه من أحلامه الملونة على حقيقة حادة كصخرة، آن لي أن أستدعي لحظات ذروتي، و تجاربي مع أمثاله، سأباغته بما لا يستطيع معه قولاً، و لن يجد من لدنه عذراً، سيطأطيء رأسه، واضعاً كفيه المشتبكين خلف قفاه، و سيطلب مني عفواً، سأفكر حينها أأمنحه أم أتركه مغموراً في التجربة– التي ستعلمه الكثير– قليلاً.
** في هذه الدقائق التي كان ينظر لي فيها السائق، كنت متأكداً أن أفكاره تجتمع و تمتزج، لتصنع مُرّكزاً يحاول به استعادة مركزه المفقود. كنت في انتظار محاولته، آملاً نتيجة تهبط به من مستقره درجات أكثر لأسفل، ربما يقرر الانسحاب حينها وتركي أستمر في رحلتي، دون سُلطة كمطرقة، تقرر تأسيس تجاربها البائسة مقياساً لحياتي، كنت في انتظاره وكان في انتظاري، كانت عيناه تفحصان ملابسي وجلستي ونظراتي، كان يدقق في كل خلية مني وكل بقعة تحيطني. حين استعدّت شفتاه للحركة، بادئاً معركته التي استعد لها حتماً، كان بريق عينيّ يضيء اللحظة أمامي، روحه متقدة ملتهبة، جاهزة للمعركة، روحي تتسع في محاولة لاستيعاب كل ممكن أو محتمل. بدأت المعركة بين عيوننا للحظات تمهد للمشهد المُنتَظر، كان الطريق المحبب أمامنا مستقيماً لمسافة كبيرة، وخالياً من أي عائق، فصار الوضع مثالياً لعراك يستمر كما نشاء، المدينة بعيدة، لن تظهر أمامنا سيارة واحدة طالما استمر تحركنا بهذه السرعة المضغوطة من أعصابه الملتهبة.
بعد لحظات أو دقائق أو ساعات، مرّ وقت لم أستوعبه و لم يستغرقني. كنت متأكداً أنه على الأقل غضب مني، إن لم يكن قرر انتقاماً مريعاً؛ بإبعادي عن وجهتي، فأشرت إلى الطريق بتوتر، مستفسراً عن اتجاهاته الغريبة. حينها نظر نحوي بطرف عينه مستمراً في القيادة، و هو يدندن بصوت مبحوح:” اجري اجري اجري.. وديني أوام وصلني”، ثم همس بروية
” قلت لك مداخلها و مخارجها، أنا أدرى بطريقك يا عسل”.