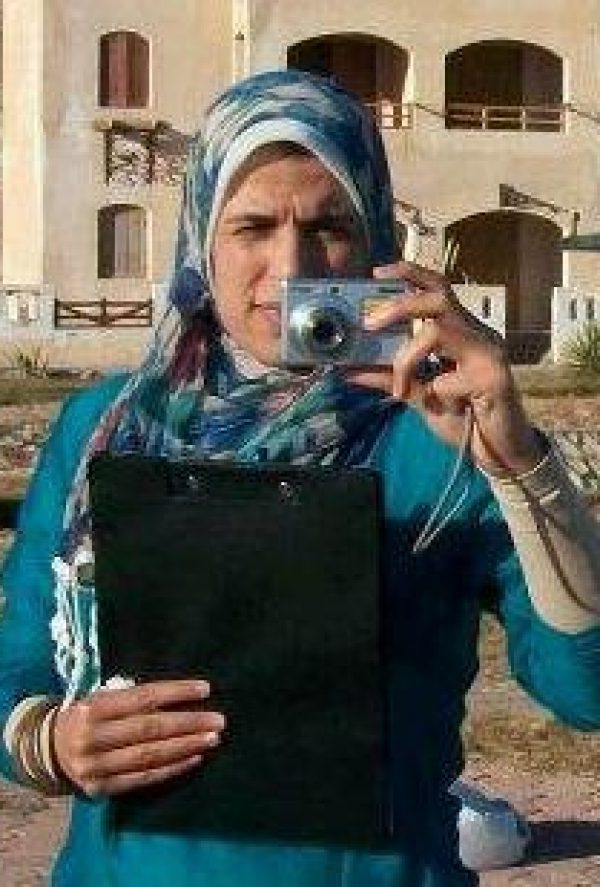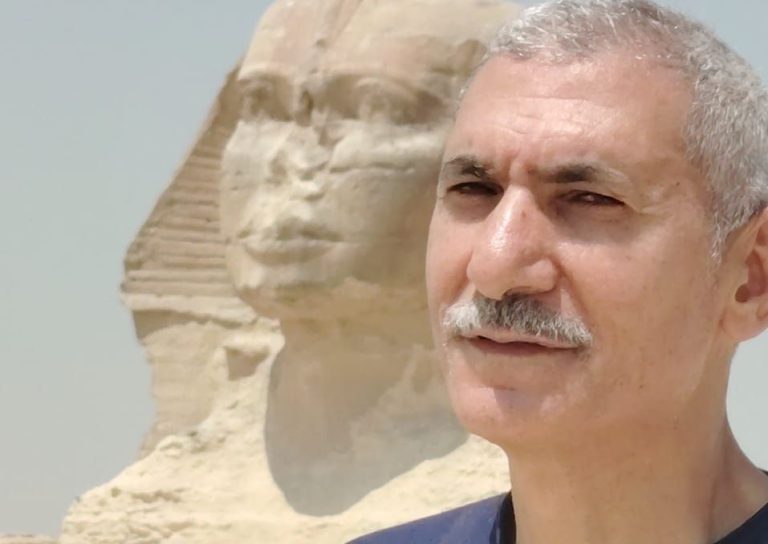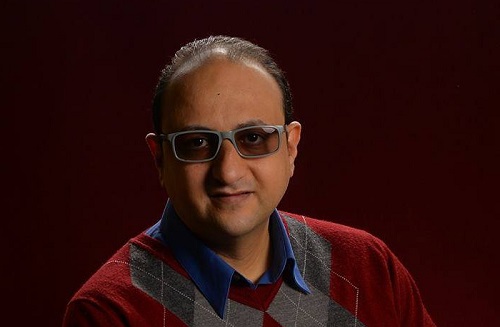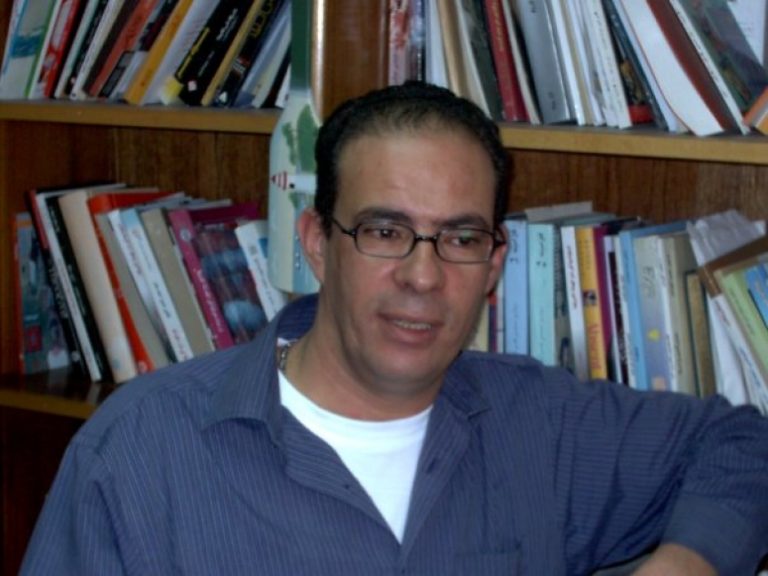ومن خلال كتابة اليوميات تفهمت كيف كيف تكتب تجربة تبدو عادية مجردة من كل “الإغراءات” الفنية، تجربة تكاد تكون “ملقاة على الطريق” بالفعل، وفي الوقت نفسه تستطيع أن تكشف أن هذه العادية هي مجرد تمويه أو ستار يخفي وراءه مستويات أخرى أكثر عمقاً، ما يبدو أنه عادي يتآلف معه القارئ من خلال النص، ويكوِّن معه ذاكرة من خلال النص، عكس الأحداث العظيمة والشخصيات المحملة بدلالات يتعرف القارئ على جزء منها قبل القراءة. في ” خروج إنسان ” القصة الأولى في مجموعة “شخص غير مقصود” عام 1999، خرج شخص يبحث عن هدية لحبيبته، وهي المرة الأولى التي يخرج للبحث عن هدية، حاولت الاقتراب من هذه النوعية من الشخصيات التي لا تملك إلا هذه الجزئيات العابرة، وفي الوقت نفسه تمثل محطات ولحظات مهمة في حياتها ، من خلال هذه الكتابة انتبهت إلى أنه من الممكن أن تكمن الغرابة داخل ما هو عادي، ولا أقصد العجائبي أو المفارق لقوانين الواقع وإنما الذي لا نستطيع تصنيفه ووضعه في خانة من الخانات المتعارف عليها، وشعرت أن هذا الغريب هو الذي يجعل رحلة الكتابة أكثر إمتاعاً لأنك تبدأ بالعادي وتحاول التنقيب فيه إلى أن تصل إلى المستوى الكامن فيه، في روايتي الثانية “أن ترى الآن” عام 2002 ، كتبت عن “إبراهيم” هذه الشخصية التي تكاد لا تملك أي شيء تتميز به إلا النسيان، مازال في منتصف العمر لكن الأشياء تهرب من ذاكرته، وهو في منطقة بين بين: في العمل وفي اختياراته في الحياة وحتى في علاقته بالمرأة، أو هو شخص في مفترق الطرق بدون أن يكون قد حدد أي طريق يختار، هو يعيش حالة مفترق الطرق هذه، وأكاد أشعر أحياناً بأنها ليست حالة فقط، بل هذا هو توصيف حياته أو اختياره الحياتي. في الوقت نفسه لا أقصد من هذا بأنه في الرواية يحاول ـ بعد حدث تشويه الصور وانهيار علاقته بزوجته ـ أن يبدأ في إعادة النظر في الأشياء من حوله، ربما هذا موجود على مستوى من المستويات، لكن هذا لا يشغل الرواية التي تنشغل أساساً بمحاولة قراءة هذه الشخصية التي ـ رغم ما تعانيه من “تخبطات” و”انهيارات”ـ لا تبادر بالفعل، هي تعيش في مرحلة كأن كل ما يحدث حولها بديهي! كنت احاول قراءة هذه الشخصية في تفاصيلها التي تبدو عادية، ومع التركيز عليها تبدأ تخايلك بأن غرابة ما تسكنها وتدفع إلى إعادة النظر في عاديتها أو في معنى تلك العادية.
وتشترك اليوميات والرواية في أن الراوي لم يعد يطمئن إلي صفات يعرفها عن نفسه ويحاول أن يبرهن عليها في مواقف سردية، بل صار الراوي يبحث عن صفاته هذه، ويحاول أن يكون في حالة عمل باستمرار، فما يتكشف له من خلال الحكي دعوة لمواصلة البحث وليس للتوقف عند ما توصل إليه، في روايتي الثالثة ” مسألة وقت ” عام 2008 ، كانت لدي يحيى الشخصية الرئيسة في الرواية مشكلة دائمة مع الوقت، فهو يعاني دائما من فروق التوقيت بينه وبين من حوله، ففي الوقت الذي تكتمل لديهم الأشياء يشعر هو دائما بأنها لم تأت بعد، وفرق التوقيت هذا هو الذي جعله يتحير عندما اكتشف أن ” رنا ” التي زارته فجأة في منزله، كانت ميتة قبل الزيارة بثلاث ساعات. كان يظن أنه على مشارف علاقة حب أو حلم و إذا به يفاجأ بالنقيض، فداخل يحيى يتعايش الموت والحياة جنبا إلي جنب وفي اللحظة ذاتها، وقد تكون المسافة بينهما تكاد تكون معدومة لأنهما يتبادلان لعبة الكراسي الموسيقية. عالم يحيى يبدو عاديا وأقرب الى المنطق الواقعي لكن تأتي حكاية ” رنا ” لتخلخل كل هذه العادية والأحداث المألوفة كل يوم، وتجعل كل ما يعيشه هذا الشخص رغم عاديته يصير على أرض غريبة وتصير الكلمات التي تقال كل يوم لها معان مختلفة، فيحيى يعيش بين الناس ويذهب إلى عمله يوميا لكنه يحمل داخله حكاية نقيض كل ما يحياه.
…………………..
سمات عديدة ممكن أن أرصدها في الروايات الجديدة التي ظهرت في السنوات الأخيرة. ومن تلك السمات أن ” البداية ” في هذه الروايات تبدو احتمالا من بين احتمالات عديدة ممكن أن تبدأ بها الرواية. فمنطقة البدء أصبحت منطقة صراع بدايات كل منها لها مسارها الخاص وكل منها يعي بوجود احتمالات أخرى للبدء. فالراوي لا يستطيع الاستقرار على بداية بعينها ولا يريد أن يظهر بمظهر الواثق المالك لعالمه الذي ينفلت من بين يديه أو المتسم بإمكانيات متصارعة. فليس المركز شخصا بعينه، هوية محددة بل اللعب بالمراكز والهويات وتجريب الحضور العابر المرتحل دون توقف.
والسمة الأخرى الواضحة في عدد كبير من روايات: تأملها لحكاياتها وطريقة أو طرق حكيها داخل الرواية نفسها، فالراوي يعرض أمام القارئ احتمالات التجربة المختلفة وحيرته في تتبع أي منها، ويطرح أسئلته علي الكتابة نفسها والمعوقات التي تواجهه في إكمال الحكاية، وليس كل هذا مجرد حيلة شكلية، إنما في صميم رؤيته للكتابة: إنها بحث عن الحكاية، وأن الراوي يصحب القارئ معه في رحلة تتكشف له مراحلها أثناء رحلتهما، لذلك قد تتعدد الضمائر التي تحكي الحكايات: ضمير المتكلم، الغائب المخاطب، ولا نقدر علي تحديد أي منها يمثل مركزا للحكي.
والكثير من الروايات الأولى للكتّاب الذين ظهروا في السنوات الأخيرة كانت تستمد تجاربها من سيرهم الشخصية إلي حد تعامل عدد من النقاد مع تلك الروايات علي أنها رواية سيرة ذاتية ، وليس المهم أن هذه السمة كانت قاسما مشتركا بين تلك الروايات وإنما الجدير بالانتباه كيفية تعامل الروائيين الجدد مع تجاربهم الشخصية، فالذات في تلك الروايات لم تعد تطمئن إلي صفات تعرفها عن نفسها وتحاول أن تتأكد منها من خلال البرهنة عليها في مواقف سردية، بل صارت تلك الذات تبحث عن صفاتها هذه،لذلك لم يعد سهلا التعامل مع الذات بصيغة المفرد، فتعدد أشكالها أو تعدد ذواتها أصبح مسعى أساسيا في تلك الكتابات، وليس بهدف توحيدها في النهاية أو جمعها في سلة واحدة بل التأكيد علي تعددها، وعلي اختلافها وعلي عدم استقرارها تحت مسمي واحد، بالإضافة إلى أن الكتابة الجديدة دائما ما تدفع القارئ إلى القلق من بطل/ أبطال الحكاية إذا جاز الوصف – الذين يفلتون أو يراوغون دائما أية منظورات أو رؤى مسبقة. ويعيش هؤلاء الأبطال لحظات ممكن أن نسميها اللحظات المجازية، استعارة أو تشبيهاً يتم التغافل عن مجازيته، أو تم تناسي أنه مجاز أصلاً ويصير لحظة يعيشها الراوي وكأنها من صميم تكوينه أو طبيعته، فتلك اللحظات المجازية هي وجوه مختلفة عن حياته وقد تكون تلك اللحظات ما تشكّل رؤاه وما ينوي أن يفعله. وهي ليست فقط توضيحاً لسمات شخصيته بل هي ما يعيشه فعلاً، ويتعامل معها ليس كاستثناء في حياته بل أجزاء أساسية في نسيج حياته. فتلك اللحظات بدلاً من أن تكون على الهامش صارت أو كادت أن تكون محركاً للأحداث، ودافعاً للفعل، وبدلاً من عبورها ليحكي ما سيحدث صارت هي ما تتوقف عنده الرواية وتجذب إليه الأحداث.
ويغلب علي الروايات الجديدة، البناء المقطعي أو الفصول القصيرة التي تكاد في معظم الروايات أن تكون مرقمة، وتمثل لحظات أو مشاهد من التجربة الروائية لا تتصل بعلاقات سببية، بل بعلاقات كيفية مرتبطة بتتبع عدد من الثيمات، واختبار أشكالها المختلفة في لحظات زمنية متعددة، وقد تكون الحكاية أو الهيكل الخارجي لها حُكي من البداية، وتأتي المقاطع المتتالية لتبحث فيما يبدو ظاهريا أنه تمت حكايته، وتكتب احتمالات أخري للحكاية. فالرهان ليس على الحدوتة فقط، كما أن عنصر التشويق لا يرتبط باكتشاف الأحداث، وإنما بكيفية كتابتها من منظور غير متوقع، وبكيفية اجتذاب الرواية للقارئ ليشاركها التساؤل حول التفاصيل ودلالاتها.
وتردد كثيرا حول الرواية الجديدة أنها صارت لا تؤمن بالقضايا الكبرى وأن اهتمامها بالجزئيات الصغيرة التي ترتبط بحياة كتّابها، وهذه الأقاويل تطمس أكثر مما توضح الرهانات الفنية لتلك الروايات، فالأمر لا يرتبط بتقسيم القضايا إلي صغري أو كبري، مهم أو غير مهم، فهذا التقسيم يعيدنا إلى ذات عارفة ملمة بكل بالتعريفات والتقسيمات، فكل القضايا أو الأسئلة تتعامل معها الروايات الجديدة علي أنها حكاية من ضمن حكايات عديدة، لا فضل لها أنها تتصدر صفحات الجرائد أو وسائل الإعلام، فإذا كانت القضية قضية سياسية مثلا، وتشغل ما يسمي بالرأي العام، فإن حضورها في الرواية يكون من منظور أنها ابنة تأويل دائم، وما شيوعها في الخارج إلا تسييد لوجهة نظر واحدة وحجب مستويات التأويل الأخرى، بالإضافة إلي أن هذا الحدث السياسي الذي تم تصديره دائما علي أنه مهم قد يتكشف لنا داخل الحكاية علي أن أهميته نبعت من تجريده من العلاقات الإنسانية، ومن دوره العيني في حياة الناس، وحينما يعود إلي مكانته الطبيعية كحكاية وليس كحدث انتهى واستقر في موقعه التاريخي نجد أن مكانته لا تفضل كثيرا أحداثا أخري طالما نظر إليها علي أنها هامشية أو صغرى، ونجد أن الحياة أغنى كثيرا وأكبر من أن تحصر وتختزل في عناوين سياسية فقط.