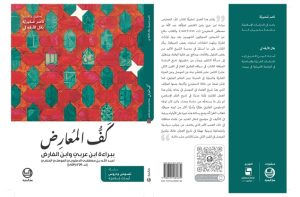عبد الرحمن أقريش
المكان آسفي، حي المستشفى.
الزمن 1985، ذات صيف.
غرفة شبابية فوق السطوح، ليلة مقمرة، جميلة وهادئة.
يبدو الأمر بعيدا الآن، بعيدا جدا، ولكن التفاصيل ما تزال حاضرة في ذاكرته، طرية، قوية وترفض الإنمحاء.
ينظر (المامون) إلى الصينية أمامه، مد يده، أخذ قطعة حلوى مسكرة، تناول لفافة محشوة وراح يدخن، يعب منها نفسا عميقا، يحبس الدخان للحظات ثم يحرره، يتلاعب به، يطرده بعيدا، يشكله، مرة يرسله أعمدة مستقيمة، ومرة يرسمه على شكل دوائر، وبين الحين والآخر يرشف من كأسه رشفات خفيفة.
كانت تلك طريقته في المزج بين النكهات، شاي، نعناع، سكر، وعبق السجائر المحشوة.
في الجهة الأخرى من الغرفة، تجلس شلة الأصدقاء، يتحلقون حول المائدة، يدخنون، يلعبون الورق، يضحكون من اللهجة المكسرة للمعلق الخليجي وهو يصف مجريات المباراة، ثم يتحول ضحكهم إلى قهقهة منفلتة، جامحة ومجنونة، لا تتوقف إلا لتبدأ من جديد.
كان مستغرقا ومنخرطا تماما، يقرأ رواية منزوعة الغلاف وبدون عنوان، ولكنه ولسبب ما يجهله، افترض أنها (ثرثرة فوق النيل) لنجيب محفوظ.
ثم في لحظة ما يحدث أمر عجيب.
فقد الإحساس بالزمان والمكان، رأى نفسه يقف عند عتبة أحد البيوت المظلمة، تنزل دموع الصيف على شكل زخات خفيفة، بللت بالكاد الإسفلت والأرصفة، زخات خفيفة تبخرت بسرعة فاحت معها رائحة الأرض، ثم ينزل المطر بقوة، يخفت قليلا، تنفخ فيه الريح فيضرب الأرض والجدران بقوة أكبر، وشيئا فشيئا تحول إلى طوفان عنيف وجارف، شعر بالخوف، تسمر في مكانه لكي لا يجرفه السيل.
أفرغت المدينة جوفها، اختلطت الأسمال بالطين والأتربة ولزوجة القذارة التي لفظتها البالوعات.
في الجهة الأخرى من الزقاق يسارا أو يمينا، لم يكن متأكدا، يسمع أصوات استغاثة جماعية ويائسة لأشخاص جرفتهم السيول.
عند مدخل الزقاق وغير بعيد عن الجردة الصغيرة، نصبت منصة خشبية مكشوفة، تجري عليها أطوار مسرحية أو محاكمة غريبة، ينتظم أمامها صف طويل، رجال، نساء، أطفال وشيوخ، بعضهم يمسك سجلات ضخمة، البعض الآخر يمسك كنانيش صغيرة كتلك التي يستعملها تلاميذ الطور الابتدائي، تتحرك عيونهم في كل الاتجاهات، ترتسم على وجوههم علامات الحيرة والاستغراب، يلتفتون في حركات عصبية ومتشنجة، ربما بسبب القلق، ربما بسبب الخوف أو هما معا، وبين الحين والآخر يسترقون النظر إلى السجلات والدفاتر التي بين أيديهم، يقرأونها خلسة.
أمام المنصة، يقف المحامون بأجسامهم الممتلئة وبدلاتهم الرسمية، فيبدو منظرهم شبيها بسرب من طيور البطريرك، يقلبون الأوراق والملفات، ثم يرفعون رؤوسهم، يشيرون بأديهم في كل الاتجاهات، يترافعون بإشارات وبدون أصوات، يعدلون هيآتهم في حركات نمطية ومفتعلة وكأنهم ممثلون مبتدؤون، على المنصة يجلس القضاة في وضعيات جسدية جامدة مثل أصنام حجرية.
تبدو المحاكمة مريبة وسريعة، يساق المتهمون بعدها مقيدين إلى أماكن مجهولة، يصرخون، يحتجون، يسمع أصواتهم تتردد، تتحول إلى صدى وتبتعد.
كان (المامون) ما يزال يقرأ عندما انفتحت فجأة كوة صغيرة في الجدار الحجري للغرفة، تسربت منها ريح قوية، يسمع صفيرها يملأ المكان، تندفع أوراق الكاليبتوس الجافة إلى الداخل، يشم رائحة الغبار المبلل، يشعر بالجوع يقرصه، شعر بعدها ببرودة شديدة مؤلمة، تابعها وهي تسافر وتخترق تفاصيل جسده مثل نصل سكين حاد وجارح، ثم أخيرا تختفي وتستقر في مكان ما بداخله.
رفع الملاية الصوفية وغطى وجهه، أغمض عينيه وراح ينظر إلى الأفق، يتخيله بعيدا، لاحت له سحابة بيضاء عابرة، بدت له مثل قطعة ثلج طائرة، مد يده، فكر أن يمسكها، أن ينتزع منها ندفات ليرى، ولكنه قدر أنها بعيدة المنال…
بعدها، رأى جسده وروحه ملتحمين، ثم رآهما ينفصلان، يخرج أحدهما من الآخر، يبتعدان، ويحلقان في اتجاهين مختلفين، ثم راح مستسلما لغيبوبة حقيقية.
يسمع صوت جنازة آت من بعيد.
– مولانا يا رحمان…جد علينا بالغفران!!
إلتفت يمينا ويسارا، كان وحيدا، الساحة خاوية، ثم توقف أمام بوابة خشبية ضخمة، بوابة من زمن القرون الوسطى، كتلك التي تستعمل في الحصون والقلاع، بوابة عالية تنتهي حافتها بأسنان معدنية قاطعة، عليها سلاسل وأقفال ضخمة، يفكر، افترض أنها ربما كانت قلعة مهجورة، أو سجنا رهيبا أو مقبرة، رفع بصر يستكشف المكان، نظر للسور العالي، كانت هناك لوحة معدنية كتبت كلماتها بخط ملون وبديع.
يقرأ.
(رياض اللذات، نادي خاص، ممنوع على العموم)
نقر على البوابة نقرات خفيفة، انفتح الباب وخرج رجل شديد ذو ملامح صارمة، يلبس الأبيض ويتمتع بوسامة سينمائية، نظر إليه مبتسما، ثم نظر إلى قائمة في يده اليمنى، انمحت ابتسامته، وقال.
– لا، ليس هنا…أنظر في الجهة الأخرى!!
اغتنم الفرصة ووقف للحظات يتلصص من فرجة الباب، رأى فضاء خلابا وآسرا، ربما كان متنزها، أو حديقة، أو فندقا فخما، في الداخل أشخاص بأعمار مختلفة، وجوههم جميلة وباسمة، أجسادهم مجنحة، يلبسون ثيابا مفتوحة، ملونة، شفافة وكاشفة، بعضهم يسبح في صهاريج بلورية شديدة الزرقة، بعضهم يأخذ حمام شمس، بعضهم يأكل من أطباق طافحة بالفاكهة، بعضهم يقرأ، وآخرون يتمايلون، يتهامسون، يتناجون، وينخرطون في أحاديث حميمية لا تنتهي.
كانوا في منتهى الهدوء والسعادة، أو هكذا تخيل.
ثم سمع صوتا أنثويا يناديه، رأى سيدة جميلة تتوسط عصابة من الحسناوات، سيدة بجسم مشدود وممتلئ، تتمايل، يتحرك شعرها الأسود، يتموج مثل شلال دافق، تشير جهته، وتلوح بيدها وكأنها تدعوه أن يلتحق.
هفت نفسه.
ثم أغلق الباب بقوة.
…
إلى اليسار، تنتصب قلعة أخرى بتفاصيل مختلفة، سور حجري متين، عال وممتد، تتدلى منه أسلاك لولبية شائكة، على جنباته انحفرت بقسوة وأناة – على طريقة الكرافيتي – كلمات ورموز نيزكية بلون اللهب.
في أعلى البوابة تتدلى بقايا لوحة نحاسية انخرعت بعض مساميرها ومالت إلى الأسفل، انمحت كلماتها ولم يبق منها إلا رقم غامض ربما كان (19) أو (16)، وقف أمام البوابة، تردد قليلا، ثم نقر نقرات خفيفة وجلة، أطل وجه ضخم من كوة صغيرة، وجه بتفاصيل مكبرة، ألقى عليه نظرة قاسية، تجهم، أشار إلى الساعة في معصمه، وخاطبه بصوت غاضب.
– أتيت متأخرا، فات الوقت، لقد أغلقنا الأبواب!!
…
نزع الملاية، كشف وجهه، عاد إلى نفسه وراح يتأمل فضاء الغرفة وكأنه يراه للمرة الأولى، كان صندوق التلفزة يبث صورا صامتة لأطفال صغار، يقفون في مكان مرتفع، يقفون مثنى مثنى، يحملون على ظهورهم محافظ مدرسية ويرتدون ملابس موحدة، يلقون بأنفسهم من مكان شاهق، تبتلعهم آلة جهنمية ضخمة، ثم تلفظهم من الجهة الأخرى على شكل معلبات معدنية وأخرى ورقية بأحجام مختلفة، أعواد كبريت، قطع صابون، مربى، لحوم، أسماك، معجنات، خضر وفواكه…
في نفس المكان، وعلى بعد خطوات يقف أشخاص هائجون، غاضبون ومنفلتون، يضرمون النار في بناية ضخمة، يدمرون كل ما تطاله سواعدهم القوية، رجح (المامون) أنها ربما كانت كنيسة، أو مدرسة داخلية، أو معزلا طبيا للأمراض النفسية.
ثم عاد إلى نفسه، أيقظه صوت البوابة وهو ينغلق بقوة، رج الصوت بعيدا، سافر، تبعثر، تلاشى، ثم عاد رجعا رهيبا يملأ الكيان.
استرجع وعيه تدريجيا، تأكد أنه ما يزال حيا، وأن تلك الجنازة كانت لشخص آخر.
كانت شلة الأصدقاء غارقة في نوم عميق، نظر إلى الساعة المعلقة على الجدار، عقاربها معطوبة ومتوقفة، وحدها تلك الدجاجة الآلية كانت هناك، تتحرك، تنقر الفراغ وتشير إلى زمن ما، زمن ممتد وسرمدي، يسرع أحيانا، يتباطأ أحيانا أخرى، ولكنه لا يتوقف أبدا.
كان ممددا بشكل مريح على أريكته القصبية، ويده ما تزال تمسك الرواية، يقرأ، يقرأ، يقرأ ويعيد القراءة.
يقرأ.
– الجميع في هذا العالم يستحقون الرحمة، حتى الكلاب، حتى اللصوص، حتى القوادون!!
قرأ الجملة مرة، مرات، حاول أن يتقدم، حاول أن يقرأ أكثر، ثم انتبه أخيرا لغرابة الموقف، كانت الرواية كلها عبارة عن جملة واحدة تتكرر إلى ما لا نهاية!!
غطى وجهه بالملاية مرة أخرى، عاد إلى غيبوبته، وهناك وقف إلى جانب الرجال، رحبوا به، انضم إليهم، ابتسموا، ابتسم هو أيضا.
كانت البناية ما تزال تحترق!!