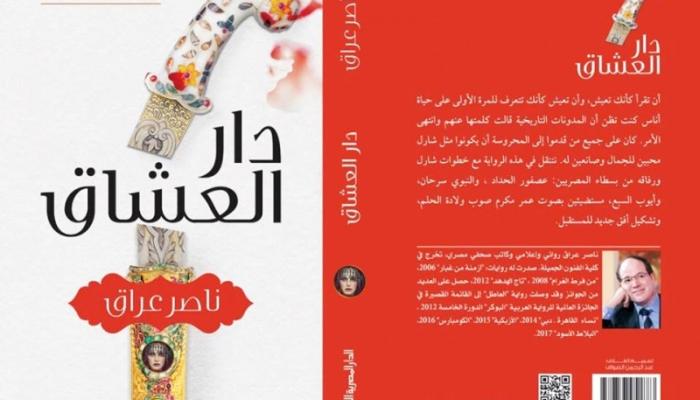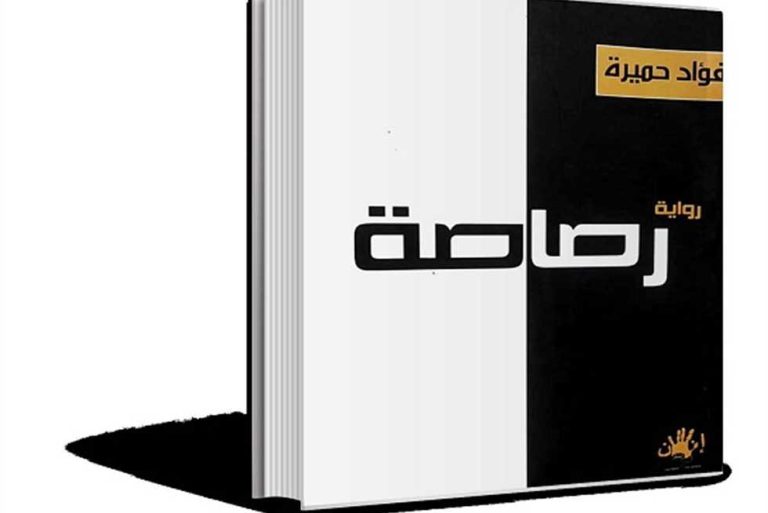د.صلاح رزق
ما أن نقرأ عنوان رواية “السيد نجم” “السمان يهاجر شرقا” حتى ندرك مدى حرص المبدع على استيقاظ المتلقي ولفته بقوة إلى ما يراه جديرا بان يستلفته فيتوقف أمامه. وحين نجارى أفق التوقع من أنفسنا، فنستبق الأمور نستشعر أن ما يريد الكاتب أن يلفتنا إليه منذ الوهلة الأولى يتعلق بالقول أكثر مما هو متعلق بكيفية القول.
ولا يعنى هذا –بالطبع أي نوع من الاستجابة للخوض فى القضايا التقليدية المتعلقة بنظرية الفن، أو ثنائية الشكل والمضمون، أو استعراض المعارف والمصطلحات الموهمة بقرط الوعي الحداثى بفن الرواية واللارواية، ومجازفات التجريب المتعددة فى هذا الصدد. كما لا يعنى أي صورة من صور الإيحاء بعدم عناية الكاتب بالمعمار الفني للرواية بقدر ما يعنى تجاوزه لهذا الأمر فى غمار التدفق التلقائي وصدق الانفعال وفاعلية التسجيل الفني.
لقد غدا الطير وحركته، حلا وارتحالا وتحليقا، رمزا فياضا بتنوع الدلالة وثرائها منذ أمد طويل من تاريخ أدبنا العربي. ثم تميز السمان منه – فى الأدب الحديث عامة والروائي خاصة- باتضاح الدور الرمزي المعين على إثراء الدلالة التي يمكن أن تكشف عنها محاولات تفسير النص.
أما الهجرة التي تسند إليه من خلال ممارسة الفعل المتخير فى الزمن الحال، من شأنها أن تمنح إطار التفسير الدلالي امتدادا دائريا ملحوظا، لأنها تشف عما هو حسي ومعنوي، وتقرن، بين العقلي والوجداني، وتصل ما بين المتعلق بالمجموع الذي بدا الفرد ممثلا له.
أما النص من الجهة “شرقا” فيؤكد القصد الواعي إلى إيقاع نوع من الصدمة الدلالية الخصبة التي تضمن للمبدع عدم قدرة المتلقي على تجاوز العنوان، وتأمل أفاق الدلالة التي يثيرها.. بل إن بمقدور تلك الصدمة المتعمدة نفى الغفلة التي قد تصيب كثيرا من القراء الذين الفوا قراءة الرواية التقليدية التي ما زالت التسلية تشكل حيزا ولو ضئيلا من دوافع كتابتها وقراءتها.
ولعل ما يؤكد عمق البعد الرمزي الخصب للدلالة الذي يبادرنا من صفحة الغلاف.. تأمل العناوين الداخلية التي صدر بها الكاتب فصول روايته.
فالفصل الأول يحمل عنوان: “الطيور لا تغرد ولا تبكى” فالعصفور –ذلك الطائر الرقيق المحبوب الذي يوافينا صوته مقرونا بجمال الطبيعة، فنتولى ترجمة ذلك الصوت في ضوء الحركة الشعورية الخاصة المقترنة بزمن التلقي وملابساته، فيرى فيه بعضنا تغريدا محلقا شجيا، ويرى فيه آخرون بكاء مؤسيا.. ذلك العصفور ينفى عن صوته الفعلان المتضادان اللذان لا يخرج عنهما التفسير “لا يغرد” و”لا يبكى”.
ولما كان العصفور رمزا دالا على الراوي الشاب الجامعي المتخرج حديثا وهو يدخل عالمه الجديد جنديا مجندا فى فترة حساسة من تاريخ امتنا ومواجهة أعدائها، باعتباره ممثلا فى ذلك لجيله كله.. فان الدلالة تنحصر فى مجرد الاستكشاف والتعرف والتزام الموقف الحيادي وعدم التسرع بإطلاق الأحكام التي قد تستمد من رؤية سابقة، أو تتعجل تعديل تلك الرؤية.
أما الفصل الثاني فيحمل عنوان “الطيور الفزعة” وبصرف النظر عن محاولة الكاتب الإيهام بالعناية بالطبقة السطحية من الدلالة حين يرصد حركة بعض الطيور التي يستشف فزعها الداخلي فى محاولة للإسقاط أو المزج بين حال الطيور الحقيقية والطيور المجازية/ الجنود فى عمق المكان الذي جمع بين هؤلاء وهؤلاء.. فان الجدير بالالتفات ما نلاحظ من أمر الانتقال من الواحد المفرد “العصفور” المشار إليه فى الفصل الأول، الى الجمع من بني جنسه عبر تعميم يسمح بادراك الفروق الفردية وينبه إليها دون إغفال للرابط الجامع بين الأفراد فى كل متوحد ومتماسك على نحو ما.
غير أن الطيور فى مستوييها الدلاليين توصف –فى ظل ذلك الرابط- بكونها فزعة تأكيدا على موقف نسى يرتد إلى وضعية شعورية وجدانية فى جانبها الأكبر، ولا ينفى إسهام العقل – حتى أعقل الفاعل الناضج المطيل للتأمل والفكر- فى صنعها وان كان المتوقع منه التخفيف من حدتها.
والكاتب بذلك يرصد شعورا عاما غلب على الوجدان الجمعي لقوات الجيش، وربما خلفهم أبناء الشعب. لا يرتد –يقينا- إلى الخوف من مواجهة الحرب، وإنما من حتمية خوضها دون الغفلة عن ضآلة الإمكانات التي نطمئن إلى جسارة خوضها وتمنح الثقة فيما يرجى ويتوقع من نتائجها. ومن ثم وصفت الحرب فى صدر هذا الفصل بأنها “القتال: المنتظر ولا يأتي”.
ولكن سرعان ما تتراءى إرهاصاتها، ولذا يحمل الفصل الثالث عنون: “السمان يهاجر مرتين”..ويلفتنا هنا الاختيار المقصود للسمان، وفى النص عليه ومن بين عموم الطير الذي يمارس حضورا فاعلا منذ الفصل السابق –توظيف أو استثمار واع لعمق الدلالة التي يرمز إليها، والتي تقترن بممارسة الفعل بدرجة واضحة من الوعي بالزمان والمكان.
وأما ازدواجية الهجرة هنا فتشير إلى مستويين من الفعل ودلالته:
أولهما: الظاهر الملحوظ متمثلا فى التحرك الفعلي نحو مواقع القتال. وظهور معدات جديدة ترى للمرة الأولى.
ثانيهما: هو الأهم، ذلك هو التحول النفسي الداخلي، والخروج من حال الفزع وما يرتبط به من مسببات متعلقة بالتوجس والتشكل وفقدان الثقة بالنفس والقيادة.. إلى حال أخرى مغايرة تماما.. تبدو مفعمة بالأنق الروحي والتوثب نحو الانجاز الذي يمنح الذات تحققها كاملا على المستوى الفردي والجمعي بحيث تشكل روح جديدة تسرى بقوة فى أعماق الفرد والجماعة مؤكدة وقوع التغير ومبشرة بما يمكن أن يترتب عليه.
ويأتي الفصل الرابع ليحمل عنوانه إشارة ملحوظة على تطور الدال والمدلول، والانتقال من مرحلة التحول النفسي والعقلي إلى مرحلة الفعل المادي الذي يعد بادرة النتائج المترتبة على ذلك التغير.. ذلك هو “الثيران تلتهم التورتة” فالفاعل المتخير يجسد عراقة الهيئة والقوة والفحولة. والمفعول يجسد هشاشة المادة مع تألق المظهر وإثارة الإغراء بإيقاع فعل النيل منها.
لذا جاء الفعل المتخير مناسبا للرابط بين الموضوع والمحمول “سكتهم”. أما مادة الفصل فالغالب عليها الوصف التسجيلي الذي يفلح فى تحقيق معايشة لحظة الفعل المتمثل فى عملية استعادة “حصن كبريت” والاستفادة من تجهيزاته لصالح مواصلة العمليات الأخرى، أو الأحداث التالية بما فيها الحصار الذي يمتد زمنا طويلا نسبيا.
ويأتي الفصل الخامس ليجسد الحضور الواضح للراوي وقد تكشفت لديه مقومات تشكل الرؤية شبه الناضجة أو المقاربة للاكتمال، فيحمل عنوان “الجمل يجتر ما فى جوفه” والجمل ما زال يعرف بيننا باسم سفينة الصحراء والراوي يعيش لحظة الصبر والجلد، ويبدو جوفه –ظاهريا ومعنويا- موضعا رحبا يتسع لاشتمال الكثير. وفى ضوء ذلك يتوازى خطان لتطوير الأحداث: خط الحدث المتمثل فى مواجهة رفاق الحصن للظروف التي تبدو سريعة التحول والتغير والخطورة بعد إتمام العملية العسكرية الناجحة فى زمن قياسي. وخط مراجعة الراوي لتجربته المعرفية الإدراكية على نحو من التأمل الذي ييسر له فرصة إعادة انظر والتقييم واسترداد الثقة بالنفس والهوية والقيادة والوطن.
أما الفصل السادس فيأتي محاولة للكشف عن وثاقة الارتباط بين الخاص والعام، ومنطقية الانتقال من الجزئي إلى الكلى، وتأكيد فاعلية البعد الانسانى فى حياة أكثر أناس صرامة ووعيا بالمسئولية العملية الشاقة المنوطه بهم.
يحمل هذا الفصل عنوانا رمزيا فياضا بالدلالة هو “ذكر النحل يموت فى أنثاه”.. إن الموت الفيزيقي الفعلي فى ختام هذا الفصل باستشهاد قائد الكتيبة العقيد إبراهيم عبدالتواب، والموت الذي يشي به البناء اللغوي وما يقترن به من إيحاءات وظلال يشير إلى فرط الحب وعمق الارتباط وتميز الإيثار. والموت المعنوي الأعمق هو حتمية فداء المحب للمحبوب، والبعد الانسانى المجاوز للزمان والمكان والحدث المحدد يتمثل فى شفافية العلاقة ما بين الأب وزوجته وطفليه عبر رباط أسرى مقدس.. تلك العلاقة التي لا تحول –على قداستها- دون أداء الواجب والنهوض بالمسئولية.. بل أنها تتجسد –فى اسمى حالاتها- حين تمارس تحققها الانسانى من خلال أداء الواجب الوطني أذى لا يقف عند حد فراق الأسرة أو قطع الإجازة القصيرة، وإنما يجاوز ذلك إلى الاستشهاد فداء للمحبوب الذي يتحول هو الأخر من دائرة الأسرة المحددة إلى دائرة الوطن الأرحب.
أما الفصل قبل الختامي في هذه الرواية فيحمل عنوان “الذئب يعرف الوفاء أيضا”، ويبدو أن الوعي بالمفارقة بشكل –فى الأعم الأغلب- سبيلا مناسبا للخروج من وطأة الأحداث المؤثرة أو الضاغطة على المشاعر الإنسانية على نحو لا تستطيع معه النفس إخفاء ضعفها الفطري.
وفى ظل هذه المفارقة يستغل الكاتب اللقب الذي أطلق على احد المقاتلين المتميزين بالقدرة على انجاز المهام الصعبة فى خفة وسرعة فساغ لرفاقه أن لقبوه ب”الذئب”. ويتخذ من ذلك فرصة لإيراد بعض الأعمال البطولية التي تشكل أوسمة متألقة للمقاتل المصري فى أحلك الظروف وأشدها قسوة وصعوبة، فضلا عن رصد بعض المواقف الإنسانية التي يمارس فيها الأفراد أسمى آيات الإيثار والوفاء، فيتشكل من هذا وذاك صورة متألقة لنقاء معدن الجندي المصري خاصة والإنسان المصري بصفة عامة.
ويأتي الفصل الأخير ليحمل عنوان “الطيور لا تأكل عشها” فيعمق فيه الرمز، وينفسح المجال للدلالة حيث تتضافر مادته على جمع خيوط الذكريات التي تكرس معنى الفدائية فى حماية الوطن.
وإذا كان هذا الفصل يصل ما بين طرفي الدائرة السردية في الرواية حين ينتهي إلى بيان حال الطيور، التي يبرز منها البعد المجازى للدلالة – حين تستميت فى الدفاع عن عشها/الوطن.. بعد أن بدأنا بالعصفور المتفرد فى حياد سلبي – لا يغرد ولا يبكى- وسط سرب من الطيور الفزعة، فان المسافة تبدو بعيدة على نحو ملحوظ بين البداية والنهاية. ويتراءى هذا امرأ طبيعيا لان مادة تشكيل تلك المسافة تضمنت من الأحداث اجلها وأكثرها فاعلية فى التغلغل عبر أعماق الراوي صاحب المنظور السردي الخاص.. تلك الأحداث التي بدت مسوغا منطقيا لقبول التحول أو التغير على المستوى الفردي والجمعي، كما بدت مسوغا منطقيا لبلورة الرؤية الفنية ونضج ملامحها.
وتنتهي البنية الفنية فى هذه الرواية التي أشرنا من قبل إلى أن المقول فيها يمثل منزلة سابقة على كيفية القول، مستندة إلى دعامتين:
أولهما: الطبيعة الخاصة بالتجربة الحربية في عمومها.. تلك التجربة التي لا تتماثل مطلقا، ومن ثم توافينا عبر منشور الرؤية الذاتية وطبيعة التسجيل الذي يتفاوت فى قدرته على منح المتلقي الإحساس الفياض بالمعايشة المنشودة لتلك التجربة.
أما الدعامة الثانية: فتتمثل فى مدى مواءمة الكيفية المتخيرة لبث الرؤية على النحو الذي يكشف عن نضجها ووعى المنظور المتخير لتجلية معالمها، وهو هنا يتمثل فى اختيار ضمير المتكلم للراوي المشارك سبيلا لنسيج خيوط تلك الرؤية انطلاقا من خصوصية ذلك المنظور فى اختيار الأحداث وتطوير مسيرتها تطويرا يمارس فيه المكان واللحظة الزمنية دورهما الايجابي عبر علاقات جدلية حيوية مع سائر مقومات التشكيل الفني فى النص الروائي.
وربما لم يكن من السابق لأوانه أن نشير إلى أن الرواية تدخل الدائرة العامة لأدب الحرب أو قصص المعركة من أوسع الأبواب. كما أنه لا جدال فى كونها محسوبة على رواية التجربة الذاتية. وليست الصلة بينها وبين القصة النفسية بمنبته لأن جانبا كبيرا من الحدث الجوهري العميق يقع داخل عقل شخصية الراوي/ البطل. وليس من الخطأ اعتبارها قصة فكرة، لأنها تقول الكثير مما يشكل رؤية عقلية موضوعية خاصة لراويها أو بطلها.
ولا يعنى هذا أي نوع من الخلط أو التناقض لأن هذه الأمور جميعا تتواشج وتترابط داخل العمل.. ومن قبل داخل الشخصية القصصية على نحو راسخ منطقيا وسرديا.
تبدأ الرواية بوصف موجز للحظة عامة ومتكررة فى حياتنا، هي لحظة سماع بيان المفتى الذي يعلن فيه بدء شهر رمضان. ولكن هذه اللحظة تكتسب قدرا من الخصوصية فى معسكر الجند الذين يعيشون فى عمق الصحراء.. بل فى خندق تحت سطح الأرض.
ومع الفرحة ببدء شهر رمضان، والانطلاق فى حركة مبتهجة لإعداد السحور، وتلك هي المساحة المشتركة بين الجند وعامة المسلمين، فان قدرا من الخصوصية المتعلقة بالمكان ورفقة الجند تبرز من خلال الدعاء المتبادل:
“ربنا لا يعوده علينا ونحن هنا”
إن التهنئة –على النحو المألوف- بأن يعيده الله علينا. وهذا موضع اتفاق.. أما المرفوض مما يؤسس للموقف النفسي الخاص فهو عبارة (ونحن هنا).. تلك العبارة التي تشي بالضيق بالاستمرار في ذات المكان دون تحرك جغرافي وتطور موقفي يكونان تجسيدا للرغبة الداخلية الكامنة فى الأنفس. ومن ثم تكشف العبارة عن شدة التوق إلى الفعل المغير.. عموم التغير مرهون بالفعل المنحصر هنا فى مواجهة العدو عبر حرب تحرير الأرض واسترداد الكرامة.
وإذا كان الراوي بدا – فى جملة الاستهلال- مندمجا فى المجموع: “التففنا- تبادلنا- ربنا- علينا- نحن” فانه سرعان ما ينفصل عن المجموع ليحتل موقف الراصد من الخارج، فيصف لنا حركة الرفاق الذين اجتمعوا لتجهيز سحور اليوم الأول من أيام الصيام.
ويمعن فى الكشف عن ذلك الانفصال تأسيسا لتفرد الرؤية التي سوف تتنامى على امتداد النص الروائي حين يقول:
“عن نفسي اكتفيت بالخروج من الملجأ لأدخن سيجارة وحدي”
وإذا كانت ملامح ذلك الانفصال تبدو مادية ملحوظة. فان الجانب الأهم منه هو ما يتعلق بأغوار النفس وحركتها الداخلية وهو ما يخبرنا به الراوى سريعا، يقول:
“لا اعرف بالتحديد فى الدنيا شيئا يستحق أن يجعلني لا اعترض على ما إنا فيه الآن فى تهوع سني التجنيد، تلك التي طالت وبلا أمل فى الخروج إلى الدنيا”
أنها حالة بلغت حدا لا ينكر من التعقيد، إذ تنتفي المعرفة المحددة عن جندي جامعي ذي رؤية مثقفة امضي أربع سنوات فى الجيش لشيء.. اى شيء فى الدنيا “يستحق أن يجعلني لا أعترض”، أن الاعتراض أمر غير وارد فى الحياة العسكرية خاصة لمثل من هم فى سن أو رتبة الراوي. لكن مع فرط التحدي واللا مبالاة وتبدد قيمة كل ما يعلى الشباب قيمته فى الظروف العادية.. يصل الأمر إلى هذا الحد من فورة مشاعر الاستخفاف والتحدي واللا مبالاة. لقد أصبح الاعتراض أمرا حتميا حيث لم تعد النفس قادرة على مزيد من الاحتمال. ومن المهم أن نعرف أن هذا الموقف التأسيسي للراوي كان قائما على نحو ما –وان لم يكن معلنا- فى أعماق كل شاب.. بل فى أعماق كل مصري فى تلك الفترة.
إن الموقف الفكري يزداد تحددا من خلال صيغة أكثر دلالة على التحديد حين يقول بعد ذلك “كل ما يشغلني الآن.. كيف أقضى رابع رمضان لي مجندا ولا جديد”.. وهل ثمة ما يدعو إلى الضيق والنفور واليأس فى حياة المرء أكثر من ترقب الجديد، فلا يقع الجديد عاما بعد عام، رغم تكرار التأكيد بأن هذا العائم هو عام الحسم، ثم ينقضي العام، بعد العام ولا حسم!.
فى رد فعل تلقائي تأتى العبارة التالية: “أصبحت فى شك أن القيادة ستصدر أمرا بالقتال على أية صورة من بعد”, وهنا نستطيع أن نتبين العالم الداخلي للشخصية أوضح ما يكون.
لكن بوعي شديد تأتى العبارة التالية لتحيلنا إلى عنصر خارجي يحتمل فيضا من الدلالة، يقول الراوي: “ريح هوجاء لطمتنى بغتة”.. انه عالم الطبيعة المحيط، وكأنما هي مؤشر التنبيه إلى ناموس الطبيعة المطرد، وتوصف الريح بأنها “هوجاء” وهى كلمة عربية ممعنة فى تراثيتها استدعاء لظلال أصالة العرق والانتماء. ثم تمارس فعل “العلم المفاجئ” للراوي. وبعدها يعود إلى نوع من السرد الذي يبدو أقرب إلى الحشو الروائي. ومعنى هذا أن الرؤية تتشكل على نحو يوشك أن يكون نهائيا وقاطعا، ولكن استنادا إلى الحسابات الفردية.. ولكن يظل من حقنا وضع هذه الرؤية فى سياق أرحب يسمح لرؤيتنا نحن بالتوقع والتشكيل والتنامي والتعديل فيما يريد الراوي لنا أن تستبينه.
يشير الراوي –بعد ذلك مباشرة- إلى أن وزنه قد زاد فى فترة قصيرة- توصف فترة اللا حرب واللا سلم”. تلك الحالة قد تكون علامة صحة، لكن يبدو أنها نتيجة توتر وخلل هرموني، لذا يعود ويخبرنا بصيغة تقريرية “تأكدت من عجزي عن التفكير فى المستقبل القريب والبعيد”.
هذا العجز عن التفكير كان شأنا عاما فى تلك الفترة، لهذا لا يحصره الراوي فى الشأن العسكري وحده، وإنما يضيف الجناح الأخر للحرب، وهو الحب حين يقول:
“كما عجزت من قبل… بشأن حبيبتي وموقف أهلها منى. إنهم يرفضون قبولي زوجا لابنتهم وأنا المجند”
إن الشأن العسكري أو الحرب لا يمكن أن ينفصم عن الشأن العام، والحرب لا تفهم إلا فى ضوء السلم والعسكري لا يتحدد إلا بالنظر إلى المدني. والوجود هنا لا يستقل عن الوجود هناك. ومن الواضح أن الحضور المجاني هنا يشكل غيابا غير مجاني هناك. ومن ثم تفسد حالة الجمود الكائنة هنا الحيوية المرجوة هناك، أو إن شئت قل أن الحالة المرضية هنا تمد أثرها فتصيب الحالة التي تشكل أمر مستقبل الشباب هناك.
وحين يصبح الموضوع محور حديث الرفاق الذين يطلب منهم الراوي أن يشيروا عليه يتأكد كونه هما عاما. وإمعانا فى هيمنة رؤية الراوي لا يقدم لنا المشهد الحواري مباشرة، وإنما تختزلها –من منظور البعض- بقدر من السطحية التي تزيدها تعقيدا حين تحيلها إلى أمر بيولوجي فحسب. ومعنى هذا وأد الحياة المستقبلية السوية، وهو ما لا يستريح إليه الراوي، ومن ثم نراه يزداد قربا من النموذج السوى “نوفل” المتزوج المتوائم مع واقعه الراضي به الذي يعلن على مسمع الراوي انه لا يخشى الموت أو ترمل الزوجة وتيتم الابنة، فيبدد شكوك الراوي وزاد تعلقه بالمستقبل والحبيبة.
ولابد للخروج من هذه الدائرة شبه المحكمة من تطور ملحوظ فى الأحداث. وما أسهل وقوع التطور فى أحداث الحياة العسكرية.. وهذا ما تيسر للراوي حين وصل رفيقه فجأة بعد استدعائه من أجازته، وإذا أمر الاستدعاء أمر عام. ومعنى هذا أن نفير الحرب يوشك أن يسمع، ويواكب استدعاء الجند وقوع تحركات مكثفة على طول الطريق اى السويس. ومعنى هذا تعدد القرائن المرخصة بتطور الإحداث.
لكن لو أن الكاتب استجاب لفورة الحدث واطراد التسجيل وحتمية حركة الزمن الواقعي لواصل تنمية الحدث، غير انه –بوعي الفنان- عدل عن ذلك سريعا من مدخل الوعي بفاعلية الزمن والحرص على إعظام الحدث المنشود المتوقع من خلال وضعه طرفا فى مواجهة الحدث أو الواقع الماضي المرفوض أذى يواصل تنميته وتكريسه حتى يصبح طرفا فعالا فى مواجهة طغيان الواقع الحالي أو ما يبشر به.
فعنى بذلك ما كان من أمر الجيش أفرادا وجماعات فى حرب 1967 وما بعدها من وقائع حرب الاستنزاف. وتتاح الفرصة للراوي لتغذية هذا الطرف المناوئ من خلال الاسترجاع والارتداد فى الزمن مستعينا بشخصية “عطية أبوشنب” فيترك له فرصة السرد والواصف لمعركة الطائرات –طائرات العدو التي حسمت المعركة فى ست ساعات من يوم خمسة يونيو- وما كان من أمر الوحدة وإفرادها الذين شتتوا فى الصحراء، ورأوا الموت رأى العين غير مرة.
ويتخذ الكاتب من السخرية المريرة أداة لتأكيد المفارقة الداعية للفكرة المرادة. ومن ابرز المواقف التي أتاحت له ذلك تصوير مأساة أفراد الجيش فى سنة67 ورصد مشاعرهم خلال فترة الترقب التي طالت مع تنامي أحاسيس اليأس والإحباط، فحين يستغرق الوصف عطية ابوشنب ويخيم الحزن يدخل “نوفل” قائلا:
“لا تحزن يا ابوشنب، لولا الضباب عام72 كنا عبرنا، ثم كان عام الحسم، وفعلا تم الحسم، لكن علينا، تابع “صلاح” بهدؤ غريب عليه وعلينا: “عندي فكرة هنا الوحدة بين تبتين اقترح عليك تنقل أحداهما مكان الأخرى.. عموما اليمنى اصغر قليلا، لاحقه “هارون”: “لكن لا تنسى أن مجموعة “الحية”- مجموعة صواريخ سام7- يحضرون مع أول ضوء ويختفون مع آخر ضؤ عليك بتنفيذ المهمة خلال فترة الليل، وإلا تاهو وتصبح مشكلة عسكرية أمنية” ص10
ولكن مهارة الكاتب وقدرته على تطوير البناء السردي تجعله ينتقل إلى الطرف الآخر من طرفي المفارقة، وهو ما يلح على دلالة التجهيزات واستدعاء الأفراد، واستكمال المعدات والأدوية والأجهزة، والاستعانة بذوي الخبرة من المدنيين خاصة الأطباء.. إلى آخر ما من شانه يكرس لنا الخروج من أزمة الانتظار الطويل وما يقترن به من مشاعر اليأس.. فضلا عن انه يكسب البنية الفنية مقومات استمرارها وتماسكها,
ويغمرنا إحساس قوى بأننا نصحب الراوي رحلة التحول النفسي الذي بدأ اليأس الضاغط على صدره فى الانزياح ليحل محله نوع من توازى طرفي اليأس والأمل فوقف الحياد “لا تبكى” متشائما بائسا، ولكنه “لا يغرد” متفائلا أو منخدعا.
مرة أخرى يعتمد تكنيك “الاسترجاع” ليدعو القوى الايجابية فى نفسه حين يستعيد إحدى العمليات العسكرية التي شارك فيها فى الليلة الأولى من إلحاقه بوحدة المدفعية من قبلن حيث المشاهد الوصفية التي تيسر المعايشة للقارئ.
ويكشف الكاتب عن مهارة واضحة فى تقديم عطاء التجربة عبر الوصف.ز من ذلك وصفه لجانب مما عاينه فى ليلة العملية الحربية الأولى إذ يقول:
“هالني ما شاهدت وقتها، أجساد بشرية هلكت، أشياء جامدة مبعثرة، حافظة نقود مفتوحة يطل منها وجه طفل يضحك.. مصحف صغير.. آه.. ممدودة هنا وهناك.. شخير أنفاس لا تقدر على الخروج، أسرعت إلى نقل ثلاثة إحياء إلى الكتيبة الطبية الثانية، استقبلني الرفاق ، قبل مضى دقائق قليلة سمعنا “أزيز” سيارة “زل” تقتحم الكتيبة، انفرج الرفاق عنى، اندفعوا نحو السيارة، رأيت السائق يعتلى إحدى التلال بمقدمة السيارة بحيث استقرت مائلة إلى أسفل، فورا فتح الجانب الخلفي لصندوق السيارة.. رأيت ما لم أتوقعه، دماء تتسربل، أعضاء بشرية تتساقط، أشياء مختلطة بجثث الجنود.. كلها معا على الأرض” ص13
ثم يعود الكاتب إلى اللحظة الراهنة قائلا:
“لم أتابع احتساء كوب الشاي، عندما عدت لم أجد ما أتفوه به، اكتفيت بالارتكان إلى حائط الملجأ المنبعج، شعرت بأسياخ الحديد للملجأ في ظهري، فى عيني ولساني” ص13
وحين يساور الراوي الشك فى وقوع الحرب يطرح المسالة فى تلقائية! ها نحن ذا هنا عند حافة القناة فى مأمورية لا نعرف هدفها! هل هي إيذان بإعلان الحرب حقا؟!
غير إننا نصحبه رحلة الاقتناع الموضوعي استنادا إلى مقومات واضحة ومقنعة “شيء ما يتأكد، يفرض نفسهن لم تعد أرغبة ولا الشواهد وحدها تشي وتفصح، تجمعات جديدة من جنود سلاح المهندسين بمعابرهم المعدنية…
ويتم التجاوز/ التحول/ الاستشفاء/ الخلاص تماما فى الفصل الأخير حين يرد على لسانه عبارة “أكيد نجحنا فى تحدى الخوف والحصار داخل أنفسنا” ص101
لقد اتخذ الكاتب من الحوار وإطرافه فرصة فعالة لطرح وجهات نظر الجندي المثقف فى مختلف القضايا (راجع ص14) كما كان المونولوج فرصة للبوح والكشف عن الحركة الداخلية للنفس التي تعيش الصراع وترجو الخلاص (ص14 على سبيل المثال) كما كان السر المباشر وسيلة فنية جيدة لرصد معالم الواقع ورسم المشاهد وبيان رد فعل هذا الواقع على الإفراد وعلى نحو لا يخلو من قدر من التفاوت فى الفاعلية والأثر.
لعل ابرز مواطن التوفيق فى نسج البنية اللغوية للرواية تضمين الموال (ص22-23-99-100) والشعر (ص22).
وإذا كانت الرواية قد حفلت بالعديد من الشخصيات الذين يمكن الاستغناء عنهم أو عن بعضهم، فان ذلك قد يبدو صحيحا لو لم تكن الرواية تنتمي إلى أدب الحرب. لكن يبدو ذلك ضرورة فنية، بالتركيز على بعض الشخصيات، وان كانت أيضا شخصيات ثانوية (مثل عم مرزوق فى الرواية).
وربما لاحظنا قدرا من علو النبرة الخطابية هنا أو هناك ولكن يكون –فى الأعم الأغلب- سبيلا لتجسيد موقف انفعالي يوشك أن يكون استثناء عارضا فى بناء محسوب. أما الإطالة التي تبدو ضرورية أحيانا فلا مناص من احتمالها. غير أن الإفاضة والتزيد فيما لا ضرورة له ينال بلا شك من تماسك البناء الفني ولقد وقع شيء يسير من هذا القبيل على نحو ما لاحظنا قصة جابر وزواجه وختانه أو بعض المواقف المتعلقة بتداعيات تصرف فوزي قبل وبعد الانتقال إلى موقع القتال.
وتبقى هذه الرواية –فى ضوء ذلك كله- عملا فنيا جديرا بالتقدير حقيقا بإعادة القراءة واتخاذ منزلته فى تاريخ أدبنا العربي المعاصر.