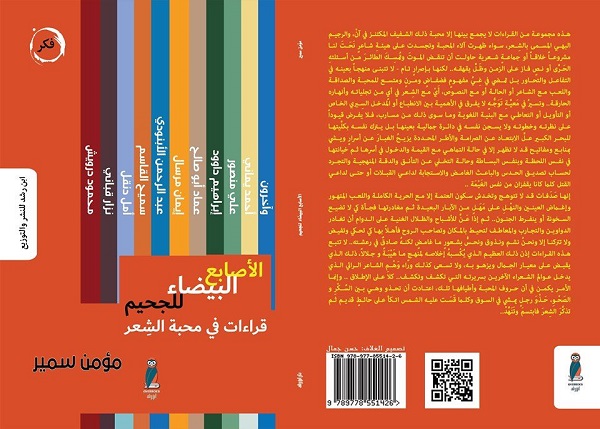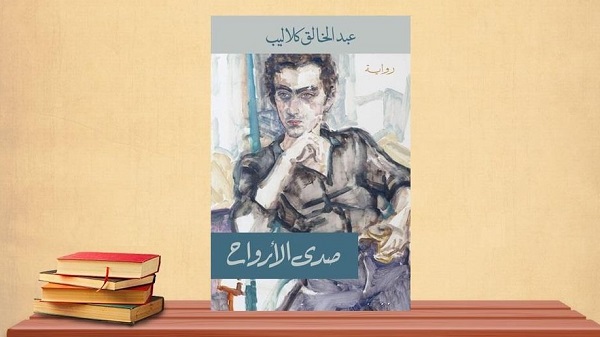قد لا يوافق بعض المهتمين على هذا الحكم القيمي إزاء الرواية العربية، إيماناً منهم بأن كل ذلك الكم الروائي فيه ما يمكن تسجيله في خانة الإبداع الخالد، وأن بعضه سيتحول إلى خلاصة نوعية تكون عنواناً لحداثة الرواية العربية، بموجب قانون التراكم. وهي مجرد استيهامات لا تصمد أمام حقيقة بهوت المنجز وارتباكاته، التي لا يمكن بحال أن ينتج عنها ذلك التراكم المأمول، وهو الأمر الذي يحتم التساؤل عما وعمن أنهك الرواية العربية.
أهي اللحظة الزمنية المفككة التي نعيشها؟ أهو المتلقي الذي غذى التفاهات وأغرى الكُتّاب بتكرار المحاولات البائسة؟ أهو الإعلام الذي نفخ بعض المتشاوفين حتى صاروا نجوماً بدون أدنى مساءلة؟ أهي المنابر الثقافية التي صارت تسبغ صفة الروائي على كل من سوّد عشرات الصفحات ووضعها بين غلافين؟ أهو الناقد الذي جامل أسماء وصعّد آخرين ولم يمارس دوره التقويمي؟ أم هي الذات المبدعة التي تجرأت على اقتراف الرواية بدون خبرة ولا تجربة ولا كفاءة؟
المهم أن شريحة عريضة من القراء توصلت إلى قناعة بأن الرواية العربية اليوم لا ترقى إلى مستوى تلك التي ظهرت في مرحلة ما بعد التأسيس، وشكلت بالفعل وجدان الإنسان العربي، حيث يمكن التقاط نبرات التأفُّف والإحباط عند فصيل عريض من القراء إزاء المنتجات الروائية الجديدة. مع ملامح يأس شبه عام من إمكانية ظهور تيار روائي يعيد الألق للرواية العربية، إذ لا ينتج المختبر الروائي العربي سنوياً إلا روايات قليلة جداً تصلح للقراءة، ويمكن أن تشكل إضافة للمنجز الروائي، وهو مناخ عام في العالم العربي، مع تباينات بسيطة جداً ما بين قُطر وآخر.
اللحظة الآنية المعاشة لا تسمح بالتأني، واختمار العمل الأدبي بما يكفي ليتجوّد. فهي لحظة ذات إيقاع سريع. كما أنها مزدحمة بالروائيين حد الفيضان، بالإضافة إلى ما تمنحه من فرص سهلة للنشر والتوزيع، وهو الأمر الذي شجع فصائل من القراء لمغادرة مواقعهم إلى خانة الكُتّاب، حيث اقتحم نادي الروائيين هواة وشعراء وأكاديميون وساسة وتربيون وحتى رجال دين. اقتربوا من الرواية وقاربوا كتابتها بدون دراية بفنون السرد، وأحياناً بلا خبرات حياتية، ومن الطبيعي في مثل هذه الحالة التي ينفتح فيها الخطاب الروائي على اتساعه، أن تتحول الرواية إلى حقل تجارب ومراودات غير ناضجة، إذ يستحيل أن تستوي داخل مختبر منفلت المعايير.
وبالمقابل كان الإعلام العربي يعيش حالة فورانية لا تقل ارتباكاً عما يحدث في حقول الأدب، إذ لم يعد المحرر الثقافي على تلك الدرجة من المهنية والخبرة الأدبية ليستعرض مضمون وأدبية هذه الرواية أو تلك، بالإضافة إلى تحوّل الملاحق الثقافية إلى لوحات إعلانية مهمتها الترويج للأصدقاء وتلميعهم، وكأن الصفحة التي يُفترض أن تكون صورة مرآوية للحال الثقافي استحالت إلى أداة لإدارة العلاقات العامة، تماماً كما صارت المنابر الثقافية المؤسساتية والأهلية فرصة لعرض المشتبهات الروائية، وتنجيم منتجيها، حيث صار الروائي محل احتفاء دائم في المهرجانات ومعارض الكتاب، سواء من خلال حفلات التوقيع أو إطلالته الشرفية على المنبر.
كل تلك العوامل وغيرها من الظروف والتداعيات أسست لحالة الإنهاك والارتباك التي تعاني منها الرواية العربية، إلا أن العامل الأهم هو الذات الكاتبة، حيث غابت تلك الذات المتنسّكة للإبداع، لتحل محلها ذات تمارس الكتابة الإبداعية على هامش الحياة بكل همومها وانشغالاتها. وكأن الرواية يمكن أن تُكتب للتسلية أو الحضور الشرفي في المشهدين الثقافي والحياتي، حيث يمكن التدليل على هذا المنحى بفصيل الطارئين على الخطاب الروائي الذين لا يفتقرون إلى أبجديات الكتابة السردية وحسب، بل يعانون من خواء التجارب والخبرات الحياتية، حتى بالنسبة للروائيين الذين سجلوا حضوراً مقنعاً في بداياتهم استسهلوا الأمر وصاروا يستولدون الروايات بكثافة ولا مبالاة ما دامت تلاقي بعض القبول القرائي والإعلامي. وهكذا تضاءل حضور الذات التي تخاطب التاريخ من خلال أعمال روائية قابلة للخلود في الذاكرة. والتأثير في طرائق تفكير وممارسات الفرد والمجتمع، بمعنى أنها تقترح منحى جمالياً للإحساس بالذات والهوية والتراث والقضايا المعاشة، أي تأريخ الوجدان الجمعي. وهي مهمة لا تبدو حاضرة في وعي الروائيين اليوم. الذين يستنسخون النماذج الجاهزة ويحقنونها ببعض الإثارة المفتعلة. وهذا يعني، بدون أدنى شك، أن الروائيين هم الذين يتحملون الجزء الأكبر من تردي الفعل الروائي.
هذا ما يبشر به طابور طويل من الروائيين الذين يعملون لتخفيض أفق التوقع القرائي. كما يسدون الطريق على النقد، سواء بتواضع ما ينشرونه من روايات أو باكتفائهم المعلن عن أي مناقدة لا تعمل كرافعة لهم. وهم الذين يحركون مطابع النشر اللاهثة وراء الربحية. وهم الذين يوهمون الإعلام بضياع مسطرة السرد الحقيقي، لدرجة أن الروائي العربي صار كمن يعاني من وهن تكويني مردّه بكل تأكيد عطالة حياتية يتم استعراض خوائها على الورق.
………….
*ناقد سعودي