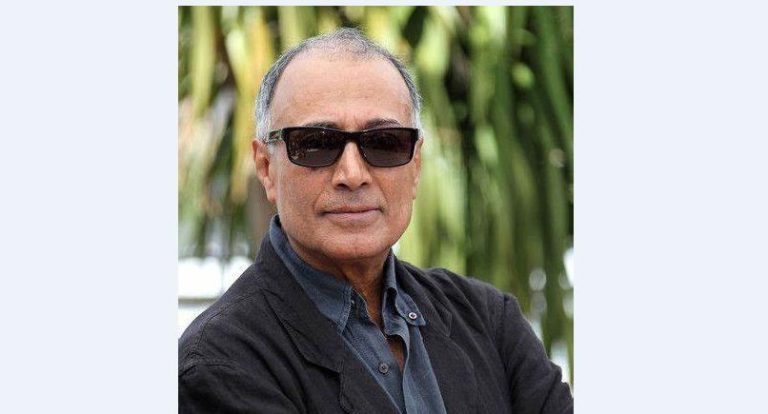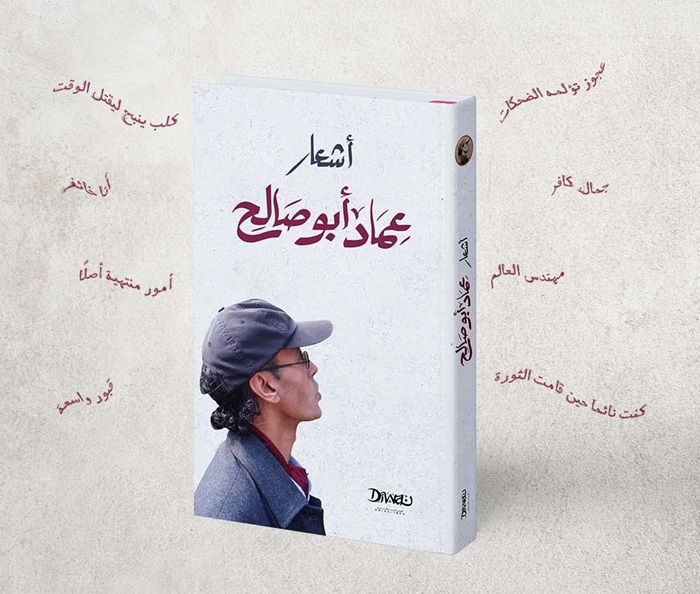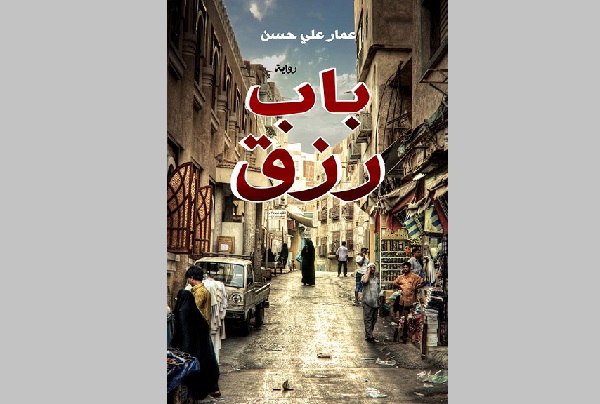سليمان المعمري
أبدأ هذا السرد عن الأدب العُماني بهذا التساؤل: هل يمكن اعتبار فوز الروائية جوخة الحارثي بجائزة مان بوكر للرواية عام 2019، منعطفًا تاريخيًا للأدب العُماني؟. لا أزعم أن لدي إجابة شافية عن هذا السؤال، لكنني أعرف أن هناك من يعتبر فوزها بالفعل منعطفًا أو مفترق طرق، ليس فقط لأن الجائزة عالمية ولم يسبق لأديب عربي الفوز بها، ولكن أيضًا لأن هذا كان اعترافًا كبيرًا بأدب بلدٍ عربي لم يعتدْ كثيرًا على مثل هذا الاعتراف، بل إن نقاد ومؤرخي أدبه ظلوا يرددون في غير مناسبة أن عُمان تتوفرّ على أدب جيد منذ مئات السنين، ولكنه –إلا فيما ندر- غير مرئي، لأسباب عديدة أهمها انعزال عُمان سياسيًّا ورفضها الانضواء تحت راية أي من الدولتين الأموية والعباسية، اللتين أنتجتا نصيب الأسد من تراثنا الأدبي. نلمس هذا حتى في كتابات قُدامى النقاد العرب، كابن سلّام الجمحي الذي أدرج عُمان في “طبقات فحول الشعراء” في قائمة البلدان التي يقلّ فيها الشِعر، وبرر ذلك بمسالمتها وعدم دخولها في حروب، يقول الجمحي: “وبالطائف شعرٌ وليس بالكثير، وإنما كان يكثر الشعر بالحروب التي تكون بين الأحياء، نحو حرب الأوس والخزرج، أو قوم يُغيرون ويُغار عليهم. والذي قلل شعر قريش أنه لم يكن بينهم نائرة، ولم يحاربوا، وذلك الذي قلل شِعر عُمان”[1].
وإذا كانت هذه هي النظرة للشعر في عُمان في تراثنا العربي، فإن النظرة للنثر يبدو أنها لم تكن أفضل حالًا. هذا على الأقل ما نفهمه من دفاع أديب كبير كالجاحظ عن النثر العُماني في كتابه “البيان والتبيين”. يقول الجاحظ: “”لربما سمعتُ مَنْ لا علم له يقول: ومن أين لأهل عُمان البيان؟”، ثم يرد هو نفسه على هؤلاء بتساؤل استنكاري: “وهل يعدّون لبلدة واحدة من الخطباء والبلغاء ما يعدّون لأهل عُمان!”.
لسنا هنا على أية حال في وارد إثبات أو دحض هذه المقولات النقدية، ولكن يحق لنا كعُمانيين أن نفاخِر أن عُمان أنجبتْ للعرب عددًا من أهم علماء اللغة وأساطين الأدب، كالخليل بن أحمد الفراهيدي مؤسس علم العروض وصاحب معجم “العين”، والمبرِّد صاحب كتاب “الكامل في اللغة والأدب”، وابن دريد صاحب “الجمهرة”، وغيرهم، وأن الشعر ظل دومًا عُملة العُمانيين النفيسة منذ مئات السنين، فلا تكاد تمر مرحلة تاريخية معينة على عُمان دون أن تسجّل شعراء بقيت أسماؤهم وأشعارهم إلى يومنا هذا. فمن كعب بن معدان الأشقري في العصر الإسلامي الأول، إلى سليمان بن سليمان النبهاني في حقبة حكم النباهنة لعُمان، إلى راشد الحبسي في عصر حكم اليعاربة، وحتى عبدالله بن علي الخليلي الذي توفي سنة 2000، ظل الشعر الكلاسيكي حاضرًا بقوة، في أغراضه المعروفة من فخر وغزل، ومدح وهجاء. دون أن ننسى بالطبع شاعر عُمان الكبير أبو مسلم البهلاني الذي أدرجته منظمة اليونسكو عام 2019 ضمن الشخصيات المؤثرة عالميًا بمناسبة مرور مائة عام على رحيله.
وإذا كان الشعر العمودي الكلاسيكي هو المسيطر في عُمان خلال الحقب التاريخية المختلفة فإن هذا لا يعني أن الشعراء العُمانيين لم يـتأثروا بالمتغيرات التي شهدها الشعر العربي في القرن العشرين، من ظهور الشعر الحر (شعر التفعيلة) أو قصيدة النثر. بل إنه ليس من قبيل المغالاة الزعم أن من يكتبون هذين النوعين من الشعر اليوم هم البارزون في المشهد الشعري العُماني. شعراء قصيدة النثر كسماء عيسى، وزاهر الغافري، وسيف الرحبي، وصالح العامري، وعبدالله الريامي، وناصر العلوي، وعبدالله حبيب، وعبدالله البلوشي، وفتحية الصقري، وإبراهيم سعيد، وفاطمة الشيدي، وعبد يغوث، وفاطمة إحسان، وعهود الأشخري، وعلي المخمري، وشعراء قصيدة التفعيلة كحسن المطروشي، وعائشة السيفي، ومحمد عبدالكريم الشحي، وحصة البادي، وناصر البدري، وخالد المعمري، وإسحاق الخنجري، ومحمود حمد، وعوض اللويهي، وخميس قلم، ومحمد السناني، وإبراهيم السالمي، وحسام الشيخ، وأحمد الفارسي، والشيماء العلوي، وشميسة النعماني، وسعيدة خاطر، وسعيد الصقلاوي، وعبدالله العريمي، ويونس البوسعيدي، وسواهم. كل هؤلاء يكتبون – كلٌّ بطريقته- غربة الإنسان المعاصر وقلقه وعزلته، وبحثه المضني عن معنى الحياة.
ولا يمكن أن أغادر الحديث عن الشعر بدون التطرق إلى شقّه الشعبي الذي بلغ اليوم في عُمان مرحلة من النضج جعلت كثيرًا من نماذجه خير معبِّر عن نبض الشارع العُماني. ولأن أحد أهم عيوب الثقافة العُمانية هي ضعف التوثيق، فإن هذا العيب يبرز أكثر ما يبرز في الشعر الشعبي كونه شفويًّا، ولذا فليس من السهل تحديد تاريخ جازم لبداية ظهوره، وإن كان الشاعر والباحث الراحل حمد الخروصي – الذي هو بالمناسبة واحد من أهم شعراء القصيدة الشعبية في عُمان – قد اعتبر الشاعر قطن بن قطن الهلالي الذي عاش في القرن السابع عشر الميلادي، في عهد حكم الإمام ناصر بن مرشد اليعربي، هو أول شاعر شعبي عُماني، بل إنه يذهب أبعد من ذلك فيعتبره صاحب “أول قصيدة مدونة في تاريخ الشعر الشعبي في شبه الجزيرة العربية”[2] مستشهدا ببعض المراجع لباحثين من الخليج.
بعد الهلالي بقرنين من الزمان ظهر الشاعر علي بن الضبع الجنيبي المولود –حسب بعض المصادر- عام 1840، وكان معاصرًا له أيضًا الشاعر عامر بن سليمان الشعيبي المعروف بـ”المطوع”، وهذان الشاعران اشتهر شعرهما بقوة العاطفة والحماسة والحكمة وتمجيد الشجاعة، وهي صفات تنسحب أيضًا على قصائد شعراء سيظهرون بعدهما في القرن العشرين، وسيصبح لهم صيت واسع بين العُمانيين، نذكر منهم حافظ بن محمد المسكري، وراشد بن سلوم المصلحي الشهير باسمه الأدبي (سويري)، ومحمد بن جمعة الغيلاني، وسعيد بن عبدالله ود وزير، وغيرهم. وقد كتب هؤلاء في أغراض الشعر المعروفة، لكنهم أسسوا بأشعارهم أيضًا لفنون عُمانية تراثية مازالت حاضرة في الوجدان العُماني إلى اليوم؛ كفن العازي، والرزحة، والميدان، والمسبّع، والدرسعي، وفن المرادّات، التي تقوم جميعها على الشعر الشعبي.
أما مصطلح “الشعر النبطي” الذي بات الاسم المعاصر للشعر الشعبي في الخليج فإن أول من استعمله في عمان هو الشاعر ربيع بن سالم العلوي الذي كان محرر صفحة الشعر الشعبي في جريدة عُمان وغير مسماها إلى “صفحة الشعر النبطي”. توفي العلوي عام 1989 وجاء بعده مشرفًا على الصفحة لأكثر من ثلاثين عامًا الشاعر مسعود الحمداني – أحد الأسماء المهمة في القصيدة العُمانية الشعبية الحديثة – الذي فتح الصفحة على تيارات شعرية كثيرة بما في ذلك قصيدة النثر الشعبية. وفي شهادته التي دونها في كتاب “جهة النبع: شهادات عن الإعلام الثقافي في عُمان” يقسّم الحمداني شعراء القصيدة الشعبية في عُمان إلى ثلاثة تيارات: التيار الحداثي، ويضع على رأسه الشاعر محفوظ الفارسي، “تبعه بعد زمن شعراء شباب من خلال نصوص معينة، منهم: حمود الحجري، وطاهر العميري، وعبدالعزيز العميري، وعبدالله العمري وأحمد الجحفلي وعلوي باعمر وغيرهم. وأهم ما يميز معظم هؤلاء الشعراء هو الاشتغال الذهني على الفكرة، وابتكار نمط جديد على مستوى الشكل والصياغة الشعرية، حيث تشكل قصيدة التفعيلة عنصرا مشتركا بين كثير منهم”[3]. أما التيار الثاني فهو “التيار الوسطي الذي يشتغل على الصورة الذهنية، ولكنه لا يفلت الخيط التواصلي مع المتلقي، وهو يبحث عن التجديد ضمن إطار لا يمعن كثيرا في (تغميض) الصورة”[4] ومن أهم شعراء هذا التيار أحمد مسلّط، وأحمد السعدي، وأحمد الشحي، وصالح الرئيسي، وحميد البلوشي، وخالد العريمي وغيرهم. ثم ينتقل إلى التيار الثالث الذي يسميه “التيار التجديدي المحافظ”، ويرى أنه “يمسك بالقصيدة من منتصف العصا، فلا يغامر إلا بقدر الحاجة إلى المغامرة، حيث اشتغل هذا الفريق على الصورة النمطية المستوحاة من البيئة، وحاول تطويرها، والاشتغال عليها، وهو ربما التيار الذي يضع المتلقي في ذهنه”[5]، ومن هؤلاء يذكر الحمداني الشعراء ناصر الغيلاني، وخميس المقيمي، وعبد الرحمن الخزيمي، وبدر الشحيمي، وخميس الوشاحي، وعلي الراسبي، ومحمد بن أحمد المعشني وعبد الحميد الدوحاني وغيرهم من جيل الشباب. ولا ينسى الحمداني أن يعرّج على الشاعرات الشعبيات العُمانيات فيذكر منهن :هجير، ومنال رعيدان، وشفيقة الجابري، وليلى الكثيري، ونجاة العوادي، وأصيلة السهيلي، وموزة الحراصي، وبدرية العريمي، وصالحة المخيبي و(رونق البادية).
أما الرواية فيبدو أنها أسعد حالًا من الشعر، بالنظر إلى أن فوز جوخة الحارثي بالجائزة العالمية التي أشرنا إليها تحقق رغم العُمر القصير نسبيًّا للرواية في عُمان. صحيح أن عبدالله الطائي كتب روايته “ملائكة الجبل الأخضر” – أول رواية عُمانية – عام 1963، إلا أن الصحيح أيضًا أنها نُشرتْ بعد وفاته، وتحديدًا عام 1981. لذا فإن عمر الرواية العُمانية هو أربعون سنة فقط. وحتى هذا العمر القصير ينقسم إلى مرحلتين: مرحلة التأسيس التي بدأت برواية الطائي هذه وروايته الأخرى “الشراع الكبير” واستمرت بروايات نُشِرت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي لسعود المظفر وسيف السعدي وحمد الناصري ومبارك العامري وآخرين، ولأنها مرحلة البدايات فإن النقد والتأريخ الأدبي في عُمان كان يتغاضى دائمًا عن عثراتها الفنية، ولم ينظر إلى أغلبها أكثر من كونه تسجيل حضور تأريخي. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة النضج الفني (أو بداياته على الأقل) التي يمكن التأريخ لها برواية بدرية الشحي “الطواف حيث الجمر” عام 1999، وهي ثاني رواية من تأليف كاتبة عُمانية (بعد رواية “قيثارة الأحزان” لسناء البهلاني الصادرة عام 1994). من هذا المعطى يمكن القول إذن إن الرواية العُمانية احتاجت فقط إلى عشرين عامًا لتفوز بجائزة عالمية مرموقة كـــ”مان بوكر”، ومن نافلة القول إنه عمر قصير في تاريخ الأدب. غير أنه تنبغي الإشارة إلى أنه إذا كانت الرواية هي ابنة الحركة والتدافع والصراع اليومي بين الأضداد، فإن ذينك العقدين من الزمن بين روايتي بدرية وجوخة شهدا تحولات اجتماعية وسياسية واضحة في عُمان انعكست على الرواية ومضامينها، بل وتقنيات كتابتها. وقد شاهدنا روايات عُمانية خلال هذه الفترة تنافس في مسابقات أدبية عربية (فازت رواية “الأشياء ليست في أماكنها” لهدى حمد بجائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2009، وصعدتْ “تبكي الأرض يضحك زحل” لعبدالعزيز الفارسي للقائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية عام 2008، و”سيدات القمر” لجوخة الحارثي، للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد عام 2011 قبل سنوات من فوزها بجائزة مان بوكر العالمية). وقد شهدنا تنوعًا في مضامين الروايات العُمانية أو الهمّ الكتابي الذي يحرك مؤلفيها؛ فإذا كانت روايات جوخة الحارثي وهدى حمد قد عُنيتْ بتقديم نماذج لنساء عُمانيات قويات يواجهن متاعب الحياة بصلابة وإصرار، فإن تجربتَيْ الروائيين الراحلين أحمد الزبيدي وعلي المعمري اهتمتا بتقديم التاريخ السياسي المعاصر لعُمان في قالب فني، لا سيما تاريخ ثورة ظفار الذي تناوله الزبيدي في رواياته “أحوال القبائل”، و”سنوات النار”، و”امرأة من ظفار”، فيما تناوله علي المعمري في روايته “همس الجسور”، بينما تناولت روايتُه “بن سولع” تاريخ الصراع في واحة البريمي. هذا التاريخ السياسي العُماني المعاصر فرض حضوره أيضًا في روايات “الباغ” لبشرى خلفان، و”حوض الشهوات” لمحمد اليحيائي”، و”الأحقافي الأخير” لمحمد الشحري، و”عودة الثائر” ليعقوب الخنبشي.
أما حسين العبري فيبرز في رواياته الخمس القلق الوجودي للفرد وغربته عن مجتمعه، حتى يمكن عدّها روايات الشخصية المأزومة الواحدة، كما هي الحال في “المعلقة الأخيرة”، و”الوخز” و”ديازيبام”، ومعظم أبطال هذه الروايات تلتهمهم العاصمة مسقط التي هي مسرح الأحداث، على عكس روايات يونس الأخزمي وزهران القاسمي التي تسرد الحياة العُمانية ولكن في مناطق بعيدة عن العاصمة، إذ يرصد الأخزمي في ثلاثيته الروائية “بحر العرب” حياة الناس في مناطق عُمانية ساحلية في محافظة الوسطى هي “بر الحكمان” و”غبة حشيش”، و”دوحة صوقرة”، في حين تتناول روايات القاسمي “جبل الشوع”، و”القناص”، و”جوع العسل” البيئة الجبلية في المنطقة الشرقية من عُمان. ورغم أنه لم يمضِ وقتٌ طويل على أحداث الربيع العربي عام 2011، والتي كان لعُمان نصيبٌ منها، إلا أننا لم نعدم روايات عُمانية حاولت تقديم رؤيتها لهذه الأحداث وانخراط العُماني في المطالبة بالعدالة والعيش والكرامة الإنسانية، كما هي الحال في روايات “صرخة واحدة لا تكفي” لحمود الشكيلي، و”الذي لا يحب جمال عبدالناصر” لسليمان المعمري، و”تعويبة الظل” لسعيد الهاشمي.
من الأسماء العُمانية التي كتبت الرواية أيضًا خلال العشرين سنة الأولى من الألفية الجديدة خليل خميس (تسع روايات) ومحمد سيف الرحبي (ثمان روايات) ومحمد عيد العريمي (أربع روايات)، ومحمود الرحبي (أربع روايات) وزوينة الكلباني (أربع روايات)، وبدرية البدري (ثلاث روايات)، وسالم آل تويّه (روايتان)، ويوسف الحاج (روايتان)، وعزيزة الطائي (روايتان)، وسعيد السيابي (روايتان).
وإذا كانت الرواية الأولى في عُمان قد نُشِرت عام 1981، فإن المجموعة القصصية الأولى نشرتْ أيضًا في العام ذاته. وهي مجموعة “سور المنايا” للقاص أحمد بلال بحار. تبعتها مجموعات قصصية أخرى لمحمود الخصيبي وعلي الكلباني وحمد رشيد وآخرين، بيد أن البداية الفنية الناضجة للقصة القصيرة في عُمان يمكن التأريخ لها بمجموعة “انتحار عبيد العُماني” لأحمد الزبيدي الصادرة في دمشق عام 1985، ومجموعة “ساعة الرحيل الملتهبة” لمحمد القرمطي سنة 1988. ثم ظهر في تسعينيات القرن الماضي جيل من كتّاب القصة أُطلِق عليه “جيل الجامعة” نسبة إلى جامعة السلطان قابوس التي كان معظم أبناء هذا الجيل يدرسون فيها في تلك الفترة. ومن كتّاب هذا الجيل يحيى سلام المنذري ويونس الأخزمي وسالم آل تويّه وبشرى خلفان وعبدالعزيز الفارسي وناصر المنجي وسليمان المعمري (الذي يفخر بأنه أول فائز بجائزة يوسف إدريس للقصة العربية القصيرة عام 2007)، كما ظهرت أسماء تنسب للجيل نفسه وإن لم تدرس في جامعة السلطان كمحمود الرحبي (الذي صعد مرتين للقائمة القصيرة لجائزة الملتقى العربية للقصة) ومحمد اليحيائي وعبدالحكيم عبدالله وعبدالله بني عرابة، وسالم الحميدي، وبدر الشيدي، وعلي الصوافي، وخولة الظاهري، وسعود البلوشي. وظل كثير من هذه الأسماء التي ذكرتُها حاضرًا في المشهد القصصي العُماني إلى اليوم، مطورًا أدواته الكتابية من مجموعة قصصية إلى أخرى، مستفيدًا من منجز القصة العالمية وتقنيات كتابتها المختلفة في الشكل، أما في المضمون فقد تراوحت القصص بين القضايا الإنسانية العامة، وتلك المستوحاة من التراث والبيئة العُمانيّيْن، إضافة إلى نصوص تعكس تفاعل هؤلاء القصاصين مع الأدب العالمي. وظهر بعدهم أسماء أخرى رسخت حضورها القصصي كذلك، كمازن حبيب، وحمود الشكيلي، وحمود سعود، وناصر صالح، والخطاب المزروعي، وأحمد الرحبي، وهدى حمد، ووليد النبهاني، وهلال البادي، وسعيد الحاتمي، وعبدالله خليفة عبدالله، وأزهار أحمد، وإشراق النهدي، ورحمة المغيزوي، وليلى عبدالله، وأحمد الحجري، وصولًا إلى أسماء أصغر سنًا من هؤلاء ولكن ليست أقل موهبة شرعت تكتب تفاصيل الحياة اليومية المعاصرة بلغة مختلفة كنوف السعيدي وأسماء الشامسي وحسام المسكري وفاطمة إحسان وبشاير حبراس وأمل السعيدي وحمد المخيني وعبير عيسى.
وإذا كان المسرح العُماني قد استهل بداياته في ستينيات وسبعينيات القرن المنصرم بالاعتماد على نصوص مسرحية عالمية وعربية لشكسبير وتوفيق الحكيم وغيرهما، إلا أنه سرعان ما أفرز مع الوقت مؤلفيه الذين تناولوا تارةً قضايا محلية تشغل الرأي العام، وتارة أخرى قضايا إنسانية عامة. فظهر في الثمانينيات محمد بن سعيد الشنفري وعبدالكريم جواد (اللذان تميزا أيضًا بأنهما مخرجان مسرحيان مؤسِّسان للمسرح في عُمان). وفي التسعينيات ظهرت الكاتبة آمنة الربيع التي أصدرتْ مؤخرًا أعمالها المسرحية الكاملة، وعبدالله خميس، وبدر الحمداني، وغيرهم. ثم ما لبث أن انضم للقائمة مالك المسلماني وهلال البادي وعماد الشنفري ومحمد الهنائي ونعيم فتح وغيرهم.
وفي الألفية الجديدة تفاعل المشتغلون بالمسرح في عُمان مع نظرائهم العرب، سواء بالمشاركة في المهرجانات المسرحية، أو مسابقات التأليف المسرحي. وفي هذه الأخيرة فاز عدد من كتّاب المسرح العُمانيين بجوائز عربية وخليجية لا سيما جوائز الهيئة العربية للمسرح التي فاز بها -في سنوات مختلفة- كلّ من هلال البادي وبدر الحمداني وعماد الشنفري وعبدالرزاق الربيعي ونعيم فتح وجهاد الشنفري. وتجدر الإشارة أيضًا أن الكاتب يوسف اللمكي فاز بجائزة الإصدار الأول في مجال المسرح في جائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2004. وآخر إنجاز تحقق للكتابة المسرحية في عُمان هو حصول الكاتبة وفاء الشامسي على جائزة الدولة لأدب الطفل في قطر عام 2020.
أما أدب الرحلات فإن الاسم العماني الأبرز فيه هو الأديب الراحل محمد الحارثي الذي فاز كتابه الأول في هذا الفن “عين وجناح” بجائزة ابن بطوطة العربية لأدب الرحلة عام 2003. وله أيضا كتابان آخران في أدب الرحلات هما “محيط كتمندو” و”فلفل أزرق” الذي صدر بعد وفاته. ومن الأسماء العُمانية التي اهتمت بأدب الرحلة أيضًا وأصدرت فيه كتبًا مختلفة: خلفان الزيدي ( نحيب النهر، والطريق 60، وخطاوي الطير، وعشر سماوات فاتنات) ومحمد المحروقي (من الفرضاني: يوميات رحلة إلى زنجبار وممباسا والبر الإفريقي) وعاصم الشيدي (لا أريد لهذه الرحلة أن تنتهي) وبدر الوهيبي (تذاكر سفر) وأحمد بن ناصر (قواعد الرحلة الأربعون).
وإذا ما انتقلنا إلى كتب السيرة الذاتية في عُمان فسنعثر على عدد كبير من الإصدارات، بدءًا من “مذكرات أميرة عربية” للسيدة سالمة بنت سعيد التي صدرت بالألمانية في برلين سنة 1886، وليس انتهاء بـكتاب “البحث عن وطن” لزهران الصارمي الصادر عام 2020 الذي يضع له عنوانًا جانبيًّا هو “سيرة مواطن عُماني عاش الغربة والاغتراب”. ويستطيع الباحث في السيرة الذاتية في عُمان أن يُفرّق بين ثلاثة أنواع من المؤلفين لهذه السيِر: الأدباء الذين يهتمون باللغة الأدبية لهذه السيرة بنفس درجة اهتمامهم بموضوعاتها، والشخصيات العامة التي ترى أنها عاشت حياة تستحق أن تُسرد للناس، وهؤلاء هم سياسيون وإعلاميون وموظفون حكوميون. أما النوع الثالث فهم عمانيو المهاجر – لا سيما في شرق إفريقيا – الذين يسردون حكايات الاغتراب عن عُمان والعودة إليها.
من النوع الأول نذكر سيف الرحبي الذي سرد طفولته في كتاب “منازل الخطوة الأولى: مقاطع من سيرة طفل عُماني”، ثم أتبعه بكتب سِيَرية أخرى كــ “القاهرة: أو زمن البدايات”. كما نذكر عبدالله البلوشي الذي تناول طفولته في كتاب “حياة أقصر من عمر وردة”. وقد نظر بعض الأدباء إلى سِيَرهم من مرآة المكان، كما فعل أحمد الزبيدي في “نبش الذاكرة”، وعادل الكلباني في “مقنيات وطن وطفولة”، ومحمد سيف الرحبي في “بوح سلمى”. في حين سرد بعضهم تجربة أليمة أثرت على ما تبقى من حياته كما فعل محمد عيد العريمي في “مذاق الصبر” الذي سرد بلغة أدبية رفيعة حكايته مع حادث سير أليم خرج منه أسير مقعد متحرك، وكما فعل خليفة سلطان العبري في “على الباب طارق” حيث سرد حكاية إصابة زوجته بالسرطان ورحيلها متأثرة بهذا المرض. أما ذياب بن صخر العامري وكما يبدو من عنوان سيرته الذاتية “ومضات من دروب الأيام” فقد انتقى محطات في حياته وكتب عنها بلغة أدبية رصينة.
النوع الثاني من كتّاب السيرة الذاتية، وهم الشخصيات العامة، نذكر منهم الإعلامي زاهر بن حارث المحروقي الذي وثق في كتابه “سارق المنشار” سيرة أربعين عاما قضاها مذيعًا في إذاعة سلطنة عُمان، كما نذكر وزير البريد والبرق والهاتف العُماني الأسبق أحمد بن سويدان البلوشي الذي وثق شغفه بالاتصالات وعمله كوزير في كتابه “رحلتي في عالم الاتصالات”، والفريق أول سعيد بن راشد الكلباني الذي سرد في كتابه “جندي من مسكن: شهد الذاكرة” السيرة الذاتية لأول مفتش عام للشرطة في عُمان. ومن هؤلاء أيضا الدبلوماسي محمود بن سليمان الزدجالي الذي سرد قصة حياته في كتاب “مشاهد وأحداث من سيرة عُمر”.
أما النوع الثالث الذي يسرد سيرًا ذاتية لعُمانيين عاشوا في المهاجر ، خصوصًا في شرق إفريقيا، فقد صدرت فيه كتب عدة، نذكر منها “العائدون حيث الحلم: مشاهد وذكريات عودة من زنجبار والجزيرة الخضراء إلى عُمان” لحبيبة الهنائي، و”مذكرات رجل عُماني من زنجبار” لسعود بن أحمد البوسعيدي، و”الصراعات والوئام في زنجبار” لعلي بن محسن البرواني، و”زنجبار والتكالب الاستعماري وتجارة الرقيق” لعيسى بن ناصر الإسماعيلي، وغيرها من الكتب.
وهناك نوع أدبي جديد بدأ يفرض نفسه في الكتابة العُمانية في السنوات الأخيرة هو أدب الرسائل، الذي تنوعت كتابته باختلاف مؤلفيه. فرسائل عبدالله حبيب في كتابه “الفراغ الأبيض الذي سيلي” كتب معظمها في الولايات المتحدة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حيث لا إيميلات وقتها ولا رسائل واتسب ولا وسائل تواصل اجتماعي، وهو ما جعلها رسائل مطولة يحكي فيها كل شيء بلغة أدبية فاتنة أقرب إلى نص سردي مفتوح، أما رسائل سعيد سلطان الهاشمي في كتابه “ياسمين على الغياب”، والتي كتبها عام 2012، فقد كانت قصيرة ومكثفة، موجهة من زنزانته الانفرادية إلى أمه وزوجته وبعض أصدقائه، يسرد لهم فيها حالته النفسية في السجن وحنينه العارم إلى الحرية وضوء الشمس. في حين كانت رسائل الكاتب أحمد الراشدي في كتابه “رسائل إلى فدوى” نوعًا من الاحتجاج على الموت من أبٍ مكلوم بابنته الصغيرة التي رحلت في ربيعها السابع، يخبرها بكل ما حدث له بعد رحيلها على هيئة تذكرات وأحلام ودموع وأشجان واشتياقات. غير أن رسائل ليلى عبدالله في كتابها “رسائل حب مفترضة بين هنري ميلر وأناييس نن” كانت نوعًا مختلفًا من الرسائل. فكما يتضح من العنوان فقد كانت رسائل متخيلة من تأليف الكاتبة نفسها أجرتها على لسان الأديبين الشهيرين، وبثتها أفكارها في مواضيع مختلفة، بدءا من الحب، ومرورًا بالكتابة والعزلة والحرية والغضب، وليس انتهاء بالطفولة والذاكرة والأحلام.
ولا يمكن أن أنهي هذا السرد عن الأدب العُماني دون التطرق لأدب الطفل الذي نال في السنوات الأخيرة اهتمامًا ملحوظًا من الكتّاب العُمانيين، بحيث باتت هناك أسماء متخصصة في أدب الطفل والناشئة. وتتفق الكاتبتان أمامة مصطفى وفاطمة أنور اللواتي – وهما من كاتبات أدب الطفل في عُمان – على السنة التي يُؤرَّخ بها بداية الاهتمام بأدب الطفل في السلطنة. ففي دراسة مطولة لأمامة، وشهادة ذاتية لفاطمة، تسردان أن نقطة الانطلاق للاهتمام بأدب الطفل في عُمان كانت بندوة عن ثقافة الطفل نظمها النادي الثقافي في مسقط عام 1989.[6] ليظهر بعدها بعامين ديوانا شعر خاصان للأطفال، الأول هو “أغنيات للطفولة والخضرة” للشاعرة سعيدة خاطر، والثاني “أنشِدْ معي” للشاعر الراحل علي شنين الكحالي. وفي الفترة نفسها نُشِرت قصتان للأطفال لطاهرة اللواتي وفاطمة أنور اللواتي، وتؤكد هذه الأخيرة في شهادتها أن أدب الطفل شهد انقطاعًا في عمان في الفترة ما بين عامي 1992 و2007، حتى عاد في هذا العام (2007) بصدور خمس قصص للأطفال للكاتبتين فاطمة أنور وأمامة مصطفى، إضافة إلى قصة للكاتبة أزهار أحمد، وهذه الأخيرة باتت اليوم من أبرز كتاب قصص الأطفال وروايات الناشئة في عُمان. ونستطيع القول إن أدب الطفل شهد ازدهارًا ملحوظًا كمًّا وكيفًا، خلال الفترة من 2007 وإلى اليوم. فمن ناحية الكم تحصي أمامة مصطفى اللواتي في دراستها المشار إليها سبعةً وأربعين كاتبًا عُمانيًا كتبوا أدب أطفال منذ ظهوره وحتى انتهائها من بحثها مطلع عام 2019. منهم أربع وثلاثون كاتبة، وثلاث عشرة كاتبا، كما تحصي 278 إصدارًا قصصيًا، وثلاث روايات، وثلاثة إصدارات في الحكايات الشعبية، وأحد عشر إصدارًا شعريًا وكتابًا مسرحيًا واحدًا وكتاب مقالات. أما أبرز من كتبوا قصصًا للأطفال – إضافة إلى من ذكرنا – فهم : بسمة الخاطري وهي الأغزر انتاجًا حيث يتجاوز إصداراتها الــ100 إصدار، وعائشة الحارثي وهي أيضًا رسامة ومصورة، فاز كتابها “الحنين” بجائزة مسابقة اتصالات لعام 2018، كما فاز كتابها “أنا والوحش” عام 2020 بجائزة أفضل الرسوم في مسابقة اتصالات أيضا. ولها اثنا عشر كتابا قصصيا. ومن الكتّاب أيضًا وفاء الشامسي التي تتميز بأنها تكتب المسرح بالإضافة إلى الشعر والقصة، وعبدالله العيسري الذي لديه مركز تربوي للأطفال يصدر مجلتين للأطفال هما “أيوب” و”حكايات”، وابتهاج الحارثي التي فازت قصتها “أنا وماه” بجائزة اتصالات عام 2015.
ورغم أنه لا يكتب أدب أطفال إلا أن المترجم العُماني فهد السعيدي لا يمكن إغفاله عند الحديث عن هذا النوع من الأدب في عُمان، فقد “أطلق عام 2013 مبادرة لترجمة أدب الطفل، تكللت بإنشاء مكتبة البطريق المتخصصة في ترجمة أدب الطفل العالمي، حيث قام فهد السعيدي بترجمة 21 عنوانًا من أشهر عناوين كتب الأطفال الكلاسيكية حتى الآن”[7]. كما أصدرت الروائية المعروفة جوخة الحارثي قصتين للأطفال هما “عش للعصافير” و”السحابة تتمنى”.
وها أنا – كما بدأتُ بجوخة – أختم هذا العرض البانورامي للأدب العُماني بها. وهو عرض لا يزعم أنه قبض على كافة مفاصل هذا الأدب، أو عرّف بجميع أسمائه، فهذه مهمة باحثين متخصصين في المقام الأول. وحسبي هنا أنني اجتهدتُ، ولي أجرٌ واحد على الأقل. أختم بجوخة الحارثي إذن مكررًا التساؤل نفسه الذي طرحتُه في بداية هذه الورقة: هل يمكن اعتبار فوز جوخة بجائزة مان بوكر عام 2019، منعطفًا تاريخيًا للأدب العُماني؟. لا أملك إجابة حاسمة لهذا السؤال، ولكنني أملك على الأقل أن أفخر بما بلغه الأدب العُماني الحديث، وأن أتفاءل بما قرأتُه منه أن القادم أفضل وأجمل.
……………………………
[1] محمد بن سلام الجمحي. طبقات فحول الشعراء، تحقيق: محمود محمد شاكر، ج1 (جدة، مطبعة المدني، 1980) ص204.
[2] انظر مقال: الشاعر العماني قطن بن قطن الهلالي في المصادر التاريخية، حمد الخروصي، جريدة الوطن العُمانية، 30 مارس 2014.
[3] كتاب “جهة النبع: شهادات عن الإعلام الثقافي في عُمان”، إعداد وتحرير: سليمان المعمري وسارة المسعودي. إصدارات مؤسسة بيت الزبير. 2018. ص 1010
[4] المصدر السابق . ص102
[5] المصدر نفسه . ص 102
[6] انظر دراسة بعنوان “ملامح أدب الطفل في سلطنة عُمان: النشأة والتاريخ والببليوغرافيا” ، أمامة مصطفى اللواتي، مجلة الطفولة العربية، العدد الثمانون.
وانظر أيضا شهادة بعنوان ” تجربتي مع أدب الطفل في السلطنة”، مدونة الكاتبة فاطمة أنور اللواتي، 18 مايو 2011.
[7] “ملامح أدب الطفل في سلطنة عُمان: النشأة والتاريخ والببليوغرافيا” ، أمامة مصطفى اللواتي، مجلة الطفولة العربية، العدد الثمانون.