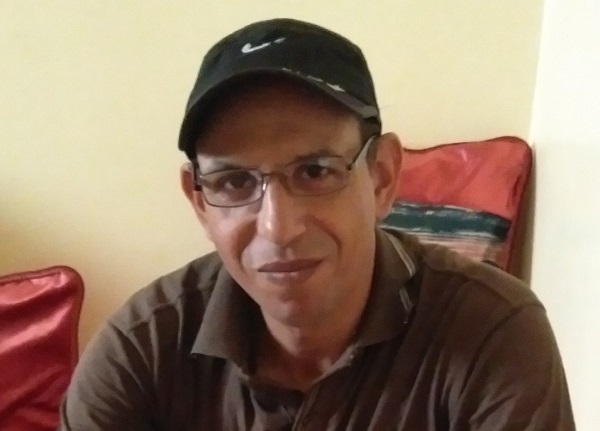عبد اللطيف النيلة
أشتهي حساء بالسميد. يتناهى إلى سمعي صخب الحياة المستيقظة في حينا السكني: هدير سيارة جارنا عبد الجليل الذي ينتظر أن يسخن المحرك قبل أن ينطلق إلى عمله، صوت بكاء طفلة صغيرة أرجح أنها إسراء رضيعة جارتنا فاطمة، نداء بائع السمك؛ ها الحوت! ها الحوووت!… تغزو خياشيمي رائحة قهوة سوداء متبلة بالأعشاب، من غير شك أن جارنا عبد الصادق، الساكن بالطابق العلوي من دارنا، يرشف كأس قهوته مدخنا سيجارة الصباح الأولى.
أدنو من الصالون حيث تنامان. أقف عند عتبة الباب، أستند بيدي على الإطار، وأتسمع. يتعالى الشخير والأنفاس تتوالى بانتظام؛ هما غارقتان في النوم، من غير اكتراث بما حولهما. من أين، يا ربي، تأتيان بكل هذا القدر من النوم؟ لا شيء يكدر انطباق أجفانهما، لا ضوء الشمس الذي أحس بأنه غمر صحن البيت واخترق ستائر نوافذ الصالون، ولا أصوات الناس والأشياء المنبعثة من الخارج، ولا صوت التلفاز الذي شغله الطفلان في غرفة الجلوس، حتى العبارات المشحونة بالغضب التي تصدر عني من حين لآخر، لم تكن تشوش على استغراقهما في النوم. فلتقم الدنيا أو فلتقعد، لا شيء يثير إحساسهما. فليبتلع الطفلان سيل الرسوم المتحركة كما يشاءان، وليغرقهما هذا السيل، يوما إثر يوم، حتى يبدأ أكبرهما في الكلام كأبطال الرسوم تماما… أطلب منه أن يخفض صوت التلفاز قليلا، يرد علي: “اغربي عن وجهي أيتها العجوز الشمطاء”، فأضحك رغم أنفي وأنا أعجب أن يتحدث طفل في ربيعه الخامس على هذا النحو… فلتستيقظي، يا نادية، على الأقل لتزيلي حفاضات ابنك الأصغر؛ أزكمت أنفي الرائحة الكريهة، والمسكين سيظل مثقلا بحمولة الحفاضات، التي امتلأت ليلا، إلى أن تشبعي نوما. يا للعجز الذي أصبح يكبل يدي! حتى هذه الحفاضات ما عدت أستطيع تخليص حفيدي منها.
أمرر يدي على الحشية، فتصطدم بكيس ابنتي سلمى حيث تحتفظ بجلباب إحدى زبوناتها وعُدّة عملها: الطارة الخشبية، وبكارات الخيط وعلبة الإبر… منذ أكثر من شهر وهي تعكف على التطريز، وصاحبة الجلباب تأتي كل يومين لتستعجلها، لكن لمن تترك النوم؟ لو بكرت في الاستيقاظ لأنهت أكثر من جلباب، ولجنت مكسبا مجزيا، فضلا عن السمعة الطيبة. أكرر على مسامعها هذا الكلام، فترد علي بعصبية: “اهتمي فقط بنفسك يا أمي، أما أنا فأعرف شغلي جيدا، ومن لا تروقه طريقة عملي فليبحث له عن طرّازة من هاته الطرّازات المدعيات الرديئات”.
أنحني إلى الأرض لأتلمس الزربية، تصطدم أصابعي بفتات الأكل. ألا تحتاج هذه الزربية إلى الكنس؟ ماذا لو زارنا في هذه الساعة أحد الجيران؟ ماذا عساه يقول عن الوسخ والرائحة الكاتمة للأنفاس؟ أتقدم، في حذر، على طول الصحن، أستنشق رائحة الغبار وتحس قدماي بخشونة تشوب سطح الزليج الصقيل، خشونة متأتية، دون شك، من تراكم الأوساخ. أين الأيدي الحاذقة التي ستسكب ماء ومطهرا على أرضية الدار، وتمرر فوقها مطاط الكرّاطة لتشتعل نظافة؟ قلبي يغص بالغم: “آويلي عْلى قَلّْةْ صَحْتي!”، أنجبتُ مع الوالدات وأضحيتُ مع العاقرات! تستدعي ذاكرتي صورة صهري وهو يعلن اشتهاءه لطاجين معد على النار الهادئة للمجمر الطيني، بدلا من الوجبة الملفقة السريعة لطنجرة الضغط. رغم هذا كله، تسخران بلا حياء: لم الاستيقاظ باكرا؟ لكن حتى لو كان كل شيء على أحسن ما يرام، ألا تحتاج هذه الضريرة من يعد لها إفطارا تخرس به عواء السكري في دمها؟
أشق طريقي، بأناة، باتجاه المطبخ. أضع أصابعي على حافة المنضدة الرخامية، أخطو على مهل حتى أبلغ حوض المجلى. أمد يدي داخله، فترتطم بالأواني المتسخة منذ عشاء الأمس. أغطس الإسفنجة في المنظف المتضوع برائحة الخزامى، وأفتح الصنبور شارعة في غسل الأواني. أتذمر بصوت عال: الدود سيأكلنا وهن لسن في هذا العالم! اللعنة على موتان القلب وبرودة النفس. أنتفض فزعة على صوت تحطم صحن من الخزف، لم أحسن وضعه في شبكة الأواني فسقط على الأرض. حتى أبسط الأعمال يغدو محفوفا بالإخفاق! أرتب الأواني في الشبكة ملتزمة أقصى الحذر، أجمع فضلات الأكل التي ترسبت في تجويف مصفاة البالوعة وألقي بها في سطل القمامة تحت الحوض. عصافير بطني تقرقر، ودوخة طفيفة تستبد برأسي. لن ألوذ الآن بفراشي في انتظار أن تنفتح أجفانهما المتورمة من فرط النوم. السكري لا ينتظر، بل إنه لا يتوانى عن شن الهجوم؛ يسلط علي جوعا شرها ينهش بدني. سأعد حساء.
أكتشف موضع علبة السميد المنقى. أحفن منه ما يكفي لصنع قدر الحساء، وأخلطه بالماء في زَلَفَة كبيرة.. ألتقط قدرا معدنيا، أملؤه ماء إلى منتصفه. أتحسس الطريق، في احتراس، على طول المنضدة الرخامية حتى أبلغ موقد الغاز. تهتدي أصابعي إلى الولاعة التي كانت مدسوسة داخل جيب من القماش معلق على الحائط. فوق أثافي الموقد أضع القدر، وأشعل الولاعة. لم تشتعل الأثافي إلا بعد المحاولة الثالثة. كدت أتسبب في ما لا تحمد عقباه، إذ حدث في المحاولة الأولى انفجار صغير. أدرك أني سربت قدرا أكبر من الغاز، فأسارع مرعوبة إلى إغلاق مفتاح الموقد. في المرة الثانية، أدير المفتاح قليلا وببطء، وأشعل الولاعة. تستشعر أصابعي عدم اشتعال النار، فأغلق المفتاح بدورة سريعة. في المرة الثالثة، أتنفس عميقا، ثم أعاود الكرة، فأحس بلفح اللهيب في رأس أصبعي. لا شيء يخيفهما من عماي غير النار. تكرران على مسمعي: “إياك ثم إياك أن تقتربي من الموقد”. ترتعبان من احتمال أن تشب النار في ثيابي، لكن سلمى واجهتني مرة بصراحة جارحة: “ستُضرمين النار فينا يوماً، إن لم تردعي رغبتك في الطبخ!”.
أتلمس طريقي من المطبخ حتى غرفة النوم. أجلس على حافة السرير، أمد يدي باتجاه الوسادة. ألتقط المذياع الصغير، أشعله. الصوت عال جدا يكاد يصم أذني، أخفضه قليلا، وأروح أستمع. كانوا يناقشون حوادث السير. إحصائيات فاجعة، انتقاد لسلوك السائقين، ونصائح… أهذا موضوع يفتتح به الصباح؟ أدير مفتاح المذياع إلى أن أصادف أغنية تذكرني بأيامي الخالية، حين كنت أتمتع ببصري:
“حطّيتْ الطْبيلة خويا
وحطّيتْ الكيسانْ
وْجاوْ لْبالي
الحْبابْ والعَشْرانْ…”
كانت صاحباتي يزرنني، بعد العصر، فأعد إبريق شاي وأضعه على الصينية الفضية محاطا بكؤوس زجاجية. نأخذ في تجاذب أطراف حديث شائق، يقفز كالطائر من غصن موضوع لآخر، فيما نرتشف الشاي بصوت مسموع، ونقضم حلوى “الغْريبة”. ولما نتعب من الحديث، أشغل شريط أغاني محمد فويتحْ، نلتذ بالإصغاء ونردد الكلمات على إيقاع الموسيقى. وبمجرد أن تنطلق أغنية “حطّيت الطبيلة”، كانت اللّا فاطنة ترفع الصينية الفضية فوق رأسها، وتشرع في الرقص، بتوازن مذهل، فلا يقع الإبريق أو الكؤوس رغم دورانها حول نفسها، ورغم تحركها، بالتعاقب، إلى الأمام وإلى الخلف، فيما حناجرنا تصدح بالأغنية حتى تغطي على صوت فويتحْ. فور انتهاء الأغنية، تعيد اللّا فاطنة بقامتها الفارعة الصينية إلى مكانها فوق المائدة وتجلس مكانها، فيما نغدق عليها عبارات الإعجاب والتهنئة: “تبارك الله عليك ألَلاَّ، الله يعطيك الصحة!”. يشيع بيننا جو مفعم بالفرح والانتشاء. ثم تدفع إحدانا اللّا ربيعة إلى وسط الصالون لترقص، فتتمنع، لكننا نستحثها، فتستسلم أخيرا. نعطيها شالا فتحزم به وسطها، وأشعل شريط الشيخات، فتأخذ في الرقص متلاعبة ببراعة بجذعها، مديرة مميلة ردفيها…
عميقا أتنهد: أين تلك الأيام الجميلة؟ رويدا رويدا انفرط عقد جلساتنا. منهن من انتقلت إلى حي سكني آخر، ومنهن من رحلت إلى دار البقاء، ومنهن من أقعدها المرض أو الشيخوخة. لكن ما أوجع صدري أن بعضهن انقطعن عن زيارتي مذ رزئت في نور عيني.
كان غليان الماء مسموعا. دلقت خليط السميد في القدر، وأخذت أحرك بالمغرفة المعدنية، حاسبة حركاتي بدقة حتى لا أقلب القدر أو تشتعل نار الموقد في كم ثوبي..
أعود إلى غرفة الجلوس حين يتناهى إلى سمعي شجار الطفلين. أقف عند عتبة غرفة الجلوس، وأسألهما: ما بكما؟ عبثا أكرر السؤال، يستمران في الشجار دون أن يعبآ بي. أفهم من صياحهما أنهما يتنازعان حول آلة التحكم. يتعالى بكاء أصغرهما، فأصيح: “آلمسخوطْ اتركْ أخاك في سلام!”. يتواصل البكاء والصياح، فأدنو من مكانهما ببطء تتقدمني يداي. تند من الأكبر صرخة، تتلوها صرخة الأصغر. أحس أنهما يتبادلان الضرب. أصيح في وجههما شاعرة بفداحة عجزي. أُسَرِّع خطوي قليلا، فتتعثر قدمي في شيء، لعله سيارة بلاستيكية صغيرة، أكاد أسقط… أتمكن أخيرا من الإمساك بكتفيهما، أفصلهما عن بعضهما البعض، وأحاول المصالحة بينهما. يكف الأصغر عن البكاء، فيما الأكبر يرد بلسان الرسوم المتحركة: “وغد أحمق! عجوز شمطاء!”.
حين أقدر أن الحساء قد نضج، أدنو من الموقد. كان مزيج الماء والسميد يبقبق، أتناول مغرفة معدنية، وببطءٍ حذِرٍ أغمسها في القِدْر، أحرك المزيج قليلا، أغرف الحساء وأرفع المغرفة أعلى القدر وأفرغها فيه، أكرر حركتي تلك عديدا من المرات، محاولة اختبار مدى انعقاد المزيج، كنت أسمع صوت انصباب الحساء من المغرفة، وأحس في آن، عبر أعصبة يدي، انعقاده. أطفئ الموقد، بعد برهة، وأضيف إلى الحساء قليلا من زيت العود. أتحسس بأصابعي موضع قوارير التوابل حتى أعثر عليها مركونة بجانب الموقد. تَشابُهُ القوارير يعيق بحثي عن قارورة الملح. بأصابعي أحاول تلمس محتوى كل قارورة على حدة، إلا أني أخفق في اكتشاف قارورة الملح. أنحني على القوارير مُدنية أنفي من أغطيتها، أتشمم روائحها واحدة بعد الأخرى، فأميز بيسر الكمّون والفلفل والزنجبيل… كانت روائح نفاذة تقتحم خياشيمي، حَدَّ أن الإبزار دغدغ شعيرات أنفي فدهمتني عطسات قوية. لكني لم أجد أثرا للملح، رغم أني استكشفت جميع القوارير. لابد أن إحداهما، قد أفردت قارورة خاصة للملح خارج طاقم التوابل. بأصابعي أتحسس كل موضع في منضدة المطبخ، لكن دون جدوى. أعاود التحسس، فأقف باستسلام أمام المنضدة شاعرة بالخيبة. لم أتقبل إخفاقي في مسعاي، بل غمرني خليط من السخط والغضب على نفسي وعلى ابنتيّ: يا لسخرية القدر! كيف أفشل في إنجاز عمل تافه كهذا؟! لقد صرت أضحوكة!
أتذكر حكاية المرأتين التي طالما رويتها لابنتيّ، في طفولتهما، على سبيل التفكه: امرأة أرهقتها أعباء أطفالها الصغار، زارتها جارتها ذات يوم، فعابت عليها تلطخ بساطها (الذي كان مصنوعا من لبدة الخروف) ببراز رضيعها. ولما دارت الأيام ردت المرأة الزيارة لجارتها، وكانت هذه قد رزقت ولدا، وبينما هي تحادثها لاحظت، في دهشة، تلطخ ناظرها ببراز رضيعها، فعلقت: “أنا كانْ ليَ غيرْ فْ الْهياضْرْ، أُمّا انْتِ وْلّى ليكْ فْ النّْواضْرْ!”. أليس هذا هو واقع حالي الآن؟
أصب لنفسي زَلَفَةَ حساء، وأجلس إلى المائدة أحتسيه دون أن أستسيغ مذاقه، يغص به حلقي، أجهش بالبكاء، يغمرني إحساس بأني أحتسي حياتي التي غدت بلا طعم.