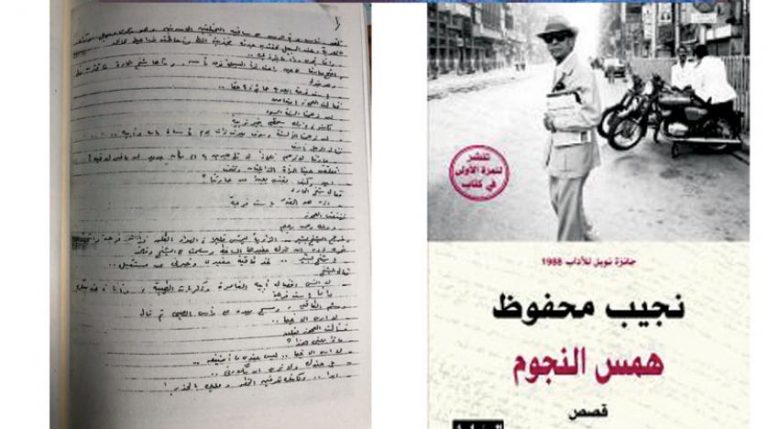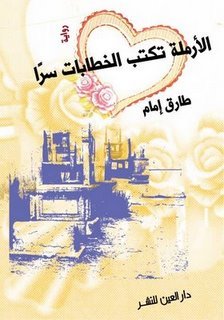ستكون متوالية الاحتمالات واحدة من استراتيجيات الخطاب الروائي الذي يتسع موجة إثر موجة وهو مع اتساعه ينطفئ، أو يتبدد، أو يذوب، لكنه يحافظ على رؤيته لحدثه المركزي، حضور رنا بعد موتها، بوصفه حقيقة تعززها إشارات متعددة: البلوزة، والقميص، ورقم ناهد، وورقة الطلبات المنزلية، وهي الحقيقة التي تتأسس عليها شبكة الاحتمالات اللاحقة قبل أن تتماهى في احتمال لا حدود له. هذه الإستراتيجية التي ستوجه مسار الخطاب الروائي حتى آخر كلمة في شريطه اللفظي وهو يقع في (الصمت) قبل أن ينقطع كلامه ويقع في البياض:
” ـ سامعني؟
ـ أيوه.
لم يعرف يحيى من سأله هل الرجل أم رنا أم أحد المسحورين أم أمه تسأله ” أنت أجازه النهارده؟” أجابهم كلهم بالكلمة نفسها. وما إن قالها حتى تلاشت أصواتهم كأن إجابته كانت الموافقة على صمتهم“.
إن يحيى لا يعمل على غلق دائرة السؤال بالوقوف على إجابة محددة أو احتمال واحد، أقرب الاحتمالات إلى الذهن وأكثرها مقبولية، كما لا يعمل على ترك الدائرة مفتوحة، دونما إجابة، لكن احتمالاته تتوالى لتكون امتداداً للسؤال نفسه، وأصداءً لا نهائية لصوت ينبثق من منطقة اللايقين، هذه المنطقة التي تسعى الرواية للوقوف على أرضها الرخوة، وهي ترعى زمنين تطلقهما عتبتها المستلة من ألف ليلة وليلة، وهي تضع الشاب بمواجهة الملك، وما الصلة بينهما إلا سؤال يوجهه الشاب لـ (ملك الزمان): ” أتدري ما بينك وبين مدينتك؟ فقال الملك: يومان ونصف. عند ذلك قال له الشاب: أيها الملك إن كنت نائماً فاستيقظ، إن بينك وبين مدينتك سنةً للمُجِدّ، وما أتيت في يومين ونصف إلا لأن المدينة كانت مسحورة”(28)، يكشف التباين في تصور الزمان بين الشاب والملك، ملك الزمان، المنطقة التي تسعى “مسألة وقت” لاكتشافها من دون أن تجد لذلك سبيلاً، إذ يشكل الزمان مشكلة الرواية التي يضيء العنوان على نحو مخاتل أحد وجوهها وهو يعمل على تخليصها من محمولاتها لتوجيهها وجهة عامة، شعبية ومؤتلفة، محولاً إياها من (مشكلة) إلى (مسألة) تحمل من البساطة والعرضية ما تؤكد معه مخاتلتها وهي تحوّل (الزمان) إلى (الوقت)، وهي تندفع إلى الهوة الصعبة بين السؤال واحتمالات الإجابة، هذه المشكلة التي تعمل الرواية على مقاربتها عبر الذاكرة وهي تبحث في الحاضر عما يؤكد الماضي ويبرهن على صدق حوادثه، لكنها في دوامة بحثها تبدد فكرة الحاضر بعد أن تُزيح أُلفته، تطمره تحت ركام الماضي وشظايا استعاداته التي تُصبح مع تقدم الرواية أكثر قوة من الحاضر نفسه، فيحاصر وهم الماضي عندئذ مجريات الحاضر ويربك جريانه، إنها لحظة انكسار الزمان بين زمن الشاب وزمن الملك، زمن رنا وزمن يحيى، زمن الأسئلة المتوالدة وزمن الإجابات المفتوحة على ما لا ينتهي من الاحتمالات، فتبدو الوقائع، ومنها واقعة زيارة رنا ليحيى “أشبه بالذكرى التي تُدخلها الذاكرة إلى زمن الديمومة، أوالزمن الذي تبتلعه الذاكرة وتخلّفه في أعماق الكائن الذي أضاع مفتاح ذاكرته”، فهو يخطو مأخوذاً بما ترسمه الذاكرة من أخيلة وما تستحضره من تصورات، إن الذاكرة تواصل فاعليتها وهي تؤسس انتباهات الخطاب الروائي بناء على قوانينها، وهي تعمل على نحو ضدي، إنها في الوقت الذي تربك تلقي يحيى للعالم وتخلخل موقفه منه جراء عدم قدرتها على تقديم فهم واضح، منتظم ومعقول، لحادثة حضور رنا وهي تستعيدها وتدقق في تفصيلاتها، تعمل، من جانب آخر، على إنقاذ يحيى من الغرق في بحر البطالة، إنها حبل الإنقاذ الذي أمّن له العمل في مكتب التوزيع، ولم يكن يملك ميزة تؤهله للعمل أهم من ميزة الذاكرة التي استحوذ من خلالها على اهتمام صاحب المكتب، إنها الذاكرة التي تخلخل حتى ما نظنه عن أنفسنا ففي البداية ظن ذاكرته ستكون نقطة ضعفه، وسرعان ما وجدها تمده بما يريد في أي وقت، مثلما تؤدي دورها في رؤية ما لا يرى وقد استحضرت المعديّة، في واحد من أجمل مقاطع الخطاب الروائي، على حائط غرفة يحيى فور استيقاظه، لتكون الرؤية، بحسب ملفوظ الخطاب، وجهاً من وجوه اليقظة لا طيفاً من أطياف المنام ” نزل من السرير ووقف وسط الغرفة ليتأكد من أنه لا يحلم. وعندما شك أنه ما زال في الحلم خرج من غرفته وعاد إليها وفتح الشباك وأطل منه. مستحيل أن يكون في حلم إلا إذا كان من الأحلام التي ترى نفسك فيها وأنت تحاول أن تستيقظ وتتخلص مما تحلم به”، إنه يستعيد صوت الشاب في عتبة الرواية وهو ينبه الملك ” إن كنت نائماً فاستيقظ”، دافعاً الرواية عبر الذاكرة إلى رؤية ما لم يُر بعين يحيى من قبل هي تعيد تقديم المشهد على نحو مرئي بناء على ما تقدم من تفصيلات، فالمعدية تُستحضر طبقاً للأوصاف التي ذكرتها ناهد، صديقة رنا، بركابها وحيواناتها وسياراتها وعرباتها الكارو، إنهم يُستحضرون لا في سبيل تأكيد وجودهم، أو الدفاع عن لحظاتهم الأخيرة قبل واقعة الغرق بل ليكونوا شهوداً على وجود المعديّة في غرفة يحيى، وهي اللحظة التي يؤخذ فيها الركاب الموتى بدهشة أن يكونوا هنا، محاصرين بحائط وسقف ينشغلون بالنظر إلى أعلى حيث من المفترض أن تكون سماء فلم يجدوا سوى سقف بمصباحه المطفأ، تُستحضر المعديّة على الجدار صورة ثابتة ـ ولنتذكر بدورنا تصور سوزان سونتاغ ـ لا يتحرك كل من كان فوقها ولا يتكلمون، إنهم يعيشون بعد الموت دهشتهم ويواصلون شهادتهم على وجود المعديّة في الغرفة، الوجود الذي يحيا قلقه الخاص وينمّي احتمالاته بين الحقيقة والحلم، حيث يكون الحلم في عالم منتصر القفاش رديفاً للخيال ووجهاً من وجوهه، وهو الآلية التي يُستحضر العجائبي من خلالها بوصفه استيهاماً يوطد علاقته بلا وعينا وبـ” الغرابة التي تسكننا” حسب جان بلمان نويل، إنه القنطرة القصيرة بين الممكن والمستحيل وهو اللحظة التي تتراسل خلالها أحلام الموتى مع أحلام الأحياء لتواصل الرواية في مزيج أحلامهما نسج حكايتها وهي تعيش دينامية المواجهة بين التذكر والنسيان.