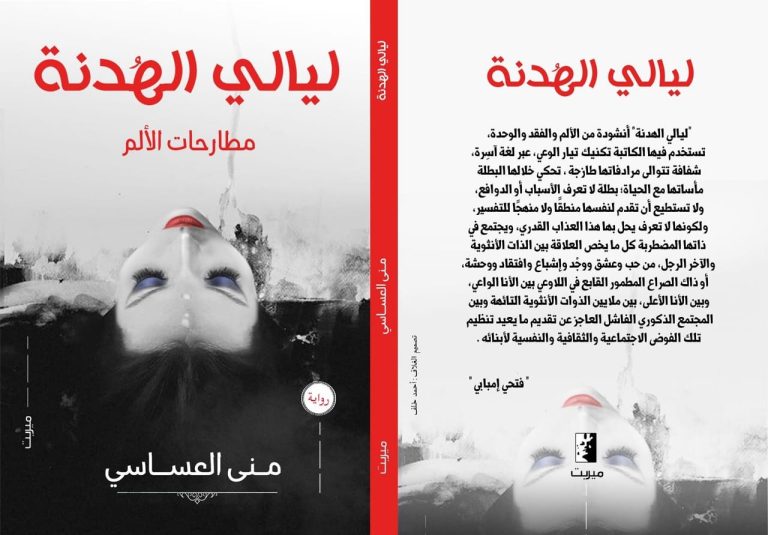رحمن النجّار
نصّ الأثر
وهما يتضاحكان على شرّ البليةِ
يقول الأعمى لصاحبهِ الأصمّ؛ “دعنا ننتظر ونرى”
صوت
في طريقه إلى ميدان الزمن، كان لماركوس أوريليوس تابعاً وكأنه ظلّه، وظيفة التابع هي، حين ينتهي المارة من مديح السيّد والثناء على أعماله وأفكاره العظيمة أن يقول جملة واحدة لا غير لسيّده وبصوت لا يخلو من ندّية؛ “تذكّر أنكَ مجرد رجل! “. قد كثر الكلام عن هذا التابع، حدّ ظنّ البعض إنهُ هو مجرد صوت ماركوس أوريليوس الداخلي ذاتهُ وهو يفكر على نحو مسموع بعد كل مديح وثناء
ونحنُ مثلما نحن
قالوا لنا، إننا جئنا من البحر
بهذا فقد صيّروا حياتنا لواحدةٍ من شؤون الصيّد الكبرى
ونحنُ مثلما نحن، نتغير أربع مرات في السنة. نحن أبناء الكون والمهنة، لنا استعاداتنا الآبدة. لنا أيضاً وصية جلجامش لإبن الأهوار وبيته الذي مِن قصب: “يا ملك شورباك، يا إبن أوبارو، إهدم بيتك وشيّد مركباً، قريتكَ ستظل تائهة أبداً “
تُزهر قبلَ أن تموت
ومنذُ أور والناس تصفُ أجمة القصب التي تقف وحيدةً في العراء وتنحني لتقاوم الهبوب، على أنها الألم. منذ أور وهم يَصِفونَ الأجمة،كيف أنّها تعمّرُ طويلاً لتزهرَ مرة واحدة في تخوم حياتها وتموت. تزهرُ قبلَ أن تموت. لكن الوصف لا ينتهي عند هذا الحدّ، إذ أنّ الأجمة الميتة تظل ناتئةً لتكوّنَ دكةً صلدةً تقف عليها الطيور، لتشرب الماء أو تستريح. ومنذ أور ونحن لا نستريح دون الجلوس على دكة آلآمِ مَن سبقونا، مِمَن أزهروا وماتوا، كما إستعادات آبدة
مراكبَ صغيرة ومياه قريبة
مَن مِنا بين حينٍ وآخر
لا ينظر لخطوط باطنَ كفّه وكأنها خارطته
كأنها الرِهان، ساعة ذئبٍ صمّاءَ وبلا عقارب
مَن مِنا لم يُشكّلَ مراكبَ صغيرة
من ورق دفاتره المدرسيّة في أولى سنيّ حياته
ويَدعها تبحرُ في مياهٍ قريبة منه وكأنها مياهه
بالأحرى، مَن منا لم يهدم أوراقَ دفاتره -والتي من قصب- ليشيّدَ مركباً
مَن مِنا لم يذكر شجرة آدم التي توارى فيها ولو لمرة
لم تكن لآدمَ من خرائطَ تُذكر، باطن كفّه كانت شاسعةً للحدّ الذي بوسعه النظر للخطوط والمشي وفق الرِهان وحياته هي المركب. هي أيضاً أول يدٍ بشرية وبطموحاتٍ لشدّ ما كانت بِكراً
لم تكن في حياة آدم من مدن تُذكر أو بشرٍ حتى، كان هوَ وحوّاء وحفنة أولاد. لم تكن له من لغة تُذكر، كانت له التمتمة والتي -لما تزل- بيننا تؤلفُ أبجدية منزوعةٍ من لغة الباطن، لغة المغمور والعصيّ. التمتمة، هذا الشكل شبه المسموع من ” المساررة” بين الأرواح جميعاً والتي من خلالها مثلاً، توصلت هيلما كلينت – وهي في قبرها – لفن التجريد قبل كادنينسكي ومالفيتش. المساررة، والتي من خلالها مثلاً أنصتَ عقيل علي ملياً لحياة إنكيدو في العراء ليبتكرَ موته
لم تكن لآدمَ من أضلاعٍ في صدره وحوّاء لم تُخلق من ضلع آدم
حوّاء خلقت من تضرعات عين آدم وتوسلات وحدته، من شراسة عين رغباته
لم تكن لآدمَ مِن أضلاع، كانت له شبكة صيّد
إصطادت قلبه ورئتيه وظلّت تتأرجح بهما في كهف صدره
حتى أننا وبعد أن خَبِرنا جلد السمكة
إبتكرنا الشبكة كنظيرٍ لجلدها، لإستدراجها وصيّدها
حتى أننا وبعد أن خَبِرنا أن ليس للمياه سوى الجريان
إبتكرنا السدود لإصطيادها وبهذا حصلنا على الرّي
نحنُ مخاتلون في إختراع أذى مصادفات كاذبة
ليكون بمقدورنا القول؛ هي مكيال الحقيقة
ومازال السمك لا يدركُ نوايا الشِباك، مثلما المياه لا تدركُ نوايا السدود. يتصوران وفي كل مرة أنهما يدخلان جلديهما كطقس من حنين. ونحن ومنذ عصور مثلما نحن، ورغبتنا في المعرفة أقل بكثير من رغبتنا في أن يتمّ خداعنا كطقس مماثلٍ من حنين
بعد موت حوّاء، تغيرت حياة آدم
تغير قلبه وظلّت رئتيه حبيستا الشبكة
ترتفعان وتنخفضان كما الرهان وكما الطريق وما مِن صيّدٍ يُذكر
آدمَ قد تغير وغادر حياته. ظلَّ يتمتم عن مراكبَ صغيرة، شخصية، لاتُرى وأنهُ سيأتي منهُ مَن يحوّل ذعرنا جميعاً إلى مجده ومن ثم يحول مجده إلى سجننا الآبد. ومن أجل أن يبقى على قيد الحياة، ليكسب الرِهان أو يخسرهُ، فقد توارى داخل شجرة عند مَصبِ النهرين، ليظلّ حيّاً بفحوى النسغ كما لو أنهُ الجذع. حتى أنهم أسموها بــــ ” شجرة آدم”!
قد توارى حدّ أن بلغ بهِ العمر وبلغت به اللحظة، بأن يربت بيده على كتفِ نوح ليوصهِ، بعدما رآه وبيده البلطة ويهمّ بهدمِ بيته الذي من قصب، ليشيّدَ مركباً:
” يا نوح، يا بُني، الموت عدوى، فإحذر أن تُرهبَ الناس بالطوفان وتحوّلَ ذعرهم إلى مجدكْ ومن ثمَ إلى سِجنهم إذا ما كان لزاماً عليك أن تبني مركباً، فليس عليك أن تفزعَ الناس بطوفانك، عوضاً، عليك أن تدعهم يبنونَ لهم مراكبَ صغيرة بإرادتهم المحّضة، مراكبَ صغيرة ولا تُرى، شخصية جداً ومِن قَصَبِ حياتهم، حدّ بمقدورها التسلل لمياه كل منهم خلسةً والإبحار بهِ للخلاص إذا ما شعرَ هو ذاته بالطوفان. بهذا سينقذُ كل إنسان نفسه ويكون مجده، بهذا سنُنقَذُ جميعاً ويكون الإنقاذ مجدَنا وليس مجدك وحدك، ولن نكونَ في سجنِك أبداً؛ يا نوح، يا بُني؛ ” تذكّر أنكَ مجرد رجل!”، وحياتُنا هي العدوى، فإحذر “
لكن نوح لم يشأ أن يكون له صوته الداخلي الذي يتبعه كما ظلّه حتى لو كان ذاك الصوت بآدم
ويحكى أنه وما أن إستدار نوح ليرى مَن يُحدّثهُ وبيده البلطة، حتى أن زمناً طويلاً قد مرّ على هلاكه وهلاكِ مركبه ومَن معه، حتى أننا الآن وبعدَ أن قصفوا شجرة آدم في 2003، رحنا نفتش عن أثرٍ ما ليده التي ربتَ بها على كتف نوح، لنضعها على أكتافنا، ليكون بمقدورنا على الأقل أن نكونَ نوح َ العصر الجديد، لنستدير ونرى مَن يُحدثنا وذات البلطة في اليد، ويكون الوقت قد مرّ على هلاكنا ومَن معنا؛
” ونحن مثلما نحن
نتغير أربع مرات في السنة
كما إستعادات آبدة”
كرسي هزاز مغطى بشرشف أبيض
يوهانا نجارةُ مراكب، مريضة، صوتها كما حين تمسّدُ شرشف سرير بباطن كفّك
في بيتها، وهي نصف ممدة في السرير، سألتني:
” هل تسمعُ هذا العِواء الذي يتسلل إليّ من النافذة؟”
:
” لا أسمع يا يوهانا، أنتِ تنصتين ملياً لحياتك، وهذا هو الحنين أو الشِعر ربما”
يوهانا:
الشعراء يتحدثون عن الإبحار دون أن يكونوا قد أبحروا ولو لمرة، لكني صنّعت عدداً من المراكب وأبحرتُ على متنها جميعاً، ورغم مهنتي هذه، تجدني لا أعرف ما هو الشِعر؟ ولو أن الحنين يعني العودة، لأزهرَ هذا الكرسي الهزّاز الفارغ والمغطى بشرشفٍ أبيض من جديد. الحنين طعنة في كل ثوب أرتديه، حتى أن الثوب الذي لبسته للقاء غوستاو أول مرة، قد أورثني العري بعد موته. منذ موت غوستاو وكرسيّه مغطىً، أسألُ نفسي أحياناً، لمَ لَم يُقدّرُ لرجلٍ أن يزيل الشرشف ويحتل الكرسيّ من جديد؟
:
أعرف يا يوهانا، وليت بإمكاني إزالة الشرشف هذا، فأنا رجل مفصوم ولا أدري حقاً مَن منا يزورك الآن، أنا أم هو أو لربما هي، مفصومٌ حدّ شعوري أنني متعدد معهم في بيتيَ الصغير وأثاثه غير المغطى ولو بمنديل جيب، لأقول، قد مات أحدنا
لكني سعيد لأنكِ غطيتِ الكرسيّ بشرشف أبيض ولم تدهنيه بدهان أبيض، إزالة الدهان ليست كما إزالة شرشف، ثمة أمل فيكِ، فاصبري. قد عرفت الحنين يا يوهانا مما قالوه عن الشِعر، وكيف للشِعر أن يتعرف على كينونته من نظرة طفل سرعانَ ما تهرم، أو وجه إمرأة صامتة، حتى لو مِن سيرة حياة قطٍ عند سياج مشفى. كيف للشعر أن لا يكون أقلّ مِن أيامنا، أيامنا التي غالباً ما تكون طويلة الأكمام وأيدينا مبتورة، لذلك نكتب كيما نمرّن ذاكرة أيدينا. بهذا يمكّننا الشعر من العيش بخلطة سحرية من حزن وسعادة وهما التثمين وإلغاء الطمأنينة دون أي تذمر، علينا أن نثمن الشمس الغاربة خلف جبل كل أول غروب. هي تغرب منذ مليار عام، ونحن نثمنُ ونهتف؛ كيف لكل هذا الحُسن أن يتواراى
يوهانا:
رحمن، كم أشعر بحلاوة الإنصات لما تقوله، رغم أني لا أعرف ما هو الشِعر ولا التثمين. كنت طفلة صغيرة تقرفصُ عند ورقة وترسمُ مركباً وسط المياه. مضت أعوام وأنا أرسمُ ذات المركب وسط المياه داخل الورقة، لكني ما أن كبرت قليلاً حتى شرعتُ أرسمُ صبية تشبهني داخل الورقة تقرفص عند ورقة داخل الورقة وترسم مركباً وسط المياه وهكذا حتى صرتُ شابة، حينها قررت الخروج بي، بالمياه وبالمركب من الورقة والدخول إلى مدرسة صناعة المراكب وما هي إلا سنوات حتى أبحرتُ مع أصدقاء لي ومعارف على متن ” فرايا”، المركب الذي لطالما حلمت ورسمت
:
كم هو جميل يا يوهانا ما تقولين عن الحلمِ والرسم داخل الورقة وخارجها، كل هذا وتدّعين أنكِ لا تعرفين ما هو الشِعر؟ تصوري أن كل الشعراء مازالوا يقرفصون عند حافة ورقة، حتى أنه لم يحدث أن دخلَ أحدهم إليها أو خرج منها، بهذا كما لو أن الشعراء هم مثلكِ أنذاك، أطفالاً لا يكبرون كي لا يدخلوا مدرسة صناعة الشِعر، ميزة الشعر أنه لا يكذب ولا يؤكد ولربما لهذا يتحدث الشعراء عن الإبحار دون أن يكونوا قد إقترفوه
يوهانا:
كنتُ قد أسميت قاربي (فرايا) وهي معشوقة الإله (تور)، وكنت أعرف أن الألهة لا تكترث إن شتمها البشر أو سخروا منها وهم في بيوتهم الآمنة، فالآلهة أكبر من عجزنا وأهون من غضبنا. لكن الألهة ستغضب إذا ما شتمها البشر وهم في عقر دارها، فالبحر بيت الآلهة مثلهُ مثل الصحراء والجبل، سرير المرض هو أيضاً أحد بيوت الألهة. وهكذا ونحن في البحر، راح البعض من الضيوف يسخرون من فرايا دون أن يحددوا إن كانت المركب أم معشوقة الإله، حتى هاج البحر وتلبدت السماء وعصفت بنا وكدنا نغرق يا رحمن، لولا أنني صليت باكية وطلبت من الإله المغفرة، قلت له؛ هؤلاء يعتقدون أنهم في بيوتهم الآمنة وفي عوالمهم الخالية من أي مدىً أو حنين. وسرعان ما هدأت العاصفة. ومثلما ترى فأنا ومذ فارقتُ فرايا أرقد في سرير المرض لأنه بيت الرّب الوحيد الذي يمكنني المكوث فيه، بينما فرايا مازالت تبحرُ في البحر وهو بيت الرب أيضاً، ثمة أمل ما ذات يوم لنبحرَ معاً
:
بيوت الرّب كثيرة يا يوهانا، الحرب هي بيت الرّب أيضاً. في الحرب، يهجر الرّب كل بيوته ليعيش في قلب الحرب ومن أجلها، لذلك ترين وحين تهرب الناس من المدن، من بيوتها عبر بيوته المهجورة كما البحر والجبل والصحراء أو حتى سرير المرض، فإنه لا فرق إن كَفَرتْ به أو صَلّتْ له، لتنجو أو تغرق أو تموت
في الحرب يا يوهانا، حتى مزية أن يسخر الناس من الرّب وهم في بيوتهم الآمنة، ليست متاحة، الحرب هي أين ما سكن البشر أو تواجدوا، بهذا ما مِن بيوتَ آمنة!
……………………
*كاتب عراقي مقيم في كوبنهاجن