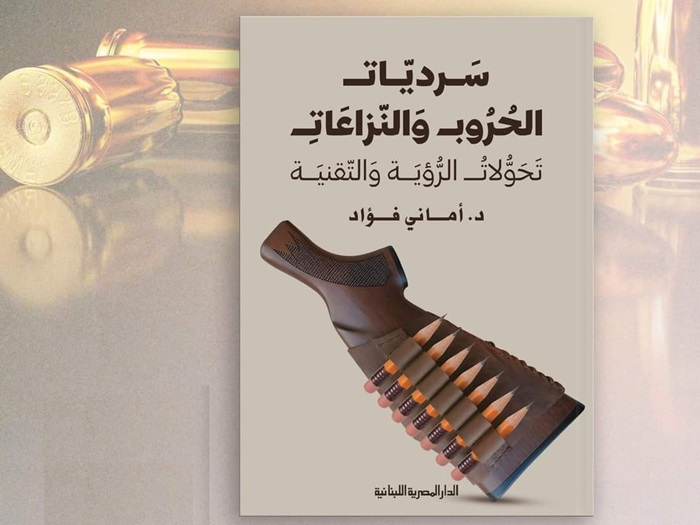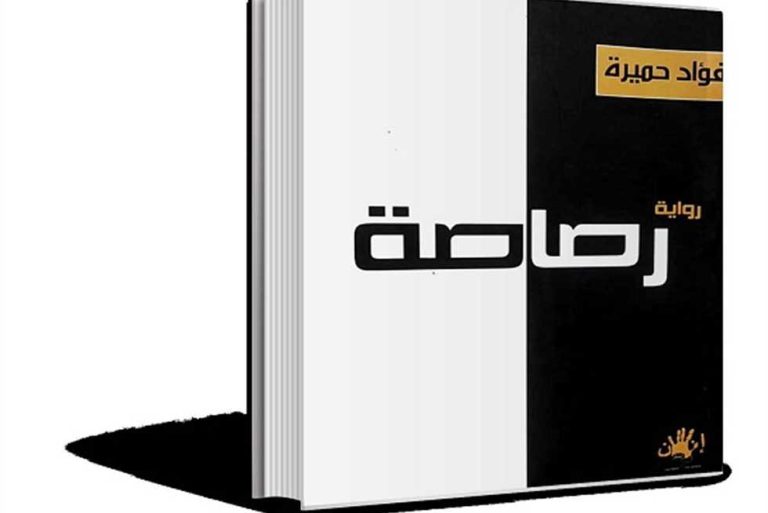ولا يتوه الغرض مع استفاضة السرد واستمرار الأحداث، فيعود الكاتب في صورة الراوي لينقي الرواية من اي شوائب، ليقتصر منظورها علي العلاقة بين الشخصين لا تخرج عنها، ولا يتمرد السرد فيسرح بمنظوره مع شخصية دون الأخري، وإنما يقبض الكاتب بإحكام علي الإيقاع لإكمال صورة البورتريه دون غيره من الانواع.
فالكاتب استاذ كلاسيكي راسخ، دارس متعمق في الآداب القديمة، ولكنه كلاسيكي حداثي لو جاز التعبير، بل وبطريقة عصية علي الوصف. فإن كان قبضه المحكم علي السرد والشكل وتقسيم الفصول لا يغيب عن قارئ مخضرم، وإنه حتي وان كان يفتتح روايته بمقدمة تليق بافتتاحيه محاضرة من محاضراته (زعموا ان من أظهر خصائص الأديب..)، الا انه يكاد يتوه هذا القارئ لاحقاً بلعبة وقور متسلسلةمن التلاعب الزمني وتبادل الضمائر بتبديل دفة السرد بين الشخصين.
يروي الطالب ثلاثة عشر فصلاً، بينما يروي الأديب ثمانية فصول، وفي غير موضع في فصل او اثنين تشعر انك فقدت الإحساس بهوية الراوي وامتزجت بصوت جديد عليم، وربما ارتبكت قليلاً ولكنه ارتباك لذيذ تنقذك منه قبضة الكاتب الهادئة بعد قليل بانتهاء الفصل.
اما اللعبة الزمنية فيمارسها الكاتب بتحفظ يليق به. فتفلت معلومة كشفية تكاد تكون الوحيدة، في بداية الفصل الثاني (فقد عرفته في القاهرة قبل ان يذهب إلي باريس، ثم أدركته في باريس بعد أن سبقني إليها.)، ثم يعود السرد إلي كرونولوجيته. وبأستثناء وثبة زمنية قوية تالية في الفصل السابع –يعود منها بانتهاء الفصل- يكاد القارئ يستكين إلي استقامة البنية التعاقبية للزمن، ويقف الكاتب من خلاله علي محطات زمنية متتابعه بما يخدم صورة البورتريه التي أرادها.
في النصف الثاني من الكتاب يركن الكاتب إلي استخدام اسلوب الرسائل وحده. ولاشك ان هذا الاسلوب قد اكمل الصورة واكمل الحكاية الروائية بما يرضي اي مستمع او قارئ، اي اننا عرفنا ما حدث. الا انه ايضاً قد افقد الايقاع شيئاً من حيويته. ففي الجزء الأول (جزء القاهرة) يتبادل الشخصان الحركة والجولات والزيارات والنقاشات الساخنة بما يرسم صورة فنية هامسة رائعة، ونادرة للقاهرة في الأدب العربي. بينما في الجزء الثاني (جزء باريس) تتولي الرسائل إغلاق القصة، ولا نرتسم صورة لباريس ومثقفي باريس مثل صورة الحياة الثقافية في القاهرة في الجزء الأول. حتي ان اللقاء بين الصديقين في باريس يمر عابراً لا يكاد يُذكر بعد لحظة الكشف الباكرة المشوقة في مفتتح الفصل الثاني. بما يسبب، ولا شك، شيئاً من الإحباط.
وينتهي غرض الكاتب من الرسائل قبل الفصل الأخير فيتجاوزه ليكتب فصلاً قصيراً، أتجاوز فيه لأقول، انه من أهم ما كُتب في الأدب العربي الحديث، ومنه خرجت وعليه سترتكز كل الإشكاليات الأدبية الحديثة التالية حول (الصوت) و (الراوي) و(الكاتب). ولو لم اكن واثقاً ان كتاباً اوروبيين وامريكيين معاصريينلم يقرءوا لطه حسين، لأتهمتهم بالتأثر والاقتباس منه. وحسبنا انهم وهم المعاصرون المحدثون ان حسين قد كتبها في 1935 قبل ووقت ولادتهم جميعاً.
هذه الفقرة التي لها ان تشغل فكر الباحث الأدبي العربي هي:
(وقد حفظت هذه الحقيبة بضعة عشر عاماً لا أعرف من أمرها إلا أنها مملوءه بالأوراق. فلما أتاح الظالمون لي شيئاً من فراغ، نظرت في هذه الأوراق فإنما هي أدب رائع حزين صريح، لا عهد للغتنا بمثله فيما يكتب أدباؤها المحدثون. وقد هممت بنشره وقدمت بين يديه هذا الكتاب. ولكن هل تسمح ظروف الحياة الأدبية المصرية بإذاعة هذه الآثار يوما ما.)
اللغة
إنما أوردت الفقرة الأخيرة في نهاية الجزء السابق لأفتتح بها هذا الجزء، وانطلق من تصريح حسين البازر: (لا عهد للغتنا بمثله فيما يكتب أدباؤها المحدثون). واربطه بتصريح الكاتب الليبي ابراهيم الكوني القريب في القاهرة في الدورة الثانية لمؤتمر القاهرة الأدبي، حيث وصف المشهد الأدبي العربي الحديث بالتقارير الصحفية، ودعا الكتاب الشبان ان يكفوا عن كتابة التقارير. وان يعودوا فيقرءوا في نظرية الأدب، وان يتعمقوا في التراث العربي.
فأن حسين وهو أستاذ كلاسيكيات كبير فهو امتداد رشيق لشيوخ اللغة العربية وشعراءها. لا عهد لنا بلغة مثل لغته في مشهدنا الأدبي الحالي. لغة رائعة صريحة حزينة، ليست بالثقيلة ولا بالبعيدة، بل ناضجة رصينة فيها شئ كبير من النزاهة ورفعة النفس، وبها موسيقي أيقونية عذبة ميزت أدب طه حسين، ومنها تستطيع التعرف عن كتابته من وسط مئات. ولقد أخذ المحدثون علي حسين كثرة المرادفات والتكرارات، وتناسوا –فيما ينسي الانسان المعاصر في حياتنا المصرية البائسة احساسه بمظاهر الجمال- انها ركن اساسي من اركان البلاغة العربية.
وان المدقق في رواية (أديب) لا يجد إسرافاً في استعمال المرادفات الموسيقية الا في فصلين. هذين الفصلين هما مجاراة من طه حسين للقدماء من الشعراء، ويكادا ان يكونا تحدياً لهم، واستعراضاً منه لمقدرته علي المجئ بمثل ما اتوا به، وربما أفضل منه. بل وفي ملعبهم الذي انشأوه وبرعوا فيه.
فالفصل الخامس هو هلوسة ممتعة ورحلة تخيلية في الريف المصري، حلق بها ذهن الأديب ومعه صديقه الطالب الصغير بينما هما في غرفته الصغيرة في القاهرة لم يبرحا مكانهما.
ويستفيقا من ثباتهما عندما يجري علي لسان الأديب بيتا شهيراً للمتنبي: (حسن الحضارة مجلوب بتطرية. وفي البداوة حسن غير مجلوب). فينهضا ذاهلين عما كانا فيه، ويقول الأديب لصديقه جاداً: (أليس هذا فناً من الشعر ونحواً من أنحائه؟ لا تظن ان القدماء من الشعراء كانوا يصنعون شيئاً غير هذا..)
والفصل الآخر هو الفصل السابع وفيه وقوف رائع حزين علي الأطلال، حيث يزور الطالب بلدته الريفية قبل ارتحاله إلي فرنسا ويكتب رسالة إلي صديقه الأديب من هناك. إن المشهد البديع للطالب وهو يقف بجوار باب المسجد يكتب علي المقعد الحجري لا يوجد له مثيل في أدبنا الحديث، ولم أقرأ مثله في أي أدب من أي جنس. وفيه ارتقاء فوق القواعد الطبيعية، فالمفترض ان الطالب الضرير لا يكتب بنفسه وإنما يملي رسائله، ولكن جمال الصورة يفرض حالته الأسطورية الخاصة وهذا هو جوهر الأدب والفرق بينه وبين التقارير الصحفية.
ويستمر الرثاء خلال الرسالة بوصف تهدم معالم القرية بمصنعها وكتابها وقناتها المائية، وتمضي الرحلة حزينة حتي تنفرج قليلاً بلمحة من الابتسام مع ظهور النخلتين القديمتين قائمين كما هما ترسلان الأمل فيما ترسلان من الظل. ويقول حسين خاتماً الفصل: (ما أكثر ما يعبث بنا من الآمال!).
تتكرر بعض ملامح من ألفاظ ولغة طه حسين خلال أمد الرواية فيتداعي لها الذهن. فيقول دائماً: (متعب مكدود) و(محزون) و(الليالي البيض) و(مضطرب) و(لغو). إن هذه الألفاظ (وغيرها) قد ساهمت في رسم صورة ذهنية عميقة لحياة المثقف في القاهرة. وقراءتها الآن تعيد إلينا الثقة في لغتنا وأدبنا وثقافتنا لما تمسه من مناطق بعيدة في القلب والعقل، وتدعونا لإعادة اكتشاف الجمال في اللغة العربية بعد ان أقصرت الحياة التكنولوجية الحديثة من قاموسنا الكثير. فها هم شخوص حسين مثقفون في القاهرة يعيشون مثل حياتنا الآن بالضبط –ناقص التكنولوجيا-واحاسيسهم نفس احاسيسنا، ووضعهم من العالم نفس وضعنا، ولكنهم يملكون اللغة العربية وجمالها، فتجري ألفاظها علي ألسنتهم حلوة جميلة وتظهر صورتهم رفيعة مهذبة سامية في انسانيتها مقارنة بانحطاطنا الانساني ونسياننا لأنفسنا.
ولا شك ان طه حسين كان أبعد الناس عن الانغلاق عن العالم. يؤكد في مقدمة كتابه (في الأدب الجاهلي) علي أهمية إتقان الباحث والقارئ-بل الرجل العادي- علي لغة أوروبية او اثنين، ليأخذ منهما حاجته من العلوم والآداب وذلك إلي جانب مثيلتهما العربية. وهو بالطبع أتقن الفرنسية، وعاش في فرنسا وكتب هناك رسالته للدكتوراه. ونلاحظه وهو في أواخر حياته، وفي تسجيلاته الصوتية، إنما يتكلم فنلمس إلمامه التام وتحليله للحركات والأتجاهات الأدبية والفكرية في أوروبا ومتابعته لكافه ما يكتبه وينشرهمفكروا أوروبا الكبار.
رغم كل ذلك فأن رواية (أديب) لا تحوي لفظة أجنبية واحدة. بل ولا تحوي إشارة إلي كاتب أجنبي واحد-باستثناء إشارة عابرة إلي ألفريد دي موسيه-. وإنما هي رواية عربية الألفاظ خالصة، ترتكز بثقة علي أساس متين منسي. فالإحالات والاقتباسات القليلة فيها تعود إلي أدباء مثل المتنبي والبحتري وامرؤ القيس والفرزدق.
الدلائل
نلتمس في رواية (أديب) العديد من الملامح الفلسفية. فبينما يتصور الطالب المبتدئ ان المثقف العربي أقدر من الشخص العادي علي النهوض والتصدي للحضارة الغربية، ومقاومتها إغراءها، ومجاراة طلابها وأساتذتها. فإنا نصطدم بالحقيقة القاسية علي لسان شخصية الأديب، الذي يعترف ببساطة انه لن يقدر ان يقاوم إغراء الحرية، وانه سينغمس في الشهوات بمجرد وصوله إلي باريس.
يعزي ذلك إلي (التنشئة الفاسدة). فيقول انه لم ينشأ نشأة منظمة. وان حياتنا في مصر تشبه الحياة المختنقة في قاع الهرم، بينما الحياة في فرنسا هي حرية التنفس عندما تخرج من أعماق هذا الهرم.
لا ينتهي الأمر لما يفعله بنفسه فقط، ولكنه يطلق زوجته قبل ان يسافر من اجل ان يستوفي شروط الجامعة، وان يحرر نفسه من كافة القيود. وهذا تعبير عن سمو حاجة المثقف إلي الاتصال بالحضارة الحديثة، علي الأستقرار والأطمئنان والسكون في القاهرة.
يعبر انهيار شخصية الأديب بعد وصوله إلي فرنسا عن الحالة الثقافية العربية التي أشرنا إليها في مقدمة المقال. فالتنشئة الفاسدة والحرمان تؤديان بالمثقف إلي الانغماس في الشهوات بأكثر الصور بدائية. حتي يري –كما يري الأديب في الرواية- في أبسط شئ مثلكوب صغير من الماء بجوار السرير لمسة حضارية بديعة، واهتماماً وحرصاً علي راحة الانسان. هذه الشهوات تعطل الثاقف عن التركيز والعمل برغم موهبته الطبيعية.
إن الفنان الذي أنتج –والذي نحن بصدده- كان عليه ان يكون محروماً من البصر لكي يقل انغماسه في الشهوات وان يتفرغ للعمل.
ومع ذلك فأن المثقف بكامل قوته في القاهرة. فيقول انني حمار نعم. ولكنني حمار مثقف متحضر، وأفضل من الشيخ المنافق. ونري فيه التعالي العلماني فيغرق في الضحك حين يذكر الطالب بدون قصد كلمة “المعصية”.
وبرغم قوته الظاهرة، إلا انه يتزوج فتاه عادية فقط لخدمته الشخصية كأي شخص عادي. وتتجسد مأساته حين يكتب إليها خطابه الرقيق قبل إتمام الطلاق، فيتذكر وهو ينهي الخطاب انها أمية لا تقرأ.
تطرح الأحداث تساؤل حائر: هل مأساته لأنه مثقف ام لأنه شرقي. فحين يتساءل أيهما أهون الظلم أم الكذب، وتدور المحادثة الثقيلة في الفصل الثامن بين الأديب والطالب، نري ان سبب تعاسة الاديب هو اضطراره لإرتكاب أي الفعلين من أجل السفر. فإن لم يكن مسافراً، ولو كان شخصاً عادياً يعيش في القاهرة آمناً مطمئناً لزالت عنه أسباب الحزن. ولكنه كان يحيا حياة خاصة، وكان الاتصال بباريس نداءاً يشبه نداء الإيمان بالنسبه إليه، فكان وضعه الجغرافي وتقاليد الجامعة تجبرانه علي ارتكاب اي الفعلين. وإذا تأملنا في اختياره فأننا نجده خياراً برجماتياً مادياً مسطحاً، يبرر له أخلاقياً بكونه يحفظ كرامة زوجته من دنث خيانته المؤكدة. ولكن ليس هذا التبرير هو واقع الأمر، فزوجته لم تكن له الا خادمة بمعني من المعان. فيحمل المثقف وزر مسايرته لحياة العامة بقوانينها الرجعية التي تنغص عليه حياته، وتجعله يشتاق لباريس ليغير فيها حياته ويتجاوب مع نوازعه الانسانية المقهورة في القاهرة.
قد ترسم الرواية للوهلة الاولي صورة تقليدية غير محبوبة للمثقف الشرقي، وهي صورته التقليدية في عيون المستشرقين، من حيث هو الشخص المغرق في نزواته، المشتت، غير القادر علي التركيز بانتظام في العمل. ولكنها ايضاً تنتصر لهذه الصورة في غير موضع، من خلال شخصية الطالب الذي يقاوم الفكر الأزهري التقليدي، وفي نفس الوقت يحتفظ بإتزان كاف يجعله يستنكر فعل الأديب.
ولعل كلمات المقال لا تتسع أكثر لتشمل كافة جوانب الرواية بالحديث، فالأجدر والأحق أن يتحذ لكل جانب من جوانبها فصلاً كاملاً للعرض والمناقشة والتحليل، لمدي ثرائها بالمحتويين المباشر والمتواري.
لما قرأت رواية (أديب) غضبت. وجدت فيها الرواية العربية الحديثة التي أبحث عنها والتي يمكن أن تُقرأ الآن في أوروبا وفي العالم. تقارب مثيلاتها الأوروبية والأمريكية اللواتي كتبن في نفس التوقيت وفي نفس المكان (باريس الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين) واللاتي صرن خالدات الآن من كلاسيكيات الأدب العالمي الحديث. أتحدث عن روايات هنري ميللر، وفيتزجيرالد، وبورخس، ونابكوف، وهيمنجواي، وغيرهم. واللاتي يقرأها كأساسيات واجبة أي مهتم بالأدب الآن، بل اي شخص عادي يريد ان يحيا حياة عصرية لا غرابة فيها، بتعبير طه حسين نفسه.
فأما الغضب فهو لغياب اي قراءة نقدية عالمية للأدب العربي القديم، برغم ان الكثير من الكتاب العرب اقاموا بأوروبا القرن العشرين وتُرجموا لللغات الأجنبية وبلغ تأثيرهم الثقافي في مجتمعاتهم الآفاق حين عادوا إليها، بما لا يقل عن تأثير الكتاب المذكورين من الاوروبيين والامريكان في الثقافتين الاوروبية والامريكية.
ولعل ناشطاً نابهاً يذكر ملامح شاردة حديثة من تأثير للأدب العربي علي الحركة الأدبية العالمية مثل إدراج أورهان باموك في احد احاديثه لثلاثية نجيب محفوظ علي قائمة استلهاماته حين كان يكتب (جودت بك وأبناءه) –أقل رواياته قراءة-. ولاينس قارئاً اخر ان جون ابدايك وهو ناقد كتب نشط، ضمن أوصاف عديدة، لم يراجع كتباً عربية الا كتاباً واحداً طوال مسيرته النقدية وكان لعبد الرحمن منيف، ولم تكن مراجعة إيجابية. ولعل من ضمن اسباب هذا الغياب –الذي لا يجب الا ان يعدو غريباً، بالنظر إلي حجم الإنتاج الأدبي العربي سنوياً- هو غياب القراءات العربية الحديثة ذاتها لأدبها القديم وإعادة اكتشافه وتحليله في ضوء المعطيات الحداثية الجديدة. فقد كانت من الأشياء التي تؤرق طه حسين نفسه هي ان الأدباء المصريين الجدد لا يقرأون التراث العربي، ويكتبون أكثر مما يقرأون، ولا يكادون يريدون ان يتعمقوا في اي شئ. هذا كلام قيل في منتصف القرن العشرين، فربما لا غرابة الآن في وضع ثقافي أكثر بؤساً.