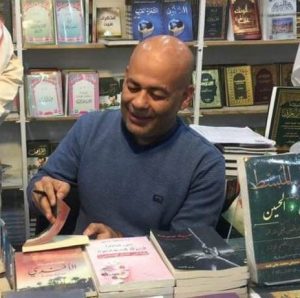سحبت الوسادة من خلف ظهره، حتى أصبح جسده مستوياً، وخرجت إلى الشارع أبحث عن طبيب. أثناء عدوى فى الشارع، كان هناك خاطر يلح على، وهوأننى أهرب من مواجهة اللحظات الأخيرة فى حياة أبى. فى المستشفى التى تبعد عن البيت مسافة عشرة دقائق عدواً، وجدت الطبيب النوبتجى. أقلنى، مع زميل له، بعربته للبيت. كان أبى مازال ممداً على ظهره وعيناه مغمضتان. قام الطبيب بإجراءآته الروتينية تجاه هذا الجسد، وفى النهاية قام بالضغط بكلتا يدية بقوة على صدر أبى، كان الجسد يهتز، ثم يعود لحالة سكونه. وأخيراً نظر لى مواسياً ” البقية فى حياتك”. صاحت أمى متسائلة ” مات؟”. أخذت تبكى وهى مذهولة بينما البول يتسرب من تحت جلبابها الكستور.
رفض الطبيب تقاضى أى نقود، فصحبته لتوصيله لباب الحديقة الخارجى، وأنا أشكره بشكل مفرط على المجهود الذى بذله، ربت على كتفى ” البقية فى حياتك”. عدت للحجرة فوجدت أمى جالسة بجانب أبى على السريرتبكى وهى ممسكة بيده. كانت ملابس أبى الداخلية متسخة. حرصه على مظهره وأناقته تراجعا خلال السنتين الأخيرتين. أصرت أمى أن نقوم أنا وهى بتغيير الملابس الداخلية لأبى قبل أن يراه أحد. كانت المهمة صعبة للغاية، فكان علينا أن ننزع الروب الصوفى. حاولنا ولم نقدر أن نخرج الجسد المتخشب من الروب. وجدت المقص هو أنسب حل، فقصصت الروب لعدة أجزاء، حتى يتسنى لنا سحبها من تحت جسد أبى. نفس الشىء فعلناه مع البيجاما والملابس الداخلية، وتحول السرير فى النهاية لصندوق ممتلىء بالملابس الممزقة. ألبسناه ملابس نظيفة وبيجاما جديدة أتت بها أمى من الدولاب. كل هذا ونحن ندور حول الجسد ونثنى الأذرع ونصفف الشعر المنكوش ونرفع الجسد فى شكل زاوية قائمة ثم نميل به ناحية اليسار أو اليمين، أو نلتف حوله . خلال أدائنا لتلك الطقوس، تسمرنا للحظة أمام هذا الجسد العارى، كانت مفاجاة لم نفكر فيها بالرغم من أننا كنا نخب الخطى إليها. أتت أمى بزجاجة كولونيا” أولد سبايس” من دولاب أبى، ومسحنا على جسده بقطعة من القطن المبلل بالكولونيا. ثم وضعنا الملاءة البيضاء على جسده.
كنت كمن يتفوق فى عمله ويسهب فى إخلاصه لأنه يريد أن يخفى مشاعر أخرى.كنت أحتضن جسد أبى كغريق وسط المياه الواسعة. الحزن والبكاء كانا تائهين، لاأقدر على تحديد مكانهما فى نفسى، هل كانا قريبين أم بعيدين. بينما أمى لم تكف عن البكاء والنهنهة، لم أعترض أو أحاول أن أوقف بكاءها، كانت تبكى بدلاً منى. برغم صمت أبى طوال الساعات الأخيرة، وتأكيد الطبيب على موته؛ دخلت على أمى الغرفة وجدتها وهى تقرب مرآتها الصغيرة من أنف أبى. أعلن سطح المرآة البارد موت الكثيرين فى عائلتنا، ولم ينج أحد من حكمها القاسى. شككت أيضاً فى موت أبى، فكنت أدخل عليه كلما سنحت الفرصة لأكشف الغطاء عن وجهه، فقد أحسست أن الملاءة تتحرك عند منطقة الأنف. تكررت مرات دخولى الغرفة ورفع الغطاء عن وجهه. كنت أخترع الأسباب أمام نفسى لأبرر دخولى. قبّلت جبينه، لم أكن لأفعل هذا أمام أحد، حتى أمى. كنت منجذبا لأكون باستمرار داخل مجال هذا الجثمان المسجى. أكتسبت مناعة مؤقتة خلال هذه الساعات القليلة، تجاه هذا الجسد، ولكنها مناعة هشة سرعان ماتبخرت عندما غادر جسد أبى البيت.
***
جاء ملاك الموت لأبى على دفعات، وظل ملازماً له طوال عامين. استيقظ ذات صباح من النوم وهو يشعر بدوار شديد. نادينا على جارنا الطبيب، شخص الحالة بأنها ارتفاع حاد فى ضغط الدم. فضل الطبيب أن تتم معالجته فى البيت بدلا من البهدلة التى سيتعرض لها فى المستشفيات. ذِكر فكرة الذهاب للمستشفى أصابتنى بالهلع، للمرة الأولى يتعرض فيها أحد أفراد البيت للخطر. هذه الرفرفة الخفيفة لجناحى ملاك الموت على بيتنا أزاحت تلك الطبقة السميكة من التراب التى كانت تغطى على مشاعرى تجاه أبى. اشترط الطبيب أن يكون أبى تحت رعاية مستمرة حتى تزول المرحلة الحرجة. ظللت جالساً أمام سريره، ليومين متتاليين، أتابع سريان نقط المحلول، وحتى لايحرك يده وتهرب أبرة المحلول من الوريد. ساعات طويلة قضيتها متسمراً أمام السريرأحاول أن أحافظ على تلك الروح النائمة. لقد اكتشفت مشاعر لم اكن أعرف أنى أحملها لأبى، مزيجا من الحب والخوف عليه، والخوف على نفسى من فقده. حرك مرضه شيئاً غامضاً فى أعماقى. هناك هيكل آخر تتحرك حوله الحياة، غير الخلاف والحب والنجاح والمساواة، وغيرها من الأفكار التى تسيطر على حياتنا. هناك أيضاً المرض والموت والضعف والشيخوخة، كلها كفيلة بأن تغير رأيك ومشاعرك تجاه من يعبر بها.
برغم أنى كنت أعلن على الدوام اختلافى مع أبى، إلا أننى اكتشفت أننا متشابهان فى أشياء كثيرة، وربما هذا هو السبب فى اختلافى معه؛ وأولها هى تلك المثالية التى كنا نؤمن بها. مثالية ليست بها ذرة رحمة بالاخرين ، وهناك أيضاً ذلك الوجه الأخر للمثالية وهو البكاء. كلانا كان يحمل وجهاً باكياً جاهزاً للظهور فى اللحظات العاطفية، وهى كثيرة فى حياتنا. وثانيها أنه كان فناناً، وجئت أنا لأكمل سيرة هذا الفنان الذى توقف فى منتصف الطريق بسبب الزواج، وأصبحت كاتباً. أحياناً يطرأ على خاطر، أن أكثر مايمكن أن يحققه أحد لنفسه هى رغبات وأحلام الاخرين الكامنة داخله أكثرمن رغبته وحلمه لنفسه..
رأيت أبى فى الحلم ولكن بوجه طفل، وربما كنت على وشك أن ألا أتعرف عليه لولا كلمته المعهودة ” يابن الكلب ” لولاها لكنت تجاهلته واعتبرته مثل الوجوه العديدة التى تمر بأحلامنا بدون أن نتذكرها. الشىء الغريب أننى رددت عليه بحنان” أيوه أنا ابن كلب”، كنت أريد أن أطمئنه بأننى ابنه الذى سعى للقائه فى الحلم . كانت ” ابن الكلب ” هى كلمة السر التى تعارفنا بها. لقد طاردتنى روح أبى، ولكن بخجل وعلى استحياء، كان يظهر فى كل التفاصيل اليومية، مثل تقطيع اللحمة وطى الجريدة وتصليح حنفية المياه وإذابة الثلج المتراكم فى الثلاجة، وغيرها من الأعمال المنزلية المهمة لاستمرار الحياة، والتى كان يقوم بها. حتى اسمه لم يختف من البيت، فكانت أمى تسهو كثيراً وهى تنادينى ” ونبى يامحمد”.
كنت أتخيل عودتى من الخارج لأجده جالساً فى الصالة وبجانبه فنجان القهوة المضبوط، وصوت أمى يأتى من المطبخ، بينما أخى صلاح يذاكر فى الغرفة التى جمعتنا، وأخى عادل يأخذ حماما ساخناً يستغرق وقتاً طويلا يجعل أبى يبدى بعض تذمره” شوف اخوك طول ليه” ثم يخرج عادل مستجيباً لنقراتى على زجاج الحمام ليصعد للطابق الثانى، حيث كان يبيت مع جدتى . لقد تكون بيت جديد من الحنين. يبدو أن خوفى من الموت هو سر قوتى، ومفتاح السر لأعيد علاقتى مع أشياء كثيرة فقدتها، أو كنت على وشك أن أفقدها.
دخل أبى فى حالة اكتئاب دامت عامين، يبدو أن ارتفاع ضغط الدم قد أثر على بعض مراكز الذاكرة فأصبح ينسى كثيراً، وأكثر من الاختلاء بنفسه فى الظلام. أدخل عليه فأجده يبكى. وصف له الطبيب المعالج مجموعة من أدوية المهدئات جعلت إحساسه بنفسه غير واضح، قال لى فى إحدى المرات ” أنا مش حاسس بنفسى زى مايكون فيه تلج حوليا”. يقوم من السرير فقط عند مواعيد تناول الوجبات، ثم يعود سريعاً إليه. كانت السنتان شتاء دائماً. كان يطلب منى أن اوقد له وابور الجاز، وأضعه وسط الغرفة المظلمة. كان يأتنس بصوت الوشيش، وهى عادة قديمة من عادات بيتنا، كنا نلجأ إليها فى شهورالشتاء، وكم ساهمت فى بناء ذاكرتنا وجعلتها ذاكرة دافئة.
لم يستسلم أبى للسرير مرة واحدة، فقد جرب أن يزاول كل نشاطاته كما كان قبل تلك النكسة المفاجئة التى ألمت به، فى الذهاب للسوق وشراء الخضروات والجرائد. خفت عليه من أن يسير وحده فى الشارع وهو بهذه الحالة. تبعته من بعيد، كان يسير منهكاً ويتوقف كثيراً ليستند على أى جدار يقابله. أخرج له صاحب أحد المحال كرسياً ليستريح عليه. انتظرت لبرهة من الزمن ثم ظهرت له كأنها مصادفة، وصحبته معى للبيت. الغريب فى الأمر أنه عند ظهورى قال لى وهو يهم بالقيام”إتأخرت ليه”.
بعد زوال أيام الخطر انشغلت عن أبى، كنت قد قدمت استقالتى من العمل، الذى مكثت به عامين، إثر تعرضى لمضايقات من أصحاب الشركة بسبب أرآئى المتحررة فى الأمور الدينية، وخيرونى لكى أثبت حسن نوايايا أن أصلى معهم جماعة. رفضت هذا العرض، وقررت أن أتخلى عن تلك القيود التى تلتف حولى. كنت أنظر للحياة، ولمن حولى، من مسافة كأنها حياة لاتخصنى. بينما أبى كان يحتاج لمن يتحدث معه ويطمئنه وهو يخوض تلك الرحلة نحو النهاية، والتى كانت كل علاماتها حاضرة بقوة، ولكنى لم أنتبه لها. لم أفعل سوى أن أتعاطف معه من بعيد وألبى له احتياجاته اليومية. كنت أذهب معه لقبض المعاش من البنك، أرى الشفقة مرتسمة على وجه الموظف خلف شباك قبض المعاش، وكذلك عند الحلاق. بمجرد دخولنا من باب البيت، كان يسلم المعاش لأمى لتتدبرهى شئون البيت، وكانت هذه أهم قلاعه التى جعله المرض يتخلى عنها.
فى إحدى المرات بعد خروجنا من البنك الذى يقع فى شارع صلاح سالم، طلب منى أن نسير قليلا فى تلك المنطقة القديمة، كان يسير ونظره لأعلى، يمسح بعينيه واجهات العمارات القديمة، دبت فى أوصاله شحنة عاطفية أعادته لسنوات الصحة والشباب. عرجنا على البحر، جلسنا على إحدى المقاهى القريبة من المقهى الذى كان يجلس فيه مع أصدقاء عمره، والذى هدم فى السبعينيات. لم أر أبى بهذه الحيوية والاسترسال فى الحديث، ولأول مرة أراه يحاول الاقتراب منى، لم يعاتبنى، كعادته، على خطوة الاستقالة التى اقدمت عليها، رأى فيها بداية لحياة جديدة” بس لازم تكون كاتب كويس”. يومها تذكر رائحة البن الذى غاب عن بيتنا بمرضه، ودس يده تحت ملابسى وأخرج سيجارة وقدم لى واحدة” انت فاكرنى يابن الكلب مش عارف أنك بتشرب سجاير”، كنت فى الثلاثين وأخشى أن أدخن أمام أبى. حكى عن حياته التى سارت عكس ماتوقع تماماً ، ولكنه كان راضياً عن حياته الجديدة .كان أبى من هذا النوع الذى لايعترف أو يرضى بالفشل، ربما لأنه لم يذق طعم النجاح. عاش تلك الحياة العادية التى لم تتعرض لإهتزازات عنيفة. خرجنا من المقهى، مررنا بميدان محطة الرمل، سحبنى من يدى لمحل طرطوسية، أشترى ربع سودانى وربع لب أسمر وربع حمص، خلطة التسالى التى كان يعود بها مساء يوم الخميس. بمجرد عودتنا للبيت، سلم لأمى الكيس الورقى الذى يحمله، كان حريصاً أن يحمل الكيس، وفى اليد الأخر المعاش ودخل لغرفته ليستأنف مسيرة النوم.
انتظرت تحسن حالته لأخبره بالإجراءات التى اتخذتها لترتيب حياتى، فقد أرسلت لى مادلين زوجة أخى عادل دعوة لزيارة فرنسا. قررت السفر وأن أعيش فى باريس التى عاش فيها توفيق الحكيم وكتب عنها ” عصفور من الشرق”، و “زهرة العمر”، و”تحت شمس الفكر”. فى اليوم الذى عدت فيه من القنصلية بعد تقديم أوراقى للحصول على الفيزا، وجدت أبى جالسا فى الصالة وعينه على وجهى، أخبرته بقبولهم للأوراق وهذا معناه أن المتبقى مسألة وقت للحصول على الفيزا. ” يعنى خلاص يابنى حتسيبنا وتسافر” قالها ودخل لغرفته. لم يكن سؤالا بل استعاطفا، أن أعدل عن رأيى. فى تلك الفترة كان أبى دائم البكاء. فى عيد ميلاده الأخير، و صادف وجود عادل أخى فى الإسكندرية بمفرده فى عمل، بدون مادلين أو سوزانا، فحمل لأبى تورتة كبيرة بهذه المناسبة. أطفأ أبى معنا الشمع، واحتضن كل منا كأنه يودعنا، وانفرد بعادل بعد الحفل الذى حضرته خالتى زينب وسعدية. خرج عادل منهارا من الغرفة، صدم عندما رأى أباه يبكى، وهو بهذه الحالة من الضعف والحنان. اعتاد عادل أن يرى أبى قوياً. وجده هشا كقنبلة موقوتة مملوءة بالدموع.
نشبت حرب الخليج الأولى، ومنع السفر للخارج، وبقيت بالإسكندرية أحرس الشهور الأخيرة لأبى فى الحياة. ولكنى أكملت أيامى حتى وفاته كانى مسافر. ظل يتملكنى شعور، استمر معى حتى بعد موته، أننا جميعا خذلناه فى أيامه الأخيرة، لم نقف بجانبه فى اللحظة التى احتاجنا فيها. سفر أخويى للخارج، وسفرى المستمر وأنا داخل البيت، جعلا الحياة من حوله فارغة، لولا أمى، ومساندتها له لصارت هذه الأيام لاتحتمل. هى التى كانت تهدهده، وهو نصف نائم ونصف مستيقظ، وتقرا له الجرائد التى عزف عنها تماما، وتصر أن تأخذه فى الصباح ليتمشى فى حديقة البيت. برغم تنبيه الأطباء لها بعد تناوله القهوة، كانت تصنع له فنجانا بقليل من البن، وتقربه من مرقده على السرير، حتى تصله رائحتها بأيام الغناء ” ع الحلوة والمرة مش كنا متعاهدين”. لم يكن سهل عليها أن يفترقا بعد هذه العشرة التى دامت اثنتى وأربعين سنة. تغالب دموعها أمامه، وتخفى عنه تماماً هذا الوجه الباكى. طوال عامين تقريباً لم يرها أبى سوى ضاحكة. لم يتوقع أحد منا موت أبى بهذه السهولة، كان كل مكان فى البيت يحمل توقيعه وملاحظاته. لم يقو عادل على الدخول عليه وهو ميت، تجرأت مادلين، بل وأصرت على أن تقبله وهو مستلق فى نومته الأخيرة، أما عادل فكان يتعلل بكل الحجج ليكون بعيدا عن الغرفة التى يرقد فيها، وتدخل مجموعة من الأقارب ليحضروا غُسله.
أصرت أمى أن تعطينى الفى جنيه، من التسعة آلآف جنيه التى وجدناها بدولابه. كانت تريد منى أن أسرِّى عن نفسى، بعد تلك الأيام الصعبة التى رافقت وفاته. كنت أشعر بنار مشتعلة فى جيبى، يجب أن أتخلص منها سريعاً. خلال ثلاثة أيام كنت أنفق ببذخ الشخص المجروح، الشخص الذى يحمل ذنباً يريد أن يتخلص منه سريعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*مختارات من فصل” ليلة وفاة الأب”، من رواية ” ألم خفيف كريشة طائر تتنقل بهدوء من مكان لآخر” – علاء خالد – دار الشروق 2009.