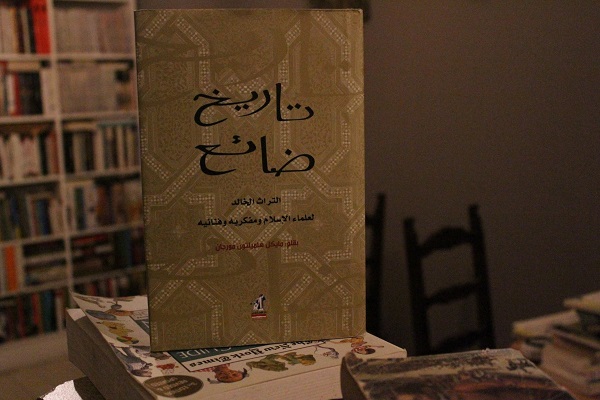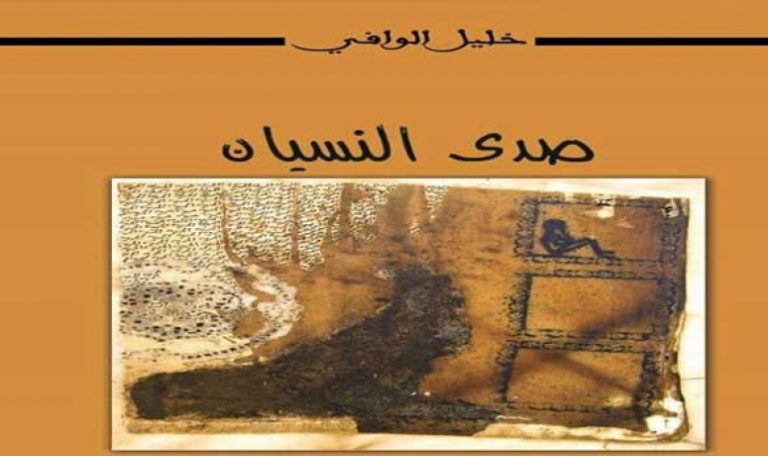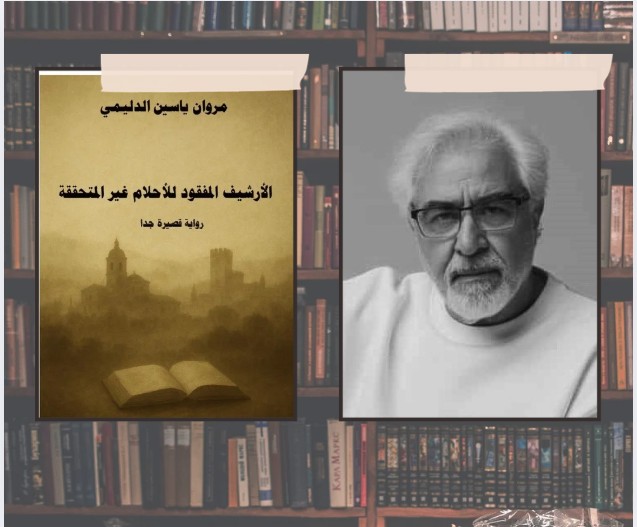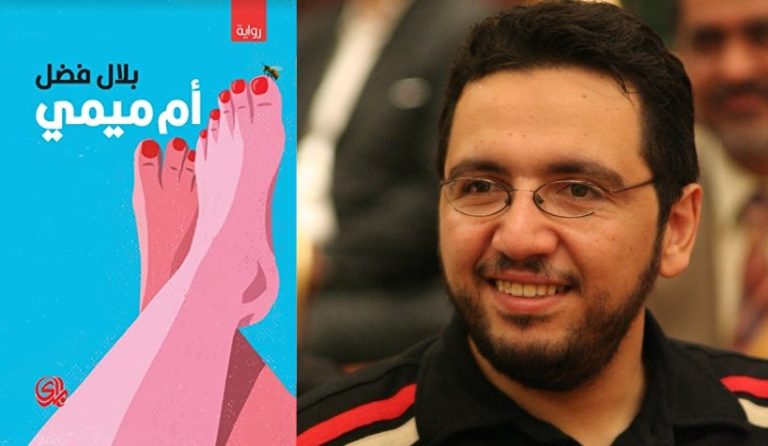أسامة كمال أبو زيد
لم يكن العمر كريمًا مع محمد إسماعيل الأقطش، منحه حضورًا خاطفًا ثم انسحب، كأن الحياة نفسها كانت على عجل، لكنه ترك خلفه ما لا ينسحب بسهولة: وشمًا في ذاكرة بورسعيد، وتميمة صغيرة كلما مرّ الوعي قرب البحر اصطدم بها. غيّبته الحياة الثقافية مبكرًا عام 2017، لكن غيابه لم يكن محوًا، بل انتقالًا إلى طبقة أعمق من الذاكرة، تلك التي لا تقلب الصفحة مرورًا عابرًا، لأن ما كُتب فيها كان معجونًا بملح البحر ودم الحروب وأسئلة الإنسان التي لا تجد إجابة. وجوده القصير بدا كوهج، لكنه وهج ممتلئ بتاريخ مدينة لا تشبه إلا نفسها، مدينة متعددة الطبقات، مثقوبة بالحكايات، تعرف كيف تخفي أبناءها في التفاصيل، ثم تتركهم يلمعون بعد الغياب. كتب الأقطش في مقتبل العمر أدبًا ينتمي إلى زمنه بقلقه، وإلى مدينته بجراحها، أدبًا لم تلتهمه قلة المنشور ولا ضيق العمر، لأنه خرج من المسكوت عنه في دواخل الإنسان، ومن ذلك التماس الغامض بين البحر والمدينة.
كان المكان تميمته الأولى، لا بوصفه خلفية، بل بوصفه كائنًا حيًا. منذ «نورس وحيد بجناحين من ورق» لم يكن البحر ماءً، بل كيانًا أسطوريًا يتأرجح بين سكون يخفي عواصفه، وحركة تبحث عن ميناء، بحرًا هو التيه واليقين معًا، العناق والقتل، الموج الذي يهبط ويعلو كما تتقلب أرواح البشر في تفاصيلها الصغيرة وأحلامها الكبرى. وفي مواجهة البحر، لم تكن بورسعيد مجرد جغرافيا، بل فضاءً مراوغًا، يتسع لأحلام أبنائها كما يتسع لندوبهم، مدينة ثابتة في مكانها، متقلبة في معناها، تترك وشمها على الأرواح كما يترك الزمن أثره الذي لا يُمحى. في هذا التماس بين البحر والمدينة، وجد الأقطش مفتاح الحكي وسر السرد؛ فالمكان عنده لم يكن زينة ولا ديكورًا، بل بطلًا وملعونًا في آن، يمنح الظلال كما يمنح الفقد، يفتح أبواب الذاكرة ثم يغلقها فجأة بالنسيان، ولهذا صار ضرورة وجودية، لا فكاك منها، لأن من يولد في مدينة مثل بورسعيد لا يستطيع أن يكتب خارجها، حتى وهو يعبر إلى مدن أخرى.
حين كتب «بورسعيد.. بيروت: أبجدية البحر والحرب» لم يكن يعقد مقارنة، بل كان يفتح جرحًا مشتركًا. هنا يتجسد المكان بلا مواربة: البحر والحرب معًا. البحر الذي يهب الحياة ويسلبها، والحرب التي تحوّل الخراب إلى قدر إنساني. بورسعيد وبيروت بدتا كمدينتين تنتميان إلى جذر واحد، تتقاسمان الموج والنار، وتعيشان الحب وهما تعلمان ثمنه. في بيروت، اندثرت معالم البسطة الحديثة، ضاعت المقاهي، تلاشت محطة القطار، لكن ما هو أعمق من الحجر ظل حيًا: وجوه الباعة، بطولات القبضايات، أدعية الذكر الصوفي التي كانت تتشبث بجدران الأزقة مع الفجر. وحدها الأرواح صمدت أمام طوفان الزمن، كأن المقاومة قدر مكتوب في ذاكرة المكان، ينهض مع كل مواجهة. وهذا القدر لم يكن غريبًا عن بورسعيد، المدينة التي انفتق جسد أرضها يوم شُقّت قناة السويس، لا كواقعة هندسية، بل كجرح إنساني حُفر بالدم كما حُفر بالماء، وسكنت فيه أرواح مئات الآلاف، ليصير الكفاح ميراثًا لا يقل رسوخًا عن الملامح. حتى قاعدة تمثال دي لسبس الفارغة ظلت حفرة في قلب التاريخ، تذكّر بأن ما سُلب لا يُنسى، وأن الحياة لا تُستعاد إلا بالمكابدة.
في الساحات، من ساحة البرج إلى ميدان جمال عبد الناصر، كان الأقطش يرى ما لا يُرى: كيف تخزّن الجدران أنفاس البشر، وكيف تحفظ الأمكنة أرواح الشهداء والعشاق والناجين. في بيروت، تغيّرت أسماء الساحة الكبرى، لكن جوهرها ظل قلبًا نابضًا، يسجّل في حجره أن الذاكرة لا تموت مهما تبدّلت الوجوه. وعلى شرفة تطل على البحر، يجلس رجل وحيد، يقيس المسافة بين صاروخ أطلقه يوم كان قائدًا، وصاروخ عاد فقتل زوجته، فلم يجد بعد ذلك سوى البحر جليسًا، البحر الشاهد، الأمين على الأسرار، الذي يحتفظ بالراحلين في أعماقه، ويترك للأحياء نضالهم وابتسامتهم الحزينة. وفي شقة قديمة، تختار امرأة أن تبقى، لأن البقاء في المكان صار شكلًا من أشكال المقاومة، ولأن البيت حين يتماهى مع الروح يصبح حضنًا أخيرًا لا يُغادر.
وكما يعود الناس إلى مدنهم، عاد نيكولا إلى بورسعيد، باحثًا عن وجهه الأول. وجد البحر كما كان، والشوارع كما حفظها، لكن البشر تفرقوا. وحدها الحكايات الصغيرة ظلت تلملم الروائح القديمة، وتعيد تشكيل الملامح الغائبة، فاستعاد نفسه، كما لو أن المكان استعاد روحه فيه. المكان عند الأقطش ليس صامتًا، بل محفز للروح، البحر فيه كلمة السر القديمة المتجددة، كائن كامل يصنع الذكريات ويحفظ بهجة الحياة كما يحفظ رعبها. فيه يتجسد الصراع، وفيه أيضًا يولد الحب. «صابيرا» الصيادة الوحيدة في بيروت، مثال مكثف: البحر الذي غيّب زوجها صار خصمها وصديقها، وحين سلّمته لابنها، لم تكن تورثه مهنة، بل عنادًا، ليظل البحر مكافئ الحياة الأكبر. وفي بورسعيد، حيث البحر أب صارم وأم حنون، تعلّم الأطفال الرجولة وهم يسحبون الشباك بأكف صغيرة، وتركوا على الرمل آثار أقدام قد تمحوها الريح، لكنها لا تمحى من الذاكرة.
هكذا كتب محمد الأقطش بالمكان لا عنه، جعله مسرحًا وفاعلًا أصيلًا، بطلًا خفيًا وعلنيًا، يحدد المصائر ويغيّر الاتجاهات. أدرك أن المكان ليس واحدًا، بل طبقات: واقعيًا ونفسيًا، صغيرًا وكبيرًا، أسطوريًا ومألوفًا، وصاغ من ذلك كتابة تتسع وتغور في آن، تجمع الزمان والمكان والإنسان في لعبة سردية واحدة، لا تقل تعقيدًا ودهشة عن لعبة الحياة نفسها.