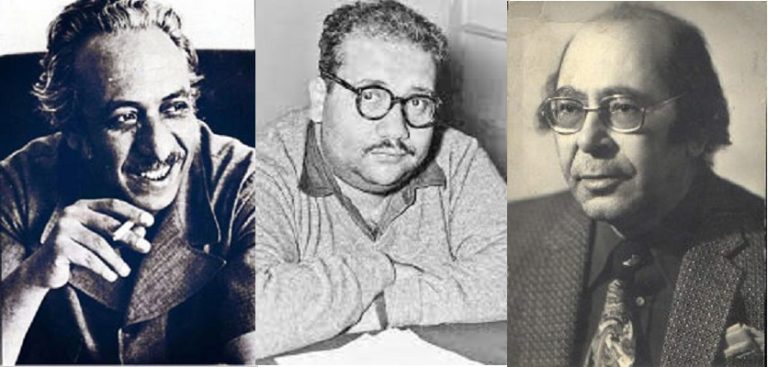حلمي سالم
الشاعر الحديث هو ابن نفسه، وابن عصره، وابن تراثه، الوطني والإنساني، في آن. هو ابن حرية، حريته، وحرية الوطن، وحرية الإنسان، وحرية المخيلة، فمخيلة الشاعر الحديث هي المخيلة المحررة من كل قيد : قيد العادة، قيد المألوف، قيد الموروث. المخيلة الجريئة المجترئة، الطائرة على كل الأزمنة ، وكل الأمكنة، وهي في كل ذلك مصفاة لشوق عصر شاعرها ومواطنيه.
ومن هنا، فإن الشاعر الحديث، ليس له موضوع. أي ليس له موضوع محدد. موضوعه هو نفسه : أغوارها، أهواؤها، تجوالها الخرب والجميل، موضوعه هو العالم كله، بأزمنته، الماضي والحاضر والمستقبل. صراع ذاته مع ذات العالم، سيرة النفس وسيرة الكون، صغائر النفس وصغائر الحياة.
ليس الشاعر الحديث خطيباً أو واعظاً أو مصلحاً اجتماعياً أو أخلاقيا أو سياسياً. ولهذا تبتعد موضوعاته عن الحكمة والدور البليغ. لتلتصق بتفاعل ذاته. ووجود ذاته في العالم.
إن هذه المفاهيم الجديدة والواسعة أعطت فرصة كبيرة للزيف والادعاء، عبر الاستتار خلف هذه القيم غير التقليدية. والحق أن تمييز القصيدة الحديث عن غيرها التي تدعي هذه الصفة، هو عمل النقاد بالدرجة الأولى. لكنني أفترض بعض العناصر، التي إذا لم تتوافر في القصيدة، كانت حداثتها مصطنعة، مزيفة، مدعاة.
من هذه العناصر الفارقة :
أ – أن تكون حداثتها منبثقة عن معرفة وافية بالأصول والأدوات الأولى المؤسسة، لا تهرباً منها أو عجزاً عنها.
ب – أن تكون حداثتها غير معتاشة على منجزات حداثية معاصرة أو سابقة. فالتقليد ليس فقط في اقتفاء خطى الكلاسيكيين، بل هو كذلك في اقتفاء خطى الحداثيين.
جـ – أن تكون – مع تجديدها الفني – حارة، غير مصمتة، حية بحرارة الخبرة الإنسانية الملموسة.
د – ألا تكرر تجارب الشاعر نفسه، وتعيد إنتاجها مرة بعد مرة. فالتقليد، ليس اتباع الآخرين فحسب، بل اتباع الشاعر لنفسه، واجترار تقنياته وأساليبه وطرائقه.
الشاعر الحق، قُلبّ دائماً : على العالم، على تجارب الشعر السابقة والراهنة، وعلى نفسه.
وإذا لم تتوافر هذه العناصر الفارقة في النص كانت القصيدة تشبّهاً بالحداثة وركوباً لموجتها الدوارة، ظناً بأن غربال الحداثة واسع، وهو – في الحق – أضيق من سم الإبرة.
أعتقد، فعلاً، أن النماذج الجديدة من الآثار الشعرية التي ظهرت في أواخر السبعينات وكل الثمانينات في جددت شباب القصيدة العربية الحديثة.
إن هذه النماذج الكبيرة – أولاً – قد أخرجت القصيدة العربية الحديثة من خطابيتها التي كانت قد أغرقت فيها – وخاصة بعد 67 – في مناطق عديدة من الوطن العربي. كما أن هذه النماذج الكبيرة – ثانياً – قد أنقذت القصيدة العربية الحديثة من التماثل والتكرار وإعادة الإنتاج والاجترار، الذي وقع فيه كثير من أبناء الجيل التالي لجيل الرواد الكبار، ولم يسلم منه بعض من بقي من الرواد أنفسهم.
كما أن هذه النماذج الحداثية الكبيرة – ثالثاً – قد جددت شباب القصيدة العربية الحديثة، حينما كسرت بناءها الأحادي الاسترسالي الميلودي وهذه صفات البناء الرومانسي، في اتجاه البناء المتعدد المتعرج المركب المتداخل البيلوفوني.
وهذه النماذج الجيدة – رابعاً – قد خلعت القصيدة العربية من قدسية الوزن الخليلي حتى لو كان تفعيلياً فقط كما في تجربة الشعر الحر عند الرواد بما قدمته من تجارب نثرية كاملة، أو بالتداخل بين النثر والوزن. أي أن القصيدة الحداثية -في تجلياتها الحقة- قد اعتمدت مفهوم الموسيقى لا مفهوم الوزن. إن الوزن التفعيلي الخليلي، أحد الصور القاعدية الاجرومية للموسيقى، لكنه ليس كل الموسيقى، التي هي أرحب وأغنى.
كما أن القصيدة الحداثية – أخيراً، مؤقتاً – قد جددت شباب الرمز، حينما أكدت على أن الرمز لا يظل رمزاً إلى الأبد، وإنما هو يصير إلى إشارة وقرار وتقرير إذا استهلك استخدامه وطال تداوله. فراحت تجدد رموزها دائماً، ولا تستنيم لرمز اقترحته، حتى لا تحيله هذه الاستنامة إلى تكلس تقريري مفتضح. ينقسم النقد العربي -تجاه قصيدة السبعينات والثمانينات – إلى خمسة مواقف واضحة:
أ – الأول هو موقف النقد الأيديولوجي، الذي يطلب موقفاً اجتماعياً وسياسياً واضحاً في القصيدة، ولهذا فهو يخاصم التجربة الشعرية الجديدة، حين لا يجد هذا المضمون الجلي بارزاً. فيصفه بالانعزال عن الحياة والاغتراب عن المجتمع والتعالي على الجمهور، ويرى اهتمام هذا الشعر بالتشكيل الجمالي للشعر استغراقاً في الشكلانية وغراماً باللعب اللفظي.
ب – الثاني هو موقف النقد الذي واكب تجربة الشعر الحر في الأربعينات والخمسينات، وسانده وثبت أقدامه. وهذا النقد لا يرى أن هناك ضرورة ولا إمكانية لتجديد الشعر بأكثر مما صنع الرواد. وهو بذلك يقيس الشعر المجدد بسعر الرواد، فيرى أنه لم يعد في القوس منزع وان ما صنعه الرواد هو سقف التجديد ومنتهاه، وبعده الهاوية. وشعر الجدد – عند هذا النقد – هو الهاوية التي سقط فيها الشعر من حالق.
جـ – الثالث هو موقف النقد الأكاديمي أو المدرسي، وهو الذي كان ضائقاً في الأصل بتجربة الشعر الحر، إذ لا يرى الشعر. إلا كما قال القدماء، ويتحسر على ما آل إليه الشعر من فساد بتركه الوزن إلى التفعيلة وبطرقه الموضوعات القومية أو الحياتية التي طرقها الشعر الحر. وهو في أحسن الأحوال : أي في حالة قبوله الشعر الحر – يرفض أي إضافة تجديدية عليه، ويرفض في كل الحالات اجتراء الشعراء على اللغة العربية المقدسة وعلى الخيال العربي المألوف، وعلى الموروث الشعري والنقدي. هذا الاجتراء الذي أكل من هيبة الشعر وجلاله !
د – الرابع هو النقد الصحافي، الداعي للسهولة والتسطح والمسايرة الفارغة، والذي يرى الشعر زجلاً خفيفاً أو لطائف ضاحكة أو نوحاً غنائياً تافهاً. وهو يرفض تجربة الرواد، ومن باب أولى تجربة الحداثيين في السبعينات والثمانينات.
هـ – الخامس هو النقد الحداثي، الذي يرى الشعر ظاهرة نوعية، ويرى أن واجب الشاعر هو واجب تشكيلي في المقام الأول، وأن المعوّل في النص هو على طرائق صوغ الموقف من – وفي – العالم، لا فقط على فحوى هذا الموقف، وأن لكل نص قوانينه الداخلية التي ينبغي اكتشافها منه لا إسقاطها عليه من عل أو من خارج. وهذا النقد هو الذي يحاول اليوم تقديم وتدعيم تجربة الحداثة وتأكيد مواقعها وكشف خصائص نصوصها الشعرية من داخلها، واستخلاص دلالاتها وفحواها من قلب النص، وإضاءة العلاقة الداخلية الجدلية بين شكل القصيدة ومضمونها، وبين النص والواقع.
كثيرة هي المجموعات أو الاتجاهات الجماعية التي لعبت دوراً كبيراً في تذوقي الشعري. أذكر على سبيل المثال – من شعرنا العربي – جماعة الصعاليك، ثم جماعة المتصوفة، ثم جماعة أبوللو، ثم شعراء المهجر العرب. وأذكر – من الشعر الغربي – جماعة شعراء السريالية الغربيين.
ولقد ساهمت – كذلك – أعمال نقدية كثيرة في تشكيل وعيي الشعري، أذكر منها – على سبيل المثال – كتابات السرياليين، وكتابات جارودي ماركسية القرن العشرين، و ضرورة الفن لفيشر والشعر والتجربة لماكليش وكتابات د. عبدالمنعم تليمة وأدونيس.
أنا – فعلاً – واحد من أعضاء الجماعة الشعرية المصرية الشابة إضاءة 77 التي تكونت عام،1977 وأًدرت مجلة شعرية بنفس الاسم، خرج منها 14 عددا، وحملت رؤانا الشعرية – نقداً وإبداعاً – في وقت كانت المنابر الأدبية الرسمية مغلقة في وجوهنا : سياسياً وجمالياً وشعرياً.
وأنا مع تكوّن الجماعات الشعرية، لأنني – من الناحية الفكرية – أؤمن بتشكيل الجماعات والتنظيمات المستقلة عن السلطة، وخاصة إذا كانت هذه الجماعات الشعرية – وهذا شرط وجودها – تحقق نوعاً من التفاعل الخصب والتواصل المجدي بين شعرائها من ناحية، وإذا كانت تساهم في تشكيل وبلورة تيار شعري جديد من ناحية ثانية، وإذا كانت لا تطمس الخصائص الفردية التي تميز كل شاعر من شعرائها عن زميله، بل تزيد هذه الخصائص تبلوراً واتضاحاً ونضوجاً، في صياغة راقية وجدلية بين الوحدة العامة التي تجمع شعراءها و التنوع الذي تتباين فيه تجارب الشعراء بملامحها المتفردة.
وأعتقد أن جماعة إضاءة 77 قد نجحت طوال عقد فاعليتها 77 – 87 في تحقيق هذه الشروط. وأرى أن الواقع سيظل دائماً محتاجاً لمثل هذه الجماعات طالما حققت الشروط السابقة، وطالما أدركت أنها : لست حزباً بالمعنى العصبوي أو الأيديولوجي، وليست أفراداً مشتتين في نفس الوقت.
الشعر كياني. وهو دفاعي الخاص عن نفسي، وأسلوبي في صيانة نفسي من القبح والخيانة والسقوط. وهو أداتي في حماية ذاتي من الجنون أو الدمار. وهو مساهمتي في أداء واجبي تجاه الحياة.
أ – ليس هناك جيل شعري. هناك تجربة فنية أو تيار فني. والجيل لا يعدو أن يكون مصطلحاً للتمييز الإجرائي، وهو تعبير غير دقيق. وهو يقال مثلاً عن السبعينات للإشارة إلى هذه الموجة من الشعراء الذين يقدمون تجربة مغايرة لتجربة جيل الرواد، لا لجمع أبناء الجيل كله في تصنيف واحد. فبين شعراء جيل السبعينات من يكتب بطريقة البحتري أو أحمد شوقي أو ناجي أو عبدالوهاب البياتي.
ب – الرواد بالمعنى اللغوي هم المبتدئون مسيرة أو طريقاً أو حياة. ونحن نستخدمه بالمعنى الشعري – حالياً – للإشارة إلى الكوكبة التي قادت تجربة الشعر الحر في الأربعينات والخمسينات. لكنه بالمعنى الفني الحق يعني كل من راد طريقاً لم يُسبق. وعليه فإن بين شعراء السبعينات والثمانينات رواداً حقيقيين فتحوا سبلاً وشقوا دروباً جديدة.
ج – الآباء الشعريون هم المصادر أو المراجع الفنية والجمالية للشاعر، بصرف النصر عن العصر أو الوطن. وعليه فمن الممكن أن يكون فاليري ورامبو من آبائنا الشعريين مثلهما مثل الحلاج وأبي تمام وجبران والسياب.
د – التمرد على السالف تعبير مخادع، لأنه يمكن أن يكون في بعض الأحيان نزوعاً عدمياً، إذا فهم على أنه انقطاع كامل عن كل السابق، فليس كل سالف خراباً، إذ فيه ما يصلح أرضاً، أو منطلقاً. كما أن ليس كل تمرد ثورة، ففيه ما يمكن أن يكون انخلاعاً في الفراغ وعجزاً عن الأصالة والإنجاز.
إن شرط التمرد الصحيح على السالف هو إدراك جدل الانقطاع والتواصل : فالانقطاع التام عدم ومستحيل، والتواصل التام اندماج وسلفية.
آقراني كثيرون، وهم كل شعراء التجديد في الشعر العربي. وأخص منهم – بغض النظر عن الأعمار – قاسم حداد وحسن طلب ومحمد بنيس ويعقوب المحرقي وعبدالمنعم رمضان وأمجد ناصر وسيف الرحبي وأدونيس ويوسف رزوقة ونوري الجراح ومحمد عفيفي مطر وخزعل الماجدي وسماء عيسى وعلي الدميني ومحمد بن طلحة وعلي قنديل وسعدي يوسف وعبدالله زريقة، وغيرهم كثيرون.
وبعامة، فإن أقراني هم كل من يضيف جديداً، ممتعاً، حاراً، في آن.