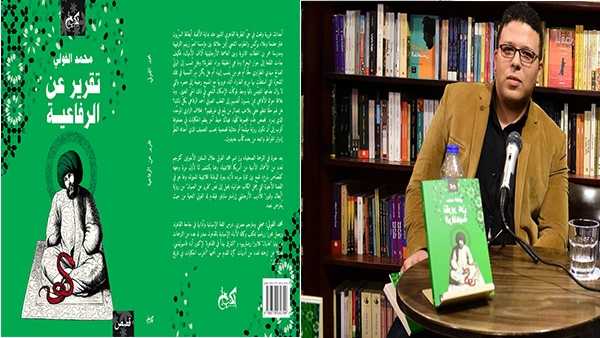مهاب محمود
توطئتان
التوطئة الأولى:
يقول”عين” إن الرجال مهما بدوا أقوياء أجلاف، ومهما صالوا وجالوا، فإنهم في النهاية محاصرون بذكرى حبهم الأول. ولا يشترط أن يكون حبهم الأول هو الأول في الحدوث فعلًا، لكنهم يعرفون أنه الأول حقًا حين لا تنفك ذكراه الساحرة تحاصرهم..
التوطئة الثانية:
يعلّمني الحب ألا أحب، ويتركني في مهب الورق..
(محمود درويش)
******
سيحكي لنا “عين” عن قصة حبه المعقدة مع “راء” وأي تشابه بين القصة، وأحداثها، مع الواقع هو محض شطحات من خيال القارئ العزيز.
(كاتب الحكاية: ميم)
**********
يحكي” عين:
يحدث أحيانًا ألا نعرف حقيقة مشاعرنا تجاه شخص ما، إلا عندما نبتعد عنه بخطوات قليلة إلى الوراء..
هذه المسافة التي يحتاجها كل شخص لتحديد مشاعره بالضبط تجاه الآخرين، لم تكن متاحة فيما بيننا..
كنًا متلاصقين أكثر من اللازم، مما جعل كل واحد منا يحجب الرؤية عن الآخر؛ الرؤية اللازمة لأي شخص كي يستكشف حقيقة مشاعر الآخرين تجاهه، وكي يتعرف على حقيقة مشاعره هو تجاه الآخرين أيضًا، والتأكد منها..
كنتِ تحبينني.. لم أدرك هذا مبكرًا، ولم أدركه أيضًا في ذروته.. وأنت، بدورك، لم تصارحينني أبدا بذلك، ورغم أن هذا يحدث أحيانا، إلا أنه الحماقة غير المغفورة أبدًا، أن ينتظر أي رجل اٍعتراف امرأة بحبها له أولًا..
كنا متلاصقين أكثر من اللازم، وعندما افترقنا، بعد أن التحق كل واحد منا بجامعته، اتيحت لي المسافة الكافية للتحقق من مشاعري تجاهكِ..
ولعل المسافة التي احتجتها أنا، لاكتشاف ماهية مشاعري تجاهكِ، هي نفس المسافة التي احتاجتينها أنتِ للبدء في نسياني، والتوقف عن حبي..
في أول الأمر بدأت أفتقدك. لم تعد رؤيتكِ أمرًا عاديًا مسلمًا به، مثلما كان الحال في الصباحات المدرسية الباكرة، إنما صارت رؤيتك ضرورة ملحة، أنتظر بصبر فارغ، حدوثها..
تحسست غيابكِ ببطء، وبألم، أو كما قال ماركيز، في روايته الأثيرة، الحب في زمن الكوليرا” شعرت بوجودك حيث لم يعد لك وجود”
ومع الوقت استوعبت حقيقة مشاعري تجاهك.
أخذت أفك إشارات كل واحد منّا المُشفرة؛ إشاراتي الخاصة التي بشكل ما لم تخفٍ حقيقة مشاعري عنكِ، وعن الجميع فقط، لخوف مثلًا من المجازفة باحتمالية الرفض، إنما أخفتها حتى عني أنا نفسي..
ثم إشاراتِك المُشفرة الخاصة بكِ أيضًا.
كل جميل أسديتيه لي،
كل ابتسامة، وضحكة،
كل إيماءه،
وكل حركة،
كانوا مفعمين، عن اخرهم، بالحب
وحينها، فقط، أدركتُ الدافع الحقيقي وراء كل ذلك. هذه لم تكن سوى حيل خفيّة مموهة تتقن الفتيات لعبها، للفت انتباه من وقعن في شباك حبه عوضًا عن التصريح المباشر المتعارض مع كبرياء أنوثتهن..
لم نكن يومًا أصدقاءً! كانت مجرد مواراة للحب..
ليست مواراة متفق عليها لتأجيل الاعتراف بالحب، للحذر من الحشد الطلابي المدرسي الذي سيلاحقنا كدأبه مع أي شبهة ارتباط، أو علاقة حب جديدة، بنظرات مستريبة، وهمسات خبيثة، وقصصِ أسطورية ملفقة، إنما مواراة حجبت الرؤية عن الجميع، وعن طرفيها، وعن نفسها.. موارة تاه الحب، نفسه، في دهاليزها..
أتذكر جيدًا المرة الأولى، والوحيدة التي تسنى لي فيها أن أمسك يداكِ..
كنا قد تشاجرنا لأمر شديد السخافة، لا أتذكر تفاصيل الشجار بالضبط، لكن حتمًا لسبب ساذج، وسخيف، ولعل هذا بالضبط ما يسبغه الآن جمالًا، وحسرةً، لأنني أفهم الآن أن شدة سخافته، كانت تؤكد، بطريقة ما، مقدار الحب غير المعلن..
أتى آدهم- صديقنا المشترك – ليصلح بيننا، طلب منا مازحًا أن نتصافح- كمعاهدة سلام- ثم شد على يدينا، كي لا نفض المصافحة.. مزح. أطلق بعض من النِكات. حطم أجواء التوتر. ضحك. ثم همس في أذني “على فكرة.. بتحبك “
ظننتها مُزحة أخرى..
لا أتذكر بالضبط، كيف انفلتت أيدينا. لا أتذكر إن كنا قد أفلتناها في نفس اللحظة كإتفاق ضمني، أم أن هناك من أفلت يد الآخر أولًا عامدًا.
لكني لم أنسَ أبدًا ملمس يدكِ، الذي سيمثل لي دائمًا الذكرى التي تظل تؤكد حقيقة حياتية حتمية، وقاسية مفادها أن الأشياء لا تضيع منا تقريبًا إلا بعد أن نوشك تمامًا على إمتلاكها، والحصول عليها، لنكتشف بعد ذلك أن جمال الأشياء لا يكتمل إلا بفقدها.. ولعل هذا هو ما يجعل الحزن مبررًا، ولعل هذا هو ما يبقي الحنين مستمرًا.. كمفارقة من مفارقاتها ثقيلة الظل..
وسيظل هذا المشهد يطاردني، مسببًا شعورًا حادًا مُرًا بالندم ومن ثم شعور عميق بالذنب.
(يصاحبني الشعور بالذنب على الدوام، ويرتبط كشعور عندي بشكل وثيق بالاستياء الشخصي الناجم عن الإحساس بالندم. في البدء كنت أخلط بين صوت الضمير، والشعور بالذنب.
لا أقول إنني تخلصت منه أخيرًا، لكن على الأقل صرت أعرف ماهية ما أشعر به.. وأطلقت عليه متلازمة الذنب، والندم)
وعلى مدار كل تلك السنوات التي تباعدنا فيها، كنتُ أتلصص على أخباركِ العاطفية من حين إلى آخر.
وعرفت ذات مرة، من أكثر من صديق مشترك، أنك قد ارتبطي. صدمني ذلك، وشعرت بالجزع.. فتيقنت حينها دون مجال للشك، بحبي لكِ..
لا أدعي أنني، في كل تلك الفترة، لم أعُجب بأي فتاة أخرى غيركِ.
أعجبت بأكثر من فتاة، وفي كل مرة، صراحةً، كنت أنتظر ذلك الحب الملحمي الذي يأتي ليصلح كل شيء. قبل أن أدركِ أن الحب لا يُصلح شيئًا، إنما يعدنا فقط، ويهيئنا لحياة أجمل..
أعجبت بأكثر من فتاة، وفي كل مرة لكن في كل مرة، طاردني طيفك، وذكراكِ.. وهذا هو ما أخشاه بالضبط- خاصة فيما بعد حين سيحبط أي احتمال لأن نكون عاشقين- أن تظل ذكراكِ الفاتنة، تطاردتي في كل مكان، ومع كل فتاة، ومع كل فرصة جديدة سانحة للحب، فيحاصرني على الدوام شعور مزمن بالزيف، واللأصالة، تجاه إعجابي بأي فتاة أخرى غيركِ، فيُهدم أي احتمال جديد لأي فرصة آخرى للحب.
ورغم ذلك أيضا أنا لا أتمنى اختفاء /زوال حبك من قلبي، وأخشى حدوث ذلك، لأنه، باختفائه، بعد كل تلك السنوات، لا شك سيربكني، وسينتح عنه شعور آخر بالخواء، وعدم الانتماء لكِ، واللأصالة أيضًا من جانب أخر( حتى اللمسة الدرامية للمحب الخائب سأخسرها) لأني أؤمن بما آمن به درويش حين قال: حين ينتهي الحب، أدرك أنه لم يكن حبًا..
فأشعر أني محاصر من كل الجوانب، دون مفر؛ كلوستروفوبيا الحب..
بعد أن أتم كل واحد منّا دراسته الجامعية، وبعد أن عرفت خبر انفصالكِ، دعوتكِ يومًا إلى العشاء عقب إنتهاءِ عملك، كأول “راندفو” رسمي لنا.. وأندهش الآن من قبولكِ لدعوتي!
أكلنا.. شربنا. وثملنا قليلا..
قلت لي
-تعرف إن إنتَ أحلى، وإنت مش شارب!
-تعرفي إن إنتِ أحلى وأنا شارب؟
– قليل الذوق والله..
اعتملت ذكرياتنا المشتركة في رأسي. وبرزت كل البراهين التي توصلت إليها، والتي تؤكد، بدورها، حبكِ لي..
فصارحتكِ في كياسة، ومواراة جديدة غير جريئة، بحبي القديم لكِ..
أجبت عليّ بموارة أخرى، ولكنها، بطريقة ما أيضًا، كانت مفهومة كفاية لأي شخص. وكان ردكِ فيما معناه أنني قد تأخرت كثيرًا.. سقط كلامِك على رأسي كصاعقة.. وسيظل هذا التلميح بالتأخر يؤرقني. فعلًا! لم أكن يومًا سوى متأخر، ليس متأخرًا بالشكل الذي يفوتني معه المشهد الجميل كليًا، إنما متأخرًا بالشكل الذي يفوتني فيه ذروة المشهد الجميل نفسه، لأرى، فقط، النهاية الدراماتيكية كاملةً، لكل جميل لم يُكتب له أن يكتمل.
فالمرة الوحيدة التي تأكدت فيها تمامًا من حبك لي، كان من خلال إعلانك عن التوقف عن الشعور(القيام) بذلك!
يبدو الآن أن اللحظة التي أدركتُ فيها حبي لكِ، كانت هي نفس اللحظة التي شرعتي فيها أنتِ في نسياني.
كنًا بشكل ما نسير في نفس الطريق، لكن في اتجاهين معاكسين. تقابلنا فقط في المنتصف. تصافحنا، ثم انطلقتي أنتِ في طريقك، ولم أبرح أنا مكاني بعد..
بعد سماعي لكلماتك المضمرة عن توقفك عن حبك لي، ارتبكتُ، حاولت التماسك. ألقيت دعابة مفضوحة. ضحكتُ لأخفي شعور آخر.. ثم ابتسمتِ في فهم. أدعيتُ برعونة بلهاء، ومكشوفة، أنني كنتُ متأكدًا من ذلك..
نهضتُ من على الطاولة. اتجهتُ إلى المرحاض..
أغلقتُ الباب خلفي. وككل المرات التي وودت فيها أن أبكي لأنهار، كبداية لاستعادة الإتزان من جديد، فشلت في القيام بذلك، لتبدأ من هنا عادتي، التي ستلازمني طويلًا، وهي البكاء فجأة في أوقات لا تستدعي البكاء أبدًا، لأنني تقريبًا، كما قال عبدالرحمن منيف، على لسان بطل روايته؛ شرق المتوسط: تظل الأحزان تتراكم في قلبي حتى أبكي فجأة. أنا كذلك أيضًا تظل الأحزان تتراكم في قلبي حتى أبكي فجأة، وحين أبكي لا أبكي شيئًا واحدًا بمفرده، إنما أبكي حزمة كبيرة من الأشياء..
عدتُ. دفعتُ الحساب، وتركت مبلغًا سخيًا للنادل، لأنه ليس هناك مكان لحزين آخر في هذه الليلة..
غادرنا المطعم.. مشينا بخفة. خفة ليست بسبب الإدلاء والإعتراف أخيرًا بما أثقلنا كاهلنا طويلًا، لأن ثقل الإحباط، والهزيمة، على الأقل بالنسبة لي، قد عادل خفتهما في مسئلة حسابية بسيطة، إنما خفة بسبب مفعول الكحول في الدم..
طلبت منك طلب أخير؛ أن أمسك يديك ثانيةً لكن ليس كمعاهدة سلام بعد شجار ساذج، إنما كوداع متأخر، ورثاء، لاحتضار الاحتمال الأجمل، في العالم، على الإطلاق؛ احتمال أن نصبح حبيبين..
وضعتي يديكِ في يدي باستسلام تام، وبحيادية قاسية،
ومزعجة، كأنك تقولين لنفسك بطمأنينة، وثقة: إننا لايمكننا أن نحب نفس الشخص مرتين..
مسكت يديكِ هذه المرة، وأنا أتمنى ألا أفلتها ثانية، أو أبدًا، لكن افتلتت أيدينا، وهذه المرة أعرف جيدًا من أفلت يد الآخر أولًا.. وانتهت قصتنا في نفس لحظة بدايتها، أو حتى قبل أن تبدأ أصلا..
ثم مضينا..
وقلت لنفسي: لم نكن سوى عاشقين حاولا لعب أدوار الصداقة.
ولعل هذا ما يفاقم الألم الآن أكثر، لأن حتى صداقتنا المزيفة صارت الآن واعية بشكل كامل بأصالة زيفها، وبما كانت تخفيه تحت رداءها، فأصبحت الآن غير قادرة حتى على التملق، ولعب أدورًا أخرى ليست أدوارها..
I was so blind but now I know
Your love’s still playing with my mind
اعتراف:
سأبدو متسولًا للحب، لكني منذ ذلك اليوم، اليوم الذي عرفت فيه منكِ أنك قد توقفتي عن حبي- سأبدأ- بشكل غريب، وإقتحامية شديدة- في دس رسائل حبي لكِ في كل شيء تقريبًا. رسالة نصية. ملصق إلكتروني. مكالمات مباغتة. سأقول بحبك كلما تسنى لي قولها.. ولعل ذلك كان جانبًا من جوانت مراحل الإنكار التي تعقب مرحلة الصدمة
الآن وأنا أكتب لكِ سطوري هذه. أرسلت لي صديقة مقربة رسالة نصية على الواتس ااب، تسألني فيها عن أخباري، وعن إذ ما كنت قد كتبت نصًا جديدًا.
انتقيت كل ما كتبته بالأعلى، وبجرأة ألصقته على الشات، ثم أرسلته لها..
ردت، بعد ربع ساعة تقريبًا، وقالت :
كتابتك- كالعادة- جميلة، سلسة، وعذبة، وأنا بحبها. لكن خد بالك، الكتابة بتقتات على أحزاننا، ثم تولّد أحزان جديدة كمان، حاول تسيب لها قدر بس، لكن عيش بالباقي من قلبك، سيب مساحة لحب جديد محتمل..
فكرتُ الكتابة تقتات على أحزاننا فعلًا، ولعلها العزاء، والاستثمار الوحيد لهذا الكم الهائل من الأحزان الذي تحتوي عليها قلوبنا..
فإن كنّا نملك هذه الكم من الحزن الذي لا نعرف معه إلى أين نذهب، ولا إلى من نلجأ، فلنحتفل به، أي لنكتب عنه..
فالخمر نخب المنتصرين..
والكتابة نخب المهزومين..
فعلًا تأتي الكتابة كتعويض للهزائم، لكن الشعور بالنشوة عند الانتهاء من كتابة النص أحيانًا يطغي على الشعور بالهزيمة نفسه عند الكاتب، فيدفعه، بعد ذلك، لاختلاق أحزان أخرى وهمية، لإعادة خلق لحظية الكتابة الاستثنائية، ومن ثم معاودة الشعور بالانتشاء، دون أن نعطي أنفسنا فرصة حقيقية فعلًا للعيش، وللحياة، فنصبح بشكل ما أسرى لكتاباتنا الشخصية، فنعيش لنكتب، ولانكتب لأننا عشنا، ونعيش ما نحكي، ولا نحكي ما عشنا، وهنا ينقلب المعنى، وتتبدل الأدوار، تتحول الوسيلة إلى غاية، والغاية تصبح وسيلة الوسيلة..
فور ذلك، شعرت بحمى خفيفة.. أنهكتني الكتابة تقريبًا..
غفوت، رأيت نفسي- فيما يرى النائم- أني أقف، في منتصف الطريق، مترددًا بين رغبتين، بينهما مسافة متساوية تمامًا، بين الرغبة في العودة إليكِ لأقول لكِ، للمرة المائة تقريبًا، أنا بحبك – على أساس إن دا ممكن يغير من الأمر شيء أصلًا!- وبين الرغبة في قطع كل طرق التواصل بيننا حتى لا أعود إليك لأقول لك للمرة المائة تقريبًا أنا بحبك، لأن ذلك- قطعًا- لن يغير من الأمر شيئًا..
فحتى الآن أنا لم أتوقف عن حبكِ تمامًا بعد.. ولا أدعي ذلك، ولا حتى أسعى إلى ذلك قاصدًا، لأن الحب لا يُبتر، ولا يُستأصل بتدخل من أحد. إنما أعتقد أن اختفاء الحب يحدث كحدوثه نفسه أي ينتهي فجأة كما بدأ فجأة، ودون قصدية من أحد
في حالتي لا يعول على ثلاث:
لا يُعول على النسيان كثيرًا، لأنه لا يجمعنا الكثير من الذكريات، ولهذا فإن حبي لكِ، وحنيني لا يعتمدا بشكل أساسي أو جوهري على ذاكرتي المشهدية، ولهذا فإني أعتقد أن النسيان لن يقو على شفائي..
لا يعول على مرور الزمن، فالذكريات، على الأقل بالنسبة لي- حتى لو كانت قليلة العدد- فإن جاذبيتها في علاقة طردية مستمرة مع مرور الزمن. فكلما مرت عليها الأيام، كلما صارت أكثر جاذبية، وفتنة..
لا أعول طبعًا على أن العالم به الكثير من الفتيات
الجميلات، والذكيات- حتى لو لم تعد تطاردني ذكراك ولم أشعر باللأصالة تجاهك- فأنا لم أحبكِ لأنكِ الأجمل أو لأنكِ الأذكى، لكني أحببتكِ ببساطة، لأنكِ أنتِ، ولأنني أنا، ولعل هذا ما يجعل حبي لكِ أكثر تعقيدًا، وغموضًا، صعب فهمه، وإدراك دوافعه، أو لعل هذا هو الحب أصلًا؛ شيء غير منطقي، وغير مفهوم، ولا مبرر..
ولهذا إذن لا يمكننا أن نعول على محض أمور، واستنتاجات عقلانية، ومنطقية لدحض شعورنا المباغت بالحب، والقضاء عليه، أو التخلص منه، ربما يمكننا أن نستعين بها- بتلك الأمور العقلانية المنطقية- فقط كي لاننساق وراء الحب أكثر..
انتهى النص.. لكن لم تنته الحكاية، ولا حب”عين” ل”راء”
.
وللحكاية باقية
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(كُتب هذا النص أثناء ورشة للكتابة الإبداعية، قدمها المهندس الكاتب مينا ناجي)