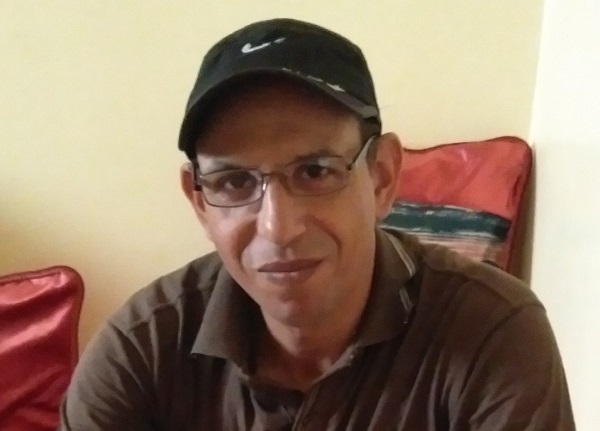أشرف الصباغ
بدأت الأمور كالعادة..
أعلنت إعلامية مغمورة أن الجلاليب البلدي لا تمثل مصر وحضاراتها، وأن من زاروا المتحف المصري الكبير، بعد افتتاحه الرسمي بثلاثة أيام، وهم يرتدون جلاليب أو فساتين “بلدي”، لا يمثلون مصر وشعب مصر الذي تفوق في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين على شعوب العالم في أشكال الملابس والموضات، وكانت بنات مصر يرتدين أحدث الموضات قبل فتيات باريس ولندن. وذهبت الإعلامية المغمورة إلى أن هذه الملابس تحديدًا علامة من علامات الردة عن الحداثة والتحضر، وتقترب من ملابس الإرهابيين ومظاهرهم المفزعة.
كان من الممكن أن يمر كلام الإعلامية المغمورة مثلما مرت إعلانات وانتقادات كثيرة من قبل. بل كان من الممكن أيضًا اعتبار هذا الكلام من قبيل العمى الإعلامي أو خفة العقل، ويتبعه بعض التعليقات الساخرة من الإعلامية المغمورة وينتهي الأمر، لكن الأجواء كانت مشحونة بحالة جديدة على الناس، في ظل كبوات اقتصادية ومشاكل اجتماعية وحوادث مرورية يموت فيها الناس بشكل مجاني تماما، وعملية استقطاب جنونية وفوارق طبقية مفزعة. لم يخضع الناس لظروف المعيشة القاسية، ووجدوا بارقة أمل، تحمسوا لإيجاد ثقوب صغيرة جديدة في جدار الحياة الصعبة، تفتح أمامهم أبوابًا للأمل، حتى لو كانت كاذبة أو مؤقتة.، وحتى لو تعلقوا بخيوط واهية تربطهم بلحظة شبع واستقرار وإنسانية.
امتلأت وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بردود أفعال متفاوتة، بدأت من قيمة الجلباب البلدي وعلاقته بحضارة المصريين العظماء، وانتهت بتحليلات علمية رصينة للأوضاع الطبقية في البلاد، ورصد جاد أحيانًا، وكوميدي في أحيان أخرى، لظاهرة الأرستقراطية في مصر، وهل هناك أرستقراطية وأرستقراطيون في مصر أصلا! وبين البداية والنهاية تعددت ردود الأفعال وتفاوتت حتى وصلت إلى أنواع الجلاليب للرجال وأغطية الرأس للنساء، والمد الوهابي، وحياة المصريين قبل عام 1952، وكيف عاش المصريون القدماء. وأنكر البعض علاقة الحلباب بحضارة المصريين، بينما نسبه آخرون إلى اليونان، وأكد آخرون أنه وسيلة لاختبار المزاج العام، ويمكنه أن يتحول بعد ذلك إلى جلباب أفغاني أو وهابي. وذهب قطاع من الناس إلى رصد تطور الأرستقراطية في مصر منذ الحملة الفرنسية، فقوبل بردود أفعال ساخرة، مرفقة بصور جموع المصريين الحفاة الذين يعملون بالسخرة، وتعرضت الشريحة العليا من الطبقة الوسطى إلى المزيد من السخرية على اعتبار أنها تقدِّم نفسها كطبقة أرستقراطية من جهة، وقاطرة للوعي والتقدم وقيادة جموع الشعب إلى عصور الازدهار والرخاء من جهة أخرى. وشرع الناس بالبحث عن أصول الأسر والعائلات، والإعلان عن انتماءاتهم الاجتماعية والعرقية.
راح رواد السوشيال ميديا يبتكرون الردود والتعليقات، يقلبون تاريخ الحضارات، ويتعمقون في حياة المصريين القدماء، ويفسرون الظواهر الطبقية وتجلياتها، واستفحال البلطجة الاجتماعية والإعلامية في العصر الحديث. وأصبحت صورة رجل وزوجته من أطراف مصر الجنوبية هي محور المعركة التاريخية- الحضارية الجديدة. طغت حالة الحماسة والفخر واجتذبت السواد الأعظم من الناس مقابل أعداد ضئيلة من الرافضين لصورة الرجل الذي يرتدي جلبابا جميلًا، ويسير بفخر وكبرياء إلى جانب زوجته التي ترتدي زيًا تقليديَّا وعلى رأسها الطرحة المصرية العادية التي كانت منتشرة في جميع أنحاء البلاد حتى مجيء الصحوة الأولى في سبعينيات القرن العشرين. تغزَّل الكثيرون في الصور التي انتشرت عن مقطع فيديو صورته مصورة صحفية شابة.
كانت الصور جذابة لدرجة أن البعض رأى أنها تصلح أن تكون وسيلة دعاية للسياحة والمتاحف والآثار المصرية. وراح البعض الآخر يصف جمال المرأة ونظراتها الحنونة المحبة لزوجها وهي تسير إلى جواره، ممسكة بيده، في فخر وكبرياء، وهما ينظران معا- في إحدى الصور- إلى التماثيل، وإلى بعضهما البعض- في صورة أخرى- في حب وتقدير ورضاء. انتشرت الصور وردود الأفعال بشكل لافت في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، وعبرت الحدود إلى وسائل الإعلام الأجنبية التي فسرت الموضوع بطريقتها ووفقًا لرؤيتها لمصر والمصريين، كل ذلك على خلفية الفرحة العارمة التي اجتاحت البلاد، وطبطبت على قلوب بسطاء المصريين، ومنحتهم بعض الأمل في الأيام المقبلة. واقترح البعض تعليق صور الزوجين داخل المطارات لاستقبال الزائرين المحليين والأجانب، من أجل إعطاء صورة إيجابية عن مصر وناسها بزيهم التقليدي.
عمت وسائل التواصل الاجتماعي نوبة حماسة وطنية وتاريخية، بل ووجودية، بشأن كرامات الجلابية وأهميتها باعتبارها الزي التقليدي والشعبي للمصريين، وأن من يرتدونها هم أصل سكان البلاد، والطبقات المكافحة التي تعمل وتكد وتكدح، وتحمل الوطن فوق رأسها. ظهر منشور صغير لأحد الكتاب يحكي فيه حكايته مع الجلابية عندما كان في السنة الثالثة أو الرابعة في الجامعة وقرر أن يشتري جلابية من قبيل أنها زي مريح وتقليدي وشعبي، وكغالبية سكان المنطقة الشعبية التي يعيش فيها بشرق القاهرة يرتدونها. وفي يوم من الأيام زاره صديقه الذي يكبره بعامين، قرب الظهيرة، وجلس معه ساعات طويلة، تجاذبا خلالها الأحاديث في الأدب والشعر والثقافة والسياسة، ودخنا الكثير من السجائر. وقرب المغرب، قرر الصديق المغادرة، فأصر الكاتب أن يرتدي جلبابه ويرافقه لاستكمال أحاديثهما الشيقة حول الفن والثقافة والمستقبل. وكان الصديق يعيش في منطقة مجاورة على بُعْد محطتي ترامواي. لكنهما قررا أن يسيرا على الأقدام لكسب المزيد من الوقت. خرجا الصديقان من بيت الكاتب في منطقة الوايلي الكبير، وسارا في شارع الخليج المصري حتى شارع سكة الوايلي، وانحرفا يسارًا في اتجاه محطة الزاوية الحمراء التي تقف على مدخل المنطقة التي تسمى بنفس الاسم. وانطلقا في الطريق الترابي المليء بالحفر والتراب والقمامة بمحاذاة شريط السكك الحديدية للترامواي القديم الأحمر الذي يعمل على خطي “شبرا- السيدة زينب”، و”شبرا- العتبة”. لم يكن أمامهما إلا محطة واحدة ليصلا إلى منطقة القيرين التي يعيش فيها صديق الكاتب. وفجأة ظهرت سيارة شرطة متوقفة على جانب الطريق. وإذا باثنين من المخبرين، وربما أمناء الشرطة، يقتربان منهما ويطلبان أوراق إثبات الشخصية والموقف من التجنيد.
كان صديق الكاتب، الذي يكبره بعامين أو أكثر قليلًا، يرتدي بنطلونًا وقميصًا، بينما الكاتب نفسه يسير إلى جواره في جلابيته وهو يرفع ذيلها قليلا حتى لا تجمع الأوراق والقمامة المتناثرة في الطريق. أخرج الصديق إثبات الشخصية وصورة من شهادة إنهاء الخدمة العسكرية. بينما ظل الكاتب، الذي لم يكن يرتدي سوى الجلابية والشبشب واللباس، واقفًا مشدوهًا ومرتبكًا. وتأزم الموقف عندما طالبه أحد المخبرين مرة أخرى بإبراز إثبات شخصيته وموقفه من الخدمة العسكرية. وعندما أجابهم بأن أوراقه ليست معه، قال المخبر لصديقه: “انصرف أنت”، ونظر إلى الكاتب قائلًا: “أما أنت، ستأتي معنا.. ستشرفنا وتؤانسنا اليوم”. زاد ارتباك الكاتب وسأله: أين؟”. رد عليه مشيرًا إلى سيارة الشرطة الواقفة على بعد عشرين مترًا: “ستركب البوكس الواقف هناك، وتنتظرنا”.
راح الكاتب يشرح للمخبرين الموضوع من البداية. قال لهما إن صديقه كان في ضيافته، وهو الآن يوصِّلَه إلى بيته، وسيعود سريعًا. نظر إليه أحد المخبرين بعنف وقال: “ليس لديك إثبات شخصية، وتسير بجلابية وشبشب، وتريد أن نصدقك؟”. رد الكاتب: “عندي إثبات شخصية. وأنا ما زلتُ طالبًا في الجامعة، ولم يأت موعد الخدمة العسكرية”. قال له المخبر: “اذهب إلى السيارة بدون كلام. وهناك سنعرف كل شيء”. وبدأت أصوات المخبرين والكاتب تعلو قليلًا. ومد أحدهما يده وأمسك بطرف الجلابية بطريقة تعمل على إعاقة الكاتب في حال فكر في الفرار. بينما صديق الكاتب يقف مرتبكا ولا يدري ماذا يفعل. لفتت أصواتهم اهتمام الضابط الشاب، فجاء متمهلًا وسأل: “ماذا يحدث هنا؟”. رد أحد المخبرين بسرعة: “لا يوجد معه إثبات شخصية، يا باشا”. نظر الضابط إلى الكاتب وسأله: “لماذا لا يوجد لديك إثبات شخصية؟”. قال الكاتب: “تركتها في البيت. اعتقدتُ أنني لستُ بحاجة إليها، وأنا أوصِّل صاحبي. أنا أسكن هنا على بعد محطة أو اثنتين”. نظر الضابط في وجهه متفحِّصًا، ثم حدَّق طويلا في الشبشب والجلابية وسأله: “ما هو عملك بالضبط؟”. رد الكاتب: “أنا لا أعمل. أنا طالب في الجامعة كما قلت لهما”. تَفَحَّصه الضابط مجددًا وقال: “خلاص، امشي من هنا”.
انتقل الكاتب إلى حكاية أخرى، جرت أحداثها بعد أن تخرج من الجامعة وقضى الخدمة العسكرية، وبدأ العمل في الصحافة كمحرر تحت التمرين. قرر في أحد الأيام، بعد انتهاء يوم العمل، أن يذهب لمشاهدة بروفة مسرحية يخرجها مخرج مشهور استعان به لكتابة بعض الأشعار. في هذا اليوم أنهى عمله وعاد إلى البيت قرب العصر. أعجبته فكرة أن يرتدي الجلابية ويذهب بها لحضور البروفة، خاصة وأن أحداث المسرحية تدور حول الفلاحين وحياتهم وتاريخهم المشرف في العمل والكد والنضال، وعن حكمة الفلاحين وتضحياتهم من أجل الوطن.
بدأت بروفة القراءة وتمثيل بعض المواقف ومناقشتها. وفجأة انقطع التيار الكهربائي وتحولت الغرفة التي يجلسون فيها إلى قطعة من الظلام الدامس. عَلَتْ أصوات الاحتجاج والغضب. أشعل الكاتب قداحته ونهض مسرعًا. فتح باب الغرفة وسار في بهو الاستقبال الواسع الغارق في الظلام. راح يتساءل بصوت عال عما يجري، ثم علا صوته بالسؤال عن مهندس الكهرباء في المسرح. لم يرد عليه أحد. فعلا صوته أكثر فأكثر مصحوبا بالغضب والاحتجاج والاتهام بالإهمال، وأن هناك من يريد إفساد بروفات المسرحية. وفجأة هجم عليه رجل ضخم ونزل بكفه السمينة على وجهه قائلًا: “مَنْ أنت، يا سافل لكي ترفع صوتك هنا؟”. اظْلَمَّت الدنيا في عينيه، وكاد يفقد الوعي. انعقد لسانه تماما عن الكلام، وجحظت عيناه من هول الدهشة والمفاجأة. حاول الهجوم على الرجل الضخم الذي كان لا يزال يقف في مواجهته بتحد غريب، لكن قدميه كانتا مُسَمَّرتين بالأرض. في هذه اللحظة، عاد التيار الكهربائي وأُضيء المسرح من جديد. وإذا بالمُخرِج المشهور يتجه نحو الرجل الضخم، ويوجه له لكمة قوية في ظهره، ثم رفع يده مرة أخرى ليوجه أخرى. التفت الرجل الضخم إليه وقال: “لماذا تضربني؟ هل تضربني من أجل هذا (وأشار إلى الكاتب).. أنا راجل كبير وعندي أولاد، وأنت مثل ابني، وتضربني؟”.
تحرك الكاتب الذي تلقى كفَّا على وجهه للتو، وأمسك بالمُخرِج ليمنعه من توجيه لكمات إضافية للرجل الضخم، واصطحبه إلى الغرفة التي يجرون فيها البروفة. بعد ذلك، سألوا الرجل الضخم، لماذا ضرب الكاتب! قال لهم: “لم أكن أعرف أنه يعمل صحفيَّا. رأيتُ أمامي شخصًا يرتدي جلابية وشبشب، واقفًا يُزَعِّق ويصيح في وسط المسرح. تصورتُ أنه أحد الباعة الجائلين أو العاملين على العربات المحيطة ببناية المسرح، يحاول إثارة المشاكل.. لم أكن أعرف أنه صحفي في هذه الجلابية والشبشب الغريبين”.
أنهى الكاتب حكاياته، معلقًا بأن مصير هذه الجلابية كان غريبًا. ففي يوم، قررت أمه أن تغسلها وتنشرها مع بقية الملابس. لكن حرامية الغسيل في المنطقة تركوا كل ما هو موجود على حبل الغسيل، وانتقوا هذه الجلابية فقط. وعندما أخبرته أمه أن الجلابية سُرِقَتْ، افتعل الدهشة والحزن، لكنه في قرارة نفسه كان سعيدًا باختفائها والتخلص منها إلى الأبد، وضحك في نفسه قائلا: “لو بقيت هذه الجلابية لديه، لكان من الممكن أن يقضي بقية حياته إما مقبوض عليه بتهمة ما، أو مسجون بأحد السجون المخصصة للمجرمين شديدي الخطورة.
ظهرت وجهات نظر جديدة. حول زيف مقطع الفيديو والصور، وأنهما من صنع الذكاء الاصطناعي. ودارت معارك حامية الوطيس بين فريق يؤكد ذلك، وفريق آخر يحاول نفى ما يقوله الفريق الأول. بينما قطاعات واسعة تراقب وترصد وتتابع في حالة من المتعة. ومتابعة مثل هذه المعارك تحتاج إلى وسائل وأدوات للتسلية مثل قزقزة اللب ومص القصب، وربما تناول أكياس كاملة من الفشار. وعلى مستوى المشاة والمارة والموظفين في المؤسسات الرسمية والحكومية، ورواد المقاهي والبارات، تحتاج الأمور إلى وسائل وأدوات أخرى للتسلية والفرجة على مشهد تاريخي حضاري نادر في حياة المصريين التي تحولت إلى أفراح واسعة، وإحساس عارم بالانتماء إلى أجدادهم القدماء الذين شيَّدوا الأهرامات والمعابد والمسلات.
وفي المقابل، انخرطت قطاعات أخرى من الناس في البحث عن أصل الزوجين، ومن أين جاءا، وماذا يعملان، وما هو تاريخ آبائهما وأجدادهما. وتدافعت وسائل الإعلام لإجراء مقابلات شخصية مع الرجل صاحب الجلباب، اتسمت بالسذاجة أحيانًا، وبالسطحية في أحيانٍ أخرى، وكأن أوامر صدرت من أحد ما، أو من جهة ما، باستغلال هذه الحالة، وتوظيفها جيدًا، وحتى النهاية، لتحييد المزاج العام الذي يعاني من إحساس بالضيق والمهانة والفقر. فقال البعض أنهما فلاحان بسيطان كلَّفا نفسيهما أموالًا غير قليلة للمجيء من بلدهما البعيد في جنوب مصر لرؤية متحفهما الوطني العظيم الذي يضم منجزات الأجداد وجثثهم ومومياواتهم. وقال البعض الآخر أنهما من الحِرَفيين الذين يعملون في مجال الصناعات اليدوية، جاءا إلى المتحف لرؤية القسم الخاص بالصناعات الحرفية، وهل يستحق الأمر أن يوسعا مجال عملهما ويأتيان بمنتجاتهما لعرضها بالمتحف. تكاثرت الروايات والسرديات والتحليلات، وظهر المزيد من المعلومات عن ابنهما المستشار، وابنتهما الطالبة الجامعية. ورأى البعض الثالث أن الزوجين مثل كثيرين من أصحاب الأعمال يركضون وراء المكاسب والأرباح، وربما سرقة الأثار والمتاجرة بها. وبدأ المصريون يمارسون هوايتهم العتيدة في تسييل المعاني وهدرها، والبكاء على أحوالهم المزرية، وأقدارهم الغاشمة ومصائرهم المخيفة، واحتياجهم إلى مَنْ يحنو عليهم ويعرف قيمتهم.
لم يكد النقاش حول زيف وحقيقة مقطع الفيديو والصور ينتهي، وفي ذروة نشوة الجدل، وعمق غواية المصريين في هدر المعاني وإسقاطها والقضاء عليها، حتى ظهر فريق جديد يؤكد أن الرجل والمرأة نفسهما من صنع الذكاء الاصطناعي، وأنه لا يوجد أصلا رجل وامرأة بهذه المواصفات في الواقع. اتسعت المعركة، وأصبحت أكثر جاذبية وتسلية، واحتشدت جحافل المصريين في الطرقات والشوارع والميادين، وتبادل الناس وجهات النظر التي لم تكن تخلو من السباب والاتهامات، وهم يقزقزون اللب ويمصون القصب، ويأكلون ساندوتشات الفول والطعمية ويلقون بالورق والأكياس في الشوارع والحواري، أو في أحسن الأحوال يركنونها إلى جوارهم. وكلما زاد النقاش، واشتعلت وتيرة الأفكار، علت أكوام قشر اللب ومصاصة القصب والأكياس الورقية والبلاستيكية حولهم.
انتقلت الحوارات والنقاشات إلى حقيقة الحضارة المصرية من عدمها. وهل بناها المصريون القدماء، أم الكائنات الفضائية، أم العمال والفلاحون الإسرائيليون الشقيانين، أم الأوكرانيون القدماء. دبت في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا حياة جديدة إضافية تتناغم بهدوء ونعومة مع حالة الناس وحماستهم، وانتشار الأغاني الوطنية، وارتفاع مؤشرات الوطنية والانتماء، والتصريحات الرسمية باقتراب الخروج من عنق الزجاجة، والكشف عن حصاد سنوات الصبر والحرمان، وحلول زمن الرخاء والازدهار والبحبوحة. وبينما النقاشات تتسع وتتخذ أبعادًا إضافية في عمق التاريخ والحضارات والأسبقية والتفوق، كانت أكوام قشر اللب ومصاصة القصب تعلو وتزدهر، وتنتشر حول الناس السعداء الفرحين الذين يرقصون على أنغام المستقبل الزاهر.
لا أحد يدري كيف انعطفت الحوارات والنقاشات إلى صور الرجل والمرأة مرة أخرى. تركوا كل شيء وبدأوا بمناقشة حقيقة وجود المصورة الصحفية الشابة التي يقولون إنها هي التي صوَّرَت مقطع الفيديو. لم ينتبه أحد منذ البداية إلى هذه الفتاة. ويبدو أن هواية المصريين وعشقهم للتكريم والخلود تغلبا على أحدهم في لحظة ما، فامتشق سيف الوعي والمبادرة وراح يدعو لتكريم المصورة الصحفية التي صنعت هذا الإنجاز التاريخي لمصر والعالم. والمصريون لديهم رسالة مجيدة، ضمن رسالات عديدة، بالاستحقاق، وبضرورة تكريمهم حتى ولو بورقة أو شهادة تقدير أو لقاء مع المحافظ أو رئيس البلدية. يكتفون بهذه الشهادات ويحتفظون بها على بطون خاوية وعقول مشتتة، وشكوى وتذمر. يفرحون ويطبلون ويزمرون، ويواصلون قزقزة اللب ومص القصب وإلقاء الفوارغ حولهم، لا يأبهون بنمو وتزايد أكوام القشر والمصاصة حولهم، فهم أكبر من ذلك، وأهم من أن يولوا أي اهتمام لهذه التفاصيل التافهة.
هبت جماعات تؤكد أن الفيديو مزيف، وبالتالي تصبح كل الصور المأخوذة عنه مزورة. بل وأكدوا أيضًا عدم وجود أي مصورة صحفية قامت بتصوير الرجل والمرأة. وحتى إذا وُجِدَت، فستكون من صنع الذكاء الاصطناعي. ظهر أشخاص يعرفون هذه المصورة شخصيًا، وأعلنوا حقيقة وجودها، وان لها صفحات على السوشيال ميديا، وتعمل معهم بالصحيفة التي يعملون بها، ولها أب وأم وإخوة. لكن الجماعات الكثيرة على السوشيال ميديا كانت هي الأكثر صدقًا ويقينًا، فأكدت مجددًا أن الفتاة المصورة الصحفية مجرد نموذج للذكاء الاصطناعي، وأنها غير موجودة في الواقع. ودخلت الحوارات والنقاشات إلى آفاق أوسع وأبعد وأعمق، حتى وصلت إلى البحث في الأكوان الموازية، والاستنساخ، ومخاطر الذكاء الاصطناعي، وتحول المصريون إلى علماء في الهندسة الوراثية والحواسب الكمومية. راحوا بكل صدق ويقين يناقشون حقيقة وجود المصورة الصحفية، وأنه من الممكن في يوم من الأيام تظهر هذه الفتاة في شكل آخر، لأنها تعيش حاليًا في كَوْنٍ موازٍ لكوننا، وربما نذهب نحن إليها في زمن ما.
ظلت الحوارات والنقاشات تتسع وتتطور، وتأخذ مسارات متعددة ومتشعبة، كشفت عن إلمام المصريين بكل العلوم الأساسية والفرعية، وتعمقهم التاريخي في علوم الاجتماع والفلسفة والفيزياء. تجلى التاريخ ليكشف في لحظة حقيقية عن عمق المصريين وأصالتهم، ومسؤوليتهم في حمل رسالة تاريخية إلى البشرية. بينما أكوام قشر اللب ومصاصة القصب وفوارغ الكوكا كولا والبيبسي والبيرة والأكياس الورقية والبلاستيكية والعديد من أنواع القمامة تتزايد وتعلو، حتى حجبت الهواء والضوء عنهم، وهم منخرطون بكل جدية، وبضمائر حية، في مناقشة ليس فقط التاريخ المجيد والإنجازات الحضارية في مراحل ما قبل التاريخ، وثياب الملوك والكهنة والعمال والفلاحين، بل وأيضا حقيقة وجود المصورة الصحفية والأكوان الموازية وعلوم الاستنساخ والهندسة الوراثية.
انتبهوا فجأة على غياب الهواء والضوء. راحوا يتحسسون أنفسهم وبعضهم، يبحثون عن باب للخروج وسط أكوام القمامة التي تحيط بهم وتكاد تغطيهم، وإذا بكائنات غريبة تطل عليهم من أعلى جدران القمامة المحيطة بهم، تتحدث إليهم بلغة لا يعرفونها ولم يسمعوها من قبل، تحاول أن تقول لهم شيئا باستخدام الأصوات تارة، وباستخدام الأيادي والعيون تارة أخرى. ولما يئست تمامًا، بدأت تبصق وتطرطر عليهم وهم يحاولون العثور على مخرج من بين أكوام القمامة التي تكاد تطمرهم تمامًا، ويواصلون مناقشة حقيقة وجود المصورة الصحفية التي صورت مقطع فيديو لزوجين يرتديان ثيابًا تقليدية قبل خمسين عامًا.
…………………………………..
*قصة من مجموعة “مدينة الخريف الدائم” التي ستصدر بداية عام 2026 عن دار “روافد”