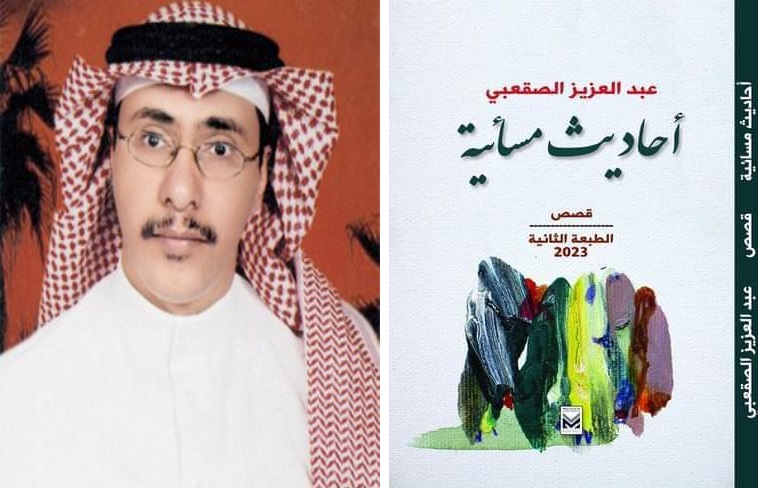د. لينا الشّيخ- حشمة
“في مديح الوقت” مؤلّف شعريّ يحتدم في قصائد مغايرة، تتفجّر جدلًا وتمرّدًا، تمور ثورةً وصخبًا.
ولمّا كان واقعنا غامضًا ملتبسًا تغدو القصيدة مرآة له، متجانسة المضمون مع الشّكل باعتمادها على الرّموز والفجوات والموتيف والسّؤال والتّضادّ والمفارقة والتّناصّ وغيرها من آليّات الحداثة وما بعدها، فتجعلها قصائد رمزيّة متعدّدة الدّلالات؛ تنفلت من أسر الشّكل الكلاسيكيّ في محاولة للوصول إلى موازٍ لحرّيّة المضمون بامتلاك حرّيّة الشّكل، فتعلن “موت المؤلّف”- كما يقول رولان بارث- وتدعو قارئها لبناء علاقة حواريّة معها، تجعله شريكًا فعّالًا، لا مستهلكًا متلقّيًا.
لا يترك الشّاعر مسألة إلّا ويغوص فيها؛ يتأمّلها في عمق السّؤال وفي بوتقة الشّكّ. لا يجمّل ولا يجامل، فالوجود عنده لا قداسة فيه لشيء، وكلّه عرضة للتّفكير والتّشكيك. يثور على واقعه بلا مواربة أو خوف، يثور عليه ليعيد بناءه، ينفصل عنه ليتّصل به، لا ليهرب منه.
*في العنوان: “في مديح الوقت”
قد يتساءل القارئ منذ العتبة الأولى: ما الّذي يجعل الشّاعر يخصّص مديحه للوقت؟ كيف يكون المديح لشيء غير محسوس؟ عن أيّ زمن يتحدّث؟ أهو زمنه الدّاخليّ النّفسيّ أم الزّمن الطّبيعيّ الخارجيّ؟
إنّ الإنسان زمكانيّ، أي حضورٌ جسديٌّ محسوسٌ في المكان، ووعي في الرّوح غير محسوس في الزّمان. الزّمان الرّوحيّ لا يُدرك إلّا بوعي الإنسان، والزّمان الرّوحيّ في المكان الجسديّ هو الحضور الكلّيّ للإنسان. وإذا مات الإنسان مات جسدًا وروحًا. أي، الوجود الكامل للإنسان يفترض بعدين: المكان والزّمان، وإذا انتفى بعد واحد انتفى الوجود كلّه. معنى هذا، المديح هنا متعلّق بالحضور الإنسانيّ، لأنّ الوقت لا يُدرك إلّا في الوعي، فنتساءل: هل يمدحه متهكّمًا أم صادقًا؟ هل الإنسان هنا كامل الوجود فيستحقّ زمنه مديحًا أم أنّه ناقص الوجود، فعندها لا يكون له من المديح نصيب؟
يعتبر العنوان عتبة النّصّ الأولى الّتي يستند إليها النّصّ الموازي، مثلما يعتبره جيرار جينيت. ولمّا كانت العناوين في السّيميائيّة إشارات وأيقونات والمفتاح الضّروريّ لسبر أغوار النّصّ لتشكيل الدّلالة، فإنّ العنوان جزء لا يتجزّأ من النّصّ، وبه يكتمل العمل الأدبيّ. ولأنّه كذلك، فإنّ الشّاعر لم يختر عنوانه اعتباطًا، بل أجهد نفسه في عمليّة ميتا شعريّة نقديّة، ليكون هو النّاقد الأوّل لمؤلّفه.
على الرّغم من أنّ هذا هو عنوان إحدى القصائد أيضًا إلّا أنّه لا يتعالق مع القصيدة الّتي تحمل هذا العنوان بالعلاقة نفسها مع المؤلّف كلّه. إذ يخصّص الشّاعر في قصيدته “في مديح الوقت” مديحه لعمره الخمسين بكلّ ما حمله له هذا العمر من رضًا وتصالح ذاتيّ، وعلى الرّغم من كلّ ما سبق في حياته من جدل وصراع، فيصل في الخمسين إلى نقطة الاعتدال وتبلغ الأمور مداراتها، فلم تعد خارجة عن نصابها أو ضيّقة على حدودها. وإذا كان هذا هو شعوره عندما بلغ الخمسين، زمنه الذّاتيّ النّفسيّ بما حصّله عمره الخاصّ، فله من المديح نصيب، ويأتي العنوان هنا كاشفًا دون مفارقة. أمّا إذا نظرنا إلى العنوان على مستوى العلاقة مع المؤلّف الشّعريّ كلّه فنجده مخالفًا؛ فالقصائد الّتي تصرخ بالخراب والصّراع والكبت والاغتراب والقمع لا يمكن أن توحي بزمن يستحقّ المديح. ويمسي العنوان إيحائيًّا يعبّر به الشّاعر عن قيمه الفكريّة والسّياسيّة والاجتماعيّة والثّقافيّة. إنّه عنوان مخادع ومضلّل، يوحي بلعبة الغواية التّأويليّة في مفارقة صارخة، يخيّب توقّعات القارئ بانزياحه المجازيّ.

يهتمّ الشّاعر كذلك بالصّورة البصريّة في تحديد ألوان عنوانه، فيختارها بانسجام مع المضمون، ويجعلها بين لونين متصارعين بدلالتهما، الأحمر والأبيض. فيجعل كلمة “مديح” بالأحمر، أمّا “في” و”الوقت” فباللّون الأبيض. إنّ الأحمر، إضافة إلى كونه رمزًا للحبّ، يرمز للدّم والقتل، ولإله الحرب عند الإغريق وغيرهم من حضارات، يرتبط بالثّورة والصّراع السّياسيّ والاجتماعيّ، هو لون الخطر والتّحذير. وفي الثّقافة الغربيّة الحديثة يرمز إلى الشّيطان. هكذا يأتي الأحمر منسجمًا مع موتيفات القصائد ودلالتها. ولعلّه يريد تحذير القارئ من خطورة الواقع ليدفعه إلى العمل على تغييره، بينما يأتي الأبيض معاكسًا دالًّا على الطّهارة والسّلام والأمل، وكأنّ الشّاعر لن يفقد أملًا ولا حلمًا.
أمّا الخلفيّة الّتي خُطّ عليها العنوان فتميل إلى اللّون الأصفر الباهت، ولعلّه يرمز به للوطن العربيّ، فهو لون الصّحراء الّتي تشكّل نسبة ثمانين بالمئة من مساحته. والأصفر يدلّ كذلك على الخوف والمرض والموت والحزن، فلعلّه يوحي بهذا إلى الخراب والبؤس في ظلّ زمن الحروب والهزائم والتّهميش والتّهشيم الّذي يسود الواقع العربيّ.
وعليه، إنّ هذا الوقت، الزّمن العربيّ الرّاهن والزّمن الإنسانيّ العامّ، ليس نقيًّا ولا صافيًا ولا أبيض، بل يغلبه أحمر الشّيطان، وبياضه مكتوم اللّسان. فكيف يمدحه والثّالوث المحرّم يقرفص فوق رقبة الشّعوب مثلما قرفص الملوك فوق رقبة الشّعوب بالوراثة في “دولة قمعستان” عند نزار قبّاني؟
إنّ هذا المؤلّف يوائم زمنه، يوائم زمن البؤس والفقد، ويدور حول وجع الإنسان المسحوق، المنفيّ في الوطن، المغيّب في الحضور.
ولكم أن تستنجوا الآن: هل يمدحه فعلًا، أم هي مفارقة صارخة؟
هذا العصر الّذي يصفه النّاقد جورج طرابيشي في كتابه “الأدب من الداخل”: ” هذا العصر العربيّ في أحد وجوهه: عصر الاعتقال، عصر التّعذيب، الزّنزانات والسّراديب، عصر الكرامة الّتي قضي عليها بمصير واحد: أن تداس وأن تداس إلى أن تموت في النّفس قبل أن تموت في الجسد ومعه… العصر العربيّ الّذي انتهك حقوق الإنسان جملًا وتفصيلًا، حتّى مات في النّفوس والأذهان” (1978: ص 54).
إذًا هذا هو زمن الشّاعر المقصود، الزّمن الّذي يموت الإنسان فيه روحًا قبل أن يموت جسدًا، أن يحضر في المكان لكنّه يُنفى بالرّوح والزّمان، وهذا هو الأفظع!
وهذا هو معنى تغييب الإنسان وتهميشه. فهل له من المديح نصيب؟!
إذًا ليس المؤلّف إلًا صرخة تدين هذا العصر؛ صرخة تعرّي الوحشيّة الإنسانيّة، كاشفة عن قلق واغتراب، صرخة ثائرة في وجه القمع السّياسيّ والتّطرّف الدّينيّ والتّخلّف الاجتماعيّ وكبت الحرّيّات، تحت وطأة رقابات الثّالوث المقدّس وتحريماتها، حين يمسي هامشُ الحرّيّة معتمًا إلى حدّ الاختناق، خاصّة في ظلّ تزايد الحركات الدّينيّة الأصوليّة المتشدّدة والّتي تصادر كلّ مغاير عنها.
يثور الشّاعر على الشّعائر والنّصوص المقدّسة، ويمقت التّقييد والتّعصّب، فالبناء العقائديّ في نظره يوصد الباب نهائيًّا في وجه حرّيّة الفكر، ذلك أنّ المؤمن يعتقد بأنّه حصل على الحقيقة المطلقة فيحتكرها، ولا يقبل فيها جدلًا، بينما الشّاعر يضع كلّ شيء موضع الجدل والسّؤال. في قصيدة “طائرات الورق” (ص 55) يثور على الطّغاة، هذه المفردة الموتيف الّتي تتكرّر كثيرًا في قصائده، فالطّغاة هم الّذين يسرقون الألوان من سطوح البيوت، ويهدمون رسومات الأشقياء، ويراقبون كلام النّاس، يصكّون كتب التّاريخ واللّغة، يسرقون تعب الفلّاحين، ويحزّون حناجر المغنّين، ويغلقون الفضاء. هم الّذين يخافون حتّى من الأطفال وطائرات الورق.
إنّ الطّغاة يخشون الفكر، فالفكر ثورة، والفكر لغة، لذا لا بدّ للسّلطات أن تقمع اللّغة وتراقبها، وتحدّد لغة خاصّة بها، لغة قامعة مدجِّنة. ولمّا كانت اللّغة لغة القمع ستمسي الثّقافة ثقافة القمع والمقموعين، الّذين يلوكون اللّغة ذاتها، ويعيشون داخل سجن بلا قضبان، في بوتقة الظّلم والعنف.
أوَ يمدح الشّاعر هذا الوقت وفيه يُبعث الحلّاج مئات المرّات من موته ليقتل من جديد؟! أوَ ليس في هذا الزّمان الخراب بتعصّبه الدّينيّ واضطهاده السّياسيّ يصبح كلّ كاتب الحلّاج نفسه،معرّضًا للسّجن والقتل لأجل فكرة مغايرة أو رأي مختلف؟ إذًا، لا غرو أنّ الشّاعر يستحضر الحلّاج، موظّفًا إيّاه في تناصّ صارخ، مؤكّدا أنّنا نعيش في زمن التّكفير وعتمة الفكر.
أمّا الوطن فيشكّل موتيفًا قويًّا، فالوطن لديه هو “قدرة الحياة على ابتداع الأمكنة”، يتحوّل المنفى إلى وطن حين يغيّب الوطن عنك، أو قل: حين يغيّبك. ففي قصيدة “التباس الوطن وضوح المنفى”(ص 111-112) يوضّح الشاعر بآليّة التّضادّ كيف يمكن للوطن أن يمسي غريبًا في حين يمسي المنفى وطنًا. في المنفى يشبه المرء ذاته، فيدركها ويدلّه عليها، بينما في الوطن هو غريب عنها، إذ يستلبها الوطن منه ويجعله تائهًا غريبًا. في المنفى يضحك في ليلة واحدة ما قد يضحكه في سنة في الوطن. في المنفى يصبح للوقت معنى آخر، فالوقت هناك يزيد عن كلّ الوقت الّذي سلبه منه الوطن. “المنفى حديقة والوطن قبو “.
هكذا عاش الشّاعر وجع الأماكن وسافر عبر قصائده إلى مدن كثيرة في العالم، وضعها في تضادّها مع مدن الوطن، تأمّلها وقارنها، ولم ينس أن يصورّ حياة اللّاجئين والنّازحين، ففي باريس بإمكانك أن تختار ما شئت من الوقت والموقع. وفي برلين كن حرًّا صريحًا؛ فبرلين راضية بكلّ الهويّات الوافدة، صارت لهم وطنًا. وهناك، بإمكان العربيّ أن يقول لنفسه الحقيقة ويبقى حيًّا.
إنّ الأوطان برأيه كمدينة فاس الّتي تختزل الحياة العربيّة، فهي المدينة المحصّنة بالأسوار والبوّابات، المغلقة كالسّجن (ص 119). من أعالي لندن يرى كيف يرتدي الطّغاة الصّحارى وينامون على رماحهم خوفًا من حركة الرّمل.. من أعالي لندن يبدو له العربيّ ضئيلًا مهزومًا (ص 133).
وهنا يثور السّؤال: “ما هو مفهوم الوطن؟ كيف تضيق الأوطان بأبنائها وتصبح بحجم قبو وغرفة تعذيب؟! كيف تقتل أبناءها وتشرذم أرواحهم؟ إنّه الوطن الّذي بات وجع الإنسان، إنّه وقته الدّامي.
هكذا، لم يعد لهذا الزّمن من المديح نصيب!
لا يتقوقع الشّاعر في بوتقة الإنسان العربيّ، بل يعالج قضايا إنسانيّة عامّة، يهمّه الإنسان للإنسان، ولا قداسة عنده لشيء على حساب الإنسان. وفي قصائده هو وجوديٌّ بامتياز، فيها يبدع عالمه الإنسانيّ، ولا حقيقة خارج هذا العالم. تدور قصائده في فلك الحياة اليوميّة بتفاصيلها الصّغيرة. الحقيقة عنده موتيف بارز، وهي الضّالّة المنشودة، يبحث عنها كصوفيٍّ يمور موجوعًا في أزقّة الحياة، لكنّه يعي أنّ الحقيقة في هذا الزّمن الّذي لا يُمدح لا وقت لها، فهي “خجولة، وبحاجة إلى من يمسك بيدها”(ص 41).
ولمّا كان الشّاعر مسكونًا بالوقت منذ عتبة مؤلّفه الأولى، فقد جعل كلمة الوقت موتيفًا مركزيًّا يتكرّر في معظم القصائد، مرتبطًا بكلّ معاني الحياة والوجود. كيف لا والإنسان زمكانيٌّ مثلما ذكرنا آنفًا؟
الوقت عنده لا يكون مجرّدًا من شيء ولا عابرًا، وليس هو مجرّد عددٍ من أرقام السّنوات تمتلئ به خزانة أعمارنا، ونعدّها في أعياد ميلادنا، بل يُقاس بعمق إحساسه في الأشياء والمفاهيم، يقاس بإحساس وعيه بالوجع أو بنقيضه الفرح، بمعنى الحياة في نقيض الموت، بمعنى الموت في نقيض الحياة. الوقت يقاس بمدى ما يعيشه الإنسان من حرّيّة وكرامة، فماذا سيتبقّى من الإنسان أصلًا إذا فقد كرامته؟ ماذا سيتبقّى منه عندما يعيش كأشباه الأموات؟ ولمّا كان الوقت لا يعني لك شيئًا خارج حدود وعيك، فإنّ وعيك إذا كان سجينًا مقيّدًا سيكون وقتك ثقيلًا كئيبًا ميّتًا، وسيشبهك تمامًا، ستحمل سجنك داخلك..
وعندها لحظة ألم واحدة ستعادل قرنًا من زمان جامد حسب نسبيّة آينشتاين.
إنّ زمان الإنسان المسحوق المقموع سجنٌ، يسير متآمرًا مع المكان/الوطن عليه، ويصبح هو جلّاده الأوّل والعدوّ الأكبر، فبربّكم، هل له من المديح نصيب؟
إنّ الميتا شعر حاضر قويّ، وهو يتجلّى في قصائد كثيرة تعكس فلسفته في نظم الشّعر وعلاقته بالقصيدة. فلا يسعى أن يكون كأحد. لغته “لغة لم يدخلها أحد”، فبرأيه أن تشبه أحدًا وتستعير لغته وأفكاره معناه أن تكون فكرة مسبقة، محذّرًا من السّرقات الأدبيّة. يمقت القيود على الشّعر، بل يحبّ القصيدة في فوضى ثائرة على كلّ القيود الشّكليّة، يريدها متجدّدة، كأنّه مع كلّ قصيدة يعيش حالة عشق جديدة، ويكون خائنًا لو كرّر نفسه!
يبحث عن حرّيّة الذّات في تفرّدها. حرٌّ يبحث عن أناه، وفي اللّغة يجدها.
هي القصيدة مرآته، ذاتٌ من ذواته، يعيش فيها حرّيّته كلّما ضاق عليه مكانه؛ هي حياته، وبقلمه يرسمها.
إنّ الشّاعر، وعلى الرّغم من صليب الوقت الموجوع، تمّوزيّ متفائل؛ فهو مع كلّ قصيدة ينظمها يُبعث من جديد، فيحيا ويتجدّد.
ألم يقل في إحدى قصائده:
“لي موعدٌ يوميّ مع الحياة
أطير إليه بشغف كأنّني ولدت للتوّ
أو كأنّني راحلٌ غدَا” (61)؟!