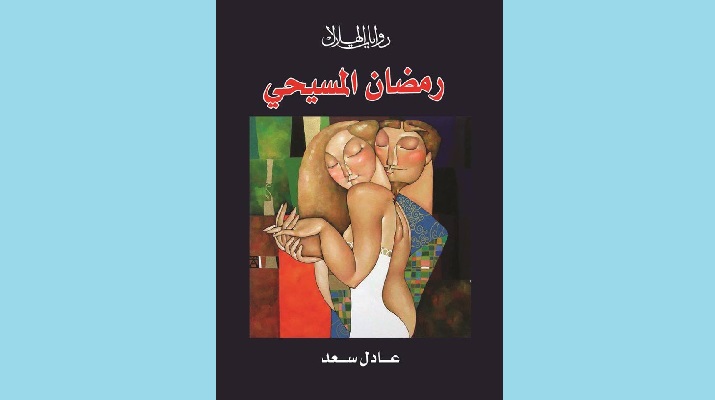شوقى عبد الحميد يحيي
رغم أن يونيو 67 ، كُتب عليه وعنه عشرات الأعمال، ورغم بعد الزمن عنها، وجريان الكثير والكثير من المياه فى نهر الحياة، فإن ظهور عمل حديث يتناول تلك الفترة، وتلك الكارثة (الإنسانية) قبل أن تكون غير ذلك، لمما يثير الانتباه، ويثير التساؤل عنما يمكن أن يكون جديدا فى ذلك الطرح. فإذا كان صاحب هذا الطرح، احد أبناء فترة ما بعد الواقعة، لمما يثير الدهشة، ويضخم من حجم السؤال، غير أن إدراكنا لنشأة هذا المبدع، والتى ترجع إلى مدينة بورسعيد، التى عانت -مثلما عانت كل مدن القناة- من جراء تلك الفعلة، فإن الدهشة، قد تخبو قليلا، غير أن التساؤل يظل يطارد القارئ عن الكيفية التى صاغ بها “حسين عبد الرحيم” عمله الروائى الأحدث “شقى وسعيد”[1]. لنجد أن عنصرين مهمين بنى عليهما عمله، ليتمشى مع كل تلك التساؤلات، ويجيب عليها، وهما السيرة الذاتية، وعامل الزمن، حيث يصبح الزمن أحد عناصر ووجود تلك السيرة، وبالذاكرة المُكوِنة لرواسب النفس وتحولاتها وتعقيداتها. وإن لم تف الرواية بما يفيد السيرة الشخصية، بما يكفى، إلا انها تنبنى على نقطة مركزية، هى يونيو 67، وإنعاكسات الزمن، والحالة علي اسرة كانت المرآة التى انعكس عليها الحدث. بل قد نقترب من الرؤية الأساسية، لنعترف أن شخصية وحيدة، هى السارد” الحسين” هى ما أصابها ذلك الصاروح النفسى الذى أصاب الشخصة المصرية، ليخرج “الحسين” من الحيز الأسرى الضيق إلى الرؤية المجتمعية الشاملة. فلم يكن ما عاناه الإنسان المصري، على المستوى الفردى، أو الجمعى، بأقل من خلق تلك الحالة التى سنرى عليها السارد، والذى يمكن أن يكون –على سبيل المثال لا الحصر- ما سرده السارد عن ام اللول، حين تسأل وقد جلست القرفصاء تسأل أم العصفورى عن منحة المهجرين فتجيبها:
ـ سيأتى مندوب الشئون الاجتماعية بعد أيام أو ساعات}ص28.
ليتكشف من صورة المرأة وهى تجلس (القرفصاء)، وما بها من بؤس وحيرة. وصورة الإجابة المنفتحة على المجهول من الزمن، فى انتظار الغيث، أو نبضة الحياة، لتنعكس صورة أولئك الذين تهدمت حياتهم بذلك التهجير العشوائى.
ولم يشأ الكاتب أن يعود بالزمن إلى تلك الفترة، بالتذكر للواقعة، وإنما عاد إليها بما انعكس على ناسها من قلق وتساؤل وتشتت، فنجد تفتت الجمل وتقطيعها، وغياب حروف العطف والربط فى الكثير من المواضع، كما نتوه مع السارد فى حصر إخوته الذين تتغير أسماؤهم، وتتزايد أعدادهم، بل نجد أن السارد نفسه، ليس فردا، بل خمسة أفراد يَنبُتن من داخله، نتوه معهم عندما يتحدث أحدهم، ونحن نظنه آخر، فيتغير الضمير المستخدم، ليعبر فى النهاية كل منهم عن زمن معين.، فتتجسد أشباح خمسة يشبهون السارد، وكأنه الفرد قد تفسخ لخمس، حتى رأينا السارد يتحدث عن الأيام الأولى من ميلاده، وكأنه يربط حياته بوقوع النكسة، وهو ما أشارت إليه الأم، ثم نرى السارد يتحدث عن الخمسة، وكأنهم أشباح لا يراها غيره، الأمر الذى يظنه الآخرون وكأنه فقد عقله – وهو ما خلق الحالة النفسية له. قال الأول {يا من ترافقنى كظلى.. فى هذى الشوارع، فى مدينة البحر والساحل، كانت لنا حياة، جمعتنا معا. أظنها حياتى وعيشنا}ص10. ثم يحدد الخمسة، وكأنها مراحل مختلفة فى عمر السارد، تجمعت فى اللحظة الآنية:
{يتقدمنى فى الخطو والمسير، طفل صغير، شاب فتى، يمشى وحده فى الظلام، بلا خوف، وآخر يرمى ببلوفر كشمير على كتفيه، يتطلع للفتيات قبل دخوله صالة العرض فى سينماعدن، آخر يكبرنى بعامين، يمسك بحقيبة من قماش الدبلان، ينظر إلى القطار، فى خرس دائم، وخامس لاتفارق البلطة قبضته ولا كفه، يبرق بعينين لامعتين، بلا هدف محدد، يتنقل بعينيه بين السماوات والأرض، يراقب العربات البيجو “أجرة بورسعيد}ص111.
ويصل التشتت، والتفتت للشخصية مداه، ف {يخرج من داخلى كائن ثالث، يرتدى بدلة زرقاء يضحك بصفاء… هل تذكر الأيام التى مضت .. ثلاثون عاما يا حسين .. واستطرد يضيف: أنا حسين المتولى، زميلك، الدفعة (سبعة وستين) فى كنج مريوط، الجيش، القطار، السرائن وهى تفارق المدينة العجوز.. تبدد جسده، تلاشى. بقى الصوت: أنا حسين المتولى. أقول لنفسى: من أنا إذن؟}ص129.
ويطير شخص آخر إلى الزمن الحاضر، وكأن أثر النكسة لم يزل قائما، لنتوه من جديد مع الزمن فى تنقلاته اللامرئية لنصل إلى الهجرة غير الشرعية {تمرق بخفة سيدة فى الثلاثين، تنادى أحد الأشخاص، تنظر إلى، تنظر إلىَّ أنا على وجه الدقة.. تقترب وتقول: انت قدرى ابن حسانين؟ اذهب لتبحث عن شقيقك الأصغر، فقد ترك البلاد، ركب اللنش وحده.. غاص فى ضباب البحر حتى تلاشى أثره}ص130. فنقرأ ذات السارد، وقد انشظر، وتشظى الزمن.
وبدون تمهيد، وكأننا نسير فى المتاهة لم نزل، نجد شخصا آخر- الصورة الأخرى من السارد- حيث يتحدث، وكأنه شخص آخر:
{أسير بمحازاته فى الظلام، أتوقف ما بين لحظة وأخرى، أدقق فى الهيئة والملامح، يتوقف فى ضجر، تحت عامود الإنارة تتأكد الملامح، بشعره الأشعث، هو الصبى والطفل، الشاب الذى تطوح وقت أن فرت العربة البيجو فى سرعة لترمى بالغبار فى الطريق. قلت إنه الحسين. خفت أن يعلو صوتى وأنا أتتبعه، خلسة خرجت من حارة سعيد بعد أن أمرنى حسانين بالبحث عن ولده}ص77.
ثم يعود الزمن للخلف، فنعيش حالة 67 من جديد:
{ عينان تلهثان فى دهشة وتوق، عاود الكرة وقد أبرز البلطة يخاطب كائنات لا وجود لها، اسمع صوت السرائن، أضواء حمراء وزرقاء وسرينة إسعاف. ولوحة معدنية فسفورية “1967”}ص87.
ثم يبلور السارد تلك الحالة، ويؤكد عملية الانفصال الذاتى فى { أسال نفسى فى خرس: هل عشت حقا ما مضى، أم أنها احلام وغاصت فى كوابيس زمن آخر عاشه غيرى. فى رحلة طويلة تتكرر تفاصيلها فى كل عقد؟ أظنها كانت حيوات أخرى لبشر يشبهوننى}ص9.
وكأنه الجرح الممتد عبر الزمن، فى تقلباته، والتى يمكن ان توحى بالدوار الذى أصاب المجتمع، المُعبِر عنه، بكل تشعباته وانبثاقاته، فيتوه القارئ بين أزمنة السارد، بما يتداخل فى ذهنه، من اختلاف مراحل السرد والسارد، وكأنه يعيش الحالة، لا مجرد أنه يقرأها. فما هى الحالة إذن؟.
أصل الحكاية
تبدأ الحكاية، حين يبدأها السارد ب {مكان مولدى: خروجنا من بورسعيد فى 5 يونيو. سمعت عم عابدين يقول: “الجنود كلهم راجعين حفاة}ص13.
وفى المهجر، تبدأ المآسى، حيث يكون التهجير فى مجمع المدارس بإحدى القرى:
{سكنا قريبا من دورة المياه العمومية، بعيدا عن المصرف المركزى، صار الفاصل بين كل أسرة وأخرى جدار من ورق الكرتون أو البطاطين الصوف الممزقة بثقوب صغيرة وأخرى كبيرة متسعة.. الفصل الدراسى الواحد يجمع عشرة أسر.. لكل اسرة رُكنة أو زاوية لنصب الأسرة}ص20.
ثم ليعتدى “سايح” على الأم “صديقة” فى الحمام العمومى.لتظهر أولى نتائج التهجير، وتكديس البشر {دقائق وكان الصراخ وجلبة النساء ، الصراخ يتعالى آتيا من ناحية الحمام العمومى،جرى عابدين ليجد أمى بشعر هائش، تتوسط النسوة فى المجمع وقد قبضت بيديها على عنق سايح، تبصق فى وجهه، تلعنه وترفع شبشبها وتهوى به على رأسه}ص22.
وتبلغ المآساة ذروتها عندما يبدأ الاختلاط والتداخل بين الأسر، وحيث فى عز عملية التهجير، يذيع التلفزيون فيلم “شئ من الخوف” وكأنها عملية إيحاء للرجوع لأصل المآىساة، والتى تتمثل فى الفردية، والجبروت، المجسمين فى شخصية “عتريس” بالفيلم، وإن سكت عنها الكاتب، وتركها لذاكرة القارئ، حيث بات ترسخ الفيلم فى الوجدان الجمعى، لتصبح الأم “صديقة” مثل فؤادة، ، ولتستمر عملية التطابق والتشابه.
{أمى تشبه فؤادة فى عنادها وقلبها الطيب السيال بعسل مصفى، ابى غائب وأنا اجتر ما حدث فى الظلام}ص24. ثم تتعدد الإشارات إلى عتريس (الرواية) فى أكثر من موضع، حيث تشير إلى سبب الخلل فى عقل “فهمى الجمال: {أرى شبحا لفهمى الجمال المخبول الذى يسكن بيننا فى حارة سعيد، أتساءل واعيا “لماذا يُشعل الحرائق فى كل ليلة فى بيته؟ فعلها كثيرا عندما حدثوه عن ناصر والسد العالى” أسمع أناته يصرخ فى هياج، يهوى فى شوارع طلخا، ويردد فى هوس: “ما زلت أسمع دوى الطلقات وأزيز الطائرات” .. وهو يهذى مواصلا البكاء فى صدر حسانين، يستحلفه بصدق، فى مخاتلات عابثة وصدق بين يقول لأبى: هارسم مركبى يا بو عبد الرحيم. وهسافر. يمكن حد يوصلنى لهناك، من غير حريق ولا نار}ص94. ليجسد فهمى الجمال تلك الأيام، بل الساعات الست التى استغرقتها عملية الضرب فى 1967.
وكذلك إذا نظرنا لممدوح الكواء، بصفته الرمزية، وعلى أنه المعتدى على الحبيبة “أم هاشم” ، فسنرى الربط بينه وبين الفأر الذى وضع السارد فيه بعض غله فى رحلة العودة من المهجر {لاحت قدم الكواء تتحرك، وقت صعود الروح فى شتات وصعود..هويت بالبلطة على ساقه من جديد، تنشطرت لخمسة قطع لحمية غير متساوية، فرت فى مؤخرة العربة.. وأنا أبصق على وجه الفأر المكوم على ظهره، قريبا من فردة حذائى المثقوب..}ص150.
صورة الأب
وهو ما يقودنا للخروج من الرؤية الفردية، إلى الرؤية الجمعية، وما أحدثه زلزال يونيو، حيث حَمَّلَ السارد الأب، بصفتة رمزا للسلطة (الأبوية التى تميز الحكم من 1952}، سنجد السارد صب عليه جام غضبه، بل وتحميله أسباب كل ما أصاب السارد من بلايا. حيث بدى الأب غائبا فى أحلك الأوقات، وحين ظهوره، كانت معاملاته مع السارد، من الأسباب الأساسية فىيما سنعرض له من أمراض نفسية. فنجده{بعد الفجر بنصف ساعة، كان أبى يدفعنى ببوز الحذاء الكرب اللميع فى رأسى: – قم .. انهض مع أخيك، عليكما بتوصيل البضاعة لفرشة السكة الجديدة}ص122. وهى الواقعة النى أصابت إصبع السارد، جراء عمليات التحميل. وهو ما طالب الطبيب المعالج له بالراحة بعد أن قال: {على فكرة ممكن صباعه يفضل على كده، وإلا سنبتر معظمه، وسيبقى بلا أظافر}ص116.- وهى الجملة التى تحمل من الدلالة ما يطير بنا إلى كُنهْ شخصية السارد {سيبقى بلا أظافر}- ولم يكن السارد فقط هو ما شعر بجبروت الأب، وإنما {سائق المركب يستعيذ بالله ويدعو لى: خير إن شاء الله بسيطة. يقول بغضب: هو عم حسانين مش عارف إنك وراك امتحانات ومدرسة؟}ص113. ثم يزفر “صلاح الوزة ويردد: { مفترى عم حسن؟}ص117. إلا ان كل تلك القسوة، وذلك الجبروت، لم يكن فقط ما أوجد تلك (العقدة) عند السارد، تلك العقدة التى بدأت بعد واقعة اعتداء “سايح”على الأم “صديقة”، والكاشفة عن تعلق السارد بها، والخوف عليها من تلك الظنون التى أصابته، والتى {تجلت الصديقة تغنى وهى تستحم فأسمع طرطشات الماء وتزيد خنقتى، أفكر فى أبى وغيابه المتكرر، غياب الصديقة منذ اليوم الأول لدخولنا الحارة}ص37. ثم استسلام الأم للأب الذى ترسب كرهه فى نفسه، وربط السارد ما بينهما، وما آل إليه حال “أم هاشم” الحبيبة {أمى تغنج، تصرخ، تتلوى تحت جسد أبى.. أم هاشم تهوى فى حارة سعيد مشتعلة}ص106.
الأزمة النفسية للسارد
وكذلك بينما نادته الأم ليرافق أخاه فى السهر بجوار أكوام الفاكهة عند السكة الجديدة (فرشة الأب وتجارته). نجد تلك المفارقة التى يمكن تأويلها للمقارنة بين معيشة (السلطة) ومعيشة أفراد الشعب:
{طلبتُ من قدرى أن أذهب لشراء الكاساتا، أعطانى قرشا وأعطانى عم عابدين قرشين فرح بهم شقيقى قدرى الذى قال: هات الساندويتشات بالمرة من الكتاتنى. مشيت جائعا، شبه نائم، شبه مخدر… وتتجلى رائحة الشواء فى الزحام وأنا أرتجف، أكوم كفى اليسرى تحت إبطى الأيمن، اضع القروش الثلاثة فى الجيب السحرى للسويتر الهلنكة الروسى، أقترب من محلات الفيومى المزدانة بالأنوار المبهرة، .. اتلفت قاصدا محل البطل الكبابجى، أنظر بعين ليلة، رأيت والدى حسانين والصدّيقة وقد جلسا فى ركن قصى بمطعم حاتى البطل، النادل يضع أمامهما أطباق الشواء لحم وريش وكبده فائحة، تفترش البقدونس فوق أطباق كبيرة…… أرقب ابى وأمى، أنظر الصديقة التى انتفخ فمها بشدقيها وهى تلوك اللحم.. تضحك وهى تنظر أبى الذى رفع طاسة الشوربة فلمع جبينه ينز بالعرق….. ذابت الكاساتا، هوى الحليب ورميت سندوتشات الطعمية…}ص 119 ، 120.
كما يصور السارد صورة كل من الأم –التى أحبها وتعلق بها- والأب – الذى كرهه- منعكستين فى مرآ ذاته، حيث يكتب فى ورق الإمتحان {اكتب فى سطورى الأخيرة: “الصديقة وكعبا قدميها قد تشققا وهى لم تزل عروسا، لم تكمل الثلاثين، بلا زفاف، بطرحة سوداء وشعر معقوص أسفل إيشارب لاميه… وابى يشعل الدانهيل فى الظلام فيتراءى لى شبح يلبس كرب لامع واصل لربع الساق، يتدلى جلبابه الصوف الجبردين والبالطو المهير، قطعة الأفيون فى مؤخرة فمه تحت الضرس}ص127 ،
وهنا نتبين أبعاد العقدة التى اطلق عليها سيحموند فرويد، بعقدة أوديب. والتى يمكن النظر إليها بإعتبار السارد “الحسين” على الصورة الفردية فى صحبة السارد (الطفل) ب”أم هاشم”، والتى يمكن النظر إليها –ايضا- بالصورة الجمعية، خاصة إذا تأملنا شخصية “أم هاشم” على الصورة الجمعية، لنتبين أنها تكبره فى العمر، وقد تعلق بها كثيرا، وكأنه يرى فيها الأم البديلة، وما يمكن أن نترجمها ب”الوطن”.
فحين يريا- الحسين وأم هاشم- المجذوب، تقول له {مسكين .. من بعد الحرب وهو على هذا الحال!. أقول: رأيته أمس يشعل الحرائق أمام بيته. صمتت وباغتتنى بالسؤال: – أين أبوك؟ .. اين أمك .. لم أرها منذ امس الأول؟}ص47. فإلى جانب الإشارة الجمعية {من بعد الحرب…}، فإن ظلال الصورة الفردية {أين أمك …}. وكان السارد قد لاحظ تعلق “أم هاشم” بممدوح الكواء، فأخبرته، بأنه قد طلب منها الزواج، ولما طالبته بالوفاء بوعده، تهرب، غير انه فى إحدى زياراتها لميضة الجامع، شعر وأدرك السارد بأنه يعتدى عليها، فوقف عاجزا دون أن يملك مقدرة الدفاع عنها- لنعود إلى تحذير الطبيب من جديد {سيبقى بلا أظافر}. الأمر الذى جعله يهذى ويفقد الشعور بالزمان أو المكان {لا أرى، لا أعى، عينى منتفخة وهى تحدق فى بلاهة وخرس وكتمان ولوم}ص74. وهو ما أدى إلى انتحار “أم هاشم” بعد ذلك {الصراخ يصل عنان السماء، يسد الآفاق، الجيران تصرخ وكنوز تصرخ وتلطم خديها وهى ترى أم هاشم. أشعلت النار فى جسدها الطويل، سكبت غاز الوابور فوق رأسها حتى فرغ ورمته بجانب الجاموس ليتحول الجسد الفارع لجزوع من لهب}ص75. {بكوها كل أطفال طلخا، حارة سعيد والجسر الواصل للمنصورة. ساعة ونصف، أنبح أنا، وخلفى الأطفال. وسط الظلام عندما أتى شقيقها أحمد الكسيح من سفره، رافعا عكازيه، فى عتمة شوارع طلخا وحارة سعيد، مشلوح الجلباب بعينين باكيتين يرميان بالدموع فوق جسد شقيقته}ص77. ولنتبين أن السارد ليس هو فقط منذوع الأظافر، بل إن أخاها – أيضا- (كسيح) وكأن “أم هاشم” قد عدمت من يدافع عنها أمام من انتهك شرفها.
وتسود الحياة فى وجه الطفل، فيبحث عن الأم – البديل- فلا يجد حضنها، ويبحث عن الأب(السلطة)، فلا يجده {كائن آخر غير من عرفت وعشقت وأحببت وارتحت وآمنت، لرائحتها تلك الونسة التى تظللنا وقت رقدتها، قعدتها بجانب أم حامد ننظر معا إلى القمر. افل القمر وقت الغروب، أم هاشم تتوارى داخل الدار وأنا الخائف المتردد ما بين الصعود لسريرى والارتماء فى حضن أمى. أسأل نفسى: أين أبى؟}ص74. وكأنه يبحث عن الملجأ، او من يظنه هو من يقدر.
صورة الأب
ويصبح موت “أم هاشم” الشخصى، والجمعى، نقطة تحول فى حياة السارد، على الجانبين , فتكثر أحلامه، لنستمر فى عملية التيه التى يدخلنا فيها الكاتب، حيث يتداخل الحلم فى الواقع. فيحمل البلطة، ويحلم بأنه يدمر كل البشر فى طريقه، ممدوح الكواء، والأب، وحتى الأم. ولم يكن ذلك بالطبع بعيدا عن الواقع، مثلما يقول الحكيم “بورداخ” : {إن حياة النهار بأعمالها ولذاتها، بسرائها وضرائها، لاتتكرر فى الحلم على الإطلاق، بل الأصدق أن الحلم إنما يهدف إلى تخليصنا من كل أولئك، ثم يأتينا الحلم بشئ مختلف النوع كل الاختلاف أو لا يلتقط من الواقع سوى عناصر متفرقة يدخلها فى تراكيبه أو يذهب إلى مجرد التلون بلون مزاجنا والإعراب عن الواقع إعرابا رمزيا..}[2]ص47.
إلا أن فرويد يوضح الصورة أكثر، ليدخلنا فى صميم شخصية السارد{ البحث السيكولوجى يرينا أن الحلم أول حلقة من سلسلة الظواهر النفسية الشاذة}[3]ص31. غير أن شخصية السارد، حين ننظر إليها بالصفة الجمعية، لانستطيع القول بشذوذها، وإنما هو حالة مرضية ناتجة بفعل الأحداث، سواء فى الأحلام، أو الخيالات التى تهاجمه، والأشخاص الذين لايراهم غيره. وهو ما يعترف به – السارد – نفسه فى: {أقلب الصفحة الأخيرة فى مادة التعبير، يتراقص ظل لغريب، يمر فى خفة كائن هلامى شفيف، يهمس فى أذنى: – قم .. تحدث مع هذا الكائن العصابى الذى يسكنك، حدثه، اسأل عن جدوى تكرار الحياة فى جسد إنسان واحد وحيد}ص127.
و {أسال نفسى: من أين تأتينى تلك الخيالات؟ .. من خارجى، من داخلى، أم هو تكوينى الجحيمى الذى يخصنى وحدى؟ وهل سيظل هكذا دوما، محركا لدوافعى وسلوكى وخطاى فى الحياة حتى آخر العمر والرحلة…}ص146. أى ان تلك الرغبة العدوانية، ليست إلا عملية تنفيس، أو رغبة فى الانتقام، حتى من أقرب الناس إليه الأم، والأبناء {أرفع البلطة بيمينى، اهجم على أمى محاولا رشق السلاح فى صدرها فتفرُ الدموع من عينى مالحة}ص95.
وفى الحلم، ما يشى بالاضراب، والرغبة الدفينة فى الانتقام {أصفع زوجتى وأرفع سلاحى اللامع متوعدا إياها بالقتل فتجرى مختفية فى غرفة النوم وخلفها أطفالى، الأطفال يصرخون، يستغيثون، والبلطة بيدى وقد هوت على رقبة الصغير}ص95.
وتستمر الأحلام، لتُخرج مكنون النفس، وينوب الحلم عن اليقظة فى تحقيق ما يتمناه، فيرى الأب {أرى أبى فى زمن ما غير معلوم، ظهر ساخرا يضحك، يضع اللى فى فمه، يسحب أنفاس الجوزة النحاس، يتحرك وسط الدخان الأزرق.. سار أمامى، بنصف جسد، وأنا ألقم بقايا سيجارة تركها العم عابدين، أتحسسها وقد ظهرت رأس النار، اضعها فى فمى}ص137. ولتصبح السيجارة بجمرتها، هى أعماقه التى يريد أن يُشعل الأب بها.
وتستمر حالة الغضب الباحث عن التنفيس حين يطالبه الأب بجمع البضاعة للفرشة، حيث يتبدى مدى كره الأب، ومدى الغيرة على الأم، كيفية اشتعال الرغبة فى الانتقام :
{أردت أن أدكه بالبلطة، شياطينى الحمراء تراودنى عن نفسى، يتكاثف غضبى، أفكر فى قتله، تهشيم رأسه، أهشم رأس حسانين، أبى، أدكهم جميعا، أمى الممددة فى فراش مخملى بلون سماوى، ممدوح الكواء، ضغطت رأسى بشدة، تعتصرنى آلام كادت أن تصهر روحى .. يظهرون أمامى فجأة.. خمسة .. ستة .. كم عددهم بداخلى}ص111.
صورة العم “حسانين
ومن الأمور التى قد تؤكد التركيز على كره الأب، أو بمعنى أدق، الغيرة منه، ما أكده السارد عن صديق الأب وهو العم “عابدين” والذى كانت كل الإشارات إليه إيجابية، على العكس من الإشارات للأب، وربما لم يكن العم عابدين ينحو نحو الصفة الشخصية- كشخصية روائية- بقدر كونه شخصية رمزية(جمعية)، خاصة عندما يرتبط ذكر العم، بإذاعة الراديو لخطاب السادات عن الحرب.. والسلام، وكأنها إشارة ، أو تمهيد للعودة من المهجر{الراديو يذيع خطاب السادات عن الحرب والسلام والعودة للمهجرين من مدن القناة}ص131.
وفى ذات الفصل أيضا :{عم عابدين يقف فى منتصف الطريق يقول: لن أنسى ماحدث، تمسك بالأمل يا حسين كن فرحا، غدا ستعود لبلدك.. بورسعيد.. مكان الميلاد.. احتضننى، دمعت عيناه، ظهرت قطرة الدمع تنزلق لفمه تحت إشارة المرور}ص135. وكأن إشارة المرور هنا هى إشارة التغيير وتحديد الطريق.
ثم يبدى “عابدين” التعاطف مع السارد، فى الوقت الذى تجاهله فيه كل من الأب، بل والأم فبعد أن طلب الطبيب له بالراحة عشرة أيام، بالعمليات، وليس بالعيادة الخارجية { يومان وفى اليوم الثالث نادتنى الصديقة، لم أرد، كررت النداء: اذهب للسكة الجديدة لترافق شقيقك فى السهر على حراسة الفاكهة حتى عودة أبيك … فيقول العم عابدين لأمى: حرام عليكم، الولد فى احتياج إلى الراحة حتى يتفرغ لامتحاناته}ص118.
و كذلك فى رحلة العودة، وقد كان هو المصاحب للسارد والوالدة، وفى غياب الأب أيضا، وهو ما قد يؤكد تلك الرؤية الجمعية {أغلقوا الضلف من الخارج وأتى عابدين بسندويتشات كباب وكفتة من البطل، وضعها فى شنطة بلاستيكية، قال قبل أن يغلق باب النقل: كُلْ براحتك، سيعجبك الطعم كثيرا}ص145.ثم تبرز المقارنة بين الأب والعم عابدين، وكأنها إشارة أيضا للمقارنة بين بطل الكارثة، وبطل العودة{ العربة مظلمة، تفوح رائحة الطعام، ورغم جوعى غير متحمس للاقتراب من اللفافة التى ذكرتنى بجلسة والدىَّ}ص146.
العنوان
حينما يصبح الحزن الشفيف، هو محور التجربة الحياتية بتغيراتها التاريخية والجغرافية، والاجتماعية والسياسية والنفسية، أى أن تكون تجربة الحياة، هى المحور، فلابد أنها تحمل الكثير فى طياتها، من الكثير من التناقضات، والمقابلات، وتشتت الدلالة، وسط متاهة العنوان، فيصبح (الحزن الشفيف) هو الأرجح على كفتى الميزان. وهو ما يمكن أن نطبقه على رواية “شقى وسعيد” بما يحمله هذا العنوان من مقابلة، واستخدام للبداية والمنتهى، ولا نعدم أن نجد امتداداته، وانبثاقاته، خلال نسيج العمل، حيث تبرز المقابلة، بين الظاهر والباطن، أو بين العنوان أو الشعار والواقع، وهى الحالة المسيطرة على حياة المجتمع فى الفترة التى تتناولها الرواية، لتغوص بها إلى بُعدٍ سحيق فى جذوره الثقافية. فنجد على سبيل المثال: {استقر بنا الحال فى طلخا.. قرب مسجد البازات كان السكن، ليصبح العنوان: 18 حارة سعيد)ص33. { أقول فى نفسى، اى سعيد هذا وقد غاب أبى سنوات فلم أره لتأتى أمى بعد غياب وتقابلنى بالصفعات أمام أجمل من رأت عينى؟)ص36. وكذلك، حين سمع السارد {الشيخ محمد رفعت يكمل التلاوة: “والتين والزيتون وطور سنين وهذا البد ؟؟”- أى بلد … أقولها فى نفسى }ص37. ولتصبح تلك المقابلة أحد شفرات النص، التى تقود لكشف اسراره، والبحث عن مخبوئه، من بين ركامات النفس الباحثة عن بصيص السعادة، وسط كثيف الشقاء.
فإذا كانت الرواية قد بدأت بالإعلان الجنائزى {ماتت أمى .. ماتت الصديقة}، ولتنتهى بالمشهد الجنائزى لغُسل الأم وتشييعها، فإن ذلك –إلى جانب تكنيز الزمن ، رغم الإحساس بامتداده وتشعبه، وتداخله، وحصره، للدلالة على أنه رغم قصر زمن الفاجعة، فإن تأثيرها امتد لما بعده. هذا من جانب، ومن جانب آخر تعد الرواية مرثية للأم التى أحبها الكاتب، وعبر عنها السارد – فى الرؤية الشخصية، فإنها مرثية لمجتمع، عاش تجربة مريرة، ولازال يعيش مراراتها، تلك العلاقة الملتبسة بين السارد والأم “الصديقة”. فإذا كان الاسم يوحى بالتقديس، إضافة إلى كل تلك الأوصاف التى تُصورها فى أبهى صورة، فإنها تنتهى بما يعكس ذلك، حين يتحدث عنها:
{اشتم رائحتها الجميلة، أريج عطر أنفاسها وهى تلقمنى صدرها فأستعيد نشوة سرسوب اللبن الساقط فى فم الطفل النونو وهى تقبل أناملى وتلعق أصابعى وتغنى لى” جاب لك إيه يا صبية عبد الناصر لما مات، جاب لى فسل من المنوفية اسمه أنور السادات”. اضحك، أبكى، أناديها فى صمت فلا تنظرنى، منذ ساعات، منذ ليال، منذ شهور، منذ سنوات. راسى تدور، أردد فى نفسى: أكره الصديقة”}ص26. حيث تكشف السطور عن أكثر من شئ: أولا أن الأم يمكن أن تمثل الفترة التى عاشها السارد “نكسة يونيو” وهو ما يكشف تلك الرؤية المبطنة فى (هدية) ناصر، تلك الفترة التى كرهها السارد {أكره أمى}. وثانيا: ذلك التناقض المباشر فى {أضحك ، أبكى}، إلى جانب التناقض بين وصف الأم بصور الجمال، مع تلك المقولة التى قالتها، وانحفرت فى أعماقه منذ أن كان طفلا، وحين أوشك على الموت غرقا فى اللنش الذى حملهم فى رحلة التهجير ، حيث راحت تردد {فقرى منذ ميلادك، جئت بالحرب وللحرب جئت، للشقا، بك عدنا يا فقرى يا وجه الفقر}ص11. الأمر الذى يعنى أن السارد يعيش مع الأم ، مترددا بين الساخن والبارد، بين الحب والكره، بين الظاهر (الكره) والباطن (الحب)، حتى وإن تحول ذلك الحب إلى الحاجة، والارتباط، والحبل السرى الذى يربط بين الإبن وأمه، بين المواطن والوطن. وكأننا نعيش مع ريهام عبد الحكيم، حين تردد كلمات الشاعر نور عبد الله:
( عارفة سواد العسل
أهو ده اللي حالك ليه وصل
إزاي قولي لي مكملة وكل ده فيكي حصل
يا بلد معاندة نفسها
يا كل حاجة وعكسها
إزاي وأنا صبري انتهى لسه بشوف فيكي أمل) تلك الكلمات التى تعبر بصدق عن الحالة التى أرادها الكاتب بعنوانه الحامل للمقابلة، ولا نقول التناقض(شقى وسعيد).
كما أن ثمة ملاحظة لافتة، تعمدها الكاتب –فيما نتوقع – فى اختيار الأسماء، يمكن النظر إليها كمرشد آخر لقراءة الرواية، فضلا عن قراءة العنوان.
فإذا ما تأملنا اسماء الشخوص الرئيسية فى العمل، فسنجد: “الأم: “الصديقة”. والحبيبة: “أم هاشم”، والعم أو صديق الأب: “عابدين”، بما تعنيه من العبادة. فضلا عن السارد: “الحسين” – بالاصرار على وضع الألف واللام-. ف”الصديقة” تعيد للأذهان كتاب العقاد “الصِديقة بنت الصِديق”، وأم هاشم ” تورد مباشرة للأذهان السيدة زينب، والسارد “الحسين” بينما الشائع هو (حسين). بما يفيد القصدية. وهو ما يعنى أنها جميعا تشير إلى رموز دينية، كما قد يسوقنا إلى تلك الرؤية، الاقتباس الذى استعاره السارد، حين سمع {الشيخ محمد رفعت يكمل التلاوة: “والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد ؟؟”- أى بلد … أقولها فى نفسى }ص37. وحيث الدين، فى الوجدان الشعبى، هو الفطرة والطبيعة والسماحة، بينما خرج الأب “حسانين” عن السياق، فينطبع الإسم فى الوجدان بصورة الرجل من صعيد مصر بكل الرؤية الكائنة فى الوجدان المصرى للإنسان الصعيدى، وفى استعادة للإعلان المطبوع فى الوجدان، أيضا (حسانين ومحمدين) لَمِنَ الأمور التى ترجح أنهما كفتان متقابلتان. يمكن أن نضع على كل من الكفتين ما نتصور أنهما متماثلا، فنضع على كفة الأب، وعلى الأخرى العم عابدين، ليصبحا طرفى العنوان، ولينحصر السارد بينهما(شقى وسعيد).
ولتضفى مزيدا من مخاطبة الوجدان، فضلا عن اتفاق ذلك الشعور المترسب فى الوجدان، مع ما تسعى إليه الرواية من ذكريات نفسية شجية. لينضاف كل ذلك إلى نجاح العمل فى مخاطبة الوجدان الجمعى، خاصة أنها قد لا تحتوى على الكثير من الأحداث، بقدر ما حفلت بالمشاعر والوجدان.
غير أن رؤية أخرى للعنوان، تتمثل فى رؤية الأب –أو السلطة- بما لعبته من دور جوهري فى حياة السارد “الحسين”. الأمر الذى نرى معه انبثاق العنوان من تلك العلاقة مع الأب “الحسانين” ، فالأب هو مصدر الشقاء فى حياته. وقد قدمها الكاتب على السعادة، لأنها الصفة الأغلب، إن لم تكن صلب الرواية، أما لماذ أضاف إليها السعادة، فهى العودة من المهجر، وحيث أن التهجير كان سابقا، فكانت الرواية (شقى وسعيد). وهو ما يعنى، انفتاح الرواية على العديد من التأويلات، الأمر الذى يوسع من فضائها الزمنى – رغم قصره- والفضاء المكانى – رغم محدوديته- استطاع حسين عبد الرحيم أن يخلطهما فى نسيج متداخل، أحاطه بالكثير من التمويه والخطوط المتداخلة، والمتماهية، ليعيش القارئ فى النهاية، تلك الحالة التى استمرت ما يقرب من السنوات السبع، فى الحكاية، مصنوعة فى بضع ساعات، فى الرواية، لتعيش فى الوجدان، بضع عقود من الزمان.
………………………………………
[1] – حسين عبد الرحيم – شقى وسعيد – خطوط وظلال للنشر والتوزيع – الأردن – ط1 2021.
[2] – سيجموند فرويد – تفسير الأحلام – ترجمة مصطفى صفوان – دار المعارف- 1994
[3] – المرجع السابق