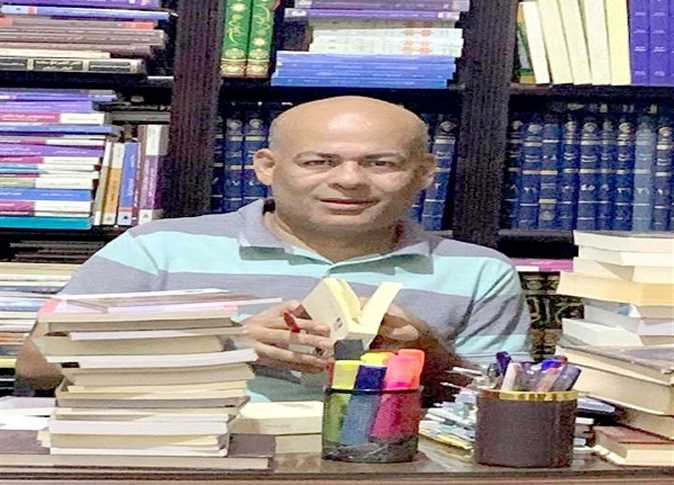محمود عزت
تتبعته بعد العزاء إلى سيارته الموازية للرصيف بالقرب من مسجد عمر مكرم، محافظا على مسافة كافية كي لا يفطن إلى وجودي قبل اللحظة المناسبة التي أقرر فيها مواصلة ما نويته أم لا.
رجل نحيل ببطن بارزة ورأس أصلع يخفيه بكاب أسود لا يناسب البدلة السوداء التي تزيد عن مقاسه درجة أو اثنتين، يسير وحيدًا إلى «هيونداي» أكسنت زيتية بخطوات هادئة، لم أميّز في أدائه أو صفاء وجهه ما يشي أنه حزين أو مفطور القلب، لكن كل شيء فيه كان حزينا بطريقة ما، بدءا من حذائه الذي أخمن أنه حذائه المفضل على مدار العشر سنوات الأخيرة، لامعاً في بؤس وحنين لأناقة زائلة، وملامحه المنحوتة في وجهه الأسمر وذقنه الحليقة تحت خد خشن.
تشجعت وناديته قبل أن يركب، فتوقف فاتحًا بابها ملتفتًا إليّ. ضيّق عينيه حين سلّمت عليه: «إزيك يا وحيد»، كأننا نعرف بعضنا البعض، وقف لحظة يتفحصني وهو يقلّب في ذهنه كل الاحتمالات التي قد تدفع شابا مثلي لمناداته بهذه الألفة ودون تكليف.
قدّمتُ له نفسي، طالب طب في سنة الامتياز الأخيرة في كلية طب قصر العيني، معجب قديم بغندور، وكنت في عزائه للتوّ، ومعجب به هو أيضًا عازف الكيبورد الذي لم يفارق المسرح وراء غندور منذ انضمامه إلى فرقته، إلا سنوات قليلة لخلاف بسيط بينهما عاد بعدها مُحتَفيًا به. ابتسم لي وافترت شفتاه عن أسنان صفراء منتظمة، قلت له أني أردت أن أسلم عليه في القاعة ولكن منعني الزحام، ربّت على كتفي بامتنان، «حبيبي يا دكتور».
دعاني ليوصلني بسيارته إلى قصر العيني، فسألته عن وجهته، أجاب أنه عائد إلى البيت، فدعوته أن نشرب شيئا في أي مقهى قريب، وافق ببساطة.
توفى غندور بأزمة قلبية في السادسة والخمسين منذ أيام ومرت جنازته في هدوء. لكن عزاءه كان مزدحمًا بمحبيه وزملاء المهنة من الآلاتية والمطربين المغمورين وبعض المشاهير الذين يتذكرون مجده الذاهب في التسعينيات وبعض أفضاله عليهم.
كنتُ أعرف «وحيد» بالطبع، كما يعرفه كل معجبي غندور، من الصور التي يظهر فيها دائما وراءه مباشرة واقفا على الأورج، عازفه الأثير الذي رافقه في مرحلة تألقه الأخيرة قبل الأفول والانقطاع المفاجئ في بداية الألفية، الرجل الهادئ على الكيبورد ثابت الوجه مهما تبدّل الإيقاع بين صاخب أو حزايني، يقوم بمهمته بأصابعه النحيلة كجرّاح، بأقل قدر ممكن من التأثّر أو الانفعال.
نجم الكيبورد كان مسترخيًا، يتنفس بشكل طبيعي وينظر حوله بفضول إلى المارة، سألته إن كان قابل غندور قبل وفاته، فأجاب أنه كان معه منذ أربعة أيام، زاره في بيته، وشربا معًا الشاي، يعمل وحيد الآن في وظيفته الحكومية الأولى التي علّقها بإجازة بدون مرتب على مدار سنوات طويلة ليطير وراء غندور من بلد عربي إلى آخر كل أسبوع، ويعزف خلفه من حفل إلى آخر في عز شهرة غندور ولمعان أسطورته.
كان ذلك ابتداءً من 92 إلى نهاية الألفية، السنوات الثمانية التي صنعت لغندور اسمه، قبلها كان موهبة صاعدة، وخلالهم لم يكن يوازي صيته أحد في لونه أو غيره، أما بعدهم فبدأ يتراجع تدريجيًا إلى أن اختفى فجأة عن الظهور وانقطعت أخباره وانزوى ذكره إلى سياق الترحّم على أيام الغناء الشعبي الطربي، كمصمصة شفاه متغضّنة على موجة الفيديو الكليب الجارفة ثم موجات المهرجانات التي سحبت إلى مركزها الدوّار الغناء الشعبي برمته، وتلاها حاليًا الراب أو التِ-راب.
فضولي تجاه غندور دفعني مرة أن أسير إلى بيته هاربًا من مناوبة ليلية مملة في أحد أقسام الجراحة، وصلت إلى البناية الكبيرة التي تحتل شقته فيها الطابق السادس كاملًا، والتي رأيت لها صورًا عديدة من الداخل على الإنترنت، أكثرها للصالة الوسيعة ذات الكنب المنجّد بلون أحمر ووسائد كبيرة خضراء على الأرض، حيث كان يظهر دائمًا جالسًا بجلباب أبيض مريح مع ضيوفه ومحبيه مستندًا إلى وركه باسترخاء، بسلسلة ذهبية فوق شعر صدره الكثيف البادي من بين أزرار الجلباب المفتوحة، تحيط السلسلة بعنقه الأسمر العريض الملفوف كجذع شجرة، صاعدًا إلى وجه وسيم بملامح شرسة وإن كانت منعّمة، فوقها شعر كبير تم تنعيمه بالسشوار بعناية، عيون عسلية وشفاه حادة نحيلة كأنه شقّت في وجهه بموس وانطباع دائم على ملامحه كأنه يكزّ على أسنانه وراء شفتيه المطبقتين في تحمّل، لكنه كان ودودًا بشكل عام ويظهر وهو يعامل كل من حوله في المقاطع المصوّرة في بيته بترحاب وأريحية، يرفع كفه إلى رأسه وينهض حين يدخل أحدهم ويبتسم بمكر إلى عازفيه من حين لآخر كأن بينه وبينهم سرًا لا يعلمه الحاضرون.
يومها وقفت تحت البناية أنظر إلى بيته مستندًا إلى سيارة في الشارع، السماعات في أذني استمع إلى أغنيتي المفضلة «أنا اللي جنّيت الجنّ..» وأنا أصوب بصري إلى نافذة مضاءة في الطابق السادس، قررت أنها غرفته، وأنها نفسها بشكل ما الصالة الوسيعة، وأنه يجلس الآن هناك وحده في صدر الصالة الخاوية بنفس هيئته القديمة لم يمرّ عليه الزمن، يغني فيتدفق صوته إلى أذني عبر السماعات وهو يغني: أنا اللي جنّيت الجنّ.. خليته يلعب ويئن.
سألتُ وحيد إن كان لقاءه الأخير مع غندور كان في الصالة، فلم يفهم، فكرت أنني ولا مرة رأيت وحيد في صور الصالة، وربما كانت كلها أُخِذَت قبل التحاقه بالفرقة، أغلب ظهورات وَحيد في الصور والفيديو كانت على المسرح، فتحركت بالحديث إلى المرحلة التي أثق بوجوده فيها، وسألته عن آخر حفلة أحيوها معًا. ابتسم وحيد وقال: حفلة الجنّ؟
فضحكت، ذاعت عن غندور شائعة قديمة، عن أنه أحيا حفلة كبيرة صاخبة للجنّ. شائعة تتناسب مع شهرته التي لم يصل إليها في الشعبي سوى أحمد عدوية فأراد ـ أو ربما أراد محبوه ـ أن يتجاوز صيته الطبيعي والمعتاد إلى إمتاع غندور لكائنات أخرى غير البشر، أعقد تركيبًا وأقدم وجودًا في الكون، بصوته العميق القوي ذي الرنّة الجزلة.
اعتدل وحيد ووضع ساقًا على ساق، وبدا أنه يريد أن يحكي شيئًا ما بعينه لا ما سألته عنه، بدأه بالحديث عن سنوات غندور الأخيرة، في مطلع الألفية وما تلاها، حين رفض عروضًا كبيرة للظهور في إعلانات شبكات المحمول، كلمه وقتها عمرو دياب ـ يحكي وحيد ـ ليظهر معه في إعلان للشبكة الكبرى وقتها، لم يمانع غندور ولكن حين عرضوا عليه تصوّر الإعلان وفكرته قال لعمرو مبتسمًا في مرارة: عايزني أخدّم عليك يا عمّورة؟
كما يصف وحيد كانت فكرة الإعلان أن يغني عمرو دياب كوبليهات متتالية بينها يدخل غندور بتنويعات صوتية وترديدات بسيطة، حاول عمرو أن يبيعها له أن العصر القادم هو عصر «الفيتشر» الذي يشارك فيه أكثر من مغني من ألوان متباينة في التراك الواحد، ولكن غندور ظل ينظر له متعجّبًا مبتسمًا ثم رفض.
شركة الإعلانات وقتها أصرّت أنها ربما تتمكن من إقناع غندور، رتبوا له جلسة مع المخرج وفريق الإعلان، أدرك غندور فجأة أن المخرج لم يسمع له أي أغانٍ، ليس أنها لم تمر عليه مثلًا، إذ كانت أشهر من ألّا يعرف تعابيرها ولزماتها الجميع، ولكنه لم يسمعها قاصدًا، لم يجلس ليستمع إليها ويتمزّج، لاحظ وحيد ذلك وقتها وتوتر لأنه كان يعرف غندور جيّدا فيما يتعلق بتقديره لفنّه وأغانيه، صمت غندور تمامًا والمخرج يشرح له ويريه على اللابتوب فيديوهات تشبه لما يريد أن يقوم به، إلى أن تخطى المخرج حدوده حين طلب مبتسمًا أن يسمح له غندور بتغيير كلمة واحدة في أغنيته «عِند الِملاح» لتناسب الأغنية العبارة التسويقية الشهيرة للشركة، إفيه يعني، بدلا من «اعْنِد لكن ما تنسى.. وخليك على الوصال» يريد منه أن يغني «خليك على اتصال».
غندور كبت غضبه للحظة وقال: لا..كده قيمة الأغنية تروح.
فرد عليه المخرج بثقة وثبات وهو ينظر في عيني غندور كأنه يريد أن يُخضِعه: لا كده قيمتها تزيد..عندي وعند جيلي
ـ «طب ما كسمك.. على كسم جيلك.. »
ثم نهض غندور، فنهضتُ ـ يقول وحيد ـ أحوش عن المخرج، الذي لم يصدق حجم الإهانات التي كالها له غندور، يلا يا ابن الكلب يا عرص، عايزني أطلع فاسوخة يا بن الوسخة. وحيد اصطحب المخرج إلى الباب، وهو شاب قصير مؤدب بعيون لئيمة حائز على جوائز عالمية في إخراج الإعلانات، اعتذر له وحيد وبرر ما حدث بمزاج غندور السيء مؤخرًا.. وبعد ساعات اتصل غندور نفسه بالمخرج واعتذر له أنه ليس هناك أي مبرر بالطبع لأن يهينه في بيته، لكنه أكّد له مرة أخرى في نهاية المكالمة مازحًا ـ ضحك وحيدـ أن هذا لا ينفي أنه كسمه على كسم جيله. أتذكر ذلك في كل مرة أرى فيها لقاء مع المخرج العالمي يضع ساقًا على ساق ويتحدث عن ذاته وإبداعه.
الحقيقة أن غندور كان حامي المزاج، يتحكم في أعصابه بمجهود، ولا أدلّ على ذلك من الفيديو الشهير الذي استفزه فيه الجمهور في إحدى حفلات الساحل الشمالي، فتمالك غندور نفسه لفترة طويلة، ثم انتهى الأمر به يخلع قميصه المشجر وينظر لشاب منهم وسط أصحابه ويقول له ـ أو ذلك ما يترجمه المشاهدون على يوتيوب من الصوت البعيد وقراءة شفاه غندورـ لو أمك جايباك حلال ماتجريش.. ووثب إليه عاري الصدر.
ربما كان غندور يعرف أن زمنه يذوي، ولونه ينطفئ، وأن ظهوره في الإعلان كان فقط ليكسبوا أرضية شعبية في الحارات والقرى والمراكز الريفية التي لا يزال غندور فيها مؤلّهًا بشكل ما. لكنه فضّل ألا ينساق وراء «التجديد». قالها وحيد هذه المرة بسخرية.
يذكر العازف النحيل أن الكل حوله حينها طلبوا من غندور أن «يجدّد»، حتى وحيد نفسه، قال له في جلسة صفا: وماله يا فنان لما تركب الجديد زي ما ركبت القديم، ولكن غندور كان يستعجب، يجدد ماذا؟، كان يوقف محدثه في أي نقطة من هذا الحديث ثم يقول له اسمع، ويغني دون تردد أو سكتات، فيخرج صوته رائقًا وعريضًا، يغني فيطلع الصوت من أعماقه في تناسق وتشكيل، كشجرة حديثة النمو تخرج من الطين بكل ما يلزمه وجودها النهائي من تشابك وزخارف، إلى أن ينتهي ويسألهم هل هذا غناء بائت؟ بضاعة قديمة؟
كان يغني الموال الشعبي والحزين والطربي والموشحات، غير أغانيه الخفيفة الغنية عن الذكر.
ثم كان أن عرضوا عليه أن يصوّر فيديو كليب، كان واثقا من طلّته على المسرح، وهل هناك أحد كان يقدم عرضًا حيّا مثل غندور؟ الذي كان يوقف الفرقة في وسط الأغنية، في وسط الكوبليه، ويحكي لجمهوره حكاية ما ينفجر بعدها ضاحكًا وترج قهقهات الجمهور المكان كله.. ثم يعود للغناء مبتسمًا كأنه لم يتوقف لحظة..
لكنهم أجلسوه مع مخرج يحاول أن يقنعه أن عليه أن يغني بينما تتراقص حوله شراميط. يضحك وحيد وهو يقسم أن إحدى الموديلز ميّزها غندور حين ذهب للتصوير وأقسم لوحيد أنها فعلياً بائعة هوى محترفة. ضحكتُ.
يستدرك وحيد بجديّة، غندور لم يكن متزمتًا، لكنه طلب أن يأتوا له براقصات وعوالم من التي عملن معه ويثق فيهن، من التي ترقص مع الأغنية، لا تتشرمط عليها دون وعي، وبالطبع قوبل طلبه بالرفض، وخلال التصوير توقف غندور عن الغناء فجأة، طلب أن يذهب إلى حجرته للحظة، ومنها إلى سيارته وفرّ هاربًا من الفيلا التي كانوا يصوّرون فيها ولم يعد ثانية، كان هذا سبب القطيعة بين وبين منتجه الذي زاره ليلتها في البيت وجلس على ركبته يستحلفه بحياة بنتيه، عزة ونرجس، أن يصوّر الفيديو كليب، بكى المنتج وأخبره أنه يخسر ملايين أمام المنتجين أولاد الكلب محترفي الفيديو كليب الذين أكلوا السوق ويقدمون كل يوم أغنية تعيد إذاعتها قنوات الأغاني دون توقف ويتسمّر أمامها الجمهور على المقاهي وفي الكافيهات. لكن غندور حين تأتي سيرة الجمهور يتوتر واستحلف ساعتها المنتج بحدة وانفعال أمام وحيد أن ينزلا معًا الآن وأنه سيقف ليغني في وسط الشارع ويلم حوله الخلق، ليرى بعينه ماذا يحب الجمهور.
كل ذلك كان يُشعر غندور بالإهانة، كان يؤذيه أن يشعر أن العربة التي طالما وقف فوقها ثابتًا وسط الناس ليغني مرتاحًا ومغمضًا، تندفع الآن بدونه وتبتعد أمامه ويحاول الجميع أن يقنعوه أن يجري ليلحق بها، ولكن كلامهم كانت تؤكده الأرقام، تراجع الطلب عليه في الأفراح أمام آخرين أقل موهبة وجمالًا، أو يحدث أن يطلب أصحاب الفرح معه مغنين جدد «مش قد المقام»، عيال صفرا قليلة الذوق، كانوا يبتسمون لغندور بتشفٍ أن الروس تساوت ويغنون قبله أو حتى بعده في نفس الفرح.
المهم، يعود وحيد للموضوع، لم يرضخ غندور للفيديو كليب، ولا الريمكس، ولا أن يشاركه أغانيه الجديدة شاب جديد رائج لـ «يصحصح» أغانيه، ولا أن يتحول لفاسوخة أو «نمرة» في حفلات الساحل الشمالي، كان ينظر إلى بروجرام الحفلات ويبتسم في حسرة حين يدرك أنه فقرته في الحفل هي فقرة «الحنين». توقف غندور تمامًا عن قبول أي عروض أو أفراح أو حفلات.
قرر أن يحرمهم منه، على حد تعبير غندور نفسه كما يقول وحيد، ومن روقانه. طيب ماذا نفعل نحن فرقته الذين ليس لدينا أي مصدر دخل آخر؟ نعزف وراء غيره؟ ترك لنا حرية الاختيار، أنا بقيت معه وجواره، بدأت في إجراءات العودة إلى وظيفتي الحكومية دون علمه، وجلس غندور في البيت لمدة تقارب على السنة دون ليلة غناء واحدة، كأنه قرر أن يعند أمام الجميع: الزمن والجمهور والغناء نفسه. تخيّل رجلًا هكذا لا يغني، أعتقد أنه كان يتألم يوميًا دون أن يُظهر ذلك لأي أحد، ومع ذلك يسهر فاتحًا بيته للجميع والذين تناقصوا بمرور الوقت ولم يبق حوله إلا أحبابه وأصفائه. يقول وحيد وهو يهز رأسه شافطًا من الشاي.
ثم يتذكر وحيد أنه مرّ على غندور بعد مشوار من مشاوير إنهاء إجازته الحكومية الطويلة، ووجد عند غندور مدير أعماله، الشاب عمرو، يجلس واجمًا وينظر في الأرض، وغندور متكئًا على وسادة مطرّزة يدخن في صمت، وبدا أن الجو ملبّد بينهم، وفور أن جلس وحيد، اعتدل عمرو إليه، وكان شاباً طيبًا وأصيلًا يستمد دافعه الأول من العمل لدى غندور من انبهاره بفنّه أكثر من العائد المادي الذي بات يقل بشكل مطّرد، اعتدل عمرو يشهده على ما يفعله النجم، برفضه إحياء حفل زفاف كبير في الفيرمونت، طلبوه بالاسم، لكن غندور يأنف أن يوافق لمجرد أنه وجد في بروجرام الفرح أسامي أخرى لا تعجبه، نظر لغندور الذي كان يتأمل وحيد مبتسمًا، وكانا يفهمان بعض بالنظرة، ولم يقل له سوى: عايزيني في فقرة الحنين يا وحيد.
ثم أتت الخادمة لتخبر غندور أن على الباب رجل يريد لقاءه، أشار لها الغندور أن تدخله، جلس الضيف وكان يرتدي جلبابا ريفيًا نظيفًا وبملامح صعيدية بسيطة، وطلب من غندور أن يحيي فرح أخيه في سوهاج في وجه قبلي. غندور استقبله بأريحية وطلب له شايًا وغداء، وبعد أن أنهى الرجل أكله وشربه، اعتذر له غندور بأسف حقيقي، لكن الرجل الذي شعر أن هيئته ربما هي السبب، مد يده في حقيبة جلدية ملاصقة لجنبه وأخرج لغندور سبيكة ذهب وهو يقسم أنه لو عاد إلى البلد دون موافقة غندور سيكسر ذلك فرحة أخيه ويكسر قلب أهل البلد كلها الذين يتوقعون مجيئه وينتظرونه.
لمعت السبيكة في عين غندور، كاد مدير أعمال غندور ـ يحكي وحيد وهو يقلّد فزّة الشاب ـ أن يثبّ ليتناولها، والرجل يقترب من غندور بحساب وتوسّل يستحلفه أن يوافق، نظر غندور للسبيكة ثم للرجل عدة مرات في صمت، لم يشك وحيد للحظة أنه تاجر آثار أو سلاح.
أخيراً، مدّ غندور يده وتناول السبيكة. نظر إليها في يده ووزنها في كفّه، كانت مصقولة ونظيفة. تهلل وجه الرجل وأخبر غندور على سبيل الإغراء أنه يمكنه أن يحتفظ بها حتى لو لم يأتِ، وإن وافق سيعود بمثلها من البلد بخلاف النقوط وكرم الحضور.
احتفظ غندور بالسبيكة، كان معتادًا على قبول هدايا محبيه ومعجبيه إن آنس منهم تقديرًا كافيًا، وقال للرجل أنه سيفكر، سأله غندور من أي بلد من سوهاج هو، فأجابه بلهجته الطيبة والناشفة في آن، وسأله إن كانوا لا يزال أهل بلده يسمعون أغانيه، فابتسم الرجل وهزّ رأسه وهو يقول لغندور أن نخيلهم يتمايل حين يسمع صوته..
ابتسم غندور.. بعد مغادرة الرجل سأله مدير الأعمال إن كان فعلًا سيقبل، لم يبدُ على غندور الحماس للذهاب وإن كانت أسكرته عبارة الرجل الأخير وأعاد تكرارها بلهجة الرجل الصعيدية بتلذذ.
كان لهذا اللقاء البسيط أثره الهائل على مزاج المطرب الشعبي، تورّد وجهه بعدها واعتدل في جلسته وانفتح صوته وتنغّم في كلامه العادي، فوافق في نهاية الجلسة أن يحيي حفل الفيرمونت، قام مدير الأعمال الشاب وقبّل يد غندور ورأسه، بينما غندور ووحيد يضحكان.
بعدها بثلاثة أيام تقريبًا، كان وحيد يتأنق للحفل الكبير، نزل من بيته حاملًا الكيبورد الكبير ووضعه في سيارته، ثم انطلق بها سعيدًا أن ربما بعد هذا الحفل قد يؤجل عودته لوظيفته الحكومية ممدداً إجازته مرة أخرى لو صار نجم غندور في صعود من جديد. وحين وصل تحت بين غندور ونقل الكيبورد إلى الأتوبيس الكبير الذي سينقلهم إلى الفندق، اكتشف أن هناك تغييرًا في الخطط، لم يصدق ما قيل له، غندور قرر في اللحظة الأخيرة إحياء حفل سوهاج!
حكي له مدير الأعمال عمرو حين قابله بعدها بسنوات أن غندور قبل أن ينزل مباشرة إلى حفل الفيرمونت، تلقى اتصالًا من الزائر الصعيدي، الذي بقي لسبب ما يتوقع أن يلبي غندور طلبه، بكى له في الهاتف واستحلفه بحياة بناته وغنى له في الهاتف وهو يبكي مقاطع من أغانيه، جلس بعدها غندور على الأريكة الكبيرة ببدلته السوداء الأنيقة في صدر الاستقبال متكئًا بمرفقيه إلى ركبتيه، وساندًا رأسه على كفيه مخفيًا وجهه، بعد أن حلّ أزرار قميصه، بقي هكذا لدقائق طويلة ومدير الأعمال يقف أمامه حائرًا.
ثم رفع غندور رأسه ونظر إلى عمرو قائلًا أنه ذاهب إلى سوهاج وطلب منه أن يخبر ذلك للفرقة أتى من أتى وبقي من بقي، كان هذا بالطبع فراقًا بين مدير الأعمال وغندور، هل يعقل أن يفعل مطربًا محترفًا شيئًا كهذا في اللحظة الأخيرة، ناهيك أن ذلك كان كفيلًا بضرب سمعة مدير الأعمال الشاب في مركزها، عمرو نزل مستسلمًا وأعلن للفرقة قبل أن يرحل نهائيًا وبلا عودة قرار غندور العجيب، ثارت الفرقة وهاجت، ولا يمكن لومهم، كانت أيامًا صعبة، بعضهم كان يعمل في أعمال وضيعة انتظارًا لليال كهذي ينفقون منها على بيوتهم، وحين نزل غندور لم يجد إلا نصف الفرقة، لم يأبه لغياب أحد كعادته لكنه اطمئن حين رأى وحيد واقفًا قرب الأتوبيس يدخن في هدوء وينادي غندور مبتسمًا: سوهاج يا عرب؟
كعادة أي فرح يذهب إليه غندور في الصعيد، يصل قبلها بعدة ساعات، ينام ويسترخي في غرفة له وحده أو يختار ما شاء له أن يضبط مزاجه، ويكون كلفة كل ذلك على أصحاب الليلة، بينما يكون للفرقة غرفتان أو ثلاث، كانوا جميعًا في دار صغيرة قرب الدار الريفية الكبيرة التي يقيم فيها أهل العروس.
أكلنا وشربنا وبدأنا التجهيز لضبط الآلات على مسرح السرادق الذي أقيم في ساحة كبيرة وسط الزراعات بالقرب من جبل كبير، من ورائه يتدفق النيل بجذعه المائي الضخم كأنه بحر ذو أمواج لا يشبه النهر المختنق بين ضفتين متقاربتين في القاهرة. وقتها أذكر أن مرت أمامنا سيدة ذات جسد ممتلئ رجراج، في عباءة فخمة وحجاب منحسر عن غرّة سوداء لامعة، وجهها حسن ـ يدقق وحيد في وصفها- إلى درجة تزعجك أنه ليس به نقص، مستوٍ وصاف ومتناسق، ولكنه ليس حسن مألوف. يسير بين يديها رجل نحيل كالخادم يلتفت يمينًا ويسارًا كلما بدا له منها أدنى إشارة، كانت تسير إلى الدار الصغيرة حيث يرتاح غندور. طبعا تغامزنا ولكن أمسكنا ألسنتنا لأننا عرفنا أنها من بيت أصحاب الليلة، ولا يعقل أن يحدث شيء من هذا في هذا التوقيت مثلًا، كان انكشافها الأنثوي المبهرج غريبًا عن عادات أهل هذه المنطقة، وكان اسمها غالية، عرفتُ ذلك لاحقًا. يبتسم وحيد.
في الموعد المحدد بدأ الفرح، الأضواء البلدية الملوّنة والسرادق الصعيدي الشهير بالأزرق والأحمر والأخضر، طاولات ممتدة تحت أفرع النور الواصلة بين الدار الكبيرة والمسرح المقابل لها..
وفي التوقيت المناسب صعد غندور إلى المسرح، كان ذلك أشبه بالليالي القديمة منه إلى اللحظة، صعد مستمتعاً وثملًا بالاحتفاء الكبير، وبنداء اسمه الذي يفخمه الصدى المرتدّ من الجبل القريب مفرقعًا في السماء كأنه زعيم هذا المكان منذ زمن بعيد، وكأنه زعيم هؤلاء الرجال الذين يشرخون حناجرهم من أجله.
الحضور كان كثيفًا، رجالًا ونساء، متنوعي الملبس والمظهر، يتدفقون على مدار الليلة بمعدّل هائل، كأنهم يتقاطرون من كل أنحاء البلدة الصغيرة بالعشرات في كل دقيقة. صعد إليهم في جلباب أبيض ناصع، فاتحًا أزراره لتبين سلسلته الضخمة وعنقه العريض. افتتح غندور الغناء ليلتها نشوانَ ومنفتح الروح، غنى بصفاء بال، وكعادته يوقف المزيكا ليحكي حكاية هنا وحكاية هناك، والجمهور يتجاوب معه ببساطة وانفعال. ومن حين لآخر يلتفت إليّ مبتسمًا وهو يغني مقطعًا ليغمزني أنه كان مصيبًا حين تجاهل حفلًا أخر لن يجد فيه ربع هذه الطاقة الهائلة من الانسجام، كان كل ما يحدث مبهجًا، بما في ذلك حين تنهض تجاهنا موجة غناء الحضور معه فتوشك أن تبتلع كل الأصوات في سقوطها المدويّ على المسرح، حينها أمسك بصعوبة في اللحن وتنقبض أصابعي على الكيبورد كأني أتشبث به من التطوح إلى الوراء، ويبين في مثل هذه اللحظات الفرق بين محترف وهاوٍ، بعض العازفين الذين جمعناهم بارتجال لإكمال نقص الفرقة كانوا مهرة ولكن مبتدئين، بعضهم كانت تجرفته موجات الصوت الخام المهيبة فنمد إليهم أيادينا باللحن ليمسكوا به عائدين إلينا من عمق البحر.
في الوصلة الثانية، ومع صعود الراقصات اللاتي يُسمح لهن الآن أن يشاركن غندور مقدمة المسرح باقتراب محسوب، اثنتان منهما قبلتا يده احتراماً لمقامه، بينما الثالثة الأصغر سنا فلم تفهم كيف تتصرف وبدأت الرقص وهي تراقبهن بطرف عين يملن إلى كفه ويقبلنها بسرعة قبل أن يبدأن وصلتهن.
وسط الغناء، وكان رقص المعازيم في أوجه، لمحتُ غالية تجلس بين الرجال تشرب وتضحك كأنها واحدة منهم، ومن حين لأخر ترمق غندور بنظرات جانبية باسمة، من ورائه كنت أشعر به يستقبل هذه النظرات ويردها بأحسن منها بعينيه وصوته ويديه، بدأ الرجال يدورون حول الطاولات متلاحمين بالأذرع أو يرقصون واقفين فوق الطاولات، وكان أن رفعت رأسي فرأيت أحدهم بعيداً في المنطقة الخلفية من السرادق كأنه معلق بين السماء والأرض قرب أفرع النور، ظننت للحظة أنه يقف على ساقين خشبيتين أو معلق من أعلى، يرقص بانسجام متمايلا لليمين واليسار، أغلقت عينيّ ضاغطًا على جفنيّ وعزوت ذلك إلى الإرهاق أو ما شربته قبل الصعود إلى المسرح، وركزتُ في العزف، ثم التفت بجواري إلى عازف الطبلة الذي وقف فجأة مشدوهًا مفغرًا فاهه، فنظرتُ حيث ينظر، حينها رأينا جميعًا ما لم يكن له أي تفسير.
بعض المعازيم كان يندفع طائرًا إلى السماء حتى يغيب في الظلمة ثم ينزل وهو يحرّك ذراعيه ورأسه، آخرون نبت لهم أذرع وسيقان تتراقص حولهم كالحيّات كل واحدة في اتجاه، نساء تطول قامتهن بشكل مستحيل، رجال تضيء عيونهم بألوان عجيبة وهم يرفعون زجاجات البيرة إلى أشداقهم الضخمة، رجل تحولت قامته إلى عَجُز حيوان ضارٍ منحنيًا إلى الأرض يرقص في جلبابه الفضفاض.
صرخت الراقصات وارتعبن، وارتجّ العازفون، وبعضهم بدأ يتراجع على المسرح حتى كاد أن يسقط، غندور رأيته على مقدمة المسرح يقف متجمدًا، يده مدلاة جواره ممسكة بالحديدة (الميكروفون)، أنا لم أعرف كيف أتصرف، كنت أرتجف من الخوف، أفرع النور كانت تضيء بشكل متقّطع وشعرت أنني سأسقط مغشياً عليّ من الفزع، الغريب أنني ظللت واقفا وراء الكيبورد، كأن ما يحدث سيتوقف في أي لحظة ونواصل العزف، رأيتُ غالية وقد وقفت، هذه المرة بقامة هائلة، رفعت رأسي إليها هكذا (يعيد وحيد عنقه إلى أقصى الوراء ليريني كيف كان ينظر إلى غالية)، التفتً إلى غندور بوجه مشدوه، أحيانًا يبدو لي أنه ابتسم، وأحيانًا لا أذكر شيئًا، لأني هذا كان أخر ما رأيته.
استيقظتُ قرب الفجر في غرفة الاستراحة في الدار الصغيرة، نظرت من الشباك فوقي فلمحت القمر، وعلى ضوءه اعتدلت ونظرت حولي، وجدت الفرقة كلها، نائمين على الأسرة وبعضهم على الكنب، العازفين والراقصات ممددين جنبًا إلى جنب كأنهم إخوة، أدخلتهم أمهم تحت الغطاء بعناية قبل النوم، سرت بينهم أسمع صوت أنفاسهم الثقيل، بعضهم كان يغمغم أو يتقلّب في نوم عميق، خرجت من الغرفة، سرت إلى غرفة غندور، فتحت الباب ورأيتها خاوية تمامًا..
خرجت إلى الساحة الكبيرة، وعلى ضوء القمر كانت تمتد أمامي أرض خلاء، لا دار كبير، لا مسرح، فقط أرض خلاء منبسطة إلى سفح الجبل المظلم ومن ورائه النيل.. وللمرة الأولى، أدرك أن الجبل منطقيًا في غير موضعه، والمنطقي أن يكون الجبل في الناحية الثانية من النيل لا قرب شاطئه.
في اللحظة التي أدركتُ فيها ذلك، شعرت بخوف رهيب، ركضتُ عائدًا إلى الدار وأيقظت الجميع، نهضوا ينظرون حولهم وهم يخرجون من النعاس بصعوبة، في جيوبنا وجدنا أجرتنا وزيادة بسخاء كبير، لم يخفف ذلك من الرعب الذي تزايد مع استيقاظ واحد وراء الأخر، يتحسس جسده ويسألنا إن كان ما حدث حقيقة فعلا، الراقصات لطمن وبكين، إحداهن ظلت تولول حين اكتشفنا أنه لا أثر لغندور، خرجنا إلى السيارات التي كانت مخفاة وراء الدار، ركبناها مكروبين وسط بكاء وقراءة للقرآن، وانطلقنا عائدين إلى القاهرة.
لثمانية أيام، تم التحقيق معنا جميعًا، وانقلبت الدنيا في ثلاث مديريات أمن، تم كل شيء في سرية كبيرة لأنه لم يكن أحد مستعدًا وقتها لتقبّل خبر اختفاء نجم بحجم غندور. لم يصل حرف للصحافة، ولم نكن نعرف أصلًا ما سنقوله لو سئلنا، بعض الضباط اعتبرنا تحت تأثير هلوسة جماعية، وخضعنا لكافة أنواع تحليلات الدمّ. وبخلاف المزاج المعتاد لم يكن هناك أي أثر لمخدرٍ يسبب هذا الحلم الجماعي الطويل بهذه التفاصيل الموحّدة.
حتى وصلني اتصال من بيت النجم، وأنه يطلبني على وجه السرعة، لم أصدق، نهضتُ أجري إلى بيته، حين وصلتُ كانت الحكومة قد سبقتني إلى هناك، انتظرتُ في قاعة الاستقبال، أسترق السمع وأتلمّس أي شيء من الكلمات التي تصلني منقوصة ومتقطعة، بعد قليل خرج الضباط بصحبة رتبة كبيرة، نظروا إليّ مبتسمين وهم في طريقهم إلى الباب بصحبة الخادمة.
جريتُ إلى غندور الذي كان يجلس في مكانه المفضّل، متكئًا على وركه وما إن رآني حتى ضحك بملء فيه، وقفت أخبط كفًا على كف، كنت فين يا غندور؟ فأشار إليّ أن أصبر، ونهض وسرت وراءه في الطرقة الواصلة إلى غرفة المعيشة، وهناك مال وشدّ من وراء دولاب مملوء بدروع التكريم والجوائز الرمزية، شوال من الخيش الكثيف، ووقف مبتسمًا وهو يدخن، نظرت إليه ثم إلى الشوال، وجلست على ركبتي وفتحته.. كان مملوءًا بالسبائك الذهبية، الصافية المستوية، تبرق حتى وهي في جوف الشوال المعتم من أقل ضوء يتسرب إليها، رفعت رأسي إليه، فقال لي أن نصيبي أنا والفرقة وكل من شهد ما حصل محفوظ.
ما عرفه وحيد بعدها أن غندور استيقظ فجأة ليجد نفسه في فراشه، جوار زوجته التي صرخت حين استيقظت وبكت ونادت على بناته، واتصل هو بنفسه بالشرطة، ثم وجد الشوال في موضع جلوسه في الصالة، ثم نظر إلى نفسه فرأى أنه يرتدي جلبابًا مزركشًا زاهيًا بنقوش منمنمة لزهور تنتهي سيقانها الملتوية برؤوس حيوانات وطيور ووحوش غريبة، رآه وحيد بعدها مرة واحدة ولا يذكر أنه رأى غندور فيه قبلها ولم يرتده بعدها أبدًا.
لسنوات طويلة رفض غندور أن يحكي حرفًا عن اختفائه الغامض لأيام، وكان يكتفي أن يقول لأعضاء الفرقة أنهم كانوا مطاريد وأنهم خدّرونا فهلوسنا، ثم خطفوه أياما ليقايضوا البلد به مقابل فدية ضخمة ثم سلّموه لأهله في إمبابة الذين أعادوه إلى بيته.
لم يشتر أحد ما قاله طبعًا، وبقي السر بين أعضاء الفرقة وبعض العازفين الصغار الذين راضاهم غندور مقابل ألا يحكوا شيئًا، وحيد نفسه بنى من عَطيّة غالية بيتًا كبيرًا، يدرّ عليه دخلًا وفيرًا إلى الآن، ولكن الحكاية على ما يبدو تسرّبت من أحدهم وتحولت إلى شائعة شهيرة.
لم أصدق أن غندور لم يحكِ لوحيد، فسألتُه عن الأغنية، «أنا اللي جنّيت الجنّ..»، فأكدّ لي أنها تم تسجيلها بعد هذه الحادثة، وأن غندور ارتدى الجلباب الزهر-وحشي المزركش لمرة أخيرة يوم التسجيل، وكانت من كلماته ولحنه، وسجّلها دفعة واحدة دون إعادة، لتخرج من الاستديو وتقلب الدنيا وقتها كالتماعة أخيرة للنجم قبل احتجابه النهائي واعتزاله الغناء حتى موته.
نهض وحيد وحاسب عني وعنه، سرنا إلى السيارة، التقطتُ لنا صورة قبل أن نركب، وقبل أن ينزلني عند قصر العيني قلت له أنني لا أصدق أن غندور لم يحكِ له هو دونا عن أي إنسان ما جرى له في خطفة الجنّ، نظر إليّ بجانب عينه، قلتُ له أنه سيراني بعد قليل أمرّ من هذه البوابة داخلًا إلى المستشفى، ليأمن أنني لستُ صحفياً أو مراسل أخبار بالقطعة، ضحك وقال إن ما سيحكيه لن يصدقه أحد على أي حال، ودرنا بالسيارة مرة أخرى.
استبقته غالية عندها سبع سنوات، في كهف مطلّ على ماء صاف، يصحو كل يوم فيسقط فيه ويسبح ناسيًا العالم، بينما تجلس غالية وسط خادماتها على الشاطئ تنظر إليه وترعاه، يقضي غندور النهار كله نائمًا على الماء حزينًا، يرى السماء فوقه تقطعها شهب وأجرام كبيرة تدور قريبة حتى تبين فوّهاتها وندباتها، ثم يخرج فتلقي غالية عليه عباءته المزركشة، يسير وحيدًا في حقول كثيفة الخضرة يغني لنفسه ويبكي حتى المغيب، لم يكن راغبًا في العودة، كان يؤلمه أن يتذكر ما كان يحدث له ويشعر بالظلم والنكران، إلى أن اعتدل يومًا في فراشهما مخفيًا وجهه بين كفيه، سألته غالية عما به، فقال أنه اشتاق إلى بيته، وحين رأى في وجهها الجميل الفرق والحزن، قال أنه ليس هناك ما يعود إليه، زهد في الغناء وفي الناس وفي كل شيء، لكنه يحنّ بلا سبب إلى حياته التي خلّفها وراءه. صار يسير وسط عصبة من رجالها يحمونه من هجمات الحنين، يسلونه ويضحكونه ويغنون معه أغانيه، قدّمت له أكثر وصيفاتها مهارة في التبدّي كأبهى ما يكون البشر، وحين يغني كانوا يتوافدون إليه سائرين وطائرين وسابحين، ثم يرقصون في انتشاء أو تسيل دموعهم الحارة، جلبت له غالية حول الكهف في ليالٍ صافية أجناسًا من الجن والمخلوقات ليسمعوا صوته ويعرفوه، كل ذلك لم يخفف من حنينه شيء، إلى أن جاءته غالية وهو جالس فوق حجر كبير كبيضة حوت، وأخبرته أنها الآن مجبورة أن تعيده إلى بيته، فابتسم غندور دامعًا. قضيا معا ليلتهما الأخيرة ينظران إلى النجوم وهي تحكي له عن اسم كل منها ووصفه حين تراه وأنت طائر قربه في مداره مخططًا بالألوان، إلى أن سقط جفنيه على صوتها وهي تعدد له أشياء لم يسمع بوجودها قط في هذا العالم، وحين فتحهما في الصباح كان في فراشه جوار زوجته، نهض وخرج ذاهلًا إلى الصالة وهناك كانت تستقر في موضع جلسته الدائمة هدية صغيرة من غالية.
***
ياما ناس دهبها يزيد، بس الأصول قالّة
ما تزورش للندل بيت، لو عنده ميت ڤيلا
ياما ناس كتير في الڤِلل، ساكناهم العِلّة
واوعاك تقول ع الأصيل، مهما هانوه.. قِلِّة
أنا اللي جنيت الجن
خليته يلعب ويئن
خليته يبكي ويحن
ويقول يا قلبي يا ميت اه
نسيوني قلت مفيش بخت
وجابوني من فوقها لتحت
وانا اللي كنت على اليخت
غنيت لدا وديّا وداه
اه من قساوتك يا زماني
خلاص كده مفيهاش تاني
الغالية حبّها سوّاني
وسقتني مُرّه ومحلاه..
شوف شوف وشوف
أو ماتشوفشي
زي اللي اغنيه.. ماتشوفشي
غيره هتسمعه وتملّه
بس اللي اقوله.. ماتنساه..
أنا اللي جنيت الجن
خليته يلعب ويئن
خليته يبكي ويحن
ويقول يا قلبي يا ميت اه
(أنا اللي جنيت الجنّ ـ غندور)