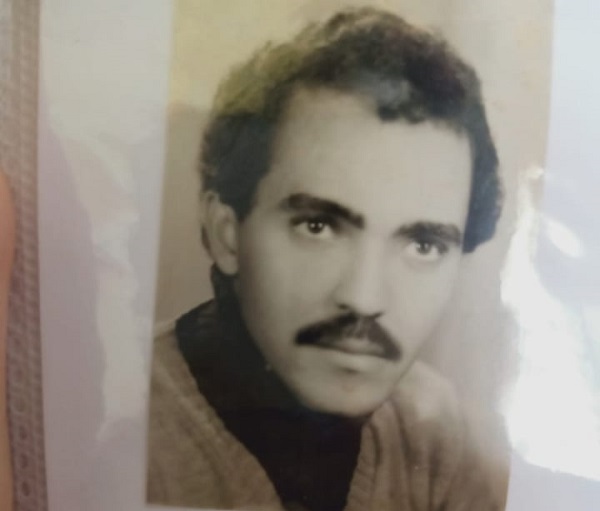حاورته: هانم الشربيني
شخصية الأديب المصري والباحث في علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن مركّبة. هو موسوعي يمزج بين السياسة والثقافة والصحافة. هو ابن الريف والمدافع عن حقوق الطبقة الوسطى ومشروعية الحياة والتعليم لكل إنسان.
الثابت الوحيد في مؤلفاته الكثيرة هو اهتمامه بالناس وحيواتهم وطرق عيشهم، ومواجهته للسلطة، كل سلطة. لذلك، تعرّض، هو ومؤلفاته، للتضييق والملاحقة.
كثيرة هي الأسئلة التي تخطر على البال عند إجراء مقابلة مع شخص مثله. نسأله عن رواياته ومجموعاته القصصية؟ عن الجوائز الأدبية؟ عن كتاباته الاجتماعية؟ عن علاقته بالتصوّف؟ عن قراءته للتغيّرات السياسية في مصر؟ حاولنا الإطلال على شيء من كل ذلك في هذه المقابلة.
ـ عمار علي حسن، عشر روايات وسبع مجموعات قصصية، و24 كتاباً في الاجتماع السياسي والتصوف والنقد الأدبي. لكن دعنا نبدأ من كتاب إضافي: سيرتك الذاتية، “مكان وسط الزحام”. ثمة من طرح تساؤلات جوهرها أنك تكتب سيرة ذاتية مبكرة، وكأنك تستعجل توثيق مَن تكون. ما الذي لا نعرفه عن أسباب ذلك؟
لا توجد سن معيّنة لكتابة سيرة نوعية، فابتداءً كتبت تحت عنوان فرعي يقول: “تجربة ذاتية في عبور الصعاب”، ما يعني أن القوس لا يزال مفتوحاً لإكمال السيرة إنْ أعطتني الحياة سنين أخرى على قيدها. كما أن كثيرين كتبوا سيرهم في سن مبكرة، مثلاً، كتب طه جسين “الأيام” وهو في التاسعة والثلاثين من عمره، وكتب العقاد من “وحي الأربعين” ثم من “وحي الخمسين” وما بعدهما وجمع هذا في سيرة بعنوان “أنا”، ويوجد كتّاب في العالم فعلوا هذا، وكل منهم كان له سببه أو عذره أو رغبته.
سيرتي الذاتية جاءت رداً على حملة إعلامية أرادت تشويه صورتي.
والسبب بالنسبة لي عام وخاص، والأول هو أن أياً منّا لا يعرف متى يأتي أجله، شاباً مثل أبو القاسم الشابي ورامبو وبدر شاكر السياب، أم طاعناً في السن مثل نجيب محفوظ ودوريس ليسنج وتولستوي وتوفيق الحكيم.
أما الخاص فهو أن هذه السيرة جاءت رداً على حملة إعلامية أرادت تشويه صورتي، على خلفية موقفي السياسي. فذات يوم وجدت أخباراً ومعالجات ومقالات متشابهة تنعتني بأكاذيب من قبيل: “الأديب المغترب” و”المفكر الافتراضي” و”عالم الاجتماع الجاهل بمجتمعه” و”المتأمرك”، ولم يكن متاحاً لي، لقيود صارمة على الصحافة، أن أرد مباشرة على كل هؤلاء، في صحفهم نفسها وفي مساحة مساوية لما أخذوه في مهاجمتني، فقررت الرد بطريقة أخرى، وهي كتابة سيرة حياة لشخص خرج من طين الأرض، وجاء من قرية نائية منسية، وحمل الفأس والمنجل والقادوم والجاروف، متنقلاً بين الحقل والمعمار، جنباً إلى جنب مع دراسته، وسار في الشوارع الخلفية حتى وصل إلى ما هو عليه.
ـ لماذا ابتعدت في رواية سيرتك عن الجانب السياسي المباشر وركزت على الجانب الاجتماعي والبيئة الفقيرة التي نشأت فيها؟
تناولت الجانب السياسي في كتابي “عشت ما جرى: شهادة على ثورة يناير”. فيه عدت إلى تجربتي هذه منذ أن كنت طالباً في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة وحتى اندلاع الثورة وما بعد هذا بقليل. ولذلك لم أشأ أن أكرر هذا في كتاب “مكان وسط الزحام”.
ـ يُدخلنا الحديث عن تقديم نفسك وتاريخك إلى القارئ بهذه الطريقة إلى مسألة أساسية، فأنت إلى كونك روائياً وأستاذاً في علم الاجتماع السياسي، تخوض كذلك في مجال النشاط السياسي والكتابة السياسية من موقع الناقد الجاد. ما التحدي الذي يفرضه الروائي على السياسي هنا، والعكس؟
أود ابتداءً أن أقول إنني درست العلوم السياسة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة، لكن اهتمامي بالأدب سابق على هذا، ففي المرحلة الثانوية كتبت قصائد شعرية كان فيها من العفوية أكثر من الإتقان، وبالتزامن معها كتبت خواطر بين القصة والمقال، وكنت أقرأ بعض الأعمال الأدبية بدءاً من المرحلة الإعدادية، ولم أرَ نفسي ابتداءً سوى كاتب، منذ أن تنبأ لي مدرسي بالإعدادية بهذا. وأول مادة نشرتها في صحيفة كانت قصة قصيرة، وأول جائزة حصلت عليها كانت أدبية. بالتزامن مع كل هذا كنت أعمل باحثاً في علم الاجتماع السياسي، وانخرطت في الحياة السياسية مع الذين كانوا يكافحون من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية. ولأن صوت السياسة له ضجيج فقد غطى على الأدب، لا سيما في لحظة الذروة التي انفتح فيها الباب لموقفي وقولي أمام الرأي العام.
في أعمالي الأدبية، جاءت السياسة في الخلفية، فهي تحضر ولا إمكانية لاستبعادها تماماً حتى في أشد القضايا ذاتية، لكنني من الذين يرفضون دوماً أن يتحوّل الأدب إلى بيان سياسي أو منشور أو أيديولوجية، فهذا يجعله يفتقد إلى الشرط الأساسي الذي يفرضه الفن ويطلبه طيلة الوقت، وبالتالي يفقد “الأدبية” أو “الفنية” ويصبح مسخاً، أو شكلاً كتابياً يمثل عالة على الأدب.
عند هذا الحد لا أدع السياسي يفرض شيئاً على الروائي إلا بقدر ما يجعل السياسة في الخلفية، وهي كذلك في أي عمل أدبي، وهذا ما يقرّ به كل الأدباء في العالم تقريباً. فنجيب محفوظ يقول “لا يوجد حدث فني إنما حدث سياسي يعالج بطريقة فنية”، وتوني موريسون، الحاصلة على نوبل أيضاً، ترى أن السياسة حاضرة في أي عمل أدبي، مهما كان موضوعه، شئنا أما أبينا. ربما يعود هذا إلى أن السياسة تدخل في كل شيء.
ـ هل يقلقك أن تتأثر صورتك الروائية بصورتك السياسية؟ بمعنى أن يُحكم عليك أدبياً بناءً على مواقفك السياسية؟
الخيال والمجاز حاضر حتى في كتاباتي السياسية، لأنني لا أؤمن بالحدود المغلقة بين الفنون.
من جانبي، أقول إنني لست قلقاً، فـ”يوسا”، البيروفي، الحاصل على نوبل في الآداب، كان ناشطاً سياسياً وترشخ للرئاسة في بيرو. وشعراء مثل لوركا ومحمود درويش كان الانشعال السياسي جزءاً أصيلاً من حياتهم. وعموم الناس، في البلاد التي تعاني من الاستبداد والفساد، يطلبون من الأدباء أن يمارسوا دورهم المنتظر في أن يكونوا في مقدمة الصفوف كمثقفين عضويين وفق تعبير غرامشي. ويحضرني في هذا المقام قول يوسف إدريس: “حين يكون عقل أمتي في خطر فلا تسألوني عن نوع الكتابة”، وذلك حين انخرط في كتابة المقالات السياسية والفكرية وتوقف عن كتابة القصص القصييرة والمسرحيات.
لكن بالنسبة لي، لم أتوقف عن كتابة الأدب، ولن أتوقف حتى نهاية عمري، وطالما أطلب من الله أن يمد فيه حتى أكتب آخر رواية أو قصة تدور في رأسي. وإنتاجي الأدبي في القصة والرواية أو حتى النقد أكبر كماً وكيفاً، وفق رأي نقاد، مما أنتجه كثيرون تفرغوا للكتابة الأدبية تماماً.
علاوة على هذا فإن الخيال والمجاز حاضر حتى في كتاباتي السياسية، لأنني لا أؤمن بالحدود المغلقة بين الفنون، ولا تلك التي تقوم بين المعارف، وأقدّم نفسي دوماً على أنني من المؤمنين بفكرة عبور الأنواع بين المعارف والعلوم الإنسانية.
ـ هل يدفع الروائي ذو الموقف السياسي أثماناً ما، ولا سيما إذا كان في موقع المعارض والناقد للسلطة؟
في هذه أقول: نعم، فيا ويل أي كاتب مستقل في بلادنا. إنني صرت أعاني في نشر أعمالي، فدور النشر ليست قادرة على استيعاب بعض ما يرد في نصوصي الأدبية أو الفكرية. وهناك مَن لا يستطيع أن ينشر خوفاً من تأثير اسمى عليه، وهناك مَن يتوقف مندهشاً من صورة “المعارض الأبدي” التي أعيشها، ولا يريد أن يتفهم ما ردي وهو أنني لم أجد إلى الآن النظام السياسي الذي أشعر أنه يليق بإدارة دولة بقيمة مصر وقامتها.
ـ كتبت وتحدثت أكثر من مرة عن التضييق الإعلامي عليك لجهة حجب مقالات ومنع أخرى وتقييد ظهورك التلفزيوني في القنوات المصرية، هل هذا سبب تقليصك للكتابة السياسية وانتقاء موضوعات لا تثير مخاوف الجهات الصحافية التي تتعامل معها؟
نعم هناك تضييق شديد عليّ، يكفي أن أقول لك إن المنع لم يقف عند حد المقالات والتصريحات السياسية، بل وصل إلى نشر قصصي في الصحف التي يسمونها حكومية، رغم أنها صحف ملك الشعب حسب الدستور والقانون، ومنع نشر أي أخبار عن صدور أعمالي القصصية والروائية، ومنعي كذلك من الظهور في أي قناة فضائية حكومية أو خاصة، بعد أن تمت السيطرة على كل شيء.
أما المقالات التي أنشرها، فهي ما يتاح نشره، وليست ما أكتبه. ما يقرأه الناس لي هو ما يسمح لي بتمريره، وقد كتبت مقالات كثيرة رفضت المنابر التي أكتب فيها نشرها، لأنها تخشى من الرقابة. أحدهم قال لي: أتريد أن يتوقف صدور الجريدة من أجل مقالك؟ الآخر قال لي: منعاً لإثارة المشاكل اكتب في النقد الأدبي والثقافي وموضوعات فكرية، لأننا لا نستطيع نشر مقالات تعبّر عن موقفك السياسي. أنا لا أكتب ما يرضي مَن ينشر، فكثير من مقالاتي تعود إلي، ويطلبون غيرها، ووقتها يمكن أن أدفع إليهم قصة أو قصيدة من الشعر القديم الذي كتبته في صباي أو مقالة نقدية، ولولا حرصي على أن أمرر ولو أقل القليل من أفكاري وآرائي، لتوقفت عن الكتابة تماماً. وعزائي أن مواقع التواصل الاجتماعي صارت تتيح لي مساحة أوسع، أقوم باستغلالها على الفور.
ـ إذا اضطرتك الضغوط إلى تجنّب الحديث في السياسة، هل يكون ذلك خضوعاً أم انحناءً أمام العاصفة؟
لا أحد يستطيع منعي من الحديث في السياسة، فإن ضاقت أمامي الصحف والمجلات والفضائيات التي تمت السيطرة عليها تماماً، تتاح أحياناً فرص للحديث على قنوات أجنبية متلفزة، أو الكتابة على صفحتي في فيسبوك وتويتر. وفي كل الأحوال لا يخضع للعاصفة مَن وضع رأسه على كفه مرات عديدة.
ـ آخر إصداراتك، “عجائز البلدة”، هو توثيق لما تصفه بـ”تاريخنا الاجتماعي المنسي” بالحديث عن 65 آلة ريفية، كذلك لك رواية “سقوط الصمت” التي توثق ثورة 25 يناير وكُتب على غلاف آخر طبعاتها “الرواية التي تنبأت بسقوط الإخوان”. هل يعكس هذا الحرص على التوثيق الأدبي هواجس من توثيق مغاير يختلف عمّا تراه؟
هذا العنوان هو من اختيار دار النشر، وكتبته في لحظة سياسية وتاريخية فارقة، وقد أقررت بما فيه، لأن هذه النبوءة كانت ظاهرة فعلاً، لكن هناك نبوءة أخرى موجودة وهي الأهم، إنها انتصار معركة المصريين من أجل الحرية ولو بعد حين.
أما بالنسبة للشق الثاني من سؤالك فيكفي أن أقول لك، إن كثيراً من مقالاتي ومداخلاتي الإعلامية المتاحة تبيّن أنني لست بحاجة إلى الاختباء خلف الأدب، فما يتيحه من قدرة على المقاومة بالحيلة أمارسها أحياناً، ربما من باب مقتضيات الفن، لكنها لم توقفني أبداً عن المقاومة أو النضال الواضح الظاهر الذي لا لبس فيه، في مجال السياسة وليس الفن، على قدر الاستطاعة.
ـ هل ترى أن ثورة 25 يناير نالت حقّها أدبياً من خلال الإصدارات التي تناولتها؟ وهل تَعتبر روايتك “سقوط الصمت” نوعاً من “الأدب الثوري”؟
سيكتب عن ثورة يناير الكثير في قابل الأيام، وبتوالي الأيام سيربو ما كتب عنها حتى عما كتب عن ثورة 1919 نظراً لأن يناير ثورة جرت في ظل عالم مفتوح يتسم بقدرة هائلة على التسجيل والتوثيق.
كتبت روايتي “سقوط الصمت” كي يقرأها جيل سيأتي في ما بعد، ويعرف ما حدث بالفعل، لهذا دارت حول الثورة، ووثقت لها في أيامها الطازجة، عبر مشاهد تمثل كل الأطراف التي شاركت فيها. لكن الثورة ستظل منبع إلهام لأدباء كثيرين، لا سيما الذين شاركوا فيها، أو ساهموا في صنعها، وأعتقد أنني واحد منهم، لانخراطي في حركة النضال السياسي التي نادت بها. وقد كتبت رواية أخرى، حضرت فيها الثورة، لكن هذه المرة في خلفية الأحداث، وتم التركيز على الجانب النفسي الذي خلفته.
ـ الأدب العربي فاعلٌ أم عاجزٌ في مواكبة تغيّرات المجتمعات العربية في مرحلة ما بعد انطلاق “الربيع العربي”؟
لا أعتقد أن الأدب العربي عاجز عن مواكبة التغيرات، لسببين رئيسيين: الأول هو أن كثيراً من الآداب العربية واكبت الأحداث، لكنها بطريقتها التي تختلف عما يكتبه الصحافي، وينتهي إليه الباحث؛ والثاني هو أن كثيراً من الأنواع الأدبية التقليدية ليس من وظيفتها، ولا في وسعها أن تلهث وراء الأحداث، لكن بمكنة الأديب، أو يجب عليه، أن ينخرط بين الناس الساعين إلى الحرية والعدل سواء من خلال مشاركتهم بجسده في حركة الاحتجاج والنضال، والأهم هو المشاركة النوعية التي تعني أن يجعل الأديب قلمه في خدمة التحرر والعدل والكرامة، لا سيما في اللحظة التي تنتفض فيها الجماهير من أجل تحصيل هذه القيم النبيلة، دون أن يجعل موقفه السياسي الانفعالي ينعكس سلباً على كتابته الأدبية، التي يجب أن تنأى بنفسها عن كل ما هو وعظ وإرشاد أو بيان سياسي وأيديولوجية ومواقف زاعقة فجة.
ـ هل ترى للأدب وظيفة تغييرية في المجتمعات العربية؟
نعم الأدب يغيّر، لكن على المدى البعيد. يكفيه أنه يعمق الوعي، وهي مسألة ضرورية للتغيير الآمن والناجح. لقد اندلعت ثورات وانتفاضات سياسية في بلدان عربية عدة، لكنها لم تمضِ في الطريق الذي أراده الناس، وفي نظري أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى تعثرها في بعض الدول، وفشلها في أخرى، وتحولها إلى مآسٍ في ثالثة هو أن الثورة السياسية سبقت الثورة الفكرية. نحن بحاجة ماسة إلى ثورة في الوعي، وهنا يكون للأدب دوره المهم.
ـ بين “شجرة العابد” و”جبل الطير” و”خبيئة العارف” ومؤلفات أخرى، تغوص عميقاً في الصوفية وعالمها،لكن ثمة مَن يرى أن هذا الموضوع بات مطروقاً في الأدب العربي بشكل كبير أوقع النتاجات المرتبطة به في التكرار، ودفع بالتالي فئة من القراء إلى النأي عنه. هل تؤيد وجهة النظر هذه؟
اهتمامي بالصوفية سابق بكثير على هذه الموجة. فقد كانت أطروحتي للماجستير التي ناقشتها عام 1996 عن “التنشئة السياسية للطرق الصوفية في مصر”، وحوت مجموعتي القصصية الأولى التي صدرت عام 1998 بعنوان “عرب العطيات” على قصتين عن أجواء صوفية، وسردت في سيرتي الذاتية علاقتي بالطرق الصوفية التي بدأت منذ الطفولة. وحتى رواية “شجرة العابد” التي ظهرت مع التباشير الأولى للموجة الصوفية في الأدب كنت قد بدأت في كتابتها عام 2001 وصدرت بعد هذا بعشر سنوات.
أعتقد أن التصوف سيظل منهلاً ومورداً مهماً للكتابات الأدبية، سواء عبر كنزه اللغوي وتجربته الوجدانية أو من خلال حكاياته وأساطيره، لكن من الضروري ألا يستسلم الأدباء للأنماط الجاهزة المكرورة كما رأينا في العقد الأخير.
ـ يُؤخَذ على بعض مؤلفاتك ولا سيما الروائية منها مسألة التطويل (“جبل الطير”، “شجرة العابد”، “سقوط الصمت”). ما وجهة نظرك الروائية حيال هذا النقد
كل رواية تختار لغتها وحجمها، وإذا كانت الروايات المذكورة كبيرة الحجم فإن لديّ روايات صغيرة، مثلاً “حكاية شمردل” لا تزيد عن 90 صفحة، ورواية “جدران المدى” صفحاتها 150، وكذلك “زهر الخريف”، وبقية رواياتي الأخرى متوسطة الحجم تقريباً.
والروايتان اللتان تصل صفحات كل منهما إلى 660 صفحة تقريباً، كان من الممكن أن تزيدا عن هذا، لأن “سقوط الصمت” هي رواية عن ملحمة سياسية وإنسانية كبرى وهي ثورة يناير، و”جبل الطير” ملحمة عن تطور الأسطورة الدينية في مصر منذ الفراعنة وحتى الآن.
ـ هل تنظر برضا إلى حال النقد الأدبي العربي؟
كان الله في عون النقاد، فالأعمال التي تصدر في مختلف ألوان الأدب كثيرة، وعليهم ابتداء فرزها، لمعرفة ما يستحق الاهتمام بعيداً عن المجاملات على أشكالها. كما أن مساحات النشر المتاحة للنقد تضيق باستمرار، وعائده المادي يتراجع. فالناقد الذي يقرأ رواية أو مجموعة قصصية أو ديوان شعر ويكرس له وقتاً طويلاً، ثم يكتب عنه، هو مجاهد. بالنسبة لي، أمارس النقد الثقافي، وصدرت لي عدة كتب تحوي قراءات في أعمال آخرين، وأعرف مدى معاناة الناقد في بلاد العرب.
ـ هل ترى أنك أُنصفت نقدياً؟
تُعَدّ عن أعمالي الأدبية خمس عشرة أطروحة جامعية ما بين ماجستير ودكتوراه داخل مصر وخارجها، بعضها تمت مناقشته بالفعل، وكتبت عني دراسات للترقي داخل الجامعة، وغيرها للنشر في درويات ثقافية، وعشرات المقالات، ومئات التغطيات والتقارير. أعتقد أنني لم أظلم في النقد ظلماً بيَّنا.
ـ نشهد في الأعوام الأخيرة نتاجاً روائياً عربياً غزيراً، ثمة مَن يراه إيجابياً لجهة ازدهار النشر وثمة مَن يراه سلبياً تحت شعار “كمية لا نوعية”. ما تقييمك؟
لندع كل الزهور تتفتح، وبعد مدة سيتضح للناس الزهرة الطبيعية من الصناعية. هذا ماراثون طويل، ومَن لديه مشروع سيمضي على الدرب، ومَن كان الأمر بالنسبة له تجربة أو محاولة وليس أكثر، سيتنحي جانباً. وهذا الوضع ليس جديداً فطوال الوقت يخرج كثيرون من السباق، وتبقى الأعمال الجيدة، ويستمر الكاتب الذي لديه قدرة على الإجادة والتجويد والتجدد. ويكفي أن ننظر على أرفف المكتبات أو نزور باعة الكتب القديمة لنجد أسماء كثيرة أصدرت أعمالاً لم تبقَ، ولم يضيفوا إليها شيئاً، وتوقفوا عن الكتابة تماماً.
ـ ما موقفك من الجوائز الأدبية الكبرى للرواية العربية في ظل مَن يشكك في نزاهتها ومَن يراها ذات صدقية وتُسهم في تحفيز الكتّاب ودور النشر؟
الجوائز لا تصنع كاتباً. نحن لا نعرف، ولا ننشغل بالجوائز التي حصل عليها طه حسين ويحيى حقي ويوسف إدريس والعقاد وصلاح عبد الصبور وأمل دنقل، إلخ، ولا نستعيدهم من خلال جوائز ولا تكريمات، إنما عبر نصوص وتجربة حياتية.
وجود جوائز شيء جيد بشرط أن تكون نزيهة وخالصة لوجه الأدب والعلم. الخوف هو من تلك الموجهة التي تريد تكريس نمط أو نوع معيّن من الكتابة، لأهداف لا علاقة له بالإبداع في الفن والأدب والعلم، وهذه أشد ضرراً من المجاملات وتبادل المنافع والأحقاد التي تصم أغلب الجوائز العربية، وإنْ كانت الأخيرة أيضاً تدفع إلى السطح العابر والزائف، وهو ما يؤثر سلباً على مسيرة ومسار الأدب العربي كله.
……………….
*نقلا عن موقع “رصيف 22”