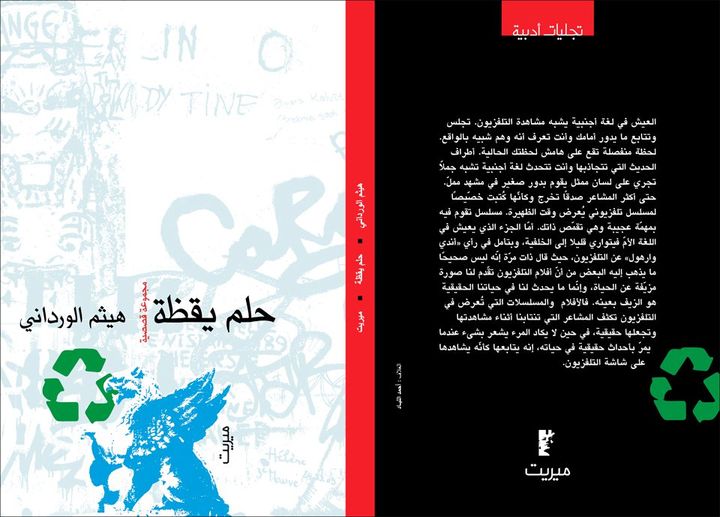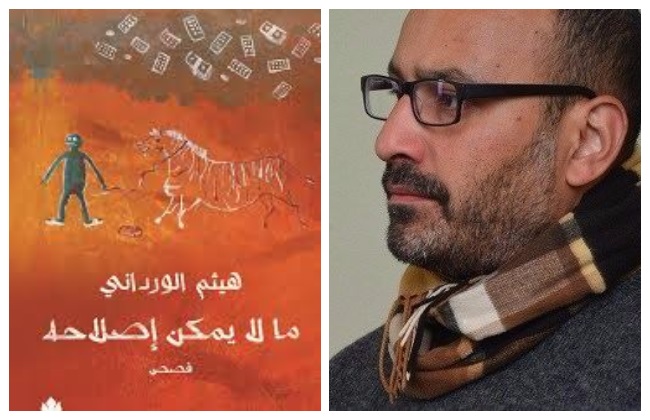يمكننا بسهولة أن نعتبر رواية على محطة فاتن حمامة رواية مكان، في موضعٍ ما من مصر الجديدة، موضع محدد بدقة شديدة، غرس الروائي عمود خيمته وبدأ يبني، أو على الأرجح بدأ يستكشف وينقّب. لكنها ليس رواية مكان بمعنى امبابة في مالك الحزين أو اسكندرية إدوار الخرّاط أو حتى قاهرة المعز عند نجيب محفوظ، فالمكان هنا يتحرّك، لا يوجد كأيقونة ساحرة، منعزلة عن تيار الزمن وما يحمله من تقبّلات سياسية واجتماعية “لا بتخللي الماشي ماشي ولا الراكب راكب”، الحركة كانت هي كلمة السر في هذه الرواية، المعتمدة في بنيتها الأساسية على المشاهد المتواترة السريعة اللاهثة، ربما دون ترتيب زمني، ومع تعمّد درجة من البعثرة والتشظي، لم تكن موفقة في أغلب الأحيان، لكن المشهد يظل كلمة السر، بحركة الشخصيات فيه وجمل حوارهم ووصف الوضع المحيط بهم برشاقة ورهافة، حتى تكاد تشعر في مواضع كثيرة أنك تقرأ سيناريو مشوّق، لا ينقصه إلا مخرج موهوب حتى يحوّل هذا الحبر على ورق إلى صور على شريط السينما، وبمناسبة السينما، تذكرت بينما أقرأ فيلم ضحك ولعب وجد وحب، الذي كان أقرب إلى ترنيمة عشق لحي مصر الجديدة، هنا أيضاً ترنيمة عشق للحيّ نفسه، لكن في لحظة زمنية أخرى، ما بعد الناصرية، تحديداً من عز السادات وحتى زلزال 1992، بكل ما سبقه من زلازل اجتماعية مدوية على مستوى الخلخلة الطبقية تحديداً.

الشخصيات حلوة، صحيح، مكتوبة جيداً وتظهر بوضوح من أول لمحة، هذا ايضاً صحيح، لكنها كانت – بالنسبة لي على الأقل – أكثر من اللازم، أو للدقة أكثر مما قد تحتمله رواية قصيرة، تكاد تكون نوفيلا وفقاً للتعريف الغربي، لا تزيد عن 120 صفحة، مع الكثير من البياض والرسومات. الأحداث أيضاً تتواتر وتحتشد فتمتلئ بها فقرة أو فقرتان نحيفتان، كان يمكن لمحتواهما أن يغطي عشر صفحات مثلاً إذا تريثنا وتأملنا وتمهلنا، دون أن ينتج عن ذلك ثرثرة لا طائل من ورائها بالمرة. لعلّ فتحي سليمان كان يضع عينه على السينما وهو يكتب، أو لعلّه كان يخشى تسرب طيف الملل والضجر إلى قارئه، فأخذه من يديه ولف به ودار في عوالمه الحميمية، التي يعرفها كما يعرف كف يده، في جولة سريعة ومنتشية بالذكريات التي أوقعته أحياناً في فخ الحنين إلى الماضي الجميل، أي النوستالجيا العاطفية الهشة، التي ظهرت بوضوح في فصل صغير، شأن كل فصول الرواية، عنوانه: مشهد لوحة الحياة في محطة فاتن حمامة، حيث الاغتراف البصري، بل بالحواس كلها، لمفردات ذلك العالم الحسيّة الفاتنة، عالم لا هو أرستقراطي فج ولا شعبي محض، عالم طبقة وسطى تضع قدماً في دنيا الأجانب والغرب وقدماً أخرى في دنيا المصريين البسطاء، حيث يكون يوم رأس السنة الميلادية أو شهر رمضان مجرد مناسبات اجتماعية لإخراج زينة شجرة الميلاد أو الفوانيس من الصناديق.
وبمناسبة السينما مرة أخرى، فبينما تتقدم في قراءة العمل تشعر وكأن هناك شريط صوت مصاحب لشريط الصور المتلاحقة، ولا يتمثل شريط الصوت هذا في حوار الشخصيات وفقط، بل في الموسيقى التي يحفل العمل بالإشارات إليها، سواءً الإنشاد الصوفي الشعبي الرزين أو أغنيات الفرق المصرية الشابة في تلك الفترة أو الموسيقى الغربية بأطيافها وحتى غناء الشخصيات ذاتها وترنمها بأعجوبة صلاح جاهين البيانولا.
الأثر الأهم الذي تتركه هذه الرواية في روح قارئها هو الخفة، خفة الروح والظل والسرد كذلك، في وصف سليمان لمظهر الشباب في السبعينات، شعرهم وثيابهم، يقول مثلا: “كنا أول عيال سيس في مصر”، والأمثلة غير ذلك كثيرة على روقان البال والمرح غير المصطنع، لكن اللغة أتت كمهزلة حقيقية من حيث أخطاء النحو والإملاء التي لا يكاد يخلو منها سطر واحد طوال الرواية وهي مسئولية لا تقع على عاتق الكاتب وحده في حقيقة الأمر، بل الناشر كذلك.
بقى أن نشير إلى الرسومات اللطيفة التي زينت العمل للفنان تامر يوسف، ورغم أني لا أحبذ رسم شخصيات أي رواية، حتى يُترك العنان مطلقاً لخيال القارئ فيتصورها كما يشتهي هو، غير أن تلك الرسومات كانت مطابقة تماماً لروح الرواية وشخصياته، روح الخفة والخطأ واللخبطة، فكانت وجوهها المرسومة أقرب إلى فن الكاريكتير منها إلى فن البورتريه.
صدرت الرواية عام م2011 عن سلسلة كتاب الفراعنة التي تخرج من الجمعية المصرية للفنون الصحفية، ولا أدري إن كانت متاحة حتى الآن في المكتبات أم لا، ولكن إذا رغب القارئ في أن يعيش تجربة قراءة خفيفة دون ابتذال، فعليه العثور عليها حتى ولو باللجوء للكاتب نفسه، أحد أشهر ظرفاء الفيس بوك، والذي أظنه سوف يسعد كثيراً بتوفير نسخة منها له.
يمكن أن نعتبر على محطة فاتن حمامة كرواية أولى لفتحي سليمان مجرد وعد وبشارة، وعد بفتح المزيد من صناديق الزينة والحكايات الآسرة والشخصيات ذات الحضور الخاص، وبشارة بروائي لديه ما يقوله، إذا اتخذ قراراً بالاقتراب من سلحفاة الثقل، دون التخلي عن فراشة الخفة.
خاص الكتابة