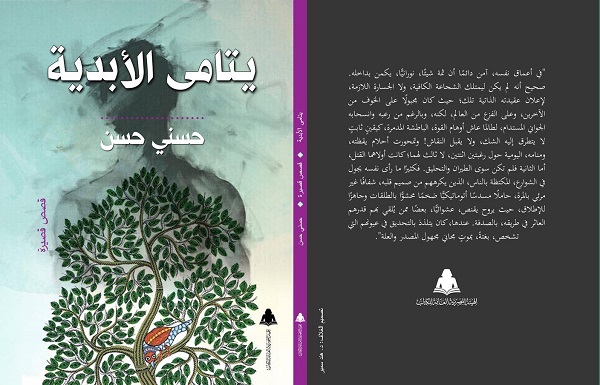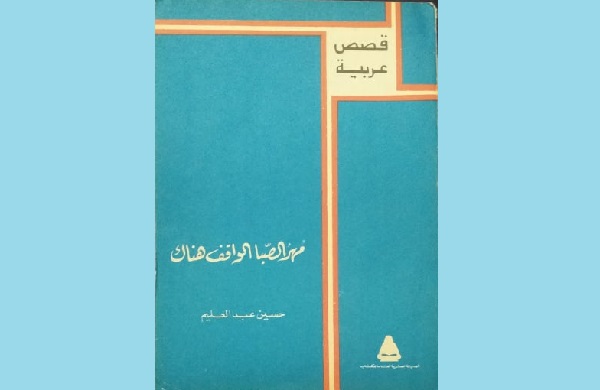د. محمد مصطفى الخياط
بنظرات زائغة تلفت عبد الله حواليه في ارتياب. ثمة هاجس داخلي لا يكف عن الإلحاح أن ثمة شخص غامض يراقبه. كان الهاجس يزوره –في أول الأمر- على فترات متباعدة، ثم راحت تقصر شيئًا فشيئا، حتى أقام معه.
باءت محاولات كشف سر هذا الهاجس بالفشل، وإن كان على يقين أن لأعدائه يدًا في الأمر. هز رأسه مطمئنًا أن كل شيء ما زال على حاله؛ قطع الأثاث تحدق فيه في بلادة، وترسم له المرآة كل صباح صورة مزيفة، تُكَرمشها وتُلقي بها في سلة المهملات فور أن يدير ظهره، تراكمت نفايات الوجوه وبلغت حدود بركة التليفزيون المبتلى بسلس برامج الهلوسة. رفع عينيه إلى الضوء، فوجد اللمبات تمارس غوايتها المعتادة بعيون وقحة.
يترقب مرور محصل شركة الكهرباء أو الغاز، يخترع موضوعات كثيرة علَّ أحدها يغريهم بالحديث معه. ما دفعه للاستغراب، يوم أمسك بذراع المحصل في إصرار، ليتناول معه الشاي، تخلص الرجل منه متوترًا، وهبط السلم مهرولاً يكاد ينكفئ على وجهه من فرط اضطرابه. وكف صبي المكوجي عن طرق الباب، رغم توبيخه له كلما قابله صدفة، فيبتسم الولد في بلاهة. ترحم على أيام صداع مندوبي المبيعات؛ منظفات، مبيدات حشرية، لوازم مطبخ..
– قلت لك ميت مرة بطل تضرب الجرس. لا. بطل تطلع العمارة من أساسه
– …
ويمضي المندوب، ولدًا كان أو بنتًا، بوجه مضرج بالحمرة، وفم من حطبٍ جاف، ويهز رأسه معتذرًا، ويمضي مطأطأً مخذولاً، يلعن في سره اليوم الذي قبل فيه هذا العمل.
قَلَبَ الهاتف مرات عدة، تأكد من تخطي نسبة الشحن 70%، وراجع عد خطوط الشبكة الخمسة، المثلثة الشكل، أكثر من مرة، ليتأكد أنها بكامل قوتها. “هل قرر الهاتف ألا يتلقى مكالمات؟”؛ سأل نفسه. ترددت في ذهنه ما سمعه ذات يومٍ عن مؤامرة تحالفت فيها هواتف ضد أصحابها، وسلمت الشرطة تسجيلات لمكالمات وصور مشبوهة. نظر بريبة لهاتفه وألقاه بعيدًا وقرر ألا يتحدث أمامه، ثم بعد هنيهة لفه في فوطة قديمة ووضعه في أحد أدراج المطبخ، ليطمئن أنه لن يغدر به.
وما أن تدحرجت كلمة “غدر” في رأسه حتى جرى شريط سينمائي يستعرض وجوهًا كثيرة، رجالاً ونساءً، وتوالت مشاهد الخيانة كزخات المطر. مرقت وجوه الخائنين أمام عينيه، كرشق سكاكين، وتزاحمت داخل إطار خشبي واحد، حتى شكلت وجهًا مشوهًا كريهًا. شعر بضيق في صدره، فاندفع نحو زاوية غرفة المعيشة يسب ويلعن، حتى تدافع زَبَدٌ أبيض من فمه، وخارت قواه بعد أن أفرغ ما في صدره.
ثمة خاطر يطرق ذهنه منذ عدة أيام، يقتحمه فيفتح عينيه على اتساعهما ويشرد بعيدًا، ثم فجأة يقهقه عاليًا وهو يتخيل رد فعل الآخرين.
انتفض من جلسته وارتدى ملابسه على عجل ونزل الشارع، لمح عن بُعد رجلاً يقف على الناصية، ربما ينتظر سيارة أو صديقًا له، اقترب منه بهدوء قط يتربص طريدة، وبينما عيناه مرشوقتان في عيني الرجل، قال له بنبرة مُخبر، “لو سمحت.. ممكن أكلم حضرتك؟”، نظر الرجل نحوه مستنكرًا مرتابًا، وابتعد وهو يتمتم “ربنا يوسع عليك”، قهقه عاليًا وضرب كفًا بكف، وكرر المحاولة مع آخرين، منهم من أشاح بوجهه، ومنهم من جامله بكلمات مقتضبة وترك وانصرف متوجسًا، أما عبدالله فكان على عادته يقهقه عاليًا في كل مرة، حتى مع أولئك الذين ظنوه يتسول، فنفَحوه مالاً، قهقه وضرب كفًا بكف ثم دس النقود في يد أقرب عامل نظافة قابله.
وعندما وجد نفسه أمام المقهى ذي التصميمات الحديثة، عاودته رغبة دخوله، فرماه الحارس بنظرة تحد ووعيد، زم عبد الله فمه، ونظر نحوه في غيظ، وقد غشيته ذكرى عراكهما منذ عدة أسابيع والندبة التي خَلَفها في جبينه، عندما رفض الحارس دخوله المقهى، بحجة أن منظره مُريب، “من الأفضل أن انتظر اللحظة المناسبة للهجوم”، قال في نفسه، ثم أردف “وأظنها ليست الآن”، وقبل أن يمضي، كور قبضته، وعقد حاجبيه وهز رأسه، كأنما يتوعده، فشوح الحارس بذراعه، وتركه وانصرف عنه.
من خلف الزجاج، لمح عاملة الكاشير، فانبسطت ملامحه، وأرسل نظرات شاعرية. كانت جميلة، بين الطول والقصر، ينسدل شعرها البني إلى حدود كتفيها. ثم شاهد الحارس يقترب منها ويشير برأسه نحو عبد الله. وبينما تمد يدها نحو الزبون الواقف أمامها بإيصال السداد والفيزا، التفتت حيث أشار، فوجدته واقفًا بميل في مكانه المعتاد إلى جوار عامود النور، كأنه يتوارى به، بينما تعبر عيناه الرصيف الفاصل وزجاج الواجهة، وتتجاوز الزبائن إلى حيث تجلس، هزت رأسها وابتسمت، وتعمدت بين حين وآخر اصطناع حركة تسمح لها أن ترمقه دون أن ينتبه، هكذا ظنت.
مر وقتٌ دون أن تراه، فانشغلت عنه ونسيت أمره، وعندما وصلت رفيقتها لتستلم الوردية، انسلت إلى دورة المياه واستبدلت ملابسها وقصدت الباب الخلفي للخروج. وهناك تجمدت في مكانها، عندما وجدت عبد الله قبالتها تمامًا. فاضطربت وأطلقت صرخة خافتة مبتورة، ووضعت يدها على صدر يعلو ويهبط من وقع المفاجأة، وخشت أن تسقط، فاتكأت على زاوية الباب. هرع العمال إليها، بينما قصد أحدهم عبد الله الواقف كتمثال، وصرخ فيه، “لو شفتك هنا ثاني ها اقطع خبرك”، “ممكن طلب؟”، رد عبد الله كأنما يتكلم من زمن بعيد، زفر الرجل بصوت عال، “اتفضل خلصنا”.. بأصابع مرتعشة أخرج عبد الله من كيس بلاستيكي مهترئ زهرة عصفور الجنة، ومد ذراعه بها نحو الفتاة التي سكن اضطرابها قليلاً، وإن خبأت ذراعها خلف ظهرها كي لا تلمس الزهرة، وعندما رأت تشجيعًا من زملائها اطمأنت قليلاً وتناولتها بخوف. فتألقت بألوانها المزيج من البرتقالي والأزرق الداكن مع خطوط رفيعة على حوافها باللون الأسود تحت ضوء عامود نور تكاثر حول ضوئه الفراش والذباب.
في تلك اللحظة كان عبد الله قد ولى ظهره ومضى مطأطئ الرأس متجهًا صوب الشارع الرئيسي ليبتلعه زحام المارة، ويتناهي إلى سمعه قهقهات عمال المقهى، عندما ارتفع صوت أحدهم ساخرًا، ومخاطبًا الفتاة في آن “حد يخاف من عبد الله؟!.. مخبول وغريب آه.. بس ده مسكين ما يتخافش منه!”.