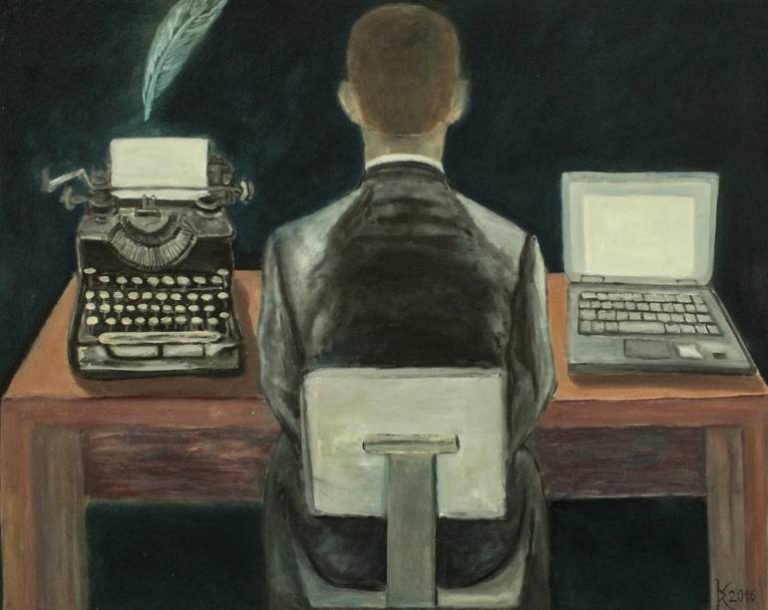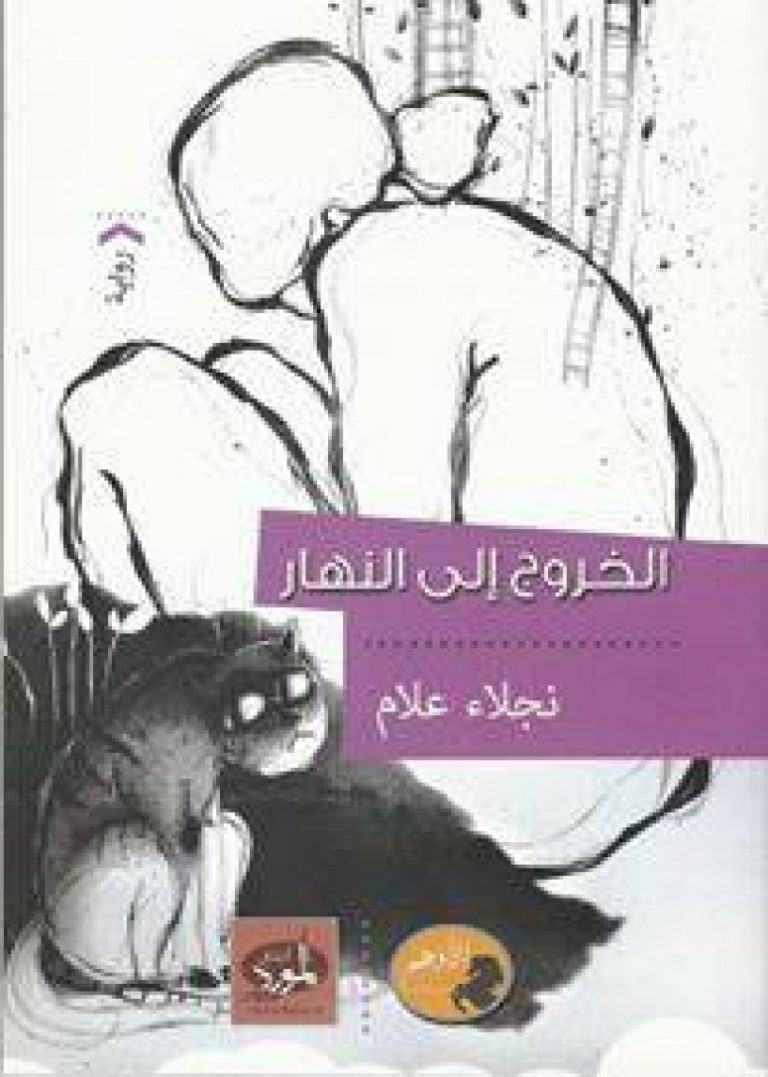أتساءل هنا لأن الطموح الذى يبدو أن دواوين عبد العزيز تطرحه يثير مشاعر عدة عندى من ناحيتين : كقارئة وكشاعرة . مثلا هى مُجازِفة بامتياز حين تختارأن يكون أكثر من ديوان لها حالة من التوزع بين متن مكتوب ( لفظى ) و آخر مرسوم ( صورة أو كارتون ) وتعدنا بهذا فى ديوانها الثانى للكبار وشيك الإصدار ، لكن هناك فارق بين حالتيها حين تكتب ديوان “ بيننا سمكة “ الصادر عن المصرية اللبنانية عام 2013 والذى صدّرته داخليا بعنوان فرعى ” شعر للفتيان و الفتيات و الكبار” رغم تصنيف الدار له كشعر للأطفال وحين كتبت “ عندما قابلت حجازى “ وما أصدرته حتى الآن للأطفال من جهة وبين “ مشنقة فى فيلم كارتون “ الصادر عن شرقيات عام 2009 من جهة أخرى .
طبعا فكرة خلط و مزاوجة الفنون ليست جديدة فعلى سبيل المثال هناك ما قدمه ماكس إرنست الذى زين كتاب الشاعر الفرنسى ﭙول إيلوار “ بؤس الخالدين “ أو ” Les Malheurs Des Immortels” بعشرين عملا ملصقا وهناك الأعمال من woodcuts للفنان راؤول دافى فى محاورته و استلهامه لأشعار أبولينير Le Bestiaire ومحاولة تقديم هذا بشكل مشترك مطبوع والمشكلات التى اكتنفت ذلك نتيجة اختلاف طبيعة الصورة و طبيعة الكتابة أو الكلمة المكتوبة وتذكر بعض المراجع الأجنبية كيف أن أبولينير كان يشجع صديقه دافى على الاستقلال بموضوعاته وكان يشير إلى محفورات دافى المستلهِمة لأشعاره بأنها ” أشياء ” دافى ” Duffy’s Thingies “ وهناك ما قدمه دافى كذلك موظفا رسومه بالليثوجراف ( وظفه كتقنية مع مالارميه ) للتعبير عن إحساسه بكتاب أبولينير Le Poète Assassiné وهناك مجموعة القصائد التى قدمها الروائى الراحل إدوار الخراط عام 1996 بعنوان “ ضربتنى أجنحة طائرك “ ومثلت قراءة غير تفسيرية للوحات أحمد مرسى وتم نشر الكتاب مزينا برسوم الفنان بالداخل بما يفرض على القارئ أو المتلقى مهمة تجميع النصين المرئى و المكتوب إذ يتجاوران و كل منهما مستقل بذاته كما نجد محاورات غادة خليفة الشعرية مع لوحات عديد من الفنانين ضمن تجاربها دائمة الحيوية و البحث عن طرائق جديدة لفيوضها الشعرية وأساليب و موضوعات تعبيرها المجترئة المتجددة ” فى المرسم ” على موقع الكتابة الذى تقدمه خليفة أسبوعيا وهناك شاعرات كاللبنانية سوزان عليوان مزجن من سنوات فى متونهن الشعرية بين الرسم و الكلمة لكن توظيف عليوان للرسم و نوع الرسوم كان شديد الاختلاف عن ما لجأت إليه عبير.
عبير عبد العزيز فى ” مشنقة فى فيلم كارتون ” و ” بيننا سمكة “و “ عندما قابلت حجازى “ تؤكد حرصها على تضمين الرسم بجوار الشعر أو الكلمة المكتوبة على نحو لصيق يفتح شهيتنا لأسئلة تظل بلا إجابات تحديدا حيال الديوان الأول ” للكبار ” إن جازت التسمية وأقصد ” مشنقة.. ” فيما يتصل برؤيتها لدور الكلمة المكتوبة ، الكلمة الشعرية و طاقتها أو بالأحرى قدرتها على التعبير – وحدها – لتجسير المسافة بين خيالين ، خيال المبدع وخيال القارئ من ناحية وأيضا فيما يتصل برؤيتها لمسألة تكامل الفنون وشعورها بالقلق الذى عبرت لى عنه من عدم تواصل الشعر مع جمهوره المفترض خارج قاعات الندوات .
فى عمل مثل ” بيننا سمكة “ بحجمه الكبير ( عريض بغلاف مرسوم ملون و مُفرِح ) و صفحاته الكبيرة الداخلية و مساحة الرسوم الغامرة فيه حيث الرسم على كل صفحة يقابله الكتابة أو القصيدة المعنونة على الصفحة الأخرى أو على نفس الصفحة فيما اتفقت معنا على أنه شعر لجميع الفئات العمرية ما يعيدنى إلى مشوار عبد العزيز مع كتابة أدب الطفل وظللت أتساءل لماذا السمكة بالذات تيمة و بطلة هذا العمل الشعرى وهى كائن له دلالته فى إرثنا القبطى والأيقونوجرافيا المسيحية فى عصور سابقة .
عبير عبد العزيز أسرّت لى بأنه فاتها التنويه فى مفتتح ديوان “ مشنقة فى فيلم كارتون “ إلى ضرورة توجه القارئ لمشاهدة فيلم الرسوم المتحركة الذى وظفت رسومه وحولتها إلى ساكنة فى متن الديوان وأن هذا كان سيشكل فارقا جوهريا فى التعاطى مع ديوانها .
قررتُ مشاهدة الفيلم الأصلى بعنوان “Manipulation “ عام 1991 لصاحب فكرته ومخرجه Daniel Greavesالذى حصلت هى على إذن باستخدام المئات من صوره والمؤسف أن هذا الاقتراح منها جاء بعد إنجازى لهذا المقال لكنى وجدت بعد مشاهدة الفيلم أن استقبالى للديوان لم يختلف جذريا فأنا حين أشاهد فيلم ” أنيميشن ” مثلا أتعاطاه بصريا ونفسيا بصورة مستقلة كعمل مكتمل الأركان ، بالانفصال الذى قدمه به صاحبه عن الكيفية التى سيستخدمها به فنانون و شعراء من بعده ، وعبير حين توظف أو وظفت مشاهد من الفيلم فى متن مكتوب فأول تنازل أو اضطرار هو تحويل المتحرك إلى ساكن . هذا يعنى – مهما تقاطع الفيلم ( كما رأت هى ) مع شعرها المكتوب بعده – أن التجربتين شديدتا الاختلاف من البداية تحكمهما مدارات و طاقات وإمكانات مختلفة ، وكما أن إدخال عنصر اللغة أوالكلمة المكتوبة يمكن أن يغير ” نوع ” الفن الذى نتعاطاه والذى نقترب منه بميراث تراكمى فى التعامل مع ” ملامح ” كل نوع من الفنون ( و هى طبعا تريد تغيير ذلك ) فكذلك الصورة – كما أتصور – لا بد أن تغيّر جوهريا فيما نستقبله من لغة مكتوبة إن شعرية أو سردية خاصة لو تحول توظيف الصورة إلى هاجس كما هو عندها ، و يمكن مقارنة ما نحسه من متعة بعد الانتهاء من قراءة ديوان شعر متميز بما نحسه حين نفرغ من قراءة ما يندرج تحت نوع ” الكوميكس ” التى ليست عن الهزل فقط ، ولدينا فى الروايات المصورة إسهام مجدى الشافعى من سنوات بروايته التى كانت تعرضت للمصادرة “ مترو “ وهناك بعض روايات الشاعرة و الرسامة / المصورة البريطانية Laura Dockrillالتى ترسم فى كثير من كتبها وكتبت للأطفال كما يمكن تأمل استمتاعنا بالروايات التى أحَبَ كتابها إدخال الرسم فى أضيق الحدود بالاستعانة برسمين جرافيتى للأعضاء التناسلية ضمن متن سردى طويل كما فعل الروائى البريطانى جون بيرجر فى روايته البديعة ” G“ وهناك ولع بالتجريب فى الخارج و نعمة التجريب تملك شطحات باسقة و يانعة حتى لو تعثرت أو أدت إلى ” حارة سد ” أحيانا. نجد فى سياق متصل تجربة الشاعرة ستيفانى بيرجر و الشاعرة كارينا فين المشتركة فى ديوان الأيموشنات أو أيقونات الكمبيوتر التى تدخل كمكون أساسى فى تركيب جمل القصائد الثلاث عشرة لديوانهما البصرى الأيقونى ” The Grey Bird “ وهى تجربة مرهقة حتى و إن كانت شيقة فى قراءة كل قصيدة كما جربتُ وللحق لم أستطع التعامل مع القصائد بجدية ، بمعنى أنى لم أشعر بشىء – عدا الفكاهة – حين كنت أجد فعلا إنجليزيا محذوفا و تم الاستعاضة عنه بأقرب إيموشن بديل كمعنى فنجد رسما لحريق أو نارا مشتعلة بدلا من فعل ” إنى أحترق عاطفيا ” عدا أن جهد ترجمة الصورة ( الإيموشن ) إلى كلمة كان يأخذ من التركيز الذى تحتاجه طاقة المفردة لإحداث التأثير الناتج عن تركيب و بناء الصور والمعانى بانسيابية.
فى كل هذه الحالات سيكون لكل منا موقفه الجمالى المختلف تجاه كل شكل من الأشكال السابقة، سيكون على كل منا أن يصارع أفكاره أو افتراضاته الداخلية عن كل نوع أثناء القراءة وسيكون العنصر الحاسم مدى تحقق المتعة من عدمها نتيجة لهذا الاقتراب أو التعاطى.
وهناك فى بريطانيا دواوين وأنطولوجيات لشعراء مرموقين موجهة للأطفال برسوم وتستهدف الكبار و الصغار كما تذكر دور النشر وأيضا المرحلة العمرية من 11 إلى 16 عاما وببعض تلك الأنطولوجيات قامات شعرية مثل جريس نيكولز وبنجامين زيفانيا الخ.

فى “ مشنقة فى فيلم كارتون “ يظل القارئ موزعا – ربما كما تريده الشاعرة – ما بين الصورة المرسومة و الكلمة المكتوبة فالنصوص بلا عناوين مستقلة وإنما تندرج تحت عناوين داخلية لكل قسم أو مجموعة من القصائد. وقد صرحت لى الشاعرة بأن ديوان ” عندما قابلت حجازى ” هو الوحيد الذى كتبت نصوصه من وحى الرسوم التى اختارتها لفنان الكاريكاتير المذكور بينما كل دواوينها الأخرى كانت قصائدها فيها مكتوبة قبل الاستعانة بالصور .
فى ” بيننا سمكة “ نحن فى حالة تأهب وتقبّل لكون العمل للأطفال أكثر وهنا أعطت فكرة العناوين الداخلية لكل قصيدة انطباعا بانحياز ما أقوى للكلمة حتى فى وجود الرسم أو الصورة ، العنوان يمضى بخيال القارئ أو المستمع إلى منطقة أكثر تحديدا فى علاقة صاحبه / الكاتب أو الشاعر / الشاعرة مع الكلمة ، مع حرصه أو حرصها على ” توجيه ” القارئ نحو رؤية و إحساس ما بالنص الذى بين يديه ، بتدعيم استقلالية النص المكتوب فى مواجهة ترجمته أو التعبير عنه بواسطة فن آخر مجاور لكن لأنه ” للفتيان والفتيات و الكبار ” فقد أبقانا طغيان مساحة الرسم على الصفحات بصريا مع توصيف عبير المقوس الذى ذكرته فى حالة متأرجحة كذلك هنا تجاه متنها الشعرى الذى يُفتَرض أنه لقراء يشملون الكبار ، فى حين كان لاعتماد رسوم داخلية من فيلم Manipulation فى ديوان “ مشنقة فى فيلم كارتون “ تأثير جعله – بالنسبة لى – مناوئا تقريبا لتأثير الكلمة و هذه المناوأة قد تكون نتيجة أو ثمنا لطموح كبير قديم بدأ بدمج بعض الفنون معا فى حضارات مختلفة فنجد “ الإيماكى “ فى التصوير اليابانى والذى يمثل لفائف سردية مصورة حيث تجمع كل لفيفة الأحداث فى تعاقبها كحركةً و مشاهد كأنما هى شريط سينمائى، وفى منتديات شعرية فى أوروبا أخذ لدى بعض الشعراء شكل تأدية الشعر بواسطة عرائس و قول أو قص حكاية الشاعر عبر دميته التى يحركها بيديه ( الشاعر الفرنسى ﭙاتريك دوبوست حيث قابلته فى غير مهرجان شعرى و شاهدت أداءه ) وأخذ هذا الطموح أصحابه إلى مناطق جديدة فى زحزحة توقعات المتلقى واستنامته حين قدم البعض شعره فى ميدان البلدة مثلما حدث فى مهرجانىّ لوديـﭪ و سيت الفرنسيين الشعريين أثناء قيام فنان تشكيلى برسم فورى ( مصاحب ومستوحى من القصيدة أثناء عملية الإلقاء ) وأثناء عزف قطعة موسيقية من موسيقى على نحو ارتجالى أثناء قراءة الشاعر لقصيدته ولم نشعر أثناء الإنصات للشعر بما أسميته المناوأة، بل لاحظت مسألة واحدة و هى أننا ننصت للشعر مثلا طلبا للتركيز أى ننصت أولا حتى لو كنا بدأنا بمشاهدة و متابعة ما يرسمه الفنان أثناء إلقاء الشاعر ، ونتشرب الموسيقى التى نكاد نظلمها لكونها تحتاج لإنصات روحى لا يقل تركيزا وتأملا ولكن بما أننا لا نستطيع بحكم تكويننا سوى أن ننصت للقصيدة أو نشاهد اللوحة أو نستمع للمقطوعة الموسيقية ( فى تتابع زمنى ما وبقدر ما مهما ادعينا العكس) فقد استمتعنا لكن بشكل مبهم تداخل فيه ذلك الظلم الحتمى لكل هذه الفنون مجتمِعة ، كأنما لا نملك سبيلا لكسر الملل سوى بهذه المطلبية المتداخِلة ، أو بتفجير التشوش الهادر الذى يسكن أعماقنا ! .
وقد لجأت عبير إلى استخدام البانتومايم مصاحبا للشعر ضمن مشروع “ ذات “ للشاعرات كما اقترَحتْ في سياق المشروع صيغة لقراءة الشعر عبر إخراجٍ مواز فى فيديو لرسوم الفنان ماتياس أدولفسون و بثته عبر الفضاء الإليكترونى و صفحات التواصل الاجتماعى من أعوام قليلة . كذلك أقامت معرضها “ عندما قابلت حجازى “ بعد وفاة فنان الكاريكاتير الشهير كما فهمت ( مقاطع على ” خدديات ” أو مربعات قماشية ملونة زاهية بجوار الأطفال أو الكائنات المجاورة على نفس مساحة المربع الذى يوضع تجميليا على الأرائك أو الحوائط فى البيوت حيث يتحرش بنا الشعر و تقفز عليه عيوننا فى كل خطوة داخل المنزل ) وقد وظفت الشاعرة عنوان ديوانها بنفس الاسم ليصبح عنوانا لمعرضها فى تجربة مزدوجة بفاصل زمنى ، توازت فيها مع الرسوم التى اختارتها من عمل الفنان وعبرت عن هذا الاشتباك بطريقتين مرة عبر كتابة نصوص من وحى أعماله أخرجتها فى عمل وصفته بأنه ” للفتيان و الفتيات ” ومرة ثانية حين عبرت بشعرها عن الاشتباك مع رسومه فى المعرض بالقطع القماشية المنَفَذّة . كل هذه أشياء تذكر بتاريخ طويل برزت فيه أسماء لفنانين من قامة دافى استخدموا تصميماتهم لقصائد شعراء كما فعل دافى محولا تصميماته من وحى قصائدOu Cortège d’Orphée Le Bestiaire إلى طباعة على النسيج والقماش و أيضا ظهرت على السيراميك ثم بعنوان تصميم Orpheus فى تنجيد الأثاث ( مستوحى من العنوان الأصلى الكامل من أبولينير لمجموعة الأشعار تلك ) عام 1939 بالمشاركة مع The Aubusson Tapestry Workshops( الرسم بالأوبيسون ) وهناك الرسامة الأفرو أمريكية Faith Ringgoldالتى كتبت للأطفال و جمعت فى أعمالها وهى تتحرك بين وسائل تعبيرية فنية مختلفة بين حياكة اللحاف كتقليد أفرو أمريكى من أيام العبيد ( توارثته من جداتها الكبريات ) تحكى عليه حكاية الجنوسة و العِرق وحكاية عائلتها مع الرسم على القماش و القصة القصيرة التى كتبتها للأطفال و بعض الناشرين كانوا يطلبون بعد مشاهدة معرض لها أن تحول محتواه إلى مجموعة قصصية .
مؤخرا قدمت عبير فى معرضها “ أبراج و كارت بوستال “ المُقام أواخر عام 2015 فى الجريك كامبوس بالقاهرة مزاوجة شعرية فنية بين أعمال تشكيلية لفنانين أوروبيين و بين شِعرها على ظهر كل كارت فلماذا أحسست بوجود فارق رئيس بين التجربة التى شاهدت سوابقها فى الخارج و بين تجربة عبير عبد العزيز فى متنها الشعرى فى ” مشنقة فى فيلم كارتون “والذى وجدت نفسى معنية به تحديدا بوصفه تجربتها الشعرية الأولى التى للكبار وهل من العدل محاولة تقييم شعرية أى شاعر من عمله الشعرى الأول ؟ .
أظن الأمر يتعلق بكلمة ” شاهدت ” ، بإحساسى أنى أشاهد عرضا جوهره تخليق مساحة متشابكة بين فنون عدة من بينها الشعر و بين مطلبي من قراءة ديوان بعينه ، بين فعل المشاهدة المركبة و فعل القراءة الذى يجعل مذاق العمل مختلفا . أستطيع أن أستمتع بعرض أنا متجهزة نفسيا لتقاطع فنونه الارتجالية المتعددة مع بعضها البعض ، إلى كون الشعر أحد عناصره الفنية و ليس سيدها الأوحد أو أكون مسترخية مع فكرة مسرحة الأداء فيه أو لقبولى مسبقا بفكرة قراءة نص شعرى أو سردى على مسرح، أو إلى أداء قصيدة بوسائط يختارها الشاعر واقفا أمامنا كبطل مسرحى بدوره ( دمية يحركها و يقرأ نصه عبرها ) و موظِفا أحيانا بعض الوسائط الأخرى مثل الفيديو آرت الخ ، بينما حين أمسك بكتاب فأنا أبحث فيه عن الطاقة القصوى للكلمة وخيالها بحد ذاتهما والتوقف فى منطقة قد تكون بينية من التساؤلات بين تلك الطاقة المحتمَلة و بين ما استطاعت الكلمة فعليا عبر شاعرها أو كاتبها أن تثيره فىّ ، أن تساعدنى على بنائه بخيالى من متتاليات و صور ومعانٍ تفجر بداخلى أحاسيس معينة، و هو جهد ينتاب القارئ بالضرورة أثناء رحلة الاستدراج التى يمدها إليه الشاعر أو الكاتب و يتركه بعدها و قد غاص إما بكل روحه أو بنصفها أو ربعها فقط فى غمر شعره أو سرده. ومما لا شك فيه أن علاقتنا بالكِتاب شديدة الخصوصية والزهد و العزلة .. بعيدا عن الجميع ، كأنما نخلع ملابسنا فى غرفة مغلقة و لا نريد لأحد الإطلاع على أجسادنا. معنا الكاتب أو الشاعر .. هو أيضا سبقنا فى خلع القشور و الطبقات عن روحه و يرانا كما نراه أو بالقدر الذى أراد لنا به أن نراه و نرى فى حيز كتابه الجنة ( إن نجح ) حيث لا نرى عرينا إذ لم يعد مصدرا للحرج .
هى تريدنا أن نراها شاعرة لكن بأشياء أخرى مصاحبة للكلمات ، قد تكون أشياء ” مشوشِة ” و مشتتِة لنا قسريا فى تلك الحالة شديدة التباعد و الفردية لعملية القراءة الصامتة بعينين فى غرفة مغلقة ، وبالتالى هى أيضا تريدنا أن نرى الشعر بطريقة مختلفة ، نرى قابليته للاشتباك والتقاطع مع حالات وتجاذبات من فنون أخرى. هى شاعرة لا تخشى الأصوات المناوئة التى قد تعلو ذبذباتها أثناء فعل القراءة ، وهى جسور انشغلت بحالات معقدة تخص فنونا مختلفة و ليس بِهَم الشعر وحده ، لا خوف عندها و لا قلق من نتائج تجريب من هذا النوع و هذا يُحسب لها أما نتائج التجريب ذاته و مدى نجاحه فى كل منجز شعرى فهو أمر ربما يتصل بمدى تأثير الحمولة الشعرية لكل ديوان على حدة و أيضا بالذائقة المختلفة لقرائها المختلفين.
قد يقول قائل : إذا كان القارئ فى مصر لم يعقد صلحه بعد مع قصيدة النثر فلعله ليس من الحكمة مضاعفة أرقه حيالها بإضافة فنون أخرى داخل متونها لكن عبد العزيز ليست معنية بهذا وهو ما أعجبنى . مع هذا يبقى التساؤل ماذا ستفعل بشعريتها و قد ” ورطت ” نفسها فى استقدام فنون مختلفة مصاحبة فى متونها المنشورة، وكى أكون دقيقة أذُّكر بأنى أكتب هذا المقال عن ديوان ” مشنقة فى فيلم كارتون “ فهو كل ما أملكه من دواوينها التى للكبار .
من حقى التساؤل كيف ستطور تلك الشعرية إذن فى ضوء اختيارها الجمالى القائم على مجاورة الفنون و ليس انفصالها ولا تعاشقها ؟ بل أحب أن أتحاذق و أفكر : بماذا سيشعر التشكيلى أو رسام الكاريكاتير أو الموسيقى حين يمسك بديوان لها ، وخاصة التشكيلى ؟. هل سيشعر بفرح لوجود الرسم مجاورا أو ” شارحا ” و مستلهِما للكلمة أو المفردة أم مجاورا بلا شرح أو علاقة ..أم سيشعر بـ ” المناوأة ” التى ذكرتُها و لكن من الكلمة أو اللغة على الصورة ؟ وهل من المهم أصلا أثناء إمساكى بكتاب ما أن أكون أنا أو كاتبه قد قررنا سلفا و عرفنا هويته : رواية ، شعر ، نثر ، أدب طفل ، قصة ، أدب رحلة ، مسرح ، مقال ؟.
بالنسبة للسؤال الأخير ستختلف الإجابة من شخص لآخر ولكن بالنسبة لى قد تكون الإجابة ” نعم ” حتى لو انقلبت هذه الـ ” نعم ” إلى اعتراض ورفض دامغ منى بعد قطع مشوار فى القراءة بمعنى أنى قد أجد نفسى حيال نص يرفض صاحبه عنونته بصفة ” شعر ” أو صفة ” رواية ” مؤثرا كلمة ” نص ” وأحيانا يختار كلمة ” قصة ” أو ” رواية ” وأرى أنا الأمر على نحو مخالف للصفة التى أطلقها صاحب العمل على عمله . هذا حدث و يحدث أثناء علاقتى بكتابات البعض خاصة من الروائيين.
أيضا يمكن التساؤل حول المساحة التى تحاصر / تحرر عبير عبد العزيز خيال القارئ بها لدى متابعته اللاهثة للمستوى اللا لغوى لنصوصها ، فهى تلكز هذا القارئ الذى عليه أن يتعامل مع علامات و دوال اللغة وصورها ثم تسحبه إلى منطقة رمال ناعمة بعلامات تخص فنا آخر ،علامات عبر لغوية trans-linguistic قد تربك عملية القراءة بصورة أكبر .
ربما نكون – بحكم لعنة النضج – أكثر استعدادًا وترحيبا لتقبل الرسوم المصاحبة لعمل ينتمى من حيث Genre إلى أدب الطفل من أن نتلقى تلك الرسوم فى عمل يوصف بأنه لنا أو حتى لا يوصف بأى شىء عدا كونه شعرا ويحتفظ بتلك الرسوم التى أرغب فى فهم مغزى توظيفها فى ديوان “ مشنقة .. “ خاصة وأننا نعرف أن الرسوم كانت أصلا متحركة وحين يتم إجهاض هذا لصالح عمل مطبوع تختلف المسألة تماما . وطبعا لاحظت تلك الأحايين النادرة عندما اقترب الرسم المختار من القصيدة فى الديوان المذكور .
يقلقنى شخصيا الاستعانة بفن الكارتون وبالكاريكاتير الذى يأتى مكتملا بطاقته الساخرة والفلسفية و يتم تطويعه لصالح النص الشعرى المطبوع والمتوجه ( بلا تصنيفات ) للجمهور خارج دائرة الطفولة، تلك الخطوط البسيطة كرسوم غير متحركة جعلت الشعر يقف بجانبها موقف المذنب الذى ستُترَك له فرصة تعليق مقتصِد جدا كجملة أخيرة يتفضل بها السيد الرسم عليه . هذا منبع قلق جمالى خاص دائم الإيحاء – لى على الأقل – أن الشاعرة تنتصر للقدرة الأعلى للصورة كعلامة عبر لغوية مقارنة بالكلمة أو العلامة اللغوية فى تخليق ما تريد من معنى وهذه العقيدة عندها تمثل فلسفة خاصة تستقبل فيها الشعر كما تستقبل مفردات الحياة بعينيها ، بلا لحظة فصل ، المعنى عندها لا يتواجد إلا بنشدانه عبر الحرف والرسم .. هذا التلازم الشرطى عندها هو المعنى الذى ربما ترى أن الشعر كمفردات تبدو لها مصمتة لن يصل إليه لو وقف وحده كما لو كَتَبته بعينين مغلقتين .

ربما هذا حجم إلحاح فكرة أن العالم كله فيلم رسوم متحركة ليس من المشروعية تغيير هويته الأصلية تلك بإقصاء الصورة فى لحظة الكتابة عنه فالتصوير يقترب من مراكز الحياة البدائية والتنقل من وسيط فنى إلى آخر يمثل ما ارتآه هنرى ميشو محاولة للعثور على العالم مرة أخرى بطريقة مغايرة ، من نافذة مختلفة للتعرف عليه و على الذات ، مع هذا فتجربة طباعة ديوان أى النشر الورقى فرضت و تفرض قيودها و قوانينها التى لم تستطع عبير رغم كل حسن النية أو حسن الحلم أن تغيّرها حين أدخلت عنصر الصورة ناهيك عن كونها فى الأصل صورة متحركة.
أوقاتا حين أقرأ لعبير لا أجد المعنى حتى داخل اللغة . وقد يكون من المثير تأمل وضعية يكون فيها قارئ الشاعرة لا يعرف اللغة العربية التى ستظهر حروفها له وقتها قريبة من أشكال الرسم ، كما نشعر حين نشاهد لغة أكثر ” غرابة ” من تعودنا على شكل الحرف اللاتينى ، و أقصد اللغة الصينية أو اليابانية أو الهندية. و من المثير كذلك التفكير هل يمكن أن يتحول مثل هذا القارئ الذى لا يعرف العربية إلى التعاطى مع دواوينها وبالأحرى ديوان “ مشنقة “ من خلال الاعتماد على الصورة فقط ؟ .
مهمة تعليق المعنى تنبع من قناعة جمالية مفادها أنه ليس لكل شىء معنى وأنا أصدق هذا بينما الاكتفاء بالإيحاء به لأغراض جمالية هو أمر يتعرض للمخاطرة و المناوأة بفعل ” الإيضاح ” شبه المحتوم الذى تقدمه الصورة أو الرسم بحكم طبيعة الصورة أو بفعل الجهد الذى سنبذله إزاء جدلية الرسم و الكلمة ، جهد استجلائى هدفه محاولة الربط بين الإثنين أو العثور على أدنى تشابه وتقارب بينهما كما فى “ مشنقة فى فيلم كارتون “ ولا يفيدنا كثيرا هنا المضى وراء مقولات شهيرة تومئ إلى العلاقة شبه المستتبة أو التطبيع الذى جرى من قرون بين الشعر و التصوير من نوع ” مثل الصورة كذلك القصيدة ” ويحق التساؤل هل تريدنا عبير عبد العزيز أن نبذل جهدا يتصل بترجمة محتوى الصورة أو الرسم إلى لغة ، إلى خطاب لغوى موازٍ ، إلى جمل والعكس مع النص الشعرى أى أن نبذل جهدا فى تحويل الكلمة إلى صورة أو رسم؟ أم تُفضّل أن نظل مؤرجحين جماليا و بدرجة ما ثيماتيا و نفسيا ؟ أم لا يعنيها أن يقوم البعض بتجربة وضع أيديهم على إحدى الصفحتين : إما صفحة الكلمات أو صفحة الرسم أثناء القراءة أو على الجزء الذى يخرج عن حيز اللغة؟.
لكن لماذا يجب أن يعنيها هذا أصلا ؟. الشعر لا ينتظر محاكمات نقدية ، حتى لو كان ينتحر وأوقاتا كثيرة أفقد شجاعتى التجريبية وأبحث فى خيالى عن الجديد عندى الذى أريده أن يفاجئنى . لكن المؤكد أن عنصر الرسم فى دواوينها التى ” للفتيان و الفتيات والكبار ” يمثل دورا حيويا فى صلته بالمرحلة العمرية المفتوحة التى تصفها الشاعرة بأنها ” للفتيان و الفتيات ” ، حيث تشكل الأبعاد البصرية و الملامسية فى أطوار الطفولة و بدايات المراهقة أساس استكشافنا للعالم ولأنفسنا.
هذا التعسف الصارم منى فى الرؤية وفى التعامل مع شعر الغير لا علاقة بينه و بين قدرتى وإتجاهى أوقاتا لتعاطى الشعر قراءة أو كتابة على خلفية مقطوعة موسيقية أو فى أعقاب مشاهدتى لعمل فنى ما( لوحة أو عرض مسرحى أو راقص الخ ). هذه تجربة أخرى و أظن قصائد / قراءة غادة خليفة بالشعر لأعمال فنانين تقع فى هذا المجال و فى تلك القصائد أو الحوارية الشعرية التى تعقدها خليفة مع لوحات وأعمال تختارها وتتأثر بها أتذوق شعريتها المختلفة كثيرا عن شعرها الذى لا ينبع من الحالة المغايرة المشتبكة مع أعمال فنية لآخرين .. هناك فارق واضح بين شعرها فى منطقة الإسار البصرى و اللونى لأعمال آخرين والتى تحمل وعيا يبدو سرياليا مضفورا مع كونكريتية ما تحاول بها ترويض الإيحاء السريالى وبين أفق شعريتها هى – و هى التشكيلية – حين تكتب قصيدتها أو تبحث عنها فى مكامن روحها. الحالة التى تحاور فيها لوحات الآخرين حالة جميلة وانتابتنى من سنوات فى كتابة سرية بينى و بين نفسى بعد مشاهدة معارض تشكيلية لكن بالتأكيد تتجلى خليفة بشكل مثير الاختلاف فى شعرها ” الخالص ” .. مع استحالة و هزل هذه الصفة الأخيرة ، ففى شعرها الذى ليس مبنيا على قراءة واشتباك مع لوحة لغيرها الصور أقل فى إيحائها السريالى وثمة بساطة فى تراكيب الصياغة و فى مفرداتها مقارنة بنصوصها المستوحاة من لوحات لفنانين آخرين كما أن علاقتنا باللوحة و النص فى محاوراتها تلك لا يشوبها التوتر الذى قد نعانيه لدى تعاطينا لقصائد عبير عبد العزيز مع الرسوم المتتالية – خاصة الكارتونية – التى تختارها.
فى قراءة / مشاهدة ديوان ” مشنقة فى فيلم كارتون “ واجهتنى الإشكالية التى أحسب أن تكون واجهت كثير من القراء و أقصد التنقل البصرى المستمر بين الكتابة و الرسم أى بين يمين الصفحة و يسارها بل بين أجزاء الرسم ذاته يمينا و يسارا و صعودا و نزولا وكان الأمر يستدعى منى معاودة قراءة النص المكتوب غير مرة ثم – أحيانا – خيانته من جديد بالتوجه إلى الرسم المجاور و هو ما وجدته فرض ما تصفه سيزا قاسم بمسارين للقراءة ” أحدهما تسلسلى تعاقبى زمانى ” يخص اللغة والآخر يقترب مما وصفته هى ” سياقى تجاورى آنى ” ووجدتُ أنا أنه قد يخص وجود مساحة الرسم على الصفحة المقابلة ( وأحيانا فى نفس الصفحة لدى عبد العزيز ثم تكثيفها للرسوم بأواخر المتون مرة أخرى) وقد لا يخصها لأنه بالتركيز على الرسم كثيرًا ما نجده منبت الصلة بالقصيدة أو المقطع الشعرى الذى اختارته الشاعرة ليجاور الرسم أو الصورة وهى ذاتها أفادتنى بأن أشعارها على ظهر كروت الأبراج فى معرضها “ أبراج و كارت بوستال “ لم تتم كتابتها خصيصا لمصاحبة رسوم الفنانين المستخدَمة كما أسلفت و مع هذا فتجربة هذا المعرض كانت جميلة رائقة فى تقديرى وأعمال الفنانين جميلة مع أنى لم أتوقف كقارئة و شاعرة عن تلمس أسباب اختيار كل قصيدة و طبعها على ظهر الكارت المطبوع عليه كل لوحة أو صورة بعينها والتساؤل عن ” السبب ” أو المعيار الذى اعتمدته الشاعرة فى اختيار قصيدة معينة على ظهر كارت به صورة معينة للأبراج الفلكية أو لوجوه نساء طالما لم تكتب القصائد من أجل الصور المختارة .
إن وجود صورة أو رسم كفيل – بحد ذاته – بفرض رؤية و تعاطٍ بصرى مغاير مع النص مقارنة بالنص الذى لا تصاحبه صورة ذلك أننا– لدى وجود صورة – لا بد سوف ننظر إليها ، سوف نتعرض للغواية البصرية ، و نخضع لما تريده الشاعرة منا واثقة أننا سنفعله نتيجة هذا الحث منها Make – see. و قد يكون لنوع الصورة أو الرسم الموظف إضافة نوعية حاسمة فى تخليق إيحاءات معينة أو معاكسة فالاستعانة بالكاركاتير تختلف عن الاستعانة بلوحة لديجا أو كليمت أو بصورة لمنحوتات مايكل أنجيلو .
و ما يضيف إلى المعضلة هو ما حاول ﭙول كلى Paul Klee شرحه لحركة العين على اللوحة – أى لسياق آخر وهو تأمل العمل التشكيلى البحت – حين يقول :
” تتحرك العين على السطح مثل الحيوان الذى يرعى : إنه يقوم بهذه الحركة لا من أعلى إلى أسفل فقط بل من اليمين إلى اليسار أيضا ، وكذلك فى جميع الاتجاهات التى ينجذب إليها ، إنه يسلك الطرق المخطوطة فى العمل الذى يشاهده وإبداعه نفسه مشروط بحركة معينة غير أن هذه الحركة تتوقف فى لحظة ما فى الزمان و المكان “. 1
فى تأملنا للوحة فإن العين تقوم بجانب المسح البصرى السريع لأول وهلة والذى يعقبه التدقيق ومراجعة المشاهدة ، نجد أعيننا تتجه إلى اختيار ” تفصيلة ” أو جزئية محددة من تفاصيل العمل الذى نشاهده للتركيز عليها ثم الاتجاه إلى غيرها و هكذا . عملية البصر أو المشاهدة بالأحرى هى عملية انتقاء طوال الوقت، والانتقاء يعنى الفرز أى الاستبعاد والحذف النفسى والانحياز الصامت لأشياء و توهم وجود معان معينة فيما نراه أو نشاهده فنحن لا نرى إلا بما هو غير حر فينا ، و نبحث دائما فى الفنون عما يحرر الأجزاء الحبيسة فى أرواحنا وميزة قراءتى لعبير هى ما منحتنى إياه من اشتباك مع نفسى .
توضح سيزا قاسم فى كتابها ” القارئ و النص : العلامة و الدلالة “ قناعتها بكون الفن ظاهرة لا يمكن أن تتجزأ ، وعدم استطاعتها فصل الأدب عن التصوير والنحت و الرقص و الموسيقى مشيرة إلى ارتباط التصوير والأدب بوشائج جعلتهما – كما تقول – ” الفنين التوأم ” حيث الحركة بينهما تسلك طريقا مزدوجا ” ذهابا و إيابا من الواحد إلى الآخر ” 2 لكنها فى ذات الوقت تعترف بميلها إلى ” نفى الكلمة خارج محيط قراءة الصورة ” 3 وهذا يشبه ميلى . أنا أميل إلى الفصل بين الرسم و اللغة مثلا حتى فى الأعمال الفنية خارج مدار الشعر وكنت كلما وجدت لوحة تشكيلية فى معرض عليها بعض الجمل المصاحبة أتجه بعيدا أو أحاول عدم قراءتها لرفضى الإتكاء على ما اقترحه الفنان من وسائل شارحة إضافية يدعم بها عناصر اللون و الخطوط والفكرة فى صورته بل تطرفتُ فى تعاطى كثير من الأعمال التشكيلية بامتناعى و عدم استحباب رؤية اسم اللوحة ربما لرغبة خفية أن أضع لها اسما يخص قراءتى لها و إحساسى بها ، و كنت أتساءل حين أجد ” كتابة ” خاصة لو كانت شارحة على اللوحة التشكيلية : هل الفنان لم يثق فى قدرة خطوطه وألوانه ووسائله التصويرية وحدها على أن يحرك ويستثير فينا ما يريده فقرر الاستعانة باللغة أيضا ؟.
لعبير عبد العزيز قصائد أستطيع القول إنها آخاذة الخيال ، لكن ليس بدون مشكلات . ثمة حد أدنى من التجانس و الترابط يجب توافره داخل بنية أية قصيدة وهذا يغيب أحيانا فى بعض نصوصها. عندها ليونة فى تسريب المعنى فتجد جزءًا من مقطع من قصيدة أو من نص شعرى يفجر الخيال على نحو فاتن ثم يعود إلى منطقة أقل شعرية أو إبانة خاصة فى سياق علاقته بما يسبقه و ما يتبعه. لكنها باذخة حين تكتب فى ” مشنقة فى فيلم كارتون “ الوصف التالى :
” يمشى على أربع..
لا على أربع وأربع و ..
فكيف يزحف بهذه السرعة
إلينا ..
لا يُحدِث صوتا
لا تنكسر الأوانى والكئوس
بمروره
فقط شرخ رقيق
يصيب كل شىء
حتى السوائل
يصنع دوائر محكمة
لم يكن متخفيا
أتى كما يعلمه الجميع
متأنقا له هيبة فى المكان
الحزن
مالك الضيعة القديم “. ( من ديوان “ مشنقة فى فيلم كارتون “ )
وأيضا فى مقاطع متفرقة بذلك الديوان ، مكتملة المعنى بذاتها مثلما تكتب :
” علمنى أبى
أن أطلق البخور حتى
يختفى أثاث الحجرة
فأسكن أماكن جديدة
لكن ..
أعواد البخور لم تعد كافية “.
ثمة وضوح حزين فى تخيُّر فعل ” لم تعد ” مقارنة بـ ” لم تكن ” لأنها تنعى كل الحاضر و المستقبل بالفعل الأول المشبع بالحسرة بينما الثانى يحيل حصريا إلى الماضى. وهى تنجو من منعطفات تحيير القارئ أمام المعنى حين تكون بعض الصور مقتضبة مثلما تقول فى نفس الديوان :
” المجرمون أيضا ..
يتذكرون أيامهم البعيدة
لكن أكثرهم لا يأسفون
للأسف حواف منزلقة “.
بينما لديها قصائد فى هذا الديوان تجريبية ، عميقة والإشكالية تتمثل فى وقوع القصيدة أحيانا فى ما يشبه الحفرة قبيل نهايتها بل لعل المشكلة تكون أحيانا فى النهاية التى أفلتت من مسيرة خيال القصيدة و صورها و بنيتها مثال النص البديع العارم الذى تكتب فيه فى ديوان “ مشنقة .. “ :
” الحذاء جميل
إذا سار فوق أرضٍ طينية
آسفة ..
الطين جميل
إذا سار فوقه حذاء
آسفة..
إذا اجتمع حذاء و طين معًا
كان هذا جميلا
آسفة..
إذا اجتمع حذاء و طين معًا
شرط أن الحذاء يسير فوق الطين
صار جميلا
آسفة ..
أننى أحتاج لسلم
حتى أتواصل معكم
فهل الأفضل لى
أن أرتدى الحذاء و أسير على الطين
بذلك سأذهب
لمكان ما..
لشىء ما ..
لشخص ما ..
لعمل ما ..
لمعنى ما ..
هنا..
ما المهم فى الجمال .”
وأرى أن القصيدة انتهت و اكتملت عند قولها ” أننى أحتاج لسلم / حتى أتواصل معكم ” بما فيها من طاقة إشباع وإيحاء بطفولة و براءة تتعامد مع كل ما سبقها فى النص من دلالات ، وصورة الحذاء وما تثيره من إيحاء بالقيود والتكبيل والالتزام بالمناسب أو اللائق المفروض مقابل حالة الحفا وحرية الطفولة ( رمزية الطين والمشى فيه ) ولو لم تكن عمرية . قوة القصيدة فى تركيبتها التهكمية ( خاصة مع تكرار استخدام كلمة ” آسفة ” ) عبر تقطيع متتالٍ يهز الإحساس بالمعنى ليدفعه فى طريق الاستهزاء وهى تحقق هذا بإبراز عدم قدرة الذات الشاعرة على الفهم ومن ثم لن يحل السلم – لو توفر – تلك المشكلة التى تعود إلى دفقة السخرية بصرخة إدانة من تلك الذات لنا جميعا .
لكنى لم أكن بحاجة إلى أية رسوم من أى نوع فى ديوانها ذى العنوان المفزع البديع ( وبالتالى لم يكن يحتمل معه أن يكون للأطفال ) “ مشنقة فى فيلم كارتون “. الشعر كان يكفى ( أو يكفينى ) وهنا الشعر كان يحتاج إلى تركيز أكبر للتعامل مع ملمح آخر شابه وهو بعض التفكك بالإضافة إلى ما رأيته كإقحام لعنصر الغيبيات و الطاقة الماورائية التى توحى بها الأحلام وتفسيراتها و دلالات بعض ما يطلع لنا فى ورق الكوتشينة و إرهاصات علاقة الشاعرة بالأبراج والكواكب و ما يمكن قراءته من طالع فى فنجان القهوة و هذه من مجالات اهتمام الشاعرة كذلك. الشاعرة جعلت هذه العناصر بمثابة مفتتح لكل قسم من أقسام “ مشنقة فى فيلم كارتون “ والذى ختمته بما عنونته بـ ” باب فك السحر ” . و رغم ظهور دوال ذات صبغة ماورائية فى بعض النصوص ( مثلا العروس التى يتم خزها بالدبابيس للخلاص من المرض ) أردت و ما زلت أريد أن أفهم مغزى ذلك التصدير للعنصر الماورائى فى مقدمة كل قسم من هذا العمل بدون إدماج داخلى حقيقى له فى عمق القصائد .
فى ” بيتنا سمكة ” الذى ليس موضوعا لهذا المقالنتعاملمعحالةمغايرة تم إعدادنا فيها لكون الديوان للفتيان و الفتيات وأيضا للكبار . وببعض التغافل عن توصيفه أمكننى استقبال متن القصائد حيث تسرب عبد العزيز جملا خفاقة بخيال فلسفى طازج أرى أنه كان سيشكل نواة إدهاش فارقة فى قصائد تصدر فى ديوان آخر لا تكون لشرائح عمرية أصغر . انظروا مثلا حين تتساءل فى قصيدة ” بصمات صغيرة ” :
” لكن كيف أتتبّع أثر سمكة فى الماء ؟ “.
أو فى جمل أخرى ذات مخزون شعرى و فلسفى مثل قولها فى قصيدة ” درجات السلم ” بديوان ” بيننا سمكة “:
” لكن لو جلست أمام الماء ألف مرة
لن أفرق بين سمكة شابة و كهلة “.
ومن حيث الصياغة اللغوية فإن الأصح كان تكرار كلمة ” سمكة ” قبل الوصف الثانى ” كهلة ” .
أو حين تتساءل الذات الشاعرة فى قصيدة ” ماركة مسجلة ” بالديوان السابق مقدمة لنا صورة مدهشة :
” لماذا لا يضع الضابط
على كتفيه أسماكًا بدلا من النجوم ؟”
أو :
” لماذا نرسم نجمة كبيرة
فى كراسة الطفل الصغير
عندما يجيب مسائله بنجاح ؟
لم لا نرسم سمكة ؟”.
أرجو ألا يُفهَم من كلامى أنى أؤيد الفصل العنصرى التام بين الفنون فى كل الفضاءات و عبر جميع وسائل التعبير أو لا أحبذ البحث عن طرق مبتكرة لتقديم الشعر أو تأديته مثلا وأتذكر استمتاعى بأساليب مختلفة لقراءة الشعر على الجمهور فى الخارج . مثلا بعض الشعراء تسلق شجرة فى الظلام وسلط الكهربائيون عليه الضوء حين حانت فقرته وكنا نبحث عن مصدر الصوت فوجدناه عاليا فوق رءوسنا يتربع شجرة و يقرأ والجمهور نفسه كان يدلى أقدامه فى ماء النهر فى مهرجان ” سيت ” أثناء الاستماع حيث رصوا المقاعد فى النهر والشاعر يجلس أمامه ليقرأ أو يذهب الشاعر فى رحلة بحرية مع عدد من الجمهور الذى اشترى تذاكر ليستمع إليه أثناء تحرك القارب ومحاورة صاحبه أو قائده للشاعر قبل الإلقاء و بين القصائد قبل عودة الجميع للشاطئ.
وطبعا هذه الابتكارات المختلفة لتقديم الشعر منعشة و ضرورية .. كدنا نقترب من بعضها عبر مجاورة الفنون فى مشروع “ الفن ميدان “ من سنوات بعد ثورة 25 يناير إلى أن توقف. لكن أيضا هناك فارق بين ابتكار طرق جديدة للإلقاء والقراءة والأداء performance وبين الشعر المعد للقراءة ورقيا فى دواوين ، ما بين تقديمه وحده أو بتداخلات بصرية مع متنه من فنون أخرى داخل الكتاب ، وأحسب أنى من أنصار الفكرة الكلاسيكية التى تفضل الكتاب الورقى الذى فى قناعتى لن يموت والذى يأتى بشروطه البصرية و النفسية الصارمة حتى وإن أحببنا توغل الشعر أكثر حولنا واشتقنا إلى صور مبتكرة لاستدخاله فى حياتنا، و ربما أصدق أن الشعر قادر وحده – مع تطور المجتمع – على أن يدخل حياتنا ويجعلها أجمل لو لم يتم حصاره أمنيا و اجتماعيا فى الفضاء العام لمجتمعاتنا ، الشعر ككلمات بدون عكازات ” بصرية” من أية فنون داخل كتبه ، الشعر كما نحب سيكون نعمة كبرى فقط لو وجدناه متاحا فى محطات المترو ، على جدرانها ، فى الحدائق العامة ، فى مقاهى مدننا ووسط البلد وفى مسارحنا و مناهجنا و قطاراتنا وأسواقنا ، غير محاصر أو مطارَد ، وهنا فى بعض هذه الفضاءات سيكون لتجاور الكلمة مع بعض الفنون ( مثلا الشعر والموسيقى فى الحدائق العامة ) طاقة شحن بجمال عارم محرِض لأرواحنا.
إن صلة الشعر بالمجتمع تزداد وثوقا و يصبح أكثر أهمية كلما تعمق تحضّر المجتمع فكما نعرف لجأ مترو لندن إلى إتاحة الشعر لرواده من سنوات طويلة بعد طرح الكاتبة جوديث شيرنايك لفكرة إتاحة الشعر لجمهور أكبر عبر اختيار ووضع بوسترات بمقاطع شعرية فى محطات المترو لرواده عام 1986 وقامت مع شاعرين آخرين باختيار قصائد بعضها لشعراء عالميين والبعض معاصر والبعض كلاسيكى وكان هناك حرص على عرض قصائد بعض الشعراء المغمورين بجانب الأكثر شهرة ونجحت الفكرة تماما رغم تعرضها للسطو أو ” التقليد ” من بعض شركات منتجات مثل نعناع بولو و من حركات مثل Greenpeace واضطرت شيرنايك للشكوى لإدارة المترو و لمحادثة أعضاء مجلس إدارة وعناصر أخرى داخل شركة نعناع بولو الذين أكدوا لها أن تقليد الوسيلة يعد أحد أكبر صور الإطراء و اضطرت للاتصال بحركة السلام الأخضر التى وضعت بدورها أشعارا وصفتها شيرنايك بكونها غاية فى ” التفاهة ” كما تعرضت الفكرة لاستياء من الجمهور فى أحد محطات نيويورك حين نُفِذّت بها ووصل الأمر إلى حد نشوب معركة نتيجة اتهامات تقترب مما يمكن وصفه بإزدراء الدين المسيحى (حيال تعليق بعض القصائد الكلاسيكية الإنجليزية! ) وتوجست إدارة بعض المحطات فى بريطانيا من قصيدة كلاسيكية جدا بسبب مفردة جنسية فى عنوانها ولكن خضعت الإدارة بعد نشر الصحف للقصيدة كاملة والآن يحتفل مترو لندن بمرور 30 عاما على بدء الفكرة واستمرارها بل و طبع ” بروشورات ” بها بعض القصائد المنتخبة أى حدث ما حلمت به شيرنايك كما تقول “ وانتصر الشعر “.
والمثير أن عمدة لندن و إدارة المترو بها استعانا بالشعر أيضا ( بعض الركاب قالوا إن هذا مثّل نماذج رديئة وبالفعل قرأت نماذج منه ووجدتها تعليمية موزونة شبه إبيجرامية الطابع ) بالتعاون مع فنانى الجرافيك لإطلاق حملة فى بوسترات المحطات أسمياها ” شاعر – إتيكيت ” هدفها حث الجمهور على سلوكيات أفضل اجتماعيا مثل عدم إلقاء القمامة أو فتح أبواب القطار عنوة أو تعطيل الركاب فى النزول مما يهدر آلاف الساعات من الوقت.
وثمة محلات بأوروبا مثل Waitrose قامت بتوظيف الشاعر Roger Mcgough الذى أصدر كتبا للأطفال لتزيين جدران المتجر بأشعار لجعل تجربة التسوق أكثر متعة للزبائن وقام الشاعر بكتابة و تعليق أشعار تناسب الغرض كما قامت متاجر موريسون من سنوات بتعيين شعراء مثل Ian Mcmillan , Peter Sansom , John Mole لكتابة وصفات أطعمة بالشعر وشجع المتجر الجمهور على كتابة أشعار تشتبك مع الحالة.
هذه نضارة لا شك لكن من يستطيع البرهنة على أن هذه الطريقة ( مطلب كتابة شعر عن موضوع ما لمكان ما مثلا ) لا تؤدى إلى الكتابة بطريقة مختلفة تماما لدى الشاعر الذى قد يرغب فى هذه الرحلة الاستكشافية لفترة أو لمرحلة لكن ليس بالضرورة حد الاستغناء عن حق اختيار الشعر الذى يريد ، بعنفوانه فى كتاب يبدؤه و ينهيه كما يحب وقتما يحب.. كتاب للشعر فحسب ؟.
المجتمعات الحرة تبحث عن طرق جديدة باستمرار لممارسة تلك الحرية ولاستحداث وسائل وابتكار أجواء جديدة يتم تقديم الفن بها. ومن أكثر تلك الصيغ حيوية و تميزا ما يعرف فى نيويورك بـ “ بيت دعارة الشعر “ / مبْغى الشعر أو ” The Poetry Brothel” وهو فكرة جو كباريه يشتمل على تقديم الشعر بطريقة مبتكرة بعد إخراجه من صورته ومكانته كفن نخبوى يُقدّم فى قاعات المحاضرات و أماكن الندوات الرصينة . تقوم الفكرة على تحرير مشاعر و إذابة حواجز فى علاقة الشاعر بالمتلقى عبر “ عاهرات الشعر “ اللواتى يعلن “ بيت دعارة الشعر “ عن حاجته إليهن وإليهم بتساؤلات حرة مرحة من نوع : هل تقرأ / تقرأين شعرك فى سريرك ليلا ؟ هل تريد/ين كأس أبسينث الآن فورا ؟ هل جربت مرة وضع قناع و اختراع اسم و شخصية لنفسك ؟ إن كان كذلك يمكنك إرسال سيرة قد لا يكون لها أدنى ارتباط واقعى بشخصك إلى مدام كذا ( مديرة المشروع التى بدأته هى الشاعرة ستيفانى بيرجر و الشاعر نيكولاس أدامسكى الذى بدأ عام 2007 وبعض المواقع تذكر 2008) وقد تحيط الشاعر الذى يلقى شعره حكاية مخترعة لوصل المتلقى أو المستمع بالغرائبى مثال اختراع حكايات خلفية .. حكايات عن هاربين من السيرك وعن فقراء لهم أصول ملكية . ويوجد فى موقع “ بيت دعارة الشعر “ على الإنترنت دعوات لمصممى الأزياء و الموضة و الحُلىّ و مصففى الشعر و خبراء التجميل و الفنانين والممثلين و الموسيقيين و قراء الكف أن يقدموا أوراقهم للمشاركة فى الفعاليات الشعرية التى تقوم على حالة قراءة عامة للجمهور أو – بسعر أعلى قليلا – لقراءة منفردة فى غرفة خاصة بين الشاعر و ” زبون ” أو مستمع واحد مع وضع الشاعر / الشاعرة لماسك أو قناع على وجهه / وجهها لحفظ الخصوصية بعد التزين و ارتداء ملابس ووضع مساحيق تخص الشخصية التى يريد الشاعر / الشاعرة الظهور بها وقد يكون الدفع بالمال لقاء تجربة الإنصات الفريدة الأجواء والمميزة بحس الـ burlesque القائم على المحاكاة الهزلية الموحية بالمجون أو الكرنفالية تلك و قد يكون كما أوضحت مديرة الجماعة الشعرية تلك بأن يكتب لها ” الزبون ” المستمع قصيدة بعد أن قرأت شعرها شبه ممددة على الكنبة أو ” الشيزلونج ” أو كما حكت أن أحد ” الزبائن ” أى المستمعين أعطاها خصلة من شَعره !. لا يبيع أحد جسده بل شِعره . وطبعا قد تكون عاهرة الشعر أو من تقدم خدمة الشعر لزبون امرأة و المتلقى امرأة أو مستمعة كذلك وقد أفادت التجربة الطرفين كثيرا – بشهادة القائمين عليها – فالشعر هو الاحتفالية كلها و جوها القائم على الفانتازيا وتعد التجربة شهادة كما أفادوا على إمكان تداخل الفنون بالتوازى والفعاليات يعلن عنها بأسعارها على موقع “ بيت دعارة الشعر “ فيوجد الرسم و الموسيقى والتمثيل. وهناك كثيرون لم تكن لهم علاقة بالشعر قبل تجربة دخول “The Poetry Brothel “ خرجوا منها وقد اتجهوا للشعر وما يلفت فى هذا الصدد أن أسماءًا شعرية كبيرة اشتركت فى التجربة مثال الشاعر الحائز على ﭙوليتز الشعر Paul Muldoon والذى قرأتُ له من سنوات بعيدة جدا و الشاعرة التى تدير برنامج الإبداع الكتابى فى إحدى جامعات نيويورك Deborah Landau.
ومن الأشياء الطريفة واقعة ذكرتها الجارديان البريطانية بطلاها إثنان من طلاب جامعة سانت أندروز كانا يملكان ما يكفى من موهبة الشعر ليرسلا قصيدة ناقدة لإحدى سلاسل سوبرماركت “Tesco“ الشهيرة ببريطانيا معترضين على غياب سلعة ما. المدهش كان رد فريق تسلم الشكاوى فى المتجر . رد فريق العمل باعتذار شعرى موزون وتقديم كارت مشتروات بقيمة عشرة جنيهات إسترلينية !.
ولأن المجتمع الحر هو الذى يفتح الطريق بالقوانين و الأعراف و المؤسسات و ردود الأفعال أمام الخيال فالشاعر هناك يستطيع أن يعيش من عوائد الشعر ولا يجوع أو يندم ، يستطيع تقديم محاضرات فى أرقى الجامعات و قراءات شعرية و إدارة ورش عمل لطلاب المدارس لأن الشعر – على الرغم من تراجع مقروئيته- قيمة عليا يتم احترامها فى العملية التعليمية و التربوية وطبعا من أبرز دلائل التحضر عدم تأثير حياتك الشخصية و اختياراتك الجنسية أو تحولاتك الدينية على الدور الذى تقدمه للمجتمع .
ما أقصده من الإطلال على أعمال عبير عبد العزيز يتصل بما فجره داخلى الملمح الأبرز فى تلك الأعمال ، و حماستها المتمسكة بإقران الصورة بالكلمة دائما فقد كان مستحيلا طرح تفضيلات تخص ذائقتى بدون قراءة نصوص تحمل صاحبتها كل تلك الحماسة والإصرار للشكل الذى تريد تقديم نصوصها به و من ثم مناقشة انحيازاتى الجمالية التى قد لا تقل التباسا عن انحيازاتها . المفيد فى مشروعها أنه يرج تصورات وافتراضات قد تكون ركدت دون أن ننتبه . قد أكون أنا نموذجا للقارئ الكسول . ربما كنت بحاجة إلى مثل اختيارها الجمالى لمساءلة افتتانى بفكرة الإخلاص المتطرف للأشياء ، لفكرة الشعر كما أراه وارتباطها بتصور أو وهم آخر مفاده أن حقيقة الشعر ستقترب منا لو كرسنا أنفسنا له بدون تقطيع بصرى مقتحم موازٍ من فنون أخرى تملك أن ترفده وتغذى مخزونه أثناء التشكل فتخرج القصيدة محمّلة بعناصر درامية وعناصر سردية وأخرى مشهدية بحد ذاتها و فى نسيجها هى بدون مجاورتها على صفحة مقابلة فى المتن المطبوع برسوم تخص خيال و روح ورؤية للكون لشخص آخر غير الشاعر أو حتى لو كانت للشاعر، لعلى أتأمل رحابة المساحة التى تفسحها عبير لفنان كاريكاتير بجوار الذات الشاعرة بأريحية تُحسَد عليها بحيث نكون دائما أمام حالة إثنينية تشمل الصورة الذهنية و الصورة البصرية مغامِرة بعدم تجاوزنا لهذه القضية بما يكفى لولوج نصها الشعرى وحده أثناء القراءة لأنه ببساطة يستحيل أن تفعل ذلك مُغفِلا وجود الرسوم التى بدت توضيحية كـــ illustrations بمعنى أنك لا تستطيع تجاهل وجود الرسم حين تقرأ ديوانا لها أو – بالأخص – حين تقرر الكتابة عنه وأتأمل تناقضاتى ، ترحيبى واستمتاعى بـ ” مشاهدة ” تجاور الفنون خارج الكتب و السعى لاكتناه صيغ تجريبية جديدة فى قراءة وإلقاء الشعر لدى غيرى( بحلم أن أفعل ذلك بدورى نجاة من السأم ومن الأفكار الثابتة ) مقابل عدم تنازلى نفسيا عن وجود الكلمة وحدها على الورق حين أمد يدى لقراءة ديوان !.
بدأت هذا المقال بتساؤل ماذا تريد عبير عبد العزيز من الشعر . وأختمه بالظن الذى ربما كان بعضه إثما .
أظن أن مسعاها الشعرى الذى يطل بتأثيرات خفاقة بالبِشر والأمل يرغب فى تطويع الشجن وإقران الجد بالهزل وعدم منح كلمة الختام لأى منهما منفردًا لكن ليس عبر العلامات اللغوية وحدها بل من خلال إنشاء علاقة احتدام وتجاور و تصادم بين فكرة الصورة و فكرة الكلمة ليظلا فى هذه المنافسة المستمرة كأنما تُسرِب إلينا عدم يقينها تجاه الإثنين ، عدم اكتفائها بأى منهما و شرطية أن يتقاسما الخيال مع عدم حرجها من إظهار هذا التردد / الولع . و ربما تريد – بالأخير – أن تستنبت تناصا فريدا نحفر فى كل نوع إبداعى على صفحات دواوينها بحثا عن شحناته و رموزه يقربنا فعليا من عالم طفولة سبق وأن كتَبتْ لها و لا تريد أن تفلتها، كأنما نقرأ لطفلة كاتبة تفكر أن تضمين الخطوط الكاريكاتيرية و الكارتونية هو الوسيلة الأوثق لضمنا إلى حالة حُلمية ، إلى الحدائق الإليزية لفردوس الطفولة المفقود ، حيث العطش لأيقونات و دوال ما قبل معرفتنا باللغة أو حتى احتياجنا لها.
______________________________________________
الهوامش 1 و2 و 3 من كتاب سيزا قاسم المذكور بينما الملعومات عن علاقة أبولينير بدافى من الإنترنت