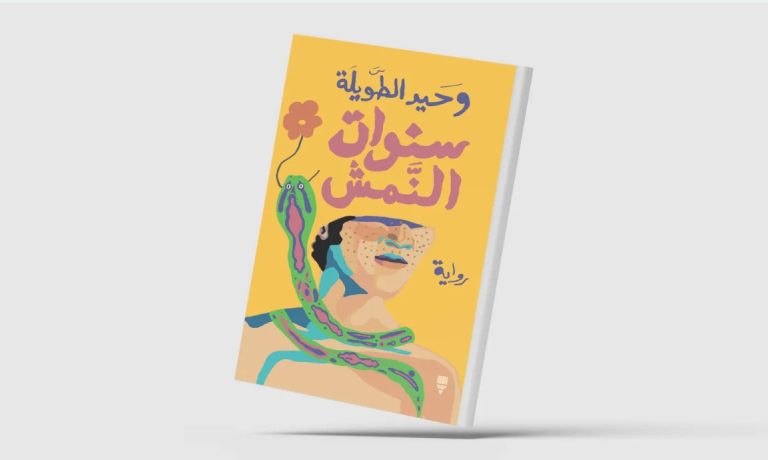ثمة روايات تنطلق من سؤال افتراضي، منبعه المخيلة المنفلتة، سؤال يستشرف المستحيل كإمكانية، ويجعل من الاحتمالات متنا من الوقائع، وهو السؤال الذي يفتح على الفور أفقا رحبا للتخييل ويحيل إلى فكرة مفارقة.
في ‘صانع المفاتيح’، رواية المصري أحمد عبد اللطيف، دار العين 2011، يبدو هذا السؤال ضربة البداية، قبل أن يتعمق وتتمدد ظلاله ليتغلغل بقوة طوال النص، ليصير محركه وجوهره.
ومبدئيا، فنحن أمام رواية تعلن انحيازا واضحا للخيال، تخاصم قوانين نص المحاكاة الواقعي، وتنقض الرؤية التي ترى في الفن الروائي محض ‘انعكاس أمين للواقع’. ولا يتبدى ذلك فقط في الجذر الفانتازي الصلب الذي تستند إليه ‘صانع المفاتيح’ ويمثل دعامتها الرئيسية كنص مكتوب، وبالتالي فيما يخص آليات قراءتها.. لكن في عدد من الانزياحات عن طرائق السرد التقليدي التي تحضر بقوة في هذا النص. ثمة نقض للزمن التعاقبي الكرونولوجي في تحقق الأحداث وفق تراتبها الزمني الطبيعي، مقابل انحياز ـ دال ـ للتلاعب بالزمن السردي، الحافل بالقفزات، وبالخلخلة الزمنية. استرجاعات عديدة واستباقات حاضرة هنا ستعمل بمعولها على إقلاق البنية التي كان يمكن أن تكون متماسكة منسجمة في تواترها الهادئ. يتعدد الرواة أيضا وتتنوع أنماط حضورهم، من خلال راويين أساسيين يتبادلان المواقع، أحدهما راو عليم يكاد يكون صوتا للسان الجمعي، والثاني هو ‘صانع المفاتيح’ نفسه الذي يلتقط خيط السرد في عدة مواضع، مقدما صوته ككتابة، عبر تدوينه ليومياته الكاشفة.
‘ماذا لو أمكن صناعة مفتاح يغلق الحاسة؟’، السؤال في هذه الحالة يفتح أفقا متسعا للاحتمالات، وتصير الرواية كلها متجهة نحو الإجابات الممكنة لهذا السؤال، ليس ذلك فحسب، بل إنها ستدعم بكل السبل معقولية طرحها لتُحكِم الإيهام.
ولأن السؤال غرائبي، سيكون من العبث الحصول على إجابات أقل غرائبية.. فكيف يجيب المتموضع على المفارق؟ كيف يجيب الواقع على سؤال لا ينتمي للواقع؟.. نحن إذن، منذ اللحظة الأولى، أمام نص غير واقعي، بمعنى أنه غير قابل للحدوث بالمعنى الحرفي، لكن ذلك لا يعني أنه منبت عن الواقع أو منفصل عنه، ذلك أن ‘صانع المفاتيح’ في مجملها تبدو كما لو كانت قادمة من عالم الأمثولة الرمزية القادرة على تجاوز شروطها الخاصة بحيث تصير دالة في سياقات مفارقة لها زمنيا ومكانيا، وهي بذلك تغدو ذات صبغة ‘كونية’، بحيث لا تقتصر على سياق بعينه يمثل شرطا لتحقق معناها.
***
الرواية، في ظني، تنطلق من طرح خاص لرؤية بطلها، وراويها في بعض المواضع ‘صانع المفاتيح’، للعلامات التي يحيا في القلب منها. إنه يحمل كفاءة تجعله قادرا على قراءة واقعه الخاص، واقعه الفني، من خلال علاماته المعطاة، لإعادة صياغتها. وهي مهمة صعبة بالطبع، ذلك أن العلامة السيميوطيقية لا تتحقق بإرادة فردية، ولكنها نتاج الثقافة، ‘ والفرد لا يملك القدرة على إبداع علامات سيميوطيقية ولكنه قادر على شحن هذه العلامات بدلالات خاصة به في صيغ الخطاب المختلفة’ حسب سيزا قاسم.
المفتاح، مبدئيا، علامة سيميوطيقية تحيل إلى فضاءين دلاليين متشابكين ومتناقضين في الوقت ذاته: الفتح والإغلاق، وهما الفضاءان اللذان تتوالد منهما فضاءات شتى.. الحرية والسجن، الداخل والخارج، الوحدة والاندماج.. والمفتاح أيضا هو ‘التفسير’، في جانبه غير المادي، فلكل نص مفاتيحه، ولكل شخص كذلك مفاتيح شخصيته.
صانع المفاتيح إذن ليس مجرد صاحب مهنة وفق هذا التأويل، لكنه إله بشكل ما.. ولنلحظ أن ‘الصانع’ أحد أسماء الله في الثقافة الإسلامية، كما يرتبط اللقب بالإله في أكثر من ثقافة..لذلك، ليس من الغريب، أن يتمكن هذا الإله من توسيع رقعة موهبته.. بحيث يصير قادرا ليس فقط على صياغة مفاتيح للأبواب، لكن أيضا على اختراع مفاتيح تغلق الحواس وتعيد فتحها.
هذا المطمح عند صانع المفاتيح هو بالأساس تفكيك جذري لمنظومته الثقافية عبر إعادة شحن علامة رئيسية فيها بحيث تكتسب وظيفة جديدة. وهنا يبرز سؤال، أي ‘فرد’ يملك هذه القدرة ‘الثقافية الجمعية’، إن لم يكن هذا الفرد، في تأويل رمزي، أبعد من حدوده المتعارف عليها كفرد؟ الإجابة تأتي من داخل الرواية، عبر الصورة الفنية التي يقدم بها صانع المفاتيح.
البطل المفارق
صانع المفاتيح بطل مفارق، لا تخلو حياته من معجزات، وكذلك هو قادر على صنع ما يمكن أن ينتمي للخوارق. يتمتع صانع المفاتيح بعدد من علامات النبوة بالفعل، ودلائلها.. بدءا من ملابسات مولده الأسطورية، مرورا بمناطق بعينها في سيرته تحمل تناصات واضحة مع اكثر من نبي.
يحفل التأسيس الفني لمولد ‘صانع المفاتيح’ بإحالة واضحة لمولد البطل الشعبي، الذي سيصير مُخلِّصا للجماعة في قادم أيامها، غير أنه هنا بطل تراجيدي أيضا إذ أنه محكوم بالهزيمة في النهاية، مقضي عليه بتآمر كل من حوله عليه، وبالعقاب لأنه وقف وحده ضد الجميع.
هو يوسف الذي توقف عن الرضاعة بمفرده قبل أن يتم العام، ووجدوه يتجول في البيت يوم ميلاده الأول بلا سند ودون أن يحبو سوى مرة واحدة.. والذي صادق منذ طفولته المبكرة قطة اعتقدها المحيطون روحا تلبسته وتوحش بعد موتها كأنه فقد روحه.قصة طويلة ملأى بالمعجزات صحبت نشأته ومهدت لسيرة استثنائية تلائم شخصا غير عادي.
وفي مرحلة متقدمة من طفولته، تظهر عرافة ـ تبدو قادمة من الموروث كما تبدو قادمة من الشيكسبيريات ـ يلفت نظرها بمجرد ان تراه، فتتقدم من باب بيته وتنادي أمه، وتخبرها ‘سينال هذا الغلام ثراء ومكانة، لكنه سيموت محبوسا’.
ومن المدهش في هذا السياق، صورة الأم. فبالرغم من أن الرواية تقدمها كأم عادية، غير متعلمة في الغالب ولا تحفل بآراء خاصة، إلا أن هذه الأم لا ترتعب من نبوءة العرافة، كما هو متوقع، ولا تفكر في خطابها ‘الميتافيزيقي’ ‘الغيبي’ بجدية. الأم تقابل هذا الخطاب باستخفاف، ‘شعر بخوف ربما تلاشى مع كلمات أمه المطمئنة بأن العرافات يقلن كثيرا ولا يحدث شيء، فقط يجب أن يقلن دوما حتى يجدن الخبز’.
هل أكون مغاليا في التأويل إن قلت إن الأم، عبر هذا المشهد، تؤسس لمرجعية الابن في تفكيك الثقافة ومساءلة المجتمع الغائب في الخرافة؟.
ثمة ملحوظة أخرى شديدة الأهمية من وجهة نظري، فالابن، الذي لم يكن بعد صانعا للمفاتيح، يبدأ تدوينه انطلاقا من هذا الموقف. كأن الكتابة ‘حضور’ يرد على ‘الغيب’.. الواقع المعاش يرد على النبوءة المفارقة: ‘ خوفا من تحقيق النصف الثاني من النبوءة، قرر أن يدون من آن لآخر ما سمعه من حكاوي القرية، وأن يذكر أسبابه لصناعة مفاتيح السمع، وأن يسجل حال القرية مع مفتاحها الجلدي، فربما كان في ذلك برهانا على براءته من سوء النية، على الأقل أمام ضميره الخاص’.
على جانب آخر، تظهر ‘علامات’ نبوة عديدة على صانع المفاتيح، تحيلنا إلى الموروث. صانع المفاتيح ‘يناجي الله’ من فوق ‘جبل’ ينعزل إليه كأنه موسى جديد. كذلك يحيل إلى المسيح الذي تجري خيانته من أحد حوارييه ـ هو هنا الصبي الذي عمل عنده ووثق صانع المفاتيح به ومنحه سره، فأفشاه متسببا في كل الكوارث التي ستقع بعد ذلك. الصبي تواطأ مع أعداء سيده ضده، كانه أيضا تدوير لصورة يهوذا. يضاف إلى ذلك اسم ‘يوسف’، اسم صانع المفاتيح الذي لم يرد في النص سوى مرة واحدة، والذي لا يخفى على أحد الدلالات المشحون بها، خاصة وأن صانع المفاتيح ‘صديق’ كيوسف، تتحقق نبوءته للقرية وتصير رؤياه بخرابها واقعا معيشا، وتتحول استشرافاته لمستقبلها إلى رؤى تخترق الحجب.
على المستوى المعرفي، يغوص صانع المفاتيح ‘ مع ابن عربي في رسائله، التي يستعين بها على رحلته الدائبة بين الصعود للجبل، حيث يتأمل القرية في سكونها، ويتفكر في أمر الخلق وبدايته، ويبحث عن الله بطريقته الخاصة، وبين تدوين بعض حكاوي القرية، التي اضطرته لصنع مفتاح خاص’.
والتماهي مع ‘ابن عربي’ تحديدا هو انحياز لمنطق صوفي في التعرف على الله، منطق يتسق وطريقة صانع المفاتيح نفسه في التعرف عليه عبر مسالك مختلفة وبتأويلات يمكن أن تعد في نظر الكثيرين زندقة، كأن يربط بين الله والصمم، رغم أن الله هو خالق حاسة السمع، وبالتأكيد لم يخلقها لتحول بين الناس وبينه.. وكأن يرى الله متجليا ‘ في ذيل قطة’.
ومن منجزات ابن عربي الكبيرة، والتي يتبناها صانع المفاتيح كإيديولوجيا’ صياغة نظرة للغة صياغة نهائية تحول الوجود كله إلى نص ماثل أمام الإنسان’.(2)
وتلتفت لغة السرد، بذكاء شديد، لقصة ‘صناعة مفتاح السمع’، باعتبارها قصة خلق بشكل ما، فتقدم مراحلها في تناص ملفت مع قصة الخلق التوراتية، عبر افتتاحيات من قبيل:’ في اليوم الأول من الشهر الرابع لصناعة المفاتيح’، ‘قبل صناعته لمفتاح السمع بخمسة أيام’، كذلك لا يمكن إغفال هذه العبارة المتخمة بالتناص مع قصة الخلق: ‘ عندما انتهى من صنع المفاتيح التي أرادوها، قرر أن يستريح عدة أيام’.. مع الوضع في الاعتبار أن صناعة مفتاح السمع استغرقت من صانع المفاتيح ‘ ستة’ أشهر بينما استغرق خلق الدنيا ‘ ستة’ أيام.. وغيرها من العبارات التي تؤرخ لصناعة هذا المفتاح وكأنه الدنيا التي يجري تأسيسها.
إنه من جديد البطل المفارق، الذي لم نعد نعثر عليه إلا فيما ندر في النص الروائي الجديد، فضلا عن كونه ‘دونكيخوتة’ آخر، يحارب طواحين هواء’.
يبدو ‘صانع المفاتيح’ جماع العديد من أشباهه، يلوح كتناص واسع متعدد المصادر مع كل أسلافه على تعددهم وتشعب مسالكهم.
الكتابي/ الشفهي ـ الصمت/ الكلام
يكتب صانع المفاتيح، في مجتمع شفهي، فأهل القرية’ لا يجيدون سوى الكلام، يقضون فيه يومهم وليلتهم، يكررون ما سمعوه مئات المرات بلا ملل، ويسردون حكاوي أخرى مليئة بالقبح كما لو كان طقسا دينيا يجب أن يؤدوه للرب لينالوا رضاه’.
إن سؤالا يلوح هنا، لماذا يتطوع صانع المفاتيح بصناعة مفتاح للسمع بينما يكاد يذوب هلعا عندما يعرف أن صبيه، أو مساعده في الورشة، بصدد صنع مفتاح للبصر؟ ما الفارق بين الحاستين عند صانع المفاتيح؟.. سأطرح تأويلي الخاص، الذي رأيته مطروحا في الفلسفة الروائية لهذا العمل.
يطمح صانع المفاتيح في أن ينتقل مجتمعه إلى المرحلة الكتابية مغادرا المرحلة الشفاهية.. يطمح في تأسيس مدرسة بدلا من الورشة. الكتابة لن تتحقق إلا بوجود البصر، فالعين تقرأ، والبصر هو الحاسة التي تستقبل المكتوب.. بينما يرحب بتعطيل السمع لأنه تعطيل في الوقت نفسه للزخم الشفاهي الذي لم ير فيه صانع المفاتيح سوى جلبة فارغة.
إنه من جديد الوعي العميق بنسق العلامات الذي يستقرؤه صانع المفاتيح، ويعيد تبعا له قراءة الحواس.
فالكلام نظام من العلامات، دواله هي الأصوات، وفي الكتابة تتحول الأصوات إلى أحرف.. والصمت، الذي تسعى الرواية عبر ساردها لتسييده، هو تعطيل للعلامة.. غير أنه لا يكتفي بذلك، بل يتجاوزه بخلق علامة جديدة عبرالسكون نفسه.
ثمة رؤية عميقة ينطوي عليها الصمت كعلامة لدى صانع المفاتيح، فالصمت هو الفضاء الملائم للكتابة. ولكنه أيضا السياق الذي يعني تحققه الوصول إلى الله: ‘خلال الفترة من صنعه لمفتاحه الخاص حتى الانتهاء من آخر مفتاح صنعه لأبناء قريته، وي مدة ستة أشهر تقريبا، وجد صانع المفاتيح الهدوء المناسب والضروري الذي يبغيه،وصفاء الذهن الذي كان يبحث عنه، ليس فقط من أجل معرفة الله بطريقته، وإنما أيضا للتدوين’.
ينسجم ذلك تماما وفلسفة صانع المفاتيح، الذي يؤكد: ‘ عندما تفقد حاسة السمع أو تغلقها، كما في حالتي، تصبح أكثر تأملا، فتسير أفكارك في طريق مستقيم، وتصل للنهاية في أقل وقت ممكن. يتيح لك الصمم المساحة الكافية للتركيز… الصمم نعمة لا يقدرها سوى من عاش في ضجيج..الضجيج يقطع الأفكار، يمزقها، يفتتها إلى أجزاء صغيرة لا يمكن بعدها إلمامها، فتبدأ من جديد، وربما لا تبدأ، فتموت أفكارك في المهد. لذا، أشعر بسعادة جمة وأنا أسير بالشارع ومنعزل عنه. أطير في عالمي الخاص، وأحلق حول فكرتي عن الله…. لقد رأيت الله في يوم وأنا أصم…. مع الصمم، أيقنت أن الله دوما كان يطل علي ويراني’.
اللعب مع الأمثولة
تنفتح رواية صانع المفاتيح على عالم رمزي، غير أنه عالم لا يستحيل فضه ليحيل للواقع المعاش، واقع المحاكاة، فهو ليس من النوع المستغلق، الذي يحيل إلى ذاته أو يلتفت الى نفسه فقط، بل من السهل إحالته لمرجعيته، أو مجمل مرجعياته، والاجتماعية خاصة.
ويمكن القول إن أهم ما استعارته الرواية من الأمثولة، طريقتها التخييلية في الإحالة إلى الواقع. في الأمثولة، كما في ‘صانع المفاتيح’، ثمة مستوى تخييلي، حافل بالتضخيم يحيل لمستوى واقعي، يسهل التعرف عليه، مع حضور ‘مغزى’ أخلاقي في الغالب، ليس مفتقدا أيضا في الرواية.
منطق الأمثولة، والحكاية الرمزية، حاضر إذن في هذا العمل، وإن تم تقويضه واللعب معه، وبه، بدأب كشكل حكائي متوارث، عبر عدد من الآليات، لعل أهمها التلاعب بالتواتر الزمني الخطي للحكاية وبطبيعة السارد.. ما يجعلنا في الرواية أمام رواية غير تقليدية بل ومشغولة بالتجريب.
ولنحاول مقاربة مغامرة الرواية فيما يخص الزمن السردي. تبدأ الرواية من لحظة متقدمة في حياة صانع المفاتيح، لحظة تحول في حياته. أي أننا ننطلق بشكل ما من لحظة ذروة لا تتفق وقوانين السرد التقليدي. صانع المفاتيح شاخ، يتأمل قريته كذكرى بعيدة، ويمشي أثناء نومه مثلما تخبره زوجته، وهي دلالة مهمة على انفصاله عن الواقع الذي اغترب فيه، فهو يمارس حياته وهو نائم، يعيش داخل أحلام مناماته مثلما يعيش داخل أحلام يقظته التي يتبدى فيها له ماضي القرية الذي اندثر. ليس عبثا في ظني، أن تبدأ الرواية بصانع المفاتيح وهو ‘يتذكر’، وكذلك ليس مجانيا أن يكون أول سطر في الرواية ‘ اختفت من القرية عدة مشاهد كانت مرتبطة بطفولة صانع المفاتيح’. إن النص ينطلق من لحظة الغياب وليس الحضور. الغياب يغدو المحرض على إعادة الحضور، بينما ينقلب السرد في جل الأعمال الكلاسيكية من حضور يحل ليؤدي إلى غياب.
من هذه اللحظة، سيبدأ اللعب الزمني، تحضر تقنية ‘الفلاش باك’لاسترجاع ما حدث قبل اللحظة الآنية التي ينطلق منها السرد.. ونظل بعد ذلك في مراوحات زمنية بين الماضي والحاضر.
الخلخلة الثانية إلى جانب الخلخلة الزمنية، تخص طبيعة السارد أو الراوي.
ثمة راو عليم يدير الأحداث ويعلق فيها بل ويتدخل فيها أحيانل معلقا أو محللا أو مفسرا. هذه حقيقة، تتلاءم وطبيعة الأمثولة. لكن هذا الراوي يجري تجريده من سلطته المطلقة عبر أكثر من موضع، عندما يحل صانع المفاتيح ساردا من خلال تدويناته، والتي تحضر متميزة طباعيا عبر خط سميك. مابين الراوي العليم الذي يسرد عن آخرين، وصانع المفاتيح الماثل كـ’أنا’ تتحقق تلك المراوحة التي تقوض تماسك وانسجام الصوت الوحيد، عمدا.
صانع المفاتيح، كسارد، لا يلتفت للأحداث بشكل رئيسي، فقد ترك هذه المهمة للسارد الآخر، لكنه يمثل ‘الصوت المتأمل’، الذي يعمق اللحظات ويستعرض ظلالها الموحية، ما يجعل نصوصه أقرب للشعر. كذلك يستخدم لغة مشبعة بحس صوفي واضح.
إن استبدال الشفاهة بالكتابة عند صانع المفاتيح، يمثل، حسب تأويلي الخاص، وجها آخر لاستبدال السمع بالصمم، وباستبدال مفاتيح الأبواب بمفاتيح الحواس. الصمم يوقظ الكتابة وكذلك يقرب المرء من الله، من المطلق..بينما يقتل السمع التأمل ويشعل الكلام الشفهي الذي تذروه الريح ولا يمكن أن يكتب له البقاء.
‘صانع المفاتيح’ تخوض في ظني مغامرة سردية، حافلة باجتراء غير محدود، حيث العالم القابل للقراءة هو العالم القابل للتحريف.