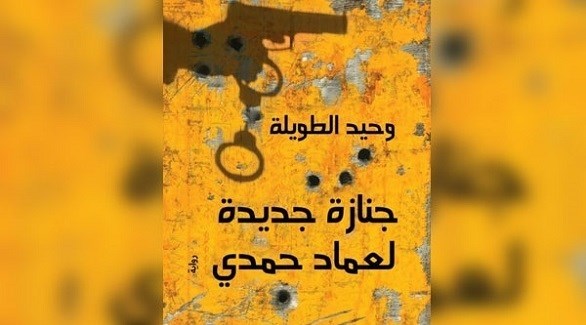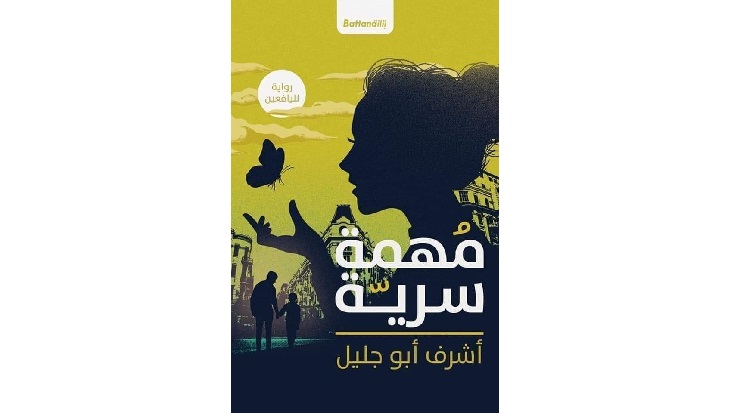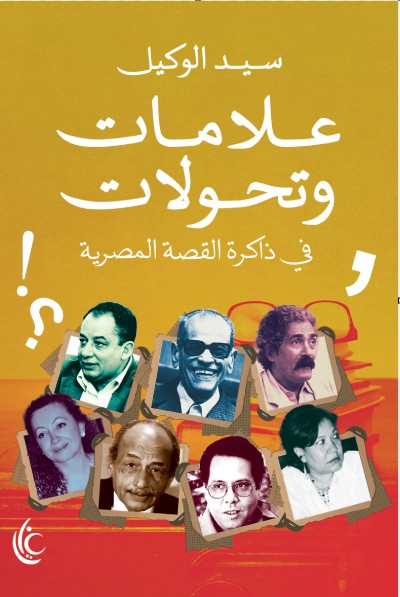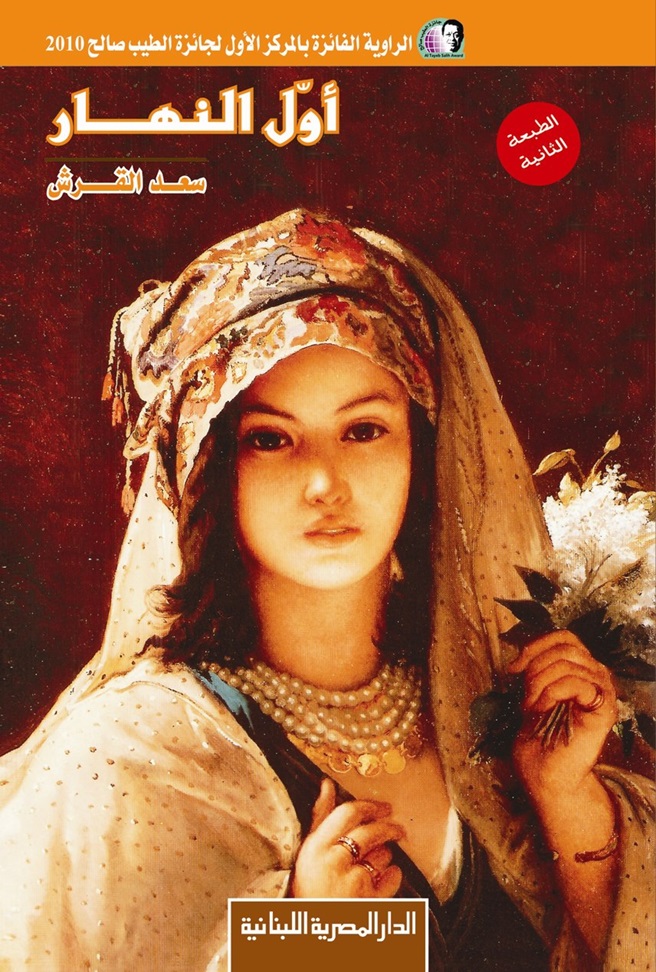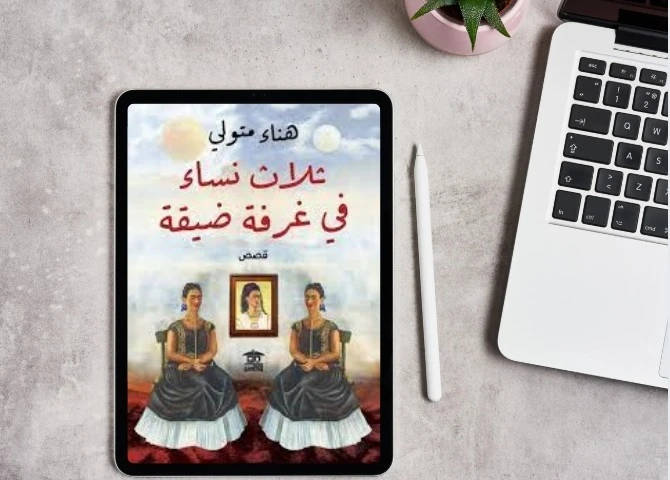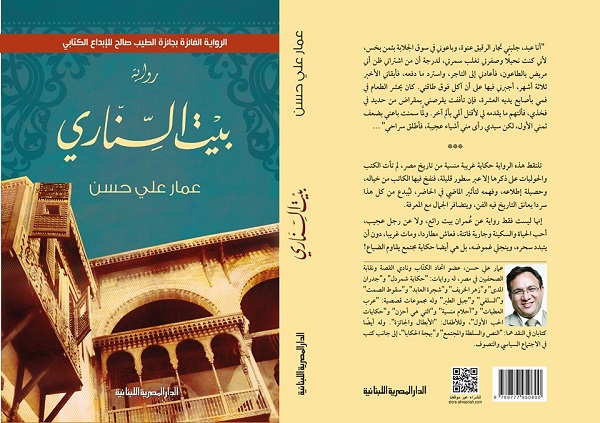شوقى عبد الحميد يحيى
على الرغم من إرتباط لفظ الشعرية فى ذهن العامة، بالشعر (الكلام المنظوم)، إلا أن علاقة الشعرية بالنثر، علاقة قديمة، وتعود إلى إثبات أن القرآن ليس بشعر ولا بنثر، وإنما هو تشكيل خاص. وقد تناول الشعرية كثير من النقاد والدارسين، خلصوا إلى أنها العلاقة التى تنشأ بين اللفظ واللفظ، أى أن التركيب المُشكل للدلالة، هو ما يخلق الشاعرية، التى لا تقتصر على الكلام المنظوم فقط، وإنما تتعداها إلى الكلام المنثور أيضا.
ومن أهم خصائص هذه الشعرية، أن يعبر الراوى عما داخل النفس، داخل ذاته، حيث يستخدم السارد أو الراوى ضمير المتكلم، والذى هو أقرب للبوح، وهو ما نجده خاصة فى الكتابة السيرية. حيث يكشف ذلك عن المخبوء داخل النفس، مغموسا بالمشاعر والوجدان والرؤى. فإذا كان الشعر يرتبط بالوجدان، مثلما يرتبط النثر بالفكر، أو العقل. فمن هنا يمكن النظر على أن هذه الخاصية – استخدام ضمير المتكلم -، هى أولى مظاهر الكشف عن شعرية النثر. ولشد ما يكون الوجدان، عنما يتأمل الإنسان حياته، ومآله. الميلاد، ألم الحياة، الموت. وهو ما يتضح من قراءة أولى قصص مجموعة “مألوف”[1] للقاصة ابتهال الشايب، والذى يوحيه –العنوان- من عادية الحياة، بكل ما تحويه، وكأنها تكرار ممل، أو أنها اصبحت (مألوفة). ويبلغ المبدع نجاحه، عندما يُحَمِلُ الدهشة للمألوف، فيصبح خلقا جديدا، ويصبح إبداعا، تفيض دواخله بالمعانى والرؤى المخبأة، والتى تؤرق القارئ، فتدعوه للمشاركة، والإيجابية. إلا أن ذلك لا يعنى أن يكون المنتَج مطابق للمُدخَل، بل على العكس، لأن ذلك يُخرج العمل من دائرة الإبداع، والذى يقوم بالأساس على التخييل. وهو ما دعا النظرة التى كانت تقول أن (أشعر الشعر.. أكذبه) وهو بالطبع لا يعنى الكذب المعروف إجتماعيا، ولكن المقولة تعنى التخيل أو الخلق. وهو ما نسعى للبحث عنه فى “مألوف”، وصولا إلى شعريته.. أدبيته.
وقد يكون من المفيد أن نبدأ بقراءة القصة المانحة عنوانها للمجموعة “مألوف” والتى تجمع خصائص المجموعة، وكأنها قرص الشمس الذى يوزع ضوءه، وحرارته، على الجميع. وليس استخدام قرص الشمس هنا، نوع من المجاملة، أو المبالغة، وإنما لقرص الشمس فى هذه القصة دور رئيس فى كشف ما خبأته الكاتبة وراء شكلها المراوغ، والذى يمتد من هذه القصة لعديد من قصص المجموعة. حيث قسمت القصة (القصيرة) إلى عدد من الوحدات السردية، بلغت سبعا فى هذه القصة، وهو ما جعل القصة عندها تأخذ الامتداد الأفقى، لا الرأسى، بمعنى أنه ليس هناك (حكاية) تُحكى، وتأخذ التسلسل التصاعدى، وإنما هى شرائح (مألوفة) أو مُمارسة فى الحياة التى نحياها، تجاورت لتمنح القارئ (إحساس) كلى- ولا أقول رؤية أو فكرة- بمعنى أن القصة تلعب على مشاعر القارئ، تنقل له ما يعانيه من وحدة، أو فراغ، أو عدم تواءم، مع الحياة من حوله. وهو ما نجده مجسما فى هذه القصة المنغلقة على نفسها. إلا أن كلمات بعينها، تتردد فى كل المقاطع السردية، بما يشكل أهمية خاصة لها، مث “الحقيقة” والتى نجدها فى الوحدة الأولى { يلعب أطفال بالكرة أسفل شرفتي، يصيحون، يشق صوتهم أذني، يعبث صوت اصطدام الكرة بالأرض بصداع مركون في أحد جوانب رأسي، تترجرج، يضاف الصوت إلى الحقيقة}. {تشعل حرارة الجو الحقيقة}.
وفى الوحدة الثانية:{ أغلق قلمي الحبر الفاخر الذي أحب التباهي به أمام الناس متخطيا الحقيقة}
وعن النيل { يؤكد بطؤه الحقيقة}. وفى الوحدة الثالثة: { أسير في الطرقات مستريحا من حرارة الصيف التي تحبها الحقيقة}.
وهكذا فى باقى الوحدات، وما نلحظه من ارتباط يربط بين الشمس، والحقيقة، يكشف عنها الجملة فى الوحدة السادسة { الحقيقة أقوى من أي شيء}. فالحقيقة إذن واضحة كالشمس، غير ان الآخرين لا يعترفون بها، فما كان من السارد إلا ان يصف نفسه بأنواع مختلفة من الطيور أو الحيوانات، مثل: {أنا كلب غير قادر على النباح}. {أنا وزغ ضعیف، صوتي مزعج، أزقزق بصوت عال فيشمئژون}.{أنا ذبابة دائخة، اصطدمت تؤا بأحد المضارب}.{لكن صوتي نعيق غراب كبير}.{ صوتي نهيق، يحاولون إسكاتي}.{أنا أسد عجوز}. حيث يبدو العجز وسط تيار جارف من البشر يحيط به، فيضيع صوته، وتضعف قوته. فلا يملك –أمام عجزه- إلا ان يسعى لموت الآخرين {أزرع عدة مشانق كافية لهم، ينظرون لي باهتمام، يتردد البعض في الإمساك بالمشنقة، يمسكها أحدهم ويعطيها لمن بجواره، يحاول آخر إزالتها، وكلما أزالها أضع أخرى، يُدخِل بعضهم رأسه بداخلها ويظل ساكنا، بعضهم يشنق نفسه}.{ لذلك أحمل عدة أفران، وعلب كبريت، أريها لهم كي يشعلوها ويعيشوا فيها إلى الأبد، يأخذها أحدهم مني بسرعة، وأفاجأ بآخر يعطيني فرنا أكبر}. حيث تكشف العبارة الأخيرة عن ذلك الصراع الدائم بينه وبين الآخرين، فهو يريد إماتتهم، بينما يرون أنه الأحق بالموت، فهوالنغمة التى لا تتوافق مع الهارمونى. فما الذى يريده هو، وما يريدون هم؟. يكشف عن ذلك، رؤية النيل، بسكونه، ولا مبالاته {أقرر تناول الغداء في أحد المطاعم المطلة على النيل، أتناوله مستغرقا في تأمل حركته البطيئة، لا يشعر بحركة الناس السريعة من حوله كأنه يعيش في عالم آخر، لما لا يسرع من حركته وتصير له أمواج عالية مثل البحر؟! أكره البطء}. وليس النيل وحده –بما يرميه من حمولة دلالية، تسرى فى شرايين الوطن، وإنما البشر برتابتهم، ونظرتهم الجامدة، الساكنة، وامتدادهم –أيضا- عبرطول البلاد وعرضها{ لماذا يتركون الأشياء هكذا جامدة؟ متي ستتحرك وتتكلم؟ هل ستظل هكذا طوال الحياة مهما حدث أمامها، يساعد جمودها الحقيقة، لا أريد أن أرى أحدا.. أو أسمع أي شيء}. وكأن الكاتبة تخرج بقصتها من الرؤية الأحادية المحدودة، إلى الرؤية الجمعية الواسعة. فإذا كانت الضوضاء، والسكونن الأمر الذى يمكن معه فتح الفضاء النصى ، ليشمل الجغرافيا والتاريخ، فنبصر الجمود عند الموروث، الذى مر عليه الزمن، وتغيرت معه المعطيات. وكذلك كان غياب الجمال، هو ما يؤرق السارد، وما يكشف عن(حقيقة) الأشياء والموجودات من حوله، وما يسعى، أو يامل ان يرى { أريد الاستماع إلى الموسيقى، أية موسيقى من الممكن أن تخلق أملا سريعا خاطفا}. فهو يريد أن يرى، ويسمع الجمال، الذى يحجبه الغبار، غبار الضوضاء، وغبار الثرثرة، والصوت العالى{ويحول الغبار دون وصول كلِّ أشعة الشمس إلى الأرض}. فلا يتبقى للسارد إلا البحث عن الضحكة، حتى وإن كانت { الضحكة شيء وقتي، أتركها وأتجه إلى جوارهم}. وكأن السارد وصل حد اليأس، وفقدان الأمل، والاستسلام. وهى النغمة التى يمكن تلمسها فى كثير من قصص المجموعة، والتى تبدأ بالإهداء، الذى يعكس أيضا رؤية المجموعة ككل { إلى دبدوبى، وأشياء لم تعد موجودة} فإذا كان “الدبدوب” هو الإشارة إلى فترة الطفولة، فإنه مع غيره من أشياء تلك الفترة، رحلت إلأى عالم الذكرى. وهو ما يشير إلى الرؤية الضبابية التى تكتنف المجموعة، وأن الكاتبة الشابة، قد وُضع على كاهلها الكثير من الحزن، والرؤية غير المتفائلة. فكيف عبرت عن ذلك؟.
فى أولى قصص المجموعة “خارج” حيث الفعل(المضارع) الذى يحمل الحركة المستمرة، مستبطنا (الخروج) اى الوداع، أو المغادر. حيث تتصدر القصة بجملة {الكتابة وسيلة لإثبات أن الإنسان غير موجود بشكل كامل.. }. حيث اٌرار بوجود الإنسان، غير أن وجوده غير كامل، أى غير متحقق، حيث تواصل الكاتبة أن هذه إحدى الجمل للشخص غير المرئى، فى دغتره (المهمل)، حيث أن مُغطى ببعض قطرات البول، وكلمتين طيبتين، وابتسامة واحدة لطيفة. فمن بين هذا الحصر لموجودات ذلك الغير مرئى، سنجدها، ببعض قطرات البول، فى إشارة إلى البدء، حيث يبدأ الوجود، ويستمد وجوده من تلك البداءة، مكان، ومصدر (البول)، إذن فهى إشارة غير مريحة، إن لم تكن بداية تدعو للنفور. ثم تستمر الحياة، التى ليس بها سوى كلمتين طيبتين، وابتسامة واحدة طيبة، لينتهى به الأمر إلى “الخروج”. ثم صفحات فارغة، حيث يتجسد فراع حياة السارد، إلا من ملاحظات، فى الصفحة رقم 20. تقول {لا أحد يحاورنى أو يلتفت إلىَّ، أُلقى التحيات فى الصباح والمساء،وتهانى الأعياد وحفلات الزفاف .. لا أحد يرد} حيث تتجسد الوحدة، وتتوحد الساردة مع نفسها.
ثم تأتى ملاحظة أخرى، حيث تفقد الأشياء وظيفتها، وينغرس الإنسان فى الأوحال التى لا يشعر بقذارتها، حيث تَجَسَد السارد فى شخص “سباك” كل تعاملاته مع (الخارج) من الإنسان، كفضلات يتخلص منها.ولتترصد الأصابع- الأسياخ – السارد، تبرز له من كل ثقب، {قرأت فى إحدى الصحف التى أشتريها كى أضع عليها الطعام.. إن عددا من الأشخاص باتوا لا يعرفون ما يقولونه أو يفكرون فيه أو يتبرزونه، يجهلون ماهية العَرَق، البلغم، المُخاط، الدم، الدموع، والبول}، لتعبر عن شعور السارد ورؤيته للآخرين، وتؤكد مدى الانفصال عنهم. ولتتحول كل الأشياء إلى اصابع بشريم من أسياخ الحديد، وكأنها السهام المسلطة بين ألإنسان والإنسان، حتى {اشعر أنها ستثقب عينى ذات يوم}. ثم نعود إلى حيث كانت البداية {الكتابة وسيلة لإثبات أن الإنسان غير موجود بشكل كامل.. }. فأمام كل تلك الوخزات، والخوف المترقب فى كل ثقب، يتوحد السارد مع الكاتبة، لتصبح القصة، (إخراج) لمشاعر مكبوتة داخل نفس الكاتبة / الساردة حين تقول {هل أصبحت غير موجود حقا؟} ولتنبثق الشعرية من السرد.
ثم تأتى ثانية قصص المجموعة “عفوية”، حيث تختبى الشاعرية فى الشكل، الذى يعبر عن الرؤية المستترة، فيعكس العنوان ، القدرية، تلك التى تحكم الإنسان، ولا يملك منها فرارا. فتبدأ القصة ببداية عامة، حيث لكل كائن أم، هى التى تحدد صورة المستقبل، فنقرأ {تقول أمى فى حائط الماضى.. حين كنت طفلا كتبت إحدى الفراشات ثلاث كلمات على حائط مستقبلى..} حيث يتحكم الماضى فى المستقبل. ويمكن أن نجده فى العادات والتقاليد، فى الموروث الذى يحدد الجينات التى تلعب دورا رئيسا فى المستقبل. ثم ينتقل السرد إلى التخصيص فى “بداية 1 مكرر”، فيولد كل إنسان داخل جدار من الجلد {فجأة تنمو أربعة حوائط جلدية من حولى.. أعيش فى غرفة من الجلد، أقشعر من إحاطتها لى فى بادئ الأمر، لكن تقتحمنى الطمأنينة حين أرى الفراشات. الآخرون يملكون غرفا مثلى، ينامون فى جوفها، يستيقظون وهى من حولهم، يسيرون بها فى الطرقات، يحيون بداخلها… تبرز الرأس من نافذة صغيرة فى حائط أمامى للغرفة، يطلق عليه حائط المستقبل}. فإذا كان الإنسان قد جاء من أم، ورَثّتهَ الجينات، فإنها هنا أطلقته للشارع، محاطا باسوار وقيود، هى جلده، يسعى فى الحياة، ويتعرض للعثرات التى تودى للنهاية، واحدة وراء أخرى. فتأتى “نهاية 1” حين يكون الحلم فى بداية الحياة، ممثلا فى البحث عن “الفراشة” رمز النعومة والشفافية {أنتظر فراشة فى بداية الطريق، لايهم لونها، انتظر أن تنادينى..} غير أن الفراشة لا تأتى، بينما { يصطدم حجر صغير بحائط مستقبلى من الخارج، مثصدرا صوتا عاليا على حين غرة، لا أدرى من أين أتى} لتصبح أول قدرية تصيب الإنسان، لكنها تحفر ثقبا فى جدار المستقبل ف{يثقب الحجر حائط مستقبلى فى المنتصف، تلتصق به بعض ذرات التراب} ورغم محاولة مسح آثار التراب، إلا أن الإنسان يظل حاملا لأثرها{أحاول تنظيفها لكن لا تستطيع يداى الوصول إليها}. وتستمر الحياة، لتبدأ عثرة جديدة، أو لتأتى (نهاية 2) {حائط مستقبلى من الداخل ملئ بالأشياء المبهمة}. و”نهاية 3″ لتغادر الفراشات تماما، حيث اخشوشنت الحياة، وكَثُرْت الاصطدامات. وتستمر محاولات جذب الفراشات التى تحدثت عنها الأم، لكنها فى كل مرة، تهرب أو ترفض أن تكتب، حتى نصل إلى “نهاية11” حين لا يفيد شرب الماء، رمز الحياة {ألقى زجاجة الماء بعيدا، أستند على أحد الأعمدة، تزورونى فراشة تبدو مريضة، تنظر.. ثم تفتح باب غرفتى ببطء، تحاول أن تكتب لكن أجنحتها مكسورة، لا تستطيع أن تحركها أو ترتفعها، تحاول وضع خطوط ضعيفة، تمر عليها عدة ثوان.. ثم تتلاشى}. وكأن تلك الفراشات التى تحدثت عنها ألم –فى البداية، قد عجزت عن الفعل، فعاش السارد، وتلاشى، عندما تلاشت الفراشات.
وإذا كانت الكاتبة قد فقدت التواصل بين البشر(خارج). فإنها وجدتها فى الجماد، فى قصة “لاشعور”، عندما حولت الماكينة الحديد، تشعر بالألفة مع المكان، وترفض أن تعمل فى غيره. بعد أن تتنقل بين الجمادات، مثل لون الحائط” الذى يشهد بفعل الزمن عليها، ثمتمتنع عن العمل، لتتوقف تماما فى النهاية. ويتحدث المقعد الذى اراتحت إليه، عن ما يحمله من أوساخ الورشة، فتشعر بالأمان، فتعمل، وكذلك حوائط المطعم الذى يرتاده عامل الورشة، وأرضية المنزل التى نقل العامل إليها الرض الصلبة التى تألفها الماكينة، فتنخدع وتعمل، وكذلك ملابس العامل بما تحمله من وسخ الورشة، فتظن أنها بالورشة فتعمل، وحتى أظافر العمل، والأظافر الأخرى، أيضا بما تحمله من وسخ الورشة ، فتعمل إلى أن تتحدث الأشياء عنها، حيث {كانت تعمل جيدا.. لكنها بعد عدة ايام ينتقل أحد الصناديق إلى محل صديقه .. تلمح بعض عمال الورشة .. ثم تجد فى المنزل عدة أدوات جديدة تشبه أدوات الورشة فى انتظار الذهاب إليها، تكف عن العمل من جديد .. وتعود إلى ورشة التصليح} حتى ييأس منها العمل، ويقر بيعها لأحد بائعى الروبابكيا، والذى يبيعها لمصنع آخر ليفرح بها ويشعر أنها جديدة، و {منشرحة للغاية، تعمل باجتهاد} لكنها تتوقف فجأة. ولا يعرف صاحب المصتع الجديد: لماذا تُحجم عن العمل فجأة}، وبالطبع هو لا يعرف أن الماكينة تعودت، وألفت المكان بوسخه، وزيوته وشحومه، فلا تستطيع العمل فى غير مكانها.
وزعت الكاتبة الشهادات على الجمادات التى جاورت، وتعاملت مع الماكينة، دون ترتيب، او تنسيق، حتى تحدثت بعض الجمادات أكثر من مرة ، متفرقة. وكان على القارئ أن يُلِمَ أشتات الشهادت التى تُبرز فى النهاية، الجو المحيط بالماكينة، والعمل، لتشعر- بلاشعورها – بالألفة، ويشعر معها القارئ – بشعوره- بفك الشفرة، والوصول إلى ما ترمى إليه القصة من رؤية تتمثل فى “الوفاء” أو “الانتماء”.
وعلى الرغم من وجود ( شبه الحكاية) فى القصص السابقة، حيث كان التركيز على (الحالة) التى تؤثر فى القارئ، وتجعله مشاركا فى خلقها، فإنها فى قصة “متكلم” قد صنعت الحكاية، أو ما يمكن أن تكون حكاية، وإن لم تغادر الحالة الكلية التى تنبثق عنها، وتتشكل القصة من عدد من الوحدات السردية. تبدأ الأولى منها حيث يجلس السارد على المقهى، مع أخيه، وفى الأمام توجد صفحة بيضاء، ويخبره أخوه بأن ذيلا قد نبت أسفل رأسه من الخلف. فيبدأ السارد بالفعل يشعر بوجود الذيل، بعد خمسين كلمة من الإقناع، يربطه الأخ فى رجل المنضدة، ويرحل.فيبدأ السارد رحلة الخوف .. مما؟ من نفس كلمات الإقناع يقولها الصديق فى الأذن القريبة من فمه عن الوضع السياسى ف{تبتعد أصوات نرد الطاولة قليلا فى المقهى الذى نجلس فيه، تبدأ كلمات الإقناع تأكل أذنى اليسرى القريبة من فمه.. رويدا رويدا وبدفء.. جزءً جزءً، تدب أنامل الخوف داخل صدرى ….. الخوف مما قاله.. أو مما قد يحدث}. لينفتح الأفق للبعيد، للحرية، والديكتاتورية،وإنغلاق فرص التعبير، حيث ينظر السارد للورقة البيضاء، فيرى بها الثنيات الكثيرة. يخاطب نفسه، أن الأمر لا يتطلب إلا التركيز، وتحكيم الإرادة {أحاول أن أحرر ذيل رقبتى.. لكن الذيل يتماسك مع رِجل المنضدة، أحاول أن أمرر إرادتى عليه، ربما أستطيع التحكم فيه}. وبعد طول محاولة.. وزيادة التركيز، تنفك كرمشات الورقة البيضاء، بعد أن مسحها برموشه، إلى أن تنفرد تماما، وينفك الذيل رويدا رويدا من شدة الجذب {أستمر فى التركيز وتختفى بقية الثنيات حتى أتحرر} حيث يتغير مدخل المقطع النفسى ب {أنا خائف} لتنتهى {أنا لست بخائف}. فهى إذن رحلة الخوف التى يصنعها الآخرون فينا. فيصبح الخوف متحكم فينا.. الخوف مما يقال، والخوف من توابع ما يقال. ولتسير باقى الوحدات على نفس المنوال، بالتحول من الحالة السلبية إلى الحالة الإيجابية {أنا سئ.. أنا لست بسئ}. {أنا غبى .. أنا لست بغبى} ثم فى النهاية، وكأننا نعود للبداية، فنرى العلاقة، أو الاحتكاك بالسلطة الأعلى، فهى فى هذه الوحدة يكون مع (المدير)، ونقرأ عن أحذيته، بما يشير إلى نوعية تلك العلاقة، والتى تؤدى إلى فشل السارد فى فرد الورقة، ويظل الذيل ملفوفا حول عنقه، ليعلن فى البداية {أنا فاشل} ثم {أبحث عن الورقة البيضاء.. أريد أن أتناثر بداخلها لكنها منبعجة، لم يظهر منها فى الظلام الداخلى المُعبأ بهمسى سوى بضع قطع بيضاء صغيرة مُنحدرة إلى أسفل، غير قادرة على حل عقدتى} فيعلنها فى النهاية {حقا .. أنا فاشل}. فإذا كانت الكاتبة قد وضعت وحداتها السردية بين دفتى “الوضع السياسى و المدير، أو السلطة العليا، فإنها أعطت هذا المنحى التركيز الأساس فى القصة، ولتتمحور الرؤية الكلية فى النهاية حول انسداد أفق التعبير، أو التكلم، والتى لن يخترقها سوى .. “الإرادة”.
تهرب الكاتبة من البشر الذين تعاملت معهم فى “خارج” و “عفوية”، وحتى فى “متكلم”، حيث يأتى القلق والإزعاج من الخارج. وتتقوقع مع نفسها، فلا تسلم من القلق، فيأتى التهديد من الداخل، من جزء بالجسد، ينشر القلق والخوف بالفكر والألم فى آخر قصتين بالمجموعة “سوداء” و “إحمرار”، حيث تلتهب الأنف فى “سوداء”، وكأن مصنعا للسُم يعمل داخلها، فتشعر بالتهديد، تهديد خفى وغير مرئى {تأخذ أنفى المصنع وتهرب بعيدا، فأنا لا أشعر بوجودهما، ولا يظهران فى المرآة}. ولتأتى فى النهاية حيث ترى أن الأنف موجود.. ويبدو طبيعيا. فمصدر القلق غير موجوجد ظاهريا، وكأن الكاتبة كتبت قصتها أثناء الجائحة -“كورونا”- حيث حارب الإنسان وحشا مفترسا –أو سُما- يؤدى للفتك به، خاصة أن الكورونا تصيب الجهاز التنفسى، وهو مصدر القلق فى قصتنا. ويقودنا لتلك الرؤية أن الكاتبة لم تحدد تواريخ الكتابة. وهو ما يعطى حق القارئ فى القراءة وفق ما يحيط به من مدخلات، فيصبح منشئا للقصة مع كاتبها. وهو ما يدعونا، إن فكرنا فى تلك القراءة إلى منحها عنوانا مخالفا، فسيكون “القلق”. ثم تنبعث الروائح الكريهة من اللامكان من جسده فى “إحمرار” ، وكأن الرائحة تخرج من لونه الأسود {يميل لون جسدى إلى الأسود.. غريبة هيأتى… يغرق لون جسدى فى السواد…تركنى هكذا دون سبب، لم أقم بإزعاجه قط.. لأننى لا أعرفه فى الأساس، ولا أعرف كيف هو شكله أو ملمسه أو رائحته، بالتأكيد له رائحة.. ورائحة مميزة، يجب أن أسألهم لأتأكد}. وتلتصق كل الأشياء برأسه { باتت رأسى مزدحمة بالأشياء الملتصقة بها، هناك 167 إبرة خيط ملتصقة بالجزء الأيمن وسط شعيرات رأسى}، وكأن الرأس جاذب لكل شئ. ولنصعد نحن إلى تلك الرأس التى تعنى التفكير، وليصبح كل ما يراه، إن هو إلا تخيلات داخلية، فتتصور أنها واقعة تحت تأثير البنج، لاستئصال جروح مختبئة من سنين{يحفر الأطباء جسدى وكلما حفروا اكتشفوا جروحا مختبئة من سنين، بنت لها بيوتا صغيرة، وتعيش فى صمت}، فما الخوف والقلق إلا نابع من داخل السارد، لا من خارجه. فتبحث عن الهروب –من جلدها- فتتصور أنها تفعل الأشياء الخارقة، ودونا عن الناس ، لا يشعر بشئ، يسقط من الدور التاسع، ويخلع ذراعيه، ويغرز الإبر فى قدمه، يقول الناس أن الدنيا حر، ويقولون إن الجو برد، دون أن يشعر بشى من كل ذلك.. ليعلن {أنا حر.. وسأظل كذلك}. وغذا ما ربطنا بين هذه القصة و قصة “عفوية” والتى رأينا فيها كيف يخطط الماضى للمستقبل، سنصل إلى أن السارد هنا يعانى سجن الجسد، المحاط باللون الأسود، والذى يشعر معه بنفور الآخرين، دون أن يكون له يد فى ذلك، وكأنها لعنة الماضى، الفارض وجوده على الحاضر.
سمات عامة
من أولى صفات الشعرية فى العمل الأدبى، استخدام ضمير المتكلم، حيث يأخذ هذا السرد تجاه البوح، أو مخاطبة الوجدان، وفق ما يقوله “تودوروف” {إن الشعر لا يروى شيئا ولا يعنى أى حدث، لكنها تكتفى فى الغالب، بالإعراب عن تأمل أو انطباع}[2]. وهنا ينزع الكاتب إلى توصيف الحالة، ويهتم بها أكثر من إهتمامه ب(حكى) حكاية معينة. وإن كان هذا لا ينفى وجود ما يمكن تسميته ب(عضم الحكاية)، فتتوارى الحكاية إلى الخلف، لتترك للوجدان فرصة الصدارة. وهو ما نستطيع تمييزه فى مجموعة “مألوف”. ففى قصة “خارج” يبدأ السارد فى تقديم الشخصية، التى تبدأ الحديث عن نفسها، {قال لى جارى … قرأت فى إحدى الصحف…علمت من صديق لى ….}. وفى قصة “عفوية” يبدأ السارد فى عمل التمهيد {تقول أمى فى حائط الماضى}. ثم تتولى الشخصية سرد الحالة {أعيش فى غرفة من الجلد…. أنتظر فراشة ما فى بداية الطريق…..تتوقف إحدهن أمامى}. وهو ما نستطيع تلمسه أيضا فى باقى قصص المجموعة. وحتى فى قصة “لاشعورى” ، التى تعددت فيها الأصوات، فإن كل صوت منها راح يتحدث عن نفسه، وعلاقته بالماكينة. الأمر الذى يكشف عن توزيع السرد بين السارد والشخصية، وهو ما يخلق الحوارية، أو توزيع الأدوار، لينضاف ذلك، كتقنية سردية، إلى استخدام الكاتبة ، فعل التكثيف، والتحايل على ما قد يوحيه امتداد الزمن فى بعض القصص، كحياة السارد من الميلاد إلى الموت، وما قد يبدو خروجا عن نظام القصة القصيرة، إلا أن الكاتبة استطاعت الهروب من ذلك باستخدام الشكل الدائرى، مثلما فى قصة “خارج”، حيث انتهت، رغم مرور الزمن، من حيث بدأت، وتوحدت الكاتبة مع السارد. أو أن تجعل نقطة البداية، حاضرة فى كل وحدات القصة السردية، ليتكثف الحضور الأول، فيشعر القارئ انه لم يغادر البداية، مثلما فى قصة “عفوية”. أو تقسيم القصة إلى وحدات مشتتة فى “لاشعورى” غير أنها تتحلق كلها حول فعل الماكينة، فيصبح التركيز عليها، وكأن القارئ لم يغادر المكان، أو الفعل. وفى قصة “متكلم” ، كما فى قصة “مألوف” رغم إعتمادهما على الوحدات السردية المنفصلة، إلا أن حضور الذيل والورقة البيضاء فى كل الوحدات فى”لاشعورى”، و”الحقيقة” فى “مألفوف”، خلق الرابط بينها، لتمنح القارئ فى النهاية (إحساس كلى) بالقصة. ثم تعود فى قصتى “سوداء” و “إحمرار” للوحدة الكلية للقصة، فلا يتم تقسيمها، أو تشتيتها فى وحدات، وإنما يتشعب الحدث الواحد، وكأنه الفروع، المنبثقة من جذر واحد. لتعلن أن الكاتبة، إلى جانب امتلاكها الموهبة التى تُمكنها من كتابة القصة القصيرة، فإنها –أيضا- تملك من الخبرة ما يمكنها من التجريب، ووضع بصمتها الخاصة فى إنشاء القصة القصيرة.
العناوين
فضلا عن العنوان الرئيس للمجموعة “مألوف”، وما يخبئه من رؤية جامعة لمجموع القصص، كذلك جاءت العناوين الفرعية، حيث استخدمت الكاتبة عناوين قصصها من كلمة واحدة لتحملها بالشاعرية الموحية، والتى تكتنز رؤية القصة فى باطنها، فتفتح أفق التصور أمام القارئ، ليبحث عن المعنى، ثم تجئ القصة لتستخرج تلك الشاعرية، ولتعلن القصة عن رؤية محددة، قد تتلخص أيضا فى كلمة، مثل أن نستنبط الرؤية “حياة” فى قصة “خارج”. ونستخلص “القدرية” فى قصة “عفوية”. و نستخلص “الوفاء” أو “الانتماء” فى “لاشعورى”. ونستخلص فى “المتكلم” “الإرادة”. وفى “سوداء” نستخلص “القلق”. ومن “إحمرار” نصل إلى “سجن الجسد”. ومن مألوف نستخلص “الجمال”، وهو ما يترسخ فى ذهن القارئ، رغم أنه من الممكن جدا، ألا يتذكر ما قد يكون بها من أحداث. أى ان الكاتبة استطاعت أن تُكثف القصة فى “رؤية” مخباة فى سرد شائق، حتى أنها –أيضا –أخفت هويتها الأنثوية وراء السرد الذكورى، باتخاذ ضمير المُذكر. وعلى الرغم من منح السرد للشخصيات (المُتخيلة)، إلا أننا لا نعدم وجود الكاتبة، من خلال ارتباط نتف الحكايات المسرودة، بالواقع المعيش. فإذا كانت الشخصية من صنع خيال الكاتب، فإن الكاتب من صنع الواقع المعيش.
……………………………..
[1] – ابتهال الشايب – مألوف – دار النسيم – ط1 2019.
[2] – سفيتان تودوروف – مفهوم الأدب ودراسات أخرى – ترجمة عبود كاسوحة – سلسلة الدراسات الأدبية – منشورات وزارة الثقافة – دمشق – 2002.