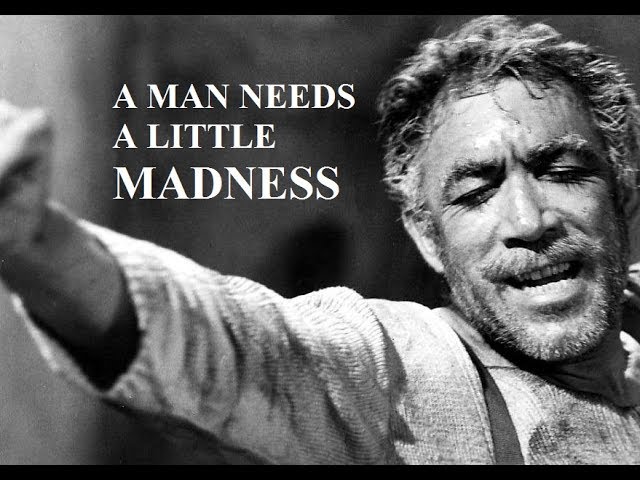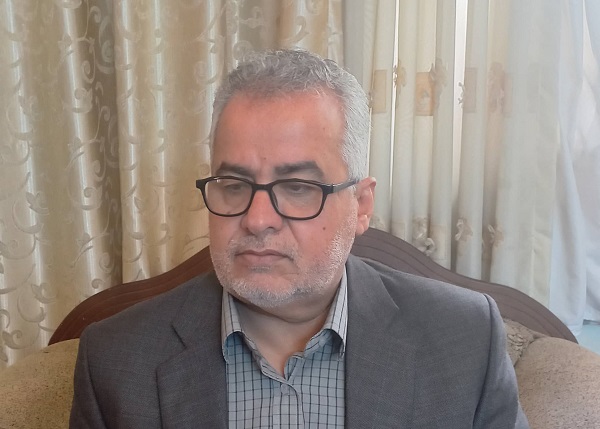مبارك وساط
– “في منتصف شهر ماي من السّنة الماضية، كنتُ قد جِئتُ مع الفريق – أقصد مع “العنبرة”- إلى مرّاكش ليلعب مباراة ضَد فريق باب دكّالة، وزرتُ أختي والتقيتُ أصدقاء قدامى، لكنّ أحداً لم يُخبرني بأنّ سي جُغمة قد مات”، قال سي المثابر.
– “العنبرة ! قال عُمَر. ثمّ أضاف: لقد شهدتُ شوطاً من مباراة كانت قد جمعت العنبرة مع فريق آخر قبل سنتين. كان حارسُ مرماها هو حمّادي الموتشو”.
قال المثابر: “حمّادي ذهب إلى أمريكا. تزوّج “مِيريكانيّة” واستقرّ هنالك. أمّا سي جُغمة…”
– “وكان أحد لاعبيها المرموقين آنذاك هو الكوشي”، قال عُمَر وابتسم.
-” وها هو الآن معنا في بولمهارز. كان قد بدأ يبيع مَاحْيا مِن صناعته في مسكنه، وهو الآ ن سحين ويشتغل في مطبخ السّجن… لا تنسَ أنّه ينفعنا أحياناً…”
تطلّع عُمَر إلى يمينه، حيثُ كان حارسان يتتبّعان سير الصّفّ العائد من فترة النّصف ساعة المسائيّة، التي كان السّجناء خلالها يطوفون بِساحة واسعة مُتربة، بها بِضع شجرات، ثمّ يتوزّعون فيتمشّى بعضهم ويقرفص آخرون أو يجلسون تحت الجدران العالية، فيتبادلون الحديث أو يصمتون، في انتظار الأوبة المحتومة إلى الزّنازين.
التفت المثابر يساراً، حيثُ كانت زنزانة بها شخص – لعلّه حلّاق سجين- يحلق شعر شخص آخر. هي زنزانة ودكّان حلّاق في آن. وقال لِعُمر: – “للأسف، ففريق “العنبرة” قد تفرّق…”
قال عُمَر: – “على أيّ حال، ها أنتَ في مرّاكش مُجدّداً، منذ عشرة أيّام !”
– “من جديد في مرّاكش ! بالفعل، لكنْ في السّجن !”، قال المثابر، وحاول أن يبتسم، لكنّ شفتيه لم تُطاوِعاه، بل بدتا بيضاوين يتخلّلهما ما يُشبه حزوزاً في لون الزَّبَد. فكّر عُمر: “لا شكّ أنّ سي المثابر في حاجة إلى أن يشرب ماء”.
انعطف الصّفّ الذي كانا يسيران فيه يساراً. ثمّ دخلا الزّنزانة مع رفاقهما الثّلاثة الآخرين، و أحكم حارس إغلاق الباب المشكّل مِن قضبان حديدية متصالبة وترك الباب الآخر الذي ليس به سوى فتحة في أعلاه مفتوحاً، لَصيقاً بالجِدار الخارجيّ، فقد كان الجوّ حارّاً حقّاً.
قال المثابر: “لو كان سي جغمة ما يزال حيّاً لربّما جلب إلينا جرائد، لكنْ…” كان سي المثابر يتحدّث عن سي جُغمة بتقدير وودّ كبيرين. وقد كان هذا الأخير، قبل وفاته، حارساً بِبولمهاز.
قال عمر: “على أيّ حال، فبولمهارز هذا مَهيب أكثر مِن سِجن آسفي الذي كنّا فيه. كما أنّ العيش في زنزانة نزلاؤها خمسة فحسب، خير من قضاء الليل والنّهار في حُجرة كبيرة مكتظّة بالبشر”.
وقد كانوا، بالفعل، خمسة في تلك الزّنزانة. وكانوا مِن ضِمن مجموعة يبلغ عدد أفرادها خمسة عشر، نُقِلوا جميعهم مِن سِجن آسفي إلى سِجن مرّاكش، كي يَمثلوا مام محكمة الاستئناف، بعد أن كانت محكمة آسفي الابتدائيّة قد قضتْ في حقّهم بِمُدَد متفاوتة من السَّجن.
كان الخمسة الآن قد اتّخذوا أماكنهم في الزّنزانة.
بادر عبد الرّحمان إلى الكلام، باسماً، كأنّه يعرض على الأنظار الفراغ الذي خلّفته ثنيّته العليا النّاقصة وسنّه السّفلى المكسورة:
-” خمسة فحسب، لِحسن الحظّ، ولكن مع “مولاي السّارية” هذا، الذي يتمدّد لنا عَرضاً، يُصبح كلّ منّا محجوزاً ومضغوطاً في ركن ضيّق”. وختم كلامه بمطّ شفتيه يساراً، في ما يُشبه ابتسامة ساخرة، موجّهاً نظرات منتقدة، فيها وُدّ بيّن، إلى سي علّو، الذي كان طويل القامة فعلاً وعلى جانب من ضخامة البدن، وكان يَحدث أن يجعل رأسه في زاوية مِن الزّنزانة ويمدّ قدميه في اتّجاه الزّاوية الأبعد عن التي يضع فيها هامتَه.
لم يُعَقِّبْ علّو بِشيء، واكتفى بأن أشار بإبهام رِجله اليُسرى نحو زاوية، وقال لعبد الرّحمان: “أعْطِني يا “رَايْب الفُمّْْ” هذاك الكتاب”. لكنّ الذي تناول رواية دافيد غوديس، “أطلق النّار على عازف البيانو””، مِن فوق كيس صغير به أثواب هو السّي محمّد ميليس، الذي كان يُدَخِّن سيجارته في طُمأنينة. وقد ناولها لِعلّو. أمّا نَعْت “رايب الفُمّ” (ساقط الأسنان)، فيستعمله علّو في لحظات المزاح لِمناداة عبد الرّحمان. وكانت هذه التّسميّة تُضحك عبد الرّحمان، الذ ي كان يثأر مِن سي علّو فيُسَمّيه “ناقة صالح”، إشارة إلى طول قامته وضخامته وميله إلى الاستلقاء لأوقات لا بأس بطولها. كان عبد الرّحمان، وهو في الرّابعة والعِشرين، يُكِنّ ودّاً وتقديراً كبيرين لِعلّو، الذي كان في نحو الرّابعة والأربعين، كما كان يساريّاً منذ أمد طويل، سُجِن مرّات بسبب نشاطه السّيّاسيّ، وكان أيضاً مثقّفاً وأُستاذاً في الثّانويّ، لكنّ فترات سِجنه كانت تليها فترات طَرد من العَمل تطول أو تَقصر، بل كثيراً ما تطول، وذلك ما جعل زوجته تَتّخِذ بادرة شُجاعة قبل بِضع سنوات. فرغم أنّها كانت أُمّا لِطفلة وفَتَيين، استعدّت لامتحان البكالوريا واجتازته ونَجَحت، ثمّ اجتازت مباراة الدّخول إلى معهد لتكوين أساتذة السّلك الأوّل من الثّانويّ فنجحت، وما إن مرّتْ سنتان حتّى أصبحت زوجة سي علّو – التي كانت تعيش حياة ربّة بيت تقليديّة – تُرى حاملةً محفظتها ومُتوجّهة صوب إعداديّة تُدَرِّس فيها العَربيّة. وكانت جاراتها قد بدأن التّعوّد، بِصعوبة ولا شكّ، على رؤيتها وهي تحمل محفظة وتتّجه لِتَدْرُس، في البداية، ثمّ لتدريس تلاميذها بعد ذلك ! وكثيراً ما عبّرت بعضهنّ عن اندهاشِهِنّ بعبارة: “ياه ! امْراة سي علّو ولّاتْ أستاذة !”.
أمّا عُمَر فكان في الرّابعة والعشرين، أكبر بسنة مِن عبد الرّحمان. وكان، قبل اعتقاله الذي قاده إلى سِجن آسفي ثمّ سِجن مرّاكش هذا، يَعرف باقي الموجودين معه في نفس الزّنزانة الآن، فسي المثابر كان مُعلّما باليوسفيّة – حيثُ كان عُمر يشتغل أيضاً بالتّدريس، أمّا سي علّو وعبد الرّحمان وسي محمّد ميليس، فهم مِن آسفي، وبهذه المدينة كان يحدث أن يلتقيهم في مقرّ النّقابة أو في مقهى معروف يرتاده مثقّفون ويساريّون وبوهيميّون… والتّهمة التي اعتُقِل بسببها رفاق الزّنزانة الخمسة وآخرون موجودون في زنازين أُخرى، هي: “الإخلال بالنّظام العامّ”، باعتبارهم محرّضين على الإضراب الذي شهدته عدّة قطاعات خلال أيّام مِن أبريل 1979…
يستمرّ سي علّو في قراءة الرّواية التي بين يدية، مُتمدِّداً على جنبه الأيسر، ومن حين لآخر، تبدو على سحنته سِيمَا اندهاش أو ترقّب، وفي بعض اللحظات يتوقّف عن القراءة لِيتحدّث إلى أحد رفقائه، ثمّ يعود إلى الانغماس في أحداث الرّواية التي بين يديه. سي المثابر يُريد أن يُدَخّن. لقد أخبر أخته – التي تزوره بانتظام وتجلب له ما يحتاجه – بأنّه انقطع عن التّدخين. وهو كان قرّر الانقطاع عن تلك العادة التي أصبح يَصفها بالرّديئة والقاتلة، لكنّ عزيمته لم تُطاوعه لِأكثر مِن يوم ونصف، وسرعان ما استبدّ به الحنين إلى السّيجارة، ففكّر أن يكتفي بالإقلال من التّدخين، وأصبح رفاقه في الزّنزانة هم الذي يمدّونه بالسجائر الأربع أو الخمس التي يُدَخّنها في كلّ يوم، في انتظار أن يستجمع شجاعته ويُخبر أُخته بأنّه عاد للتّدخين. يُناوله عُمَر سيجارة فيُشعلها ويَبقى صامتاً وشاحباً.
يتوقّف علّو عن القراءة ويضع الكتاب، مفتوحاً، أمامه. يَفرك عينيه – مغمضتين – بقبضتيه. يتوجّه إليه عُمر بالكلام: “لقد شاهدتُ الفيلم المقتبس مِن هذه الرّواية. فيلم أعجبني، يلعب فيه شارل أزنافور دورَ عازف البيانو… شاهدته في سينما كوليزي بهذه المدينة نفسِها أيّامَ كنتُ تلميذاً بثانويّة ابن عبّاد”.
قال علّو: “آخر فيلم شاهدته لشارل أزنافور هو “طاكسي إلى طُبرق”… يمثّل فيه أيضاً لِينُو فُونْتيرَا. شاهدتُه في الرّباط قبل سنوات طويلة… الواقع أنّي لم أدخل قاعة سينما منذ سنوات”.
قال عبد الرّحمان لِعَلّو: “لم ننتقل من سِجن آسفي إلّا منذ أيّام، ويبدو لي الآن كأنّنا كنّا فيه قبل سنتين أو أكثر”.
رَفَع سي علّو رأسَه عن كتابه وقال: “هذا السِّجن أنا كنتُ فيه في سنة 1973، وغادرتُه في 1974، وأشعر الآن أنّني لم أقض بين خروجي منه وعودتي إليه سوى أيّام معدودة…”.
قال المثابِر: – أنا أيضاً كنتُ ها هنا في تلك الفترة.
– “بالفعل، قال علّو. كنّا معاً ضِمن مُعتقلي تلك الفترة… لم نكن في نفس الزّنزانة، لكنْ ما أكثر ما تحادثنا وتناقشنا… كنتَ تحفظُ شِعراً كثيراً، وبالخصوص للأندلسيّين”.
بقي سي المثابر صامتاً لِلحظة، كأنّ ذاكرته تقوم بسياحة طويلة في أماكن بعيدة. وهكذا إلى أن استعادتْه إلى اللحظة الحاضرة ضحكة جهيرة أطلقها سي محمّد ميليس، الذي أتبع ضحكه بالكلام:
– إنّه لا يزال يحفظ شِعر الأندلسيّين… وفي ساعات حُزنه يُرَدّد قصيدة ابن زَيدون: “ما عَلى ظَنّي باسُ / يَجرح الدّهر وياسُو…”
سَرَّ هذا الكلام المثابر، لكنّ محمّد ميليس لم يستطع أن يُقاوِم ميله ألى معابثة رفيقه، لِذا قال: ” سي المثابر يؤسّي نفسه ويُواسيها، وهو شجاع بالطّبع. بعد أن نغادر السِّجن، يلزم أن نبحث له عن زوجة، فحياة الوحدة صعبة عليه ولا شكّ”.
وضحك ميليس، ولم يُسايره أحد فَصَمت.
قال علّو للمثابر: “في المرّة السّابقة كان هنالك حارس يُسدي لنا خدمات، وكان طيِّباً… كان لك به علاقة قرابة حسبما أظنّ”.
قال المثابر: “إنّه سي جُغمة. كان أخَا المرحومة زوجتي، وكان صديقي أيضاً. كنتُ أتوقّع أن أجده من جديد ها هنا، لكنّي أعلم الآن أنّه مات”.
وبدا أنّ مسحة أَسَف جلّلت وجه المثابر النّحيف، وكانت معالم الكهولة المتقدّمة باديةً عليه، وعظْمتا وجنتيه أضحتا بارزتين.
قال المثابر: “تَعرف، لو كان سي جغمة ما يزال حيّاً لربّما جلب لنا جرائد… لقد كنّا صديقين في أيّام شبابنا الأوّل، ولعبنا معاً في فريق واحد لكرة القدم… أحدِ فرق الأحياء بِمرّاكش… وشاءت الظّروف أن يُصبح صهري بعد ذلك”.
لاحظ عمر أنّ عيني المثابر اغرورقتا بِدموع قاومها دون رغبة فِعلِيّة في التّستّر عليها. كان واضحاً أنّ المثابر استحضر في تلك اللحظة زمن عيشه مع زوجته كلثوم قبل رحيلها.
كرّر ميليس ما كان قد قاله مِن قبل: “بعد أن نغادر السِّجن، يلزم أن نبحث عن زوجة جديدة لِسّي المثابر، فحياة الوحدة صعبة عليه ولا شكّ”.
المثابر هو مرّاكشي. بالمدينة الحمراء وُلِد وترعرع ودرس حتّى سنة البكالوريا. حدث ذلك قبل عقود. وكان قد ترك الدّراسة وأصبح مُعَلِّماً. كان يُحِبّ كرة القديم، وهو الآن مشرف على أحد فرق الأحياء باليوسفيّة.
ثمّ سُمِعت طقطقات مفاتيح على قضبان أبواب الزّنازين، وأصوات عجلات العربة التي كانت تَنقل للمساجين وجبات العشاء الفقيرة عديمة المذاق. لكنّ نزلاء الزّنزانة الخمسة تركوها جانباً، فقد كانت لهم مؤونة ممّا تجلبه لهم عائلاتهم.
أشعل سي محمّد ميليس فتيلة مغموسة في وعاء زيت دائريّ الفوّهة، وأشعل قدّاحته، ومَدَّ رأسَ الشُّعلة إلى طرف الفتيلة، وبدأ يُسَخّن دجاجاً وخضراً. وكي لا يُرى وعاء الزّيت مِن خارج الزّنزانة، رَكنه ميليس خلف الجدار الجانبيّ للمِرحاض الصّغير.
في تلك الأثناء، التفت عُمر صَوْب سي محمّد ميليس. كان هذا الأخير يُوَزّع ما سخَّن في أوان تنكيّة. وكان هنالك لافبو للاغتسال بداخل المرحاض الصّغير المحشور في جانب من الزّنزانة. ووضع كلّ من نزلاء الزّنزانة إناءه أمامه وبدأ بعضهم في الأكل.
وبدا أنّ الوقت سرّع مِن دوران عجلاته، فالليل قد حلّ والمصابيح أُشْعِلتْ، ولم يعد هنالك سوى حارس واحد يُسمع وقع حذائه في الممرّ المواجه لِصفّ الزّنازين.
كان عبد الرّحمان يتحدّث إلى علّو. والمثابر أكل قليلاً وترك إناءه أمامه.
قال المثابر: “لو كان في الإمكان الآن، لاقترحتُ عليكم أن نخرج لنشرب قهوة في واحد من شوارع غيليز أو في مقهى بجامع الفنا”.
وبلا مقدّمات، قفزت الذّاكرة بِعُمر إلى أحد الأيّام مِن شتاء 1972، وكان ماطِرًا بشكل جميل، فمطره كان خفيفًا ومتقطّعًا، وكان هو يَسيرُ في حيِّ غِيليز، بمرّاكش، في شارع كبير، صَوْبَ سينما “كوليزي” ليرى فيلماً بعنوان “طَيران فوق عُشّ الوقواق”.
وبدا أنّ سي محمّد ميليس لم يُرِد أن ينسى ما اقترحَه على المثابر، فعاد وقال له: “أنا أتحدّث إليك بِجِدّ، فَتَدارَك الموقف وتهيّأ لنتدبّر لك زوجة بعد أن نغادر هذا المكان، قبل أن تُصبِح شيخاً مأفوناً بلا حَول ولا قُوّة”، وأردف كلامه بضحكة مَرِحة.
قال له المثابر، وقد رغب في مُماحكته بِدوره: “أنا موافق، بِشرط أن تعمل على إعادة زوجتك السّابقة إلى بيتك، بعد أن أقدمتَ على تطليقها بتهوّر”.
تحرّكتْ شفتا ميليس، وقد انسحب الدّم مِن وجنتيه قليلاً، لكنّه لم يقل شيئاً. وكانت الجماعة تعرف أنّ ميليس كان مُتزوِّجاً بأستاذة للرّياضيات، كانت تتميّز بالجمال والرّصانة، لكنّهما انفصلا بعد أن كثرتْ بينهما المشاحنات. أمّا تفاصيل تلك المشاحنات وأسبابها، فلا أحد سأل عنها ميليس طبعاً.
ضَحك علّو بصوت مسموع ثمّ قال: “يا لَلموقف الغريب”. كان يُعلِّق علىى أسطر مِن الرّواية التي يَقرأ. قال له عبد الرّحمان: “حين تنتهي من الرّواية، أعطنيها لأَقرأها”. قال علّو: “طبعاً، طبعاً”، وضحك عبد الرّحمان وأراد أن يقول شيئاً، لكنّ علّو هو الذي بادر وقال لعبد الرّحمان: “والآن دعني أقرأ… آرايْب الفُمّْ !”.
في الخارج كان الممرّ شبه مظلم الآن، وكانت هالات ضوء طفيفة وقليلة تظهر فيه، شِبه دائريّة ومُتراقِصة. لا شكّ أنّها كانت تنبعث مِن مصباح يَدويّ صغير مُعلّق إلى حزام حارس، كانَ الرّفقاء الخمسة يسمعون وقع خطاه الخافت في الممرّ، مثلما كان سجناء الزّنازين المُجاورة يَسمعونها.
أمّا محمّد ميليس، فسرعان ما تجاوز شُعورَه بالحَرَج أو الانزعاج. بل إنّه كان قد أَلَِف المناكفات العابرة مع المثابر، وأصبحتْ نوعاً من العادة بالنّسبة إليهما. وقد توجّه إليه المثابر مِن جديد، قائلاً: “اِحْمد الله أنّك عُدتَ مِن جديد سي محمّد ميليس… بعد أنْ قضيتَ أيّاماً وأنت سي مُحمّد… فيليس !”، وشرع المثابر في قهقهة سارع إلى وَأْدِها لِكيْ لا ينبعث صَخب من الزنزانة إلى خارجها.
فَهم الجميع قَصْدَ المثابر، وابتسم عُمر وعلّو، والتفتَ عبدالرّحمان صوبَ ميليس، فرأى على سحنة هذا الأخير علامات التّضايُق، وعلى شفتيه ابتسامة مُفتعلَة. فالمثابر أشار، بطريقته في السُّخريّة، إلى أمر مثير كان قد وقع لمحمّد ميليس في هذا السِّجن، إذ إنّ مُمرّضاً بِسجن بولمهارز كان قد جاء يوماً وقال لِميليس: “أنتً مُصاب بالسِّيفيليس”، وذلك بعد ثلاثة أيّام مِن فحص للدّم كان قد أُجري لهذا الأخير. وكان تحليل الدّم ذاك قد تمّ إثر اضطرابات في خفقان قلب ميليس نجمت عتها حالات إغماء… وقد استغرب هذا الأخير كثيراً ما سمعه من المُمَرِّض، وقال إنّه لم يُقِم في حياته أيّ علاقة مِن النّوع الذي يُمكن أن يترتّب عنه ذلك الدّاء. وبقي ميليس مُمتقعاً شِبه ذاهل أيّاماً عِدّة، ثمّ جاء نفس المُمرّض وقال له إنّ ما كان قد أخبره به غير صحيح، وإنّ المصاب بالسّيفيليس كان شخصاً آخر، وإنّ خلطاً وَقع… إثر ذلك، ناداه المثابر للمرّة الأولى بتسمية “سي محمّد فيليس !”، وها هو يستعملها الآن من جديد !
ينهض المثابر ويخطو نحو باب المرحاض الصّغير. يلتفت عُمَر صوب مُحمّد ميليس، فَيرَفَع هذا الأخير سبّابته المفرودة، ويَجعلها لِصْق شفتيه اللتين ارتسمت عليهما ابتسامة عريضة. إنّه يطلب من عُمَر أن يَصمت. يُمسك ميليس بسيجارة بين إصبعين، ويُفرغ أعلاها مِن التّبغ. يُخرِج ثلاثة أعواد ثقاب من علبة أمامه، ويسحب رؤوسها الزّرقاء. يَحشر رأساً أزرق أوّل داخل السّيجارة. يُغطّيه بِقليل مِن التّبع. يُكرّر العمليّة حتى تكون الرّؤوس الزّرقاء الثّلاء قد اندسّت وسط القِسم العُلويّ مِن تبغ السّيجارة، ثمّ يُعيد هذه الأخيرة إلى العُلبة. يفهم عُمَر ما ينوي ميليس القيام به. لا يُحَبِّذ ذلك فِعلاً، لكنّ ميليس والمثابر قد ألفا المبالغة في المزاح مع بعضهما. في الممرّ المُقابل للزّنزانة، تُسمَعُ خُطى الحارس، بعيدةً بعض الشّي، فهو لم يعد يقطع الممرّ كلّه في كلّ مَرّة، ذاهباً آيِباً، بل أصبح يقوم في الغالب بِبضع خُطى على ناصية الممرّ، وفي مرّات قليلة يُكمل سيره على امتداد الممرّ.
يَعود المثابر إلى مكانه. في الإناء الذي أمامه، بقايا خُضَر، وكأس من تنك بها شاي. يَرشف منها جُرعة. يَبدو أنّه في حاجة إلى سيجارة، لكنّه لا يُفْصِح عن ذلك. يكتفي بالالتفات وتسريح بصره حواليه ورفقاؤه يَفهمون. يُسارع ميليس إلى إبراز طرف سيجارة من عُلبته، ثمّ يعرضها على المثابر. على شفتي ميليس ابتسامة عريضة، وهو يبدو بشوشاً منشرح القسمات. يتناول المثابر السيجارة، فيُشْعِلها له ميليس بِعود ثقاب. ينتر المثابر دخاناً مِن سيجارته وييدو مستمتعاً بِشَفط الدّخان ثمّ مجّه بِشكل تدريجيّ، من خلال نفخات متواليات. ابتسامة ميليس ثابتة في مكانها، وإن كانت عضلاتُ وجهه تبدو كالمتقلّصة، بِفِعل التّرقّب. إنّه ينتظر. والمثابر يسحب أنفاساً من السّيجارة، وخُطى الحارس تُسمَع، خافتةً، من ناصية الممرّ.
يستلذّ المثابر نكهة دخّان السّيجارة، ويُمسكها بين إصبعي يُمناه السّبابة والوُسطى، مُباعِداً بينهما بِبَعض الخُيَلاء. خُيَلاء أملاها عليه الانتشاء بالتّأكيد. أمّا ميليس، فقد افترّتْ شفته العُليا. إنّه يَشعر بأنّ ما يتوقّعه هو على وشك الحدوث. وبالفعل، فما هي إلّا ثانية حتى ارتعشت ملامح المثابر، وَسَرَت اهتزازة في صفحة وجهه كأنّ يداً خفيّة ترجّه. ذلك أنّه سمع ما يشبه انفجاراً خافتاً، اندلع على إثره لهيب في رأس السيجارة التي بين إصبعيه. اللهيب شكّل شُعلة صغيرة، بادر المثابر إلى النّفخ عليها وإطفائها. والتفت إلى ميليس ونظر إليه شَزراً وقال له: ” آشْ هاذْ السّلوك الصِّبيانيّ، آسّي محمّد فِيلِيسْ”.
فكّر المثابر أنّ ميليس حَشَر رأس عود ثقاب في وسط تبغ السّيجارة، واكتفى بإسقاط الدّخان المتصلّب قليلاً عَن طرفها إلى غطاء علبة الجُبن الذي كان يستعمله منفضةً. لقد رغب في الاستمرار في تدخين السّيجارة حتّى النّهاية، واعتبر مزحة ميليس الثّقيلة منتهية.
استمرّ في التّدخين لِثَانيتين. بعدها، سمع شنشنة في طرف السّيجارة، ثمّ اندلع منها لهيب مرّة ثانية. سمع المثابر انفجارين خافتين مُتتالين، وتأذّى حلقه مِن نكهة الفوسفور. في هذه المرّة، أَسقط ما تبقّى مِن السّيجارة في الإناء الذي يُوجَد أمامه، والذي يحتوي خضراً مطبوخة. وبانفعال، ضربه بِحاشية يَده. انقذف الإناء إذن ومضى لِيرتطم بِقضبان باب الزّنزانة، فتناثر بعض من محتوياته بداخلها، قريباً مِن الباب، وطارت قِطع خضروات مِن بين القضبان وحطّت على أرضيّة الممرّ. إنّها قِطع طماطم وكُوسَى وبصل، تشرّبت المرق والتّوابل وارتخت، وبمجرّد ما سقطتْ على أرضيّة الممرّ، سمع لها الرّفاق الخمسة صوتاً ظنّوه مُرتفعاً جِدّاً: اطّاشْ ! لكنْ سرعان ما تبيّن لهم أنّ ذلك الصّوت لم يَصل إلى أذني أيّ حارس.
تسمّرتْ عينا المثابر على الممرّ، وبدا أنّه امتقع قليلاً. كانت خُطى الحارس تُسمَع في ناصية الممرّ، وبدا أنّه سَيَطأ، عاحِلاً أو آجِلاً، قِطع الخضر المنتفخة بالمَرَق. ربّت عُمَر على كتف المثابر ووشوش له: “لا تهتمّ، إذا انزلق وسقط، سأقول إنّي أنا الذي ضربتُ الإناء بما فيه، فانقذفتْ قِطع الخضار إلى الممرّ…”. كانت خطى الحارس تقترب. وساد الصّمت والتّرقّب. الأضواء مطفأة الآن بداخل الزّنزانة، لكنّ الظّلام في الممرّ ليس دامِساً. اجتاز الحارس منطقة فتات الخضر ولم يحدث شيء. قال المثابر لِعُمَر بِصوت شديد الخفوت: “لا، لا، أنا سأقول الحقيقة… فما الذي سيقع في نهاية المطاف؟” ثمّ ساد الصّمت، فالحارس كان الآن عائداً أدراجه. الجميع يترقّبون مِن جديد. لا يستطيع عبد الرّحمان أن يكبح جماح ميله إلى المزاح، فيقول، بِصوت خافت: “ها هو سينزلق”. يُسايره عُمر، وبِدوره يَقول: ” ها هو سيتزلّج”. يَقطع الحارس منطقة فتات الخضر ولا يحدث شيء. يقول المثابر بصوت خافت: “ليست المشاكل ما كان يَنقصنا”. يقول علّو، بِصوت مُحايد: “على الأرجح، هو لن ينزلق”. تُسمَع خطى الحارس قادمة مُجَدَّدا نحو المنطقة التي أضحت خَطِرة في عيون الخمسة المترقّبين. بصوت جِدّ خفيض، يَضحك عبد الرّحمان ويقول: “قد ينزلق ويتزلّج قليلاً وتسبق رجلاه في انزلاقهما بقيّة جَسَده…”. يَصْفِق محمّد ميليس جبينَه بكفّه اليُمنى المفتوحة، في حركة عَفويّة واهنة، لكنْ ينجم عنها صوت يسمعه رفاقه. يقول ميليس: “نتمنّى ألّا يسقط وأن تمرّ الليلة بسلام”. يتوجّه إليه المثابر بالكلام: “هذه نتيجة مزاحك الأخرق”. يقترب الحارس من بقعة الخضر المنثورة، لكنّه يعود أدراجه قبل أن يصل إلى بقعة الخضر المنثورة. يقول علّو: “لا شكّ أنّ الحارس قد تعب، وسيمضي الآن لِينام”. يقول المثابر: “إنّك منحوس يا سي… فِيليس”، ثمّ يضحك ضحة واهنة. تصدر عن محمّد ميليس بدوره بداية ضحكة. يقول علّو: “لن ينزلق ولن يحدث شيء وربّما لن يمرّ مجدّدا من أمامنا. أنا سأنام”. يقول عبد الرّحمان: “وقد يمرّ من جديد، ويسقط وترتطم جمجمته بالبلاط”. يَصمت رفاقه جميعاً، فَيُضيف: “وربّما ينكسر قِحْفه ويختلط فُتات مُخّه بِفُتات الطّماطم والكُوسى والبَصَل”. يقول المُثابر لِعبد الرّحمان: “أَعْفِنا مِن نتاج خيالِك المجنون”. يقول عبد الرّحمان: “أنا أمزح فقط، آسّي المُثابر”. يقول عُمَر: “لم تعد خُطاه تُسمَع، ولربّما يكون قد نام. أمّا قطع الخضر القليلة التي انقذفتْ إلى الخارج، فلا شكّ أنّها قد يبست الآن وتفتّتت إلى ذرّات”. وكان الصّمت قد أطبق بالفعل في الممرّ.