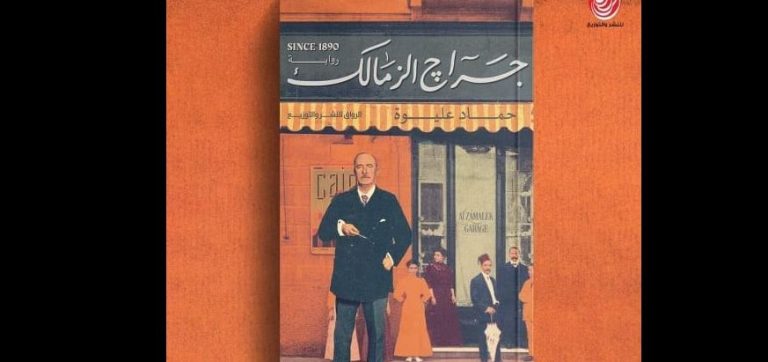عبد الرحمن أقريش
في الطريق إلى العمل، يمر الرجال غير بعيد من (دار الشيخات)، تتباطأ خطواتهم، يلقون نظرة خاطفة على الشرفة المفتوحة، ينظرون للستارة الحمراء، تنفخ فيها الريح، تحركها، تتموج، تتمايل، تجتاحهم مشاعر متناقضة، إعجاب، إغراء، تحريض، غواية، مزيج من الخوف والانجذاب الغامض، ولكنهم في أحاديثهم العلنية، عادة لا يكشفون عن مشاعرهم الحقيقية.
لسنوات، كان ذلك البيت مصدرا للحكايات والأسرار، وموضوعا للفضول والنميمة القاسية.
- إنه بيت سيء السمعة…
- الله يستر العيب…
- الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب…
- الله يهدي ما خلق…
- الله يحفظنا، لي تعجب يتبلى (يبتلى) !!
أما النساء فيشعرن بالخوف، والحزن، والغيرة، والكثير من الحسد.
يشعرن بالخوف على أزواجهن من الفتنة والمغامرات العاطفية بعيدا عن مؤسسة الزواج، يتأجج الخوف في نفوسهن في كل مرة يشاهدن الشرفة مفتوحة، ويتأجج أكثر لرؤية الستارة الحمراء وهي تتراقص وتعبث بها الريح.
أما مشاعر الغيرة والحسد فأمرها مفهوم تماما، فصاحبة البيت سيدة جميلة، ميسورة الحال، دنيوية، عصرية، متحررة، تلبس على الموضة، تسافر كثيرا، ومتصالحة تماما مع ذاتها.
…
نقف نحن الشباب عند مدخل الحي، نتحدث عن الكرة والمدرسة والكتب والسينما، نحكي النكت والمستملحات والنوادر الغريبة، نتحرش بالمارة، نتودد للفتيات، نتلصص، نسخر، نلمز، نضحك، ثم نصمت، نطأطئ رؤوسنا، نمثل الوقار واللياقة عندما يمر الكبار والأمهات.
ثم تمر هي، تنزل من سيارتها الفخمة، نرفع رؤوسنا بحذر، ننظر إليها بإعجاب، نتأملها، جسدها الشهي، الممتلئ من غير إفراط، لباسها العصري الأنيق، ثم نتوقف كثيرا عند التفاصيل الأخرى، حقيبتها اليدوية المذهبة، النظارة السوداء، ماكياجها المرسوم بعناية، تسريحتها القصيرة على الموضة، خطواتها وصوت كعبها العالي على الأرضية الإسفلتية، طراق، طراق، طراق…
وعندما تختفي في نهاية الزقاق، يهيمن الصمت للحظات، نلوذ بالصمت بفعل سلطة سحرية وغامضة، شيء يشبه الصدمة أو الذهول، ولا نعود إلى الكلام إلا عندما يتلاشى أريج عطرها القوي والغامض…
في البداية عندما استقرت في الحي، بدا أمرها غريبا ومحيرا، لم نكن نعرف اسمها، ولا نعرف شيئا عن عملها، فهي تخرج في المساء ولا تعود إلا مع الخيوط الأولى للصباح، أحيانا تختفي لأسابيع، ثم تظهر من جديد…
ثم بدأ الكبار يتكلمون، يقولون إنها (شيخة) تغني وترقص في الأعراس والمناسبات، يقولون أيضا إنها تشتغل في الفنادق والإقامات الخاصة بالأثرياء، البعض يتحدث عن احتفالات مشبوهة تقام في أندية مغلقة تحضرها فصيلة خاص من البشر، أثرياء، وجهاء، رجال سلطة، قضاة وموظفون كبار، احتفالات يمتزج فيها الجمال والمال بالمتعة الحرام…
تمضي الأيام والشهور والسنوات، وفي كل مرة تظهر (الشيخة) برفقة رجل جديد، يتغير الرجال في حياتها بانتظام، لا يتكررون أبدا، يظهرون بنظام، ويختفون بنظام.
بدا الأمر وكأنها تنقيهم بعناية، فالرجال في حياتها عابرون، عابرون فقط…
آخر هؤلاء الرجال كان شخصا مختلفا بكل المقاييس، تبدو عليه علامات الثراء، رجل قصير القامة، أحدب، وفي مقابل جمالها الصارخ يمثل هو نموذجا فريدا للبشاعة والقبح، ثم تناسلت الحكايات حول الرجل الغامض، البعض يقول إنه زوجها، البعض يقول إنه عشيقها الرسمي، والبعض يقول هو وكيل أعمالها، والبعض الآخر يقول إنه مجرد سمسار أو وسيط دعارة، أما نحن، فحسمنا الأمر بسهولة، منحناه هويته الخاصة، وسميناه (زوج الشيخة)
ثم تدريجيا، انكشفت تفاصيل قصة عاطفية قاسية بطلها ذلك الرجل الغامض.
…
هو مقاول يشتغل في مجال البناء، رجل بدوي، نصف أمي، وجد نفسه ثريا عندما اكتشف أن الأرض التي ورثها عن والده تصلح مقلعا للأحجار، حجر غال يستعمل لتزيين الفيلات والإقامات الفاخرة.
التقيا صدفة ذات مساء في أحد الفنادق الراقية المطلة على البحر، يجلس هو إلى مائدة فخمة أمام بركة عملاقة شديدة الصفاء والزرقة، يأكل، يشرب، يدخن ويستمتع بما يشبه استراحة طبية من ضغوط أعماله التي لا تنتهي، وعلى بعد خطوات تعتلي هي منصة معدنية مفتوحة، تغني، ترقص، تنعش السياحة وتدعم الاقتصاد الوطني بطريقتها الخاصة، تحيي حفلات لرواد سياحة من نوع خاص، أثرياء وأمراء من دول الخليج، رجال أعمال، تجار ووسطاء يتاجرون في كل شيء…
أحبها الرجل من النظرة الأولى، دعاها للخروج معه مرة أو مرتين، عرض عليها الزواج ولكنها رفضت.
- أنا لا أصلح للزواج، ولكننا يمكن أن نكون صديقين، أكثر من صديقين لو شئت، فقط ينبغي أن تكون كريما…
كانت تشير إلى حياتها، ماضيها، رؤيتها المختلفة للأمور، فالمهم في نظرها هو المال، المال فقط، الأمور الأخرى، الحب، الزواج، الأبناء والشرف مجرد تفاصيل زائدة.
نظر إليها صامتا.
- …؟؟
- ينبغي أن تدفع، أنت تفهم طبعا فلا شيء بدون ثمن.
اقتنع الرجل، اقتنع على مضض، طبعا هو لا يزعجه أن يدفع، فقد كان عالقا في شباكها ويمني نفسه بالزواج منها.
دامت علاقتهما سبع سنوات.
ثم دخل الرجل دائرة الفقر، تآكلت ثروته، خسرها تدريجيا، ولم يبق منها إلا شاحنة يتيمة لنقل الرمال ومواد البناء، فقد كان ينفق عليها بسخاء، ولكنه لم يفقد الأمل أبدا، ففي الحب عزاء وشفاء، الحب في نظره مبرر لكل الحماقات.
تقول الحكايات، إن نهاية القصة كانت مؤلمة.
في المرة الأخيرة، طاف على بارات المدينة كلها، شرب كما لم يفعل يوما، إقتنى ورودا، وراح يزورها في بيتها.
وضع باقة الورود على المائدة، جلس، أمسك رأسه بين يديه وراح يبكي بعنف.
- ما الأمر؟
- تتزوجينني؟
- اأنت أعمى؟
- أنا أعمى فعلا، فأنا أحبك ولا أعرف كيف أعيش بدونك…
نظرت إليه مشفقة.
- كن عاقلا للمرة الأخيرة، فأنا لا أصلح للزواج، لا أصلح لك، وأنت لا تصلح لي…
أحس الرجل بالغضب، ود لو يصرخ، لو يحتج، ولكنه كان مهزوما ومستسلما، انكتم الغضب بداخله، فخرجت كلماته خائفة ومترددة.
- وثروتي ومالي؟ وكل هذا السخاء الذي أغدقته عليك، ألا أستحق مقابله عرفانا بالجميل؟
مدت يدها إلى كأسها، رفعتها إلى شفتيها ووضعتها دون أن تشرب، عبت نفسا عميقا من سيجارتها، حبسته للحظات ثم أرسلته في وجهه وهي ترسم ابتسامة شامتة.
- عن أي ثروة تتحدث أيها المغفل؟ أتسمي شاحناتك البئيسة ثروة؟
وقفت منتصبة، نظرت إليه، نظرت في عينيه بقوة، نظرة هي خليط من الهدوء والغضب والاحتقار.
رفعت قفطانها المفتوح، رفعته قليلا إلى الأعلى، وأشارت إلى مكان ما في جسدها، وقالت.
- أدخل هنا وانظر، وابحث عن شاحناتك البئيسة، وسترى أنها لاشيء…
رفعت ثوبها إلى الأعلى مرة أخرى، وأشارت إلى نفس الموضع.
- الكثيرون ضاعت أموالهم هنا، الكثيرون ابتلعهم هذا البحر، وغرقت سفنهم وبواخرهم هنا…إذهب أيها الرجل المسكين، إذهب بعيدا من هنا، أنج بنفسك قبل أن يبتلعك البحر…
…
المساء، بدا الجو لطيفا، هادئا ومغريا.
في أعلى نقطة في كورنيش المدينة، في مكان مفتوح يهيمن على الأفق، وعلى بعد خطوات من البحر أوقف الرجل شاحنته، مال برأسه قليلا إلى الوراء، أغمض عينيه، ينصت لهدير المحرك، أطلق العنان لهواجسه وراح يدخن سيجارته الأخيرة.