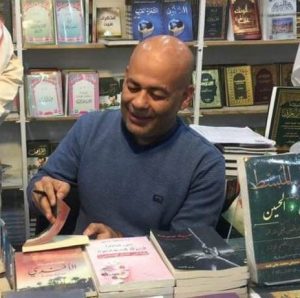إنجي همام
كان زوجي عاريا تماما تحت صنبور الاستحمام، عندما باغتته وفتحت الباب دونما حتى أن تطرقه، في البدء استأذنته في استخدام دورة المياه، ولكنه طلب منها الانتظار حتى ينتهي، لم تخرج، بل خلعت كامل ملابسها وانضمت إليه تحت الصنبور، عندما عدتُ من الخارج سمعتُ صوتا غريبا، صوتا نسائيا في بيت لا تسكنه امرأة سواي، في البدء ظننته التلفاز، ولكن الصوت صادر من دورة المياه، ذهبت لأجدهما يتشاجران تحت المياه المفتوحة، لم أنبس ببنت شفة، توجهتُ من فوري لغرفة النوم وعدتُ عارية مثلهما، وقبل أن يتفوه أيهما بحرف رحت أباهيها بجمال سمار بشرتي الأشد وهجا من بشرتها البيضاء، ووقف هو مشدوها ينظر لكلينا بفم مفتوح على أشده.
كانت “غزل” رفيقته الجامعية، كانت تكبره بعام واحد لكنها كانت تبدو كأنها تصغره بأعوام عدة، عندما تعرفتُ علي كليهما كنتُ بصفي الأول الجامعي، وكانا معا بالثالث، يعيدونه لمرة لست أعلمها، كانت شائعة تلك الحيلة على أيامهم بين كثير من الطلاب المناضلين، البقاء في الجامعة، كنز لا يعادله شيء، الكفاح من أجل القضايا الوطنية، تخرجوا جميعا في النهاية، وبقيت صداقتهم تأرجحها أرجوحة الزمن، جميعهم، إلا “غزل”، كانت حاضرة وإن غابت، كانت شريكتنا على طاولة الغداء بشكل شبه يومي، موجودة بتاريخها، جرأتها اللافتة التي يدعونها شجاعة نادرة، خفة ظلها وروحها الأخاذة، صباها الأبدي، أصبحتَ أصغر مني أنا أيضا في الشكل، أنا التي تصغرها بتسع سنوات.
لم تتزوج غزل قط، أحبت الكثيرين، ومن أحبوها أكثر، عاشت القصص طولا وعرضا، لكنها رفضت قيد الزواج، الحب حرية والزواج سجن، كانت تقول، عرفتُ محبته لها منذ البداية، كانت محبة خاصة، نوع من الإجلال والأخوة وتزاوج الأفكار والتاريخ المقدس، أحب طفولتي وعنادي منذ الوهلة الأولى، كان يريد بيتا، بيتا بحق، وعرفه في روحي منذ تعارفنا، لم أنبش خلف الحكايات، أحببته أنا أيضا كثيرا، أردته أكثر، أخذني اعتدادي بنفسي، حتى وإن لم يرد هو لكنت عرفت كيف أجعله يفعل، كان لقائي الأول بهما معا، وسط الماء، برك المياه الصغيرة ورائحة الغاز وصدري يختنق، بالكاد كنت ألفظها “بموت.. بموت” كان عن يساري وكانت عن يميني، جذباني كأبوين ليس لديهما طفلة غيري، أعدو في يديهما بعيدا عن الرائحة، دخلنا الجامعة التي كنا أمامها، أجلساني على الأرض وأسندا ظهري لشجرة.
كنتُ سنة أولى نضال أيضا كما كانت سنتي الجامعية، بعد أن هدأتُ ضحكنا طويلا، وصرنا أصدقاء، لم أكن أشبهها في شيء تقريبا، حتى في النضال الذي جمعنا منذ البدء، كانت تميل للزعامة، أكثر مكان رأيتها فيه فوق أكتاف الزملاء، أما أنا فلم أمسك الهتاف يوما، كنت أثق في صمتي، ليس لدى الجميع ميول استعراضية أو حب للظهور، هناك من يسيرون في صمت، يعيشون وربما يموتون أيضا بلا ضجيج كبير، لكنهم في الأفعال كانوا أكثر إقداما، فعلتُ ما كان يحلو لي بالضبط، أتممتُ سنواتي الجامعية بلا زيادة، واستكملتُ نضالي جوارا إلى العمل، وحصلت على قلبه، لكنها ظلت هناك، في خزانة تذكاراتنا القديمة، كنت أغار في سري، وكنت أشيح برأسي عن هذا التفكير، قلت: ستتزوج، ستبتعد، ستأخذها الأيام، لكن الأيام لم تفعل، بقيت كما كانت دوما، في كل شيء، مستعصية على التبدلات التي أصابت الجميع.
لم نكن نلتقيها كثيرا في السنوات الأولى، استراح هو، ألقي بحمل الدنيا من فوق كاهله على صدري، أحب البيت، وانغمس فيه وفيّ، لكنها ظلت شبحا يطارد مناماتي، رفض كبريائي أن أطلبها منه، أن أنُهي أحاديثه الدائمة عنها، عوّضت نفسي باحتوائي له، سأنسيه سيرتها بالفعل لا القول، ذهبت السياسة وأيامها، عشنا أياما طوالا بدونها، العمل والبيت ونزهات حلوة لها طعم محبتنا، في الإسكندرية عشنا عمرا فوق أعمارنا، عشنا كما لم نعش من قبل، طالما نزلنا بوسط المدينة، نعشقه كما في القاهرة تماما، لا نذهب للبحر فيها، بل للشوارع، كل الشوارع العتيقة وروائح الزمن المتراكمة، تمنينا يوما البقاء بها للأبد، حلمنا بدعوة جميع من نحبهم، لبدء حياة جديدة لنا جميعا، سميناهم بأسمائهم، كل الأصدقاء القدامى والجدد، من صنع أسرة ومن ظل وحيدا، لم يأت باسمها أولا كما كنت أظنه سيفعل، عندها عرفت أنه بدأ يتقصد إخفاء شيء ما، لم يكن من الغباء ليسقط اسمها تماما، ولكنه دسه وسط الأسماء، أخفاه كي لا يلفتني، أو هكذا ظن.
بعد سنوات من الحلم تمكنا من تحقيقه، ظننتها ابتسامة قدرية، لم أكن أدري ما تخفيه خلفها تلك الابتسامة الماكرة، كان بيتنا حيث تمنينا، أصبحت جولاتنا السنوية أسبوعية ونصف أسبوعية أحيانا، تحملنا الشوارع بمحبة كبرى، مسيرات رائقة لا يعكر صفوها شيء، شعرته ميلاد جديد للمحبة، حتى من دونه كنت أتسكع مليا بشوارع محبتنا وكان يرافقني، داخلي، كنت أجوب طرقاتنا حتى ينتهي من عمله الجديد، وينضم إليً بالجسد أيضا، ذات صباح خريفي بارد التقيتها بشارع صفية زغلول، تسمرت خلجاتي، اندفعت في صدري بلهفة مصطنعة، من دون كل الأسماء التي ذكرناها انضمت هي للعيش معنا، تحت سماء مدينتنا الجديدة، ثلاثة أسابيع وكانت نافذتها في مواجهة نافذتي، كانت أول ما ألتقيه مع كل طلعة شمس، منعني كبريائي من الرفض، أعرف أن ما له أن يحدث سوف يحدث، مهما تجنبنا مواجهته، لم يكن هناك شيء مادي يؤكد أو ينفي هواجسي، كل الأفكار تلوتها على نفسي صباح مساء، كانت أمامه قبلا … كانت ولازالت تعلن رفضها للعلاقات الطويلة الموسومة بالرسمية والتقليدية.. والممنوع مرغوب .. والسر يحلو للرجال، يحلو للجميع … كل الأفكار وعكسها رددتها ليل نهار، لم أصل إلى شيء، عيناها المسحوبتان بثقة قطة ماكرة كانتا ترتشقان بروحي كل صباح، تلقي التحية من النافذة وتدعوني أو تأتي لشرب القهوة، تركتُ عملي بالقاهرة ولم أعثر على آخر بعد، قلتُ إجازة أفرغ فيها روحي للمحبة خالصة، أسعدته الفكرة كثيرا، أو هكذا أظهر لي، أما هي فجاءت في إجازة طويلة من العالم، هدنة من الحياة، لم تكن تنوي الاستقرار، ولكنها كانت رحلة مطولة، لم تفصح هي حتى عن طولها، ولما لا وهي لا يعوزها المال، لا يعوزها شيء أبدا، دوما لديها كل ما تريد، نحن فقط من كانت تستطيع مخالطته من زمن تمنت الاستراحة منه لبعض الوقت، نحن فقط أصفياء السريرة هانئي البال الذين أرادت أن تنطبع روحها بهنائتهم وصفاء حياتهم الخالية إلا من المحبة، أخوتي الوحيدين بحق، لم تغيركم الأيام الصعبة، كانت تردد دوما ما يشبه ذلك، كان يبتسم وكنت أصمت، ولم تكن تريد هي أكثر، فسحة في ذلك البيت، في تلك الحياة، لم يتغير هو أبدا، لم تبدو عليه أية أمارات تدعو للقلق، لم يبالغ حتى في اللطف المعتاد عند حدوث تلك الأمور، ظل كما كان، نفس العادات والمواعيد، لم يدّع تأففا من إنضمامها الدائم لكل شيء نفعله، كان يربت على كتفي ويهمس بابتسامته الودودة “وحيدة” نحتملها قليلا، كانت تتقمص الأدوار وتتبادلها، مرة ابنة ومرة أم وأخرى أخت، لعبت أدوار جميع الأقرباء، نحن أيضا وحيدون وتلزمنا الصحبة، ربما لولاها لبهتت الحياة، الحب لا يصمد إلى الأبد في وجه الملل، كنت أقنع نفسي بذلك، ذلك الصبر العتيد المزروع في روحي جبلها على إيثار السلام والسكينة والعقل، لن أرتضي دور الغيور المجنونة متزعزعة الثقة في عينيه يوما، قضيتُ الصباحات معها باسمة بثقة، تعمدتُ أن تُخيفها ثقتي، فردت بثقة لا تقل، وقضينا ليلات معا، ثلاثتنا، في المقاهي والسينمات والمتاجر، والمشافي أحيانا.
كانت الواحدة بعد منتصف الليل عندما رن هاتفه برقمها، اتصلت عليه مباشرة تعللت بمعرفتها أني أغلق هاتفي عند انتصاف الليل، كانت تبكي بحرقة عندما فتحت باب شقتها بعد وقت طويل، لا تعرف سببا واضحا لاعتصار معدتها المفاجئ، تركني للمبيت معها بالمشفى وذهب للبيت، في الصباح أتى باكرا طلب مني العودة لأنام، يعرف أني لا يغمض لي جفن خارج سريري، استراح وجهها وأنا على عتبة الباب، أعرف بالشعور وحده، أنه لم يكن يوما عاديا، أعرف عندما تفيض المرأة بضعفها، عندما تقرر منحه ذلك الضعف بمنتهى القوة.
في مساء نفس الليلة كانت المرة الأولى التي يخرج فيها ضعفي أنا الأخرى، لكنه ليس الضعف المحبب للرجال، طلبتُ وضع حدا لتلك الحياة، طلبتُ العودة للقاهرة لو كانت آخر الحلول، أعتقدُ صوتنا في الليالي التالية كان يخترق جدار بيتها، لم يعد يعنيني شيء، بل من الأفضل أن تعرف، ربما أبعدها الخجل، وقعتُ في فخ الحماقة الذي حاولت تلافيه زمنا، أي خجل هذا!!
سافر زوجي في مهمة عمل طويلة، فالتصقتُ بها، كان ذلك ضمانة لي، أما هي فكانت تبدو عليها سعادة عجيبة، تبدو كمن امتلكنا بشكل ما، كنت أظنها تريده، ولكنها أرادتنا معا، أرادت تلك الحياة حتى أخر قطرة فيها، لم نعد للقاهرة بالطبع، ولا عادت هي، في الليل كنتُ أتنصت، أسمع أصواتا دائمة، أتسحب بخفة حافية القدمين، أفتش في غرف البيت، أتنشق رائحتها الموزعة فيه، في الظلام وحده كنتُ أراها بوضوح كامل، عند الاستعانة بأية وسيلة إضاءة كانت تختفي، تفر مخلفة رائحتها التي لا ترحل أبدا، ذات صباح في شرفة بيتها الكبيرة قالتها مازحة: “إيه رأيك تبقي ضرتي”
بين رشفتي من فنجانها الأبيض المستطيل، قسمت الجملة نصفين وأطلقتها في وجهي كلاعب كرة ماهر سدد ضربته برشاقة بالغة، لا أذكر كم ساد الصمت، ولكنني ضحكت ضحكة صفراء وأخبرتها بنبرة مرتعشة أنها فعلا كذلك، بعد يومين أخبرته بمزحتها وظللت أبحث في عينيه عن الأثر، قالها بنبرة محايدة لا تحمل أية معنى: “اطمئني .. غزل تكره الزواج”
لم أصدقه، لم أعد أصدق كليهما، في الأيام التالية بدا كل شيء عادي، لم تأتي غزل بسيرة مزحتها مرة أخرى رغم انتظاري وتأهبي لذلك، فكرتُ أنه لا مناص من التعامل مع الأمر، ولما لا، في كل الأحوال هي حاضرة، بعض حضور أو حضور منقوص، ربما إذا أكتمل بهت، ربما إذا اتضحت غابت، تعجبهما تلك المراوحة، يتسليان على حسابي، لن يحدث ذلك، أنا التي ستخطبها له، سأصحبها في اختيار مستلزمات الزواج، سأضع بصمتي على حياتهما الجديدة، سأتركه ليكتشف من منا الأكثر حضورا وقوة، بالفعل ازدادت جولاتها الشرائية، جبنا الاسكندرية شرقا وغربا، كانت بالفعل تتحضر كعروس، لم تهتم بشيء سوى الملابس، جميع الملابس لجميع المناسبات، للبيت والشارع، للصبح والمساء، ملابس مبهجة تفوح منها روائح الفرحة، لم نكن نتحدث، كنا نختار ونجرب ونشتري بهدوء غريب، بعدها كانت تختفي بعد عصر كل يوم، لم أسألها عن شيء، لم أسأل أحدا، أغلقت بابا على صمتي ونفسي وظللت أنتظر، ها قد رتبتُ معهما لكل شيء، لن يصدمني أحد، أنتظرها لتفاتحني في المواعيد والتفاصيل الصغيرة في أية لحظة، أعرف أنه سيجيء صباح قريب ستنظر في عيني ببسمة وسيعة وقحة وبين رشفة قهوة وأخرى ستقول بهدوء مخيف أن كل الأشياء أصبحت جاهزة، ستطلب مني تحديد الموعد المناسب بنفسي، على أن يكون قبل حلول الصيف، هي تكره الصيف، على أية حال لا أظنها ستطيق الانتظار حتى وصوله، من مارس الجاري إلى مايو القادم لن أراه إلا قليلا، سيكون من اللائق ترك فسحة للعروسين، في يونيو سيبدآن بالظهور، أما يوليو وأغسطس ستتركه لي، ستكون قد اكتفت، الحرارة تمنعها من التنفس الجيد، مع تلك الرطوبة هنا ستختنق، ستريد بعض من الوقت لنفسها، ربما تعاودها الرغبة فيه على منتصف أكتوبر، ربما أعود أنا للقاهرة في نفس التوقيت، سأتركه لها كاملا في الشتاء الأول، سأدير اللعبة كاملة وسأستمتع كثيرا، ربما تبادل المقاعد مثير جدا في بعض الأحيان، ولكن، لمن يستطيع، يمكنني فعلها، بالطبع يمكنني، سأتسلى كثيرا، وهم سيخافون، سيخافون بشدة دائما من غيابي وحضوري، أم أن هناءتهم الطازجة ستحول بينهم وبين الخوف؟، سينسونني تماما في غيابي والحضور؟ هل نصبت فخا لنفسي؟ ليس حقيقيا، كانوا سيفعلونها، بيدي لا بيد عمرو، سأحرمهم لذة الاختلاس، أنا هنا، وسأبقى..
في مطلع إبريل فاجأتني باستعداد مباغت للرحيل، الرحيل الكامل، قالت لي: شبعت، الاسكندرية حلوة ولكن القاهرة أوحشتني، أحب القاهرة في هذا الوقت، كنا بشرفتها هذه المرة، نحتسي مشروبات الصباح، كانت تضع دبلة لم أرها في يدها من قبل، عندما تسمرت عيناي على إصبعها حملت صينية القهوة ودخلت للمطبخ، بعد أيام ثلاثة تبخرت، أصبحت النافذة في وجهي مغلقة والشقة خالية، والجو يحمل صفاءاتٍ مسكرة، عدتُ لجولاتي القديمة، التسكع الطويل في وسط المدينة بلا هدف، أغسل تجاويف عقلي من كل ذلك الجنون الموجع، أنظر للطرقات بمحبة فائضة، في نهاية الأسبوع تحضرتُ لليلة هناءة لم أعشها منذ وقت طويل، اشتريتُ طاقم حريري أبيض اللون، كعروس، جهزت عشاء فاخرا واحتسينا حتى الغياب، لم أحاول البحث عنها في عينيه، لم أحاول إفساد ليلتي بيدي، نظرتُ فقط لصوته، كان مبتهجا رائقا، اكتفيت بتلك النبرة، ربما هي من غيبتني لا الشراب، على فخذيه أجلس، أضمه بحنو في صدري متحاشية عينيه، أسأله الغناء كما الأيام الخوالي، فيدندن بصوت خفيض حتى تنام رأسي على كتفه، لا أذكر كيف حدث ذلك، لا أذكر سوى صوتيهما وصوت الماء، صورتهما المغبشة تحت الصنبور تتضح وتغيب في رأسي، ذلك الألم الكبير يسكنها بقوة وكذلك كتفان ملتمعان تحت الماء لرجل وامرأة.