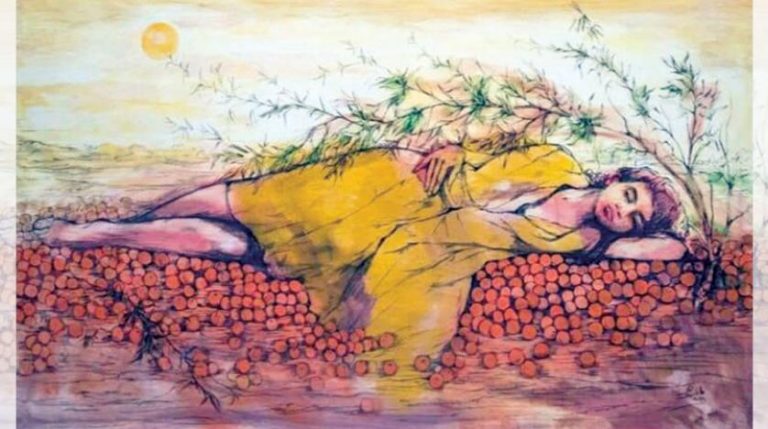د.سعيد السيابي
قرأت أن الفلسفة الوجودية تُؤكد على حرية الإنسان ومسؤوليته في خلق معنى خاص به في مواجهة العدم، حتى لا يعيش في عالم يكون فيه مُهددًا طول الوقت. بعد كل أزمة مررت بها، كنت دائمًا أؤمن أن الحل الوحيد أن أُغلق الأبواب خلفي بسرعة، حيث لا يستطيع الخروج مجددًا.
لم يكن الهروب حلًّا، لكنني كنت أبرع من أي أحد في إتقانه. مع كل أزمة، كنت أغلق الأبواب خلفي بعنف، أمحو آثار كل شيء، كأنني لم أكن هناك أصلًا. كنت أعتقد أنني أنجو بهذه الطريقة، لكنني هذه المرة لم أستطع.
في عمق عتمة ممتدة، أحدق في الأمواج التي تتكسر على جسد الباخرة المبحرة من طرطوس إلى بيروت، ممسكًا بالحاجز المعدني البارد، وجدتني أتأمل نفسي كظلٍّ مجهول يحاول الهروب من انعكاساته المتشظية في المياه. كان البحر يمتد أمامي كمرآة ضخمة لا نهاية لها، مرآة تعكس كل ما تركته خلفي. الذكريات التي لم أستطع دفنها، والوجوه التي رسمتها بخطوط ضعيفة في صفحات الأيام.
قلبي يئن تحت ثقل أحمال لم أكن أملك الشجاعة لمواجهتها. كل مرة أحاول فيها التخلص مما مضى، كنت أشعر وكأن هناك شبحًا يطاردني، شبحًا يحمل بين يديه صورًا لأحداث قد مضت، لكنها ما زالت تنزف في أعماقي. كنت دائمًا أؤمن أن الحل هو الهرب—هرب سريع ومفاجئ، مثل سجين يُغلق الباب خلفه بكل قوة، معتقدًا أنه بذلك يستطيع إغلاق الماضي، كما لو كان يمكن طمس آثار الحريق بمجرد إطفاء اللهب الأول. لكن هذه المرة، لم أستطع. الجروح كانت غائرة، واللحظات التي تركتها وراء ظهري ليست مجرد ذكريات، بل كائنات حية تتنفس وتصرخ في صمت.
أذكر ذلك المشهد الذي ظل يطاردني ككابوس لا ينتهي. مشهد ميّ الحسين وأصدقائها، ولماذا تصورت كيف ستبدو وهي تقف هناك، واثقة، هادئة، حتى في لحظة القبض عليها؟ تخيلت كلماتها وهي تخرج واحدة تلو الأخرى، كأنها قطرات ماء تسقط من سقف عتيق في ليلة شتوية. كانت كلماتها نصلًا يقطع عميقًا داخل روحي، ليس لأنها كانت قاسية، بل لأنها كانت صادقة، واضحة كالسماء الصافية في صباح يوم لا يمكن نسيانه. تلك الكلمات أشعلت شيئًا بداخلي، شيء ما كان نائمًا منذ زمن بعيد، ربما منذ أن قررت أن أعيش حياتي كجسد بلا روح، أركض نحو الأمام دون أن أعرف لماذا أو إلى أين.
بينما كانت الباخرة تشق طريقها عبر الأمواج، شعرت بأنني كمن يقف على الحافة الفاصلة بين العالمين: عالم الأحياء وعالم الموتى. فوضى المدينة التي اختفت خلفي كانت تشبه فوضى روحي، كأنني مدينة مهدمة، وأنا الوحيد الذي يمشي بين أنقاضها، غير قادر على إعادة بنائها أو حتى الهرب منها.
محرك السفينة كان يزمجر كقلب غاضب، يقذف ببقايا أفكار مجنونة في عرض البحر. كنت أسمعه يهدر وكأنه يغني أغنية قديمة، أغنية عن الخيبة والفرار. كنت أحاول أن أقنع نفسي بأنني هنا للبحث عن بداية جديدة، عن فرصة لتعليم جديد، عن حياة تجمعني بشخص آخر قد يكون هو السند الذي أحتاجه. ولكن في قرارة نفسي، كنت أعلم أنني هنا لأهرب، ليس فقط من الآخرين، بل من نفسي أيضًا.
حينما ابتسم لي الحظ بهذه الفرصة، شعرت وكأنني طفل يحصل على لعبة جديدة، ولكنه يدرك في نفس الوقت أن هذه اللعبة لن تكون قادرة على إصلاح الكسر العميق الذي يسكنه. كنت أبحث عن حبيبة تشاركني هذا الاغتراب، عن شخص يدفئ تلك المشاعر المتضاربة التي تسكنني، ولكني في النهاية كنت أهرب، أهرب من نفسي، ومن كل ما تركته ورائي.
بينما كنت أتأمل السماء من وقت لآخر، حيث تتلألأ النجوم كأنها تهمس بأسرار الكون. شعرتُ بأن كل نجم هو ذكرى، وكل ذكرى هي قصة. وبدأت أتساءل: إن كانت ميّ تنظر إلى نفس السماء الآن، وإن كانت تذكرني. هل كانت تفكر في نفس الأسئلة التي كانت تدور في رأسي؟ هل كانت تشعر بنفس الخوف الذي يختبئ تحت قناعة الهدوء؟
بدأت أتخيل نفسي أعود، أخطو على سطح الباخرة في الاتجاه المعاكس، عائدًا إلى حيث بدأت. لكن الصورة كانت مشوشة، كأنها حلم لا يمكن التحكم به. كنت أعرف أن العودة لن تكون سهلة، لكنني كنت أشعر بأنها الطريقة الوحيدة لأجد السلام.
وفي وسط هذه الأفكار، ظهرت صورة أخرى. فتاة تقف على سطح الباخرة، تنظر إلى الأفق بعيون مليئة بالأسئلة. كانت تشبهني في شيء ما، في ذلك البحث الدائم عن معنى في عالم يبدو أحيانًا بلا معنى. ربما كانت هي الفرصة التي كنت أبحث عنها، الشخص الذي يمكن أن يشاركني هذا الاغتراب، ويدفئ تلك المشاعر المتناقضة التي كانت تعصف بي.
لكنني كنت أعرف أن الحل لم يكن في الهروب معها، بل في مواجهة نفسي أولًا. كنت بحاجة إلى أن أجد معنى في كل هذا، أن أخلق شيئًا من الفوضى التي كنت أحملها. ربما كانت الفلسفة الوجودية على حق، ربما كان علينا أن نخلق معنى خاصًا بنا في مواجهة العدم.
………………….
ـ روائي وباحث مسرحي
ـ مقطع من رواية “جسور متداعية” صدرت عن درا لبان، سلطنة عمان 2025