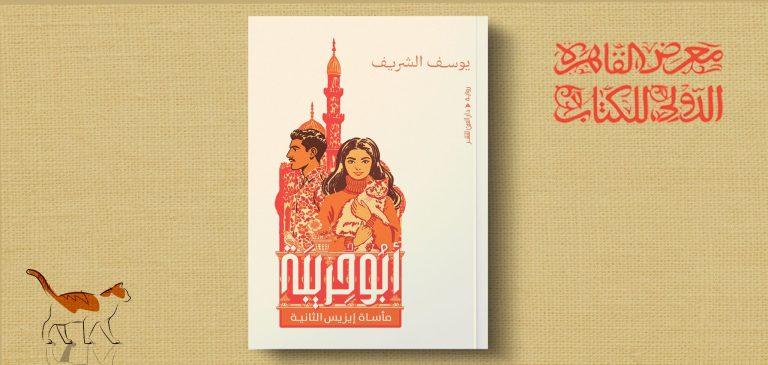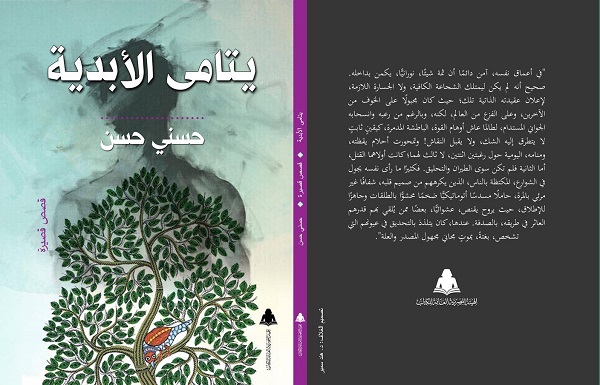عبد اللطيف النيلة
كنت أخطو فوق الرصيف، قاصدا مبنى الوزارة. حانقا كنت. فمرة أخرى ينشب شجار بيننا، بسبب تلك الفلذة: طفلي الذي لم يجاوز الخمسة عشر شهرا. كيف لا أغضب؟ علبة الحفاضات تنفد في أقل من ثلاثة أيام! وحبيبتي تقول إنه يتبول ويتبرز كثيرا. أقول لها: سَرْوِليه بخرق عادية. لكنها تقول إن تلك الخرق تلهب بشرته الناعمة.
في العاشرة إلا ربعا كنت أقف أمام المبنى الفخم لوزارة المالية. حرارة الشمس تشتد شيئا فشيئا. لم أكن وحدي. المسؤول النقابي كان يوزع نسخا من منشور على الذين حضروا.. كنا ننتظر أن يكتمل الجمع لنخوض وقفتنا الاحتجاجية. جلست تحت ظل شجرة كاليتوس وارفة على الرصيف وأنا ألقي نظرة على الساعة من لحظة لأخرى. لماذا نتأخر دائما عن المواعيد الخطرة؟ انضم إلي صاحبان يشتغلان معي في نفس المؤسسة. أحدهما من “قدماء المحاربين”، والآخر يجاورني في السكنى.
نفث المحارب القديم دخان سيجارته، وتطلع إلى وجهي شبه شارد، وقال:
– بم تحلم؟
– أحلم؟
– نعم. هل لك حلم خارج هذه المعمعة؟
– لا حلم إلا داخل المعمعة.
– أقصد حلما خاصا، حميميا.
كان جاري يمسح غبار حذائه بمنديل من ورق، بينما لبثتُ صامتا وقد تداعى إلى ذهني حلم لا تتعب زوجتي من قذفي به، من حين لآخر، فتنغص عليّ بهجة يومي. تقول لي:”كم أرغب في تزيين جيدي بسلسلة من الذهب الخالص!”. عاد المحارب القديم إلى الكلام:
– اِسمع! أنا أحلم ببيت من خشب، يشبه بيوت الريف في أوربا. هل تذكر مسلسل “المنزل الصغير”؟.. مثل ذلك البيت تماما. وطبعا أنت تتصور معي أن لهذا البيت نوافذ تطل، من كل الجهات، على الأشجار. هناك اخضرار على مدى البصر، وهناك جداول ماء..
– وطيور تزقزق، ورائحة التراب الندي، والسماء الصافية الزرقة، والحطب الذي يحترق، و..
– تماما. وأنا وسط كل ذلك أحلم بيوم على مقاسي.
– تنقصك فقط امرأة وكتب وموسيقى.
– الموسيقى في الطبيعة، والكتب أفضل أن تكون كتب تاريخ تروي صراعات البشر التي لا تنتهي. أما المرأة فقد اكتفيت بنصيبي منها: تلك “الدراما” التي تصاحبني منذ عشرين عاما.
ضحكت من أعماق قلبي، وأحسست بالافتعال في ضحكة جاري الذي كان يتابع حديثنا متظاهرا باللامبالاة.
بدأ لغط الواقفين يصل إلينا، لكن الوقفة لم تبدأ بعد. جذب المحارب القديم نفسا من سيجارته وتطلع إلي متسائلا:
– وأنت؟ بماذا تحلم؟
كدت أقول له إني أحلم بتغيير العالم. خشيت أن يتهكم، فشردت. وهو يترقب ردي، شعرت أنه في حاجة إلى من يشاركه الحلم، الحلم الحميمي. ثم وجدت نفسي أقول:
– أحلم بجو الشتاء، البرد قارس وأنا مستلق تحت غطاء صوفي، في غرفة صغيرة، بلا تلفزة، معي إخوتي يسخنون أطرافهم فوق نار المجمر الطيني..
– والستارة مسدلة، وأبوك في الخارج يسترزق الله، وأنت تشعر عميقا بلذة الدفء..
– تماما. وأمي تَقْلب سلة قصبية فوق المجمر، وتضع فوقها ثيابنا المبتلة لتجف.
– وهناك بالمطبخ “بِصارة” تنضج على مهل فوق نار موقد الغاز.
– وأنا تحت الغطاء الصوفي أقرأ.
– تقرأ؟
– نعم، أقرأ حكاية السندباد البحري.
– أو علي بابا والأربعين حرامي.
– أو جزيرة الكنز.
شرد المحارب القديم وقد طفح وجهه بالرضا، حتى بدت بشرته المصفرة المتعبة نابضة بالدم. وظللنا في صمت لذيذ، صمت مسكون بالحلم والحنين…
قال جاري، فجأة، كأنه صوت الواقع:
– هيا نلتحق بالرفاق! لقد بدأت الوقفة الاحتجاجية.
التفت إليه المحارب القديم، وقال في شبه تحد:
– وأنت يا رفيق! ألا تحلم؟
نقّل نظراته القلقة بيننا. وقبل أن يجيب، مرقت في ذهني قسمات سيرته: عازب يلهث خلف بائعات الهوى. صامت في أغلب الأحيان، لا تدري فيم يفكر. لا يحب أن يكون صاحيا: في زاوية من مطبخه المسكون بالفوضى، صفوف من القنينات الخضراء الفارغة. زبون دائم لشركات السلف: ينحدر من قرض لآخر، حد الإفلاس. بم يمكن أن يحلم؟
أجاب:
– الله يفك الجرة على خير!
– أية جرة؟
ترك السؤال معلقا، ومضى باتجاه الجموع الواقفة. تبادلنا نظرة أنا والمحارب القديم، وسرنا في أثره.
كانت الحناجر قد ارتفعت تردد الشعارات، وقوات الأمن تطوق المكان. انحشرت بين الواقفين، تغمرني الأصوات. لكني كنت أفكر في ذلك السؤال: “بم تحلم؟”. خطر ببالي أن أسمّي هذا اليوم “بمَ تحلم؟”، وغدا “مِمّ تخجل؟”، وبَعْدَ غَدٍ “ماذا تكره؟”، وبَعْدَ بَعْدَ غَدٍ “مِمّ تخاف؟”، وهكذا…
ظلت البوابة الحديدية المهيبة موصدة، ومبنى وزارة المالية، بأعمدته الرخامية، منتصب بفخامة أمام الهتافات الحارة العالية، والعيون المحتقنة بالاحتجاج، وقبضات الأيدي المهتزة في قوة وإصرار. فكرت: نقف تحت الحر معا، نحن المحتجين وهؤلاء المطوقين للمكان. أما أولئك القاعدون خلف الأبواب على الكراسي الوثيرة……. وقفز إلى رأسي مقطع من مقاطع الحلم: أنا ألتذ بدفء الغطاء الصوفي، بينما أبي، في السوق، يسترزق الله وبرد الخارج يلسعه و .. والعسس لا يتعبون من مطاردته من يوم لآخر!
كانت الشمس ماضية في إذكاء لهيبها. لكن حماس الواقفين كان يشتد أكثر فأكثر، فيما شابَ الحذرُ المضاعف حركاتِ قوات الأمن. وانتقلت إليّ عدوى الحماس يغذيها القلق الذي صرت أكابده بمجرد التفكير فقط في احتياجات فلذة كبدي البسيطة. رفعت صوتي عاليا، وأحسستني خفيفا كما لو كنت محمولا على جناح الحلم.
***