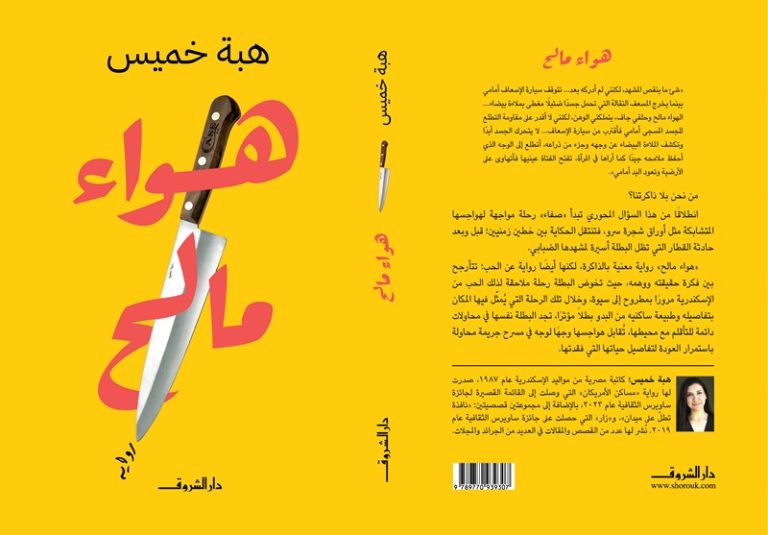وصلنى قبل أسبوعين إيميل من إحدى الشركات التى راسلتها فى الآونة الأخيرة بحثا عن وظيفة جديدة بعدما فقدت عملى السابق فى تلك الجريدة الأسبوعية التى لا يقرأها أحد. وصفنى رئيس التحرير، وكان ضخما وذى هيئة مهيبة وصوت عميق، بأننى جبان ومتردد ولا أصلح لأكون صحفيا أو حتى فراشا بجريدة. سكتُّ وطأطأت رأسى كما كنت أفعل أمام المدرسين صغيرا، وفى الطريق إلى المنزل ظننت أننى أعطيته بتصرفى هذا دليلا إضافيا على ضعفى وجبنى، وتمنيت لو كنت سببته أو تبجحت عليه، إلا أننى صدقته، أنا لا أصلح للصحافة، فأنا أخاف المجرمين والساسة، وأكره الدم والكذب، وأمقت النفاق، لذا لجأت إلى شهادتى الجامعية التى أهملتها لسنين وراسلت عددا من المؤسسات والمكاتب الحسابية. ظللت أنتظر ردا لأسابيع حتى وصلنى ذاك الإخطار على بريدى الإلكترونى لينبأنى برد مقتضب من شركة (الطريق)، حددوا لى موعدا وكتبوا لى العنوان دون أى تفاصيل أخرى حول طبيعة الوظيفة أو متطلباتها.
وصلت إلى العنوان المحدد قبل الميعاد بحوالى نصف ساعة، تقدمت إلى داخل العمارة العتيقة، تأملت بنيانها الأثرى، سلالمها الدائرية الممتدة وأسقفها العالية ومدخلها الفسيح، ولكننى ارتبكت أمام أبواب الشقق، لم يذكر العنوان رقم الشقة أو الدور الذى تقع فيه. تنقلت بين طوابق البناية الثلاثة دون أن أجد أثرا للافتة تدلنى على مكان الشركة أو شخصا يقودنى إليها، اعتقدت أننى أخطأت العنوان، فقررت أن أدق على أى من الأبواب وأسأل من يصادفنى من السكان. انتقيت إحدى الشقق فى الدور الثانى بعدما سمعت صوت سعال يصلنى من داخلها، مددت يدى للزر، سمعت رنين الجرس، وانتظرت بينما يقترب صوت السعال تدريجيا وببطء حتى انفتح الباب عن رجل ثلاثينى يرتدى نظارة شمس بعدستين شديدتى السواد، معطف أسود ثقيل، وشورت، كانت هيئته مربكة، فلا تفهم إن كان يشعر بالبرد أم أن الحرارة تجتاح جسده. ظل يحدق فى وجهى من خلف نظارته الداكنة التى تخفى معظم وجهه، قبل أن يقول بصوت أجش متحشرج وعنيف “نعم ؟؟” . أجبت بابتسامة اجتهدت كى أفتعلها “شركة الطريق؟”. رفع شفته العليا مستنكرا قبل أن يكرر ولكن بلهجة متهكمة وغاضبة “نعم؟!” فكررت بدورى “مقر شركة الطريق؟ “، فقال بصوت أعلى وأعنف من ذى قبل “لاء”. وظل ينظر إلىَّ متفحصا دون أن يتحرك أو يغلق الباب. امتد الصمت وطالت النظرات بيننا وهو يتأملنى بتقزز وغضب غير مفهومين، ورغم أننى لا أكاد أرى عينيه من خلف نظارته السوداء إلا أننى تخيلت نظرته، واستفزنى ما تخيلته، أثار انفعالى، فكسرت السكوت وقلت له “طيب ما تتكلم كويس” إلا أنه ظل ثابتا على وضعه، لم يرد أو يبد أى حركة، أضفت “لاحول ولا قوة إلا بالله” ثم أدرت ظهرى، تركته خلفى وقررت أن أكمل بحثى عن الشركة فى الطابق الأعلى.
صعدت الدرجات بتردد وبطء، نظرت إلى الشقق المتجاورة كى انتقى واحدة أدق على بابها، ولكن الشقق الثلاث بدت متشابهة حد التطابق ودون أى علامة مميزة لأى منها. وفجأة وفى أثناء وقوفى أمام الشقق الثلاث، سمعت صوت اصطكاك باب الشقة الأولى، هز انغلاق الباب العمارة كلها وترك صدى وراءه ثم تبعته أصوات السعال من جديد، ربما كان سكرانا، أو لعله كلت فى الفراش يطارح امرأة متزوجة وأصابته زيارتى بفزع ممزوج بالغضب.
ولإن خير الأمور الوسط، ضغطت على جرس الشقة الوسطى، ولكنه لم يصدر صوتا، فدققت على الباب بيدى، تأخر الرد للحظات قبل أن أسمع صوتا أنثويا يسألنى الانتظار لدقيقة. وقفت على مبعدة من الباب وانتظرت أن تفتح لى سيدة ذات جسد مكتنز وشعر مغطى بإيشارب غير محكم وبيجامة يغلب عليها اللون الوردى.
فى لحظات انتظارى عدت بتفكيرى إلى الرجل ذى الجاكت والشورت مرة أخرى، فكرت أنه ربما يكون مختلا، مريضا أو مجنونا، من المؤكد أنه يحمل سلاحا داخل شقته. لو كنت صممت على الشجار معه، لفتح درجا مجاورا للباب، وأخرج منه سلاحه ثم أسكن رصاصة باردة فى صدرى، ربما لا يزال يفكر فى الموقف الذى جمعنا هو الآخر، قد يكون غضبه ازداد اشتعالا الآن، وقد ينتظرنى أثناء هبوطى على السلم، فيندفع من شقته كما يليق بمجنون، مصوبا فوهة مسدسه نحو رأسى الثقيل. أرعبتنى الفكرة، وخُيل لى أنى أراه الآن وهو يتحرك بعصبية خلف باب شقته، ينظر بين لحظة وأخرى عبر العين السحرية منتظرا مرورى، تراجعت نحو المصعد وضغطت كل أزراره حتى انفتح بابه أمامى، نسيت المرأة التى دققت بابها من لحظات، ودسست جسدى فى المصعد الضيق، ثبت قدمى على أرضيته التى لا تسع إلا قدمين، وتكاثفت أنفاسى على بابه الحديدى المواجه لأنفى راسمة سحابة بيضاء. مددت يدى نحو زر الدور الأرضى، تحسست الأزرار فوجدت الأرقام من صفر إلى سبعة، رغم أن البناية مكونة من ثلاثة طوابق فقط! دفعنى فضول صبيانى غير محسوب إلى الضغط على الرقم سبعة، لم أتردد وكأن الشيطان أمسك بيدى وضغط عليه. اندفع المصعد إلى أعلى فى سرعة لا تتناسب مع هيئته المتهالكة، محدثا ضجة كالتى سمعتها فى أثناء إجرائى فحص الرنين المغناطيسى منذ شهور، كان الجهاز ضيقا أيضا مثل هذا المصعد، بدا وكأنه تابوت، أما الآن فأنا فى تابوت صاروخى، وكأن نار تشتعل بأسفل المصعد قاذفة به نحو الفضاء. استغرق الأمر بضع ثوانٍ ولكنها مرت بطيئة وطويلة، حتى توقف المصعد دون أن تتوقف اهتزازاته المستمرة. فتحت الباب لأجدنى معلقا فى السماء، إن اختل توازنى أو تحركت قدمى سقطت قتيلا على الفور. ثبّتُّ قدمى فى الأرض، أغلقتُ الباب بحرص، ضغطتُ على الرقم صفر، ونسيت كل ما يخص شركة (الطريق) ورحلة البحث عنها، بات كل ما يشغلنى أن أخرج من تلك البناية وأعود مجددا إلى الأرض، إلى عالمى الذى عهدته.
عندما وصلت إلى الدور الأرضى وأنار الرقم صفر فى أعلى المصعد، أطحت بالباب، واندفعت نحو الشارع دون أن أنظر إلى يمينى أو يسارى، هرولت فى الطريق حتى كادت تدهسنى سيارة فارهة، أغمضت عينى وأنا أستعد لاستقبال صدمتها إلا أنها توقفتْ فجأة بعد أن لامست مقدمتها فخذى، كان صوت مكابحها مخيفا وصداه فى أذنى طويلا. خرج منها شاب أشقر ببدلة كاملة وصرخ فىّ “أنت مجنون؟؟” كدت أن أقول له أنى خائف فقط. تأملت ملامحه، كان شبيها بأحمد عسكر، زميلى فى الدراسة من سنين بعيدة، سألته إن كان هو، فاجأته بسؤالى، فارتبك ودقق فى وجهى قبل أن يجيب، وشت ملامحه بأنه عرفنى بعد تفكير وتنقيب فى ذاكرته، إلا أنه لم يتذكر اسمى، قال لى “شكلك تغير”، هززت رأسى وزاغ بصرى، كدت أسأله هل يعنى ذلك أننى أصبحت عجوزا. بدا أحمد شابا أكثر مما كان، عينه لاتزال متقدة بالحماس وجسده مشدود ومتناسق، ولا تبدو شعرة بيضاء بين شعيراته الصفر. سألنى عن واجهتى، عرض علىّ أن يصحبنى فى طريقه، لم أكن متيقنا إلى أين سأذهب فاعتذرت. أخرج لى كارتا من جيبه مكتوبا عليه اسمه وأرقام تليفونه، ودعانى لحضور حفل فى العنوان المكتوب فى عصر الغد. أكّدَ على أن آتى ثم ربت على كتفى ورحل بينما وقفت أراقب سيارته التى غطتنى بما أثارته من غبار وأتربة. نظرت إلى الكارت مرة أخرى وكان مكتوبا عليه (أحمد عسكر – مدير بشركة الطريق).
فى الصباح التالى تجهزت للحفل، فكرت أننى سأفاتح أحمد فى أمر الوظيفة والرسالة التى تلقيتها من شركتهم والميعاد الذى أفلته غصبا عنى. رتبت الجمل فى ذهنى، أضفت دعابتين، وتخيلت أننا سنتبادلها ونحن نحتسى أكوابا من عصير الفراولة أثناء سيرنا بخطى هادئة فى حديقة الفيلا التى يسكنها.
على باب الفيلا التى بدا لى فور وصولى أنها فى واقع الأمر قصر مترامى الأطراف، أوقفنى رجل أمن بجسد مفتول، وطول فارع، وسلاحين فى جنبيه، فأشرت له بالكارت، سألنى عن اسمى ثم أشار لى بالدخول. أصابنى الإحراج عندما تبينت أننى الوحيد الذى أتى بملابس رسمية، بدلة كاملة، وربطة عنق تكاد تخنقنى، وحذاء جلدى لامع احتفظت به لتلك المناسبات. الكل هنا يرتدون ملابس رياضية وأحذية تساعد على الجرى السريع، بدوت شاذا بين تلك الجموع إلا أن أحدا لم يهتم بالنظر إلىَّ أو التعليق على هيئتى، حتى أن أحمد نفسه لم يلاحظنى فى أثناء وقوفه بين أصدقائه. ذرعت الحديقة جيئة وذهابا، وأخذت قطعتين من منقنقات يوزعها الخدم ويأكلها الضيوف بتلذذ، وضعت إحداهما فى فمى، كانت مُرَّة جدا حتى أنى كدت أبصقها ولكنى تصنعت التلذذ.
بعد عدة دقائق، تقدم شاب نحيف إلى قلب الحديقة وحمل بين يديه ميكرفونا صغيرا وأعلن على الحضور أن المسابقة ستبدأ بعد دقيقتين، وعلى كل المتسابقين الاستعداد، أما المتفرجين فعليهم الابتعاد عن ساحة اللعب. ثمة مسابقة ستدور هنا إذن، لم يوضح الشاب شيئا عن طبيعة المسابقة ولكنى انزويت مع من بدا أنهم المتفرجون، وقفنا على الأطراف، خفتت الأصوات، وبات الكلام همسا. تبينت سيماء الخوف وهى تعتلى وجوههم، ارتعشت يد الواقف إلى جوارى، وقال أحدهم “ربنا يستر”، ثم اضاف آخر هامسا أن فى المسابقة الأخيرة قُتل رجلان. تقدم المتسابقون إلى الساحة بملابس رياضية خفيفة، أحدهم يرتدى نظارة شمسية ويشبه ساكن الدور الأول ذا الجاكت والشورت، انكتمت الأنفاس بينما قام المتسابقون بتدريبات الإحماء متأهبين للمنافسة المنتظرة.
انفتح باب المرآب الكبير عن آخره، علا صوت مدوٍ من خلفه حتى تردد فى الفضاء صداه، وخرج من عمقه المظلم أسدان ضخمان متبختران، تقدما بتمايل نحو الساحة وتوقفا ليطلقا زئيرهما فى كل مكان حتى اهتزت الأرض تحت أرجلنا. بدا أنهما ذكران، بذلك العُرف الشَّعرى أو التاج الذهبى الذى يزين رؤوس الذكور وتفتقده اللبؤات، كانت خطوات قليلة تفصل اللاعبين عن الأسدين المتبخترين بعنفوان وملامح متحفزة، سألت الرجل المرتعش بجوارى متلعثما عن طبيعة المسابقة، فأخبرنى أنها شبيهة بمصارعة الثيران، سيُطلق سراح هذين الأسدين الجائعين، وعلى المتسابقين الهرب منهما، ثم أضاف أن شركة الطريق تقيم المسابقة بين جميع مشتركيها سنويا. ما تبينته أن ما من ضامن ألا تهاجم الأسود المتفرجين، أى ألا تهاجمنا نحن، ميزتنا الوحيدة –إن اعتبرتها كذلك – أننا أكثر بعدا عن مرماهما. تراجعتُ بين الصفوف ودفعت بالأجساد أمامى حتى أصبحت فى الصف الأخير، ظهرى ملتصق بالجدار، لم أعد أرى شيئا، أسمع فقط، تصلنى التأوهات المتطايرة والصرخات المدوية، نداءات وزئير، هرولة أقدام وقليل من التصفيق.
زحفت نحو البوابة التى أصبحت قريبة بعد تراجعى، إلا أن رجل الأمن الضخم وقف فى مواجهتى مشيرا لى بالعودة، كشف عن سلاحه وقال بنبرة مخيفة “ممنوع.” شعرت أن الأمر برمته كان فخا، بداية من الرسالة التى تلقيتها من شركة الطريق وصولا إلى تلك اللحظة، لعبة ما حُبكت ضدى. تكومت فى أحد الأركان، أغمضت عينى، تطاير التراب فوق جسدى وظلت الأصوات المتداخلة تطاردنى. فكرت أننى إن خرجت من هنا سأعود للعمل فى الجريدة مرة أخرى، سأكتب ما يُطلب منى من مقالات، سياسية أو فى صفحة الحوادث، أيا كان، سأثبت لرئيس التحرير أننى لست جبانا وسأحكى له عن مسابقات الأسود، سأعد تحقيقا صحفيا مثيرا عنها.
لاحظت أن الضجيج توقف والأصوات انطفأت، عم الهدوء من حولى بشكل مفاجئ، تساءلت عما يحدث وفتحت عينى ببطء، فانكشفت الصورة أمامى تدريجيا عن أسد ثابت فى مواجهتى، على بُعد قدم منى، تمتزج أنفاسه بأنفاسى. لم يصلنى من حولى إلا صوت ضحكة منفلتة قطعتها صرخة أخيرة مدوية أطلقها الأسد، زئير مرعب أصابنى بالصمم. حملقتُ مشدوها وأنا عاجز عن الحركة، تسمرت وأنا أراقب حركة فكه الذى ينفتح عن آخره كاشفا عن كل أعضاء جسده ومتجهزا للإطباق علىّ. استسلمت، أغلقت عينى من جديد، أرخيت كل عضلات جسدى وانتظرت القضمة التى ستفصل رأسى عن جسمى، إلا أنها تأخرت قليلا بينما تتعالى أصوات القهقهات والضحكات الصاخبة والتصفيق والصفافير التى تملأ أذنى.
طال انتظارى أكثر مما توقعت، ولكنى لم أجرؤ على إعادة فتح عينى إلا بعد دقائق طويلة، ساعات ربما، كلما هممت بفتحها عاندتنى، إلا أننى فعلت أخيرا، بتروٍّ وخوف، لم أجد أثرا لكل الصخب والجلبة السابقين، لم أجد شيئا على الإطلاق، لا أثر للحفل أو المسابقة أو القصر، لا أسد ولا زئير، وحدى أجلس منكمشا بجوار سور متهالك وسط صحراء ممتدة، أستند إليه كجنين فى وضع التكوير، استرخيت وفردت ساقى تدريجيا، ثم زحزحت ظهرى رويدا رويدا حتى صرت مستويا على سطح الأرض كورقة شجر سقطت ولم ينتبه لها أحد، فجأة انتهى كل شئ وهدأ كل الضجيج وانطفأ كل الصخب، ونمت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشرت في مجلة إبداع المصرية _ يناير 2022