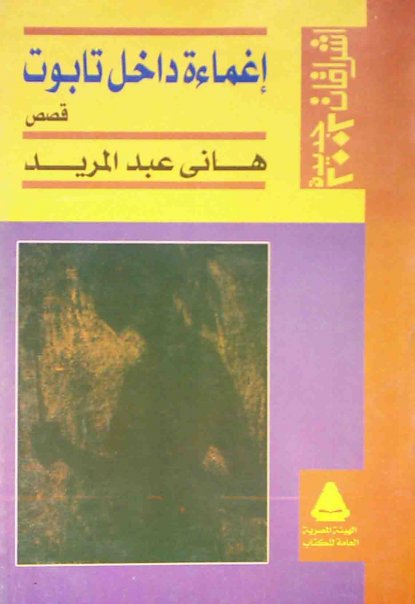بسمة الشوالي
لم يجئ.
تسلّط اللّحظة المتوتّرة عليَّ الضّوء فأنكشف ملء وعيي اللوّام الواقف على عتبة الصّحو، ولا أجد كيف أحتمي بالغياب من جديد هربا منه، منّي..
أرمش سريعا عنيفا دامعة بغير بكاء، وأغمض أشدّ. أخشى لو رُفعت عن عيني ستارة الظّلمة أن ينفر عن روحي الهدوءُ راكضا من باب الحياة الخلفيّ، ويذرني صورة امرأة مُكمّمة القلب، وحيدة تماما، عرضة لعيون مفجوعة تصوّب نحوي بنادقها مخافة أن أفشي كلّ تلك الأسرار التي أودعوني إيّاها فيما أنا تحت لوح الصّمت الجليديّ بهذا المستشفى الذي كمقبرة نهِمة.
منذ سقطت على العتبة الحرجة من مكتب القاضي فاقدة للوعي والرّغبة في الحياة، وأنا هنا على السّرير المعقّم، داخل حجرة العناية المركّزة، خارج الإدراك، على رصيف حيويّ من شارع الوجود يرتاده المتعبون، أتمدّد..
غيبوبتي انزياح وجوديّ، عماء راءٍ. وعي خاصّ بالعالم تنبت له، في الصّمت المطبق على جسده، قرون استشعار تتحسّس المناطق الخبيئة في الذّوات الملتبسة بالثّياب والانضباط الاجتماعي، وتفتح على المسارب السّريّة للقلوب المقفلة والنّفوس الغامضة.
يُطمْئنهم أنّي في عداد الموتى مشرعة الأذنين مطبقة الشّفتين، سُخرة باردة لرغبتهم المريعة في الثرثرة من طرف واحد، فيختلون إليّ عراة إلاّ من ألبسة تستر عوراتهم الجسميّة. أنا المغيّبَة قيامتهم قبل القيامة، يقرؤون عند جسمي السّاكن كتبَهم. أنا الصّامتة طقس في الاعتراف لكن بلا كاهن يسدي النّصائح نفسها للجميع، أو إمام يمنح التّوبة لمن يشاء ويحجبها عمّن يشاء، بلا سلطة مولعة بالرّدع والتأنيب..
بيد أنْ لا أحد، إذ يتخفّف من أوزار أسراره، ينتظر فينة أخرى ليحمل عنّي بعض شَكاتي.. فجأة أعود وحيدة جدّا.
مرّ بي جميع الذين أذنبوا فيّ ومسحوا في ملاءة الصّمت البيضاء أخطاءهم وذهبوا.. ناصر، ابني، ابنتي، الأقربون من الأهل والأبعدون، الأصدقاء، الجيران، الزّملاء، المعارف، العابرون، وكثير غيرهم لم يبق منهم في قاع الأذن غير رجع البكاء المرتّل في صحائف الاعتراف. يتخفّفون بسرعة ولا يبقى، بعدئذ، لزيارتي من معنى سوى تقصّي أخبار رحيلي، والمحطّة التي يقف عندها قطار العمر الآن. لم يعد أحد منهم ليعرف إن كنت غفرت له أم لم أغفر. اِكتفوا جميعا بتفريغ حمولة الاعترافات جانب جسمي الهامد وانصرفوا.
وحده الذي كان يجيء ليسكت فيمنحني فرصة رُخاء للفضفضة.. أكان يعرف أنّه منصّة اعترافي الخفيّة كلّما جاء اعتلتها بقايا المرأة التي فيّ واسترسلت في ترميم وجودها الصّدع بالحكي؟
يجيء.
يؤقّت بندول الحنين المعلّق إلى ظهر يدي الملقاة جانبا منّي موعده. يهيّج، فور دخوله، نثرُ التّراب حساسيّة جيوبي الأنفيّة كما لو كان على سفر مستمرّ يجيء إليّ من المسالك الترابيّة القديمة للعمر، من ذاكرة جسد يخاصمني منذ أشهر وينتبذ منّي ركنا قصيّا من الإدراك..
خالصا لي، مفعما بي، لهِفا عليّ، يأتي ليجلس صامتا على جانب من عين البوح المتفجّرة. تحطّ شفتاه بردا شفوقا على نار الجبين. تسكن أرضي الرّاجفة. يرفّ دمي مستدركا شيئا من نبض العنفوان المُخمَد. يهجع في الرّأس نمل الحمّى حين نفَسه خشنا مجروحا مغرورقا يسرّب إليّ ماء الحنان. لا يتكلّم فأراه، لكن تبصره عين الخيال وجها نضِرا لوجهي المطفإ، جسدا ثريّا لجسدي المحنّط في شحمه الوفير، عينا رفيقة لعيني المغمضة كطفلة تطبق على حلوى الفرح بين أصابعها المشتبكة، وتخشى لو فتحت كفّها لم تجد غير الفراغ الدّبق.
تعال..
تقول أخراي التي لم تنته فيّ من الحياة بعد، ضع النّور الذي على كتفيك عند قدميّ، وأضئني. أنت الفانوس الأخير على ناصية الشّارع الوحيد المؤدّي إلى أنفاقي الدّاخليّة المطفأة، ووحدك الذي لا أخجل من عريي المريع ملء حضوره البذِخ. اُدن منّي، اِخلع عنك صمتك وعليّ بعض السّكينة، وارفع عنّي حجاب الحرج أخرجْ لك بكلّ صدقي المطمور في كُمّ التحفّظ، ضمّني رفقا بلا شفقة واحذر أضلعا تراخت أربطتها. اُنفخ فيّ بعض نفسك الحميم تبرد نار بالجوف تتّقد، ويلد الرّماد طائر الفينيق من جديد..
لا تقل من أنتَ، ظلّ هكذا حضورا رحبا تامّ البهاء بلا تاريخ، انتماء آمنا بلا هويّة، وكن الغد الذي لن أبلغه. أنت تجعل خساراتي أقلّ، وسفرتي الأخيرة أشهى.
تعال..
أرسل في حضورك فوضاي وأترك نوافذ النّفس مفتوحة دوما على الطّريق الرّئيسيّة للوجود، وأغطيتي منشورة على حيطان الرّجاء تشرب الشّمس نهارا وتندى غسقا تحت دمع القمر. لا أكنّس غُرَفي الدّاخليّة من غبار أعضائي الآخذة بالتّفتت داخلي منذ أشهر، على أهبة الرّحيل حواسّي، لا تنفكّ تضرع بالصّلاة. وعلى العتبة أنا ممدّدة أحمّل حمام الأثير إرساليّاتي القصيرة إلى الحياة فتروح وتجيء أنت ويذهب الثّقل عن وزني. ” تكلّمْ.. تكلّمْ.. لماذا تنسى حين تلقاني نصف الكلام..” وأنت الآن صديقي الأخير القديم الذي لا أعرفه ولم أنقطع أنتظره على شرفة الأمل وبلا سأم أنتظر.. لكن، متأخّرا جدّا قد أتيت. مضى أجمل العمر ولم أعش إلاّ لأجل أن أكون ما أنا عليه الآن: ضفدعة بدينة، ثقيلة الخطو، لاهثة أنفاس الحياة. زوجة سابقة لرجل يصاحب شابّة بنصف عمري، وأمّ صالحة، بشهادة هاتفي الجوّال وبطاقتي البنكيّة، لولدين يحبّانني دوما وأكثر عند كلّ حوّالة بريديّة..
أتعلم.. !؟
لا يبقى أطول ليعلم. يذهب خفيفا كما يأتي. تنقر الممرّضة على باب الغرفة فتصرفه عنّي وتترك عند سمعي الجملة ذاتها:
– هذا الزّائر يردّ إليك الرّوح كلّما جاء.. يبدو فعلا أنّك لا تحبّين أن تغادري حالتك هذه لاستبقائه أطول إلى جانبك. لو كنت مكانك لفتحت عينيّ لأراه..
“صفيه لي أرجوك.”
أتوسّل، فتمرّ إلى قيس ضغط دمي المستقرّ، ودرجة حرارتي التي اعتدلت في حضرته..
– أنت بخير.
“صفيه لي.. ألا تعرفين اسمه؟”
لا تسمعني. يردّ سَدُّ الصّمت صوتي إلى كهفي العظميّ بانتظار الغد..
غير أنّه اللّيلة أيضا لم يأت..
تنتصب مكانه شاشة مسطّحة تكتسح مجال عين القلب، وتعرض عليّ في بثّ حيّ مسترسل مغرض شريط الحياة الأقسى في حياتي مدّة ذلك اليوم الذي بطول أُمّة من الضّنك.. أغمض أشدّ فرارا منّي فأراني في ظلمة الغيبوبة أوضح أسمن أصدق أقصر، و.. أسوأ.
ذلك اليوم.. !
ماءت أواصر الباب الخشبيّ كقطّ موجوع. لفظ مكتب القاضي عبوّة بشريّة حانقة ليستقبل أخرى. رجل رذيل العمر يغادر مزمجرا، تتبعه عجوز تثرثر بعشقه لقاصر في الحيّ.
شابّة تجرّ فستانها، وتدفع حمْلها إلى داخل المكتب. زوجها من خلفها يفرد صدره، ويُسقط حزام بنطاله إلى ما دون خصره بمسافة تستفزّ أزواجا مزدحمين جاؤوا على قدم الإصرار وساق يتشاكون أو يتطالقون.
بعضهم كالـ… غمغمت أُهوِّئ صدري من بقايا الضّغينة، ثمّ سرّحت جدي الكلام يرتع في حقل العمر الآخذ بالشّحوب. سيطلب الصّلح كالمرّة السابقة ولن أقبل. ناصر لا أحد دوني. يقف أمامي خاشعا كطفل مذنب، حزمة من عظام ترتعش توشك تنفكّ روابطها تحت جلد ناشف ينشدّ على هيكله فيبرّز مقاطعه وتنتأ منه رؤوس المفاصل.. دمعه يمِض مكابرا بين الجفون وكلّ ما فيه يرتجف، يهتزّ، يعلو، ينخسف، يروح على حافّة الوجع الجهم على تقاسيمه النّاشبة وينكسر.. قامة رجل شبه مُنْتَهٍ كان، بعض حياة ساخنة تنتفض أعضاؤها تحت بقايا الأدريالين.. ضمّة واحدة تلملم تبعثره كلّه من أوّله حتى انهياره الأخير هذا، ضمّة واحدة تعيده حيّا يرفرف..
لا أضمّه.
شيء ما يمدّ أذرعه النّباتيّة الغليظة ويشدّني عنه إلى غوري.. أعترف. لم أنته إلى اليوم من طيّ صفحة الأمس.. يحبّ الحبّ قطع عِرْق العلاقة المنتهية وتسييح دمها على أرصفة الأجوبة العارية ليمضي في شأنه إلى حبّ جديد. الجروح الطّفيفة تجعله معلّقا إلى نقط الاستفهام كفانوس في مجرى التيّار الهوائيّ، وتذر علبة البانادورا مفتوحة على أسرارها المهلكة.. مضى العمر ولم أنس. أكرّر الـ “لماذا” نفسها، واقفة على باب “لو” لا أبرحه.. أضطرب، أغرز أصابعي في جلد حقيبة اليد لأثبّتني إلى رصانة كاذبة على مقعد الانتظار..
أنا على حقّ. ناصر ما كان له أن يخرج عن حدّ الخصاصة لولا أنا. لا تستقيم الحياة الأسريّة دون قبضة صارمة تبني المستحيل، دون امرأة نظيفة بكفاءة عالية مثلي.. لا وشَب يعلق على أثاث، لا لطخة لحذاء تمسّ البلاط، لا مشكلة تنسرب إلى الحياة، لا فاتورة يتأخّر خلاصها.. كيف يجحد؟ منزل بطابقين توغر هندسته قلوب الحُسّد، سيّارة لم تُمسّ بخدش منذ عقد، الابن البكر بجامعة خاصّة، والبنت تدرس الطبّ بروسيا. أمن عميم. هدوء وِقْر. هناء بارق. نظافة ناصعة. وزوجة برَكة لا تتابع غير برامج دينيّة تنير سبيل الجنّة وتوشك لا تكلّم أحدا خوف الإثم، ونحن بعد في حيّز الأربعين..
كيف يا ناصر !؟
عشنا معا عمرا مكثّفا بطول قرن من حديد القبضة النّاجعة.. كلفة النّجاح باهظة. لم أقتّر إلاّ لأجل أن أوفّر لولديْنا كلّ ما يطلبان.. كيف يجرؤ فيطلب منّي تلويث حياته بالخصام وهو فاحشة، تبذير ماله في الرّحلات وهي ترَف مجانيّ.. تحريك ساكنة السّعادة بالسّفر إلى بؤر الرّقص وهو حرام.. حشو الأذن المؤمنة بقطن الغناء وكلّه مستفزّ للشّهوة، مفقر للجيب.. هل الآن؟ ونحن على آخرة العمر؟ لكن.. لماذا وصلتُ سريعا إلى حدود الآخرة؟ أليس تقتضي الحكمة شيئا من المرونة؟ نعم.. أو ربّما.. لكنّه..
– تأخّر.
غمغمت شابّة مترفة الهيئة والحسن إلى جانبي تصادر تنهيدة هواجسي:
– من..؟ سألتُ.
– أتُرى ذات السّترة الخضراء كضفدعة هي زوجته؟ أم العوجاء تلك..؟ لا – وكزتني لتعدّل وجهة نظري- هناك..؟ أترينها؟ لا لا، لا أظنّ. قال إنّها طويلة، تلك الشّمطاء، ويابسة كحطبة. يبدو أنّها لم تأت بعْد. سئم من شرّها “المِسْمامَة”، أدمت قلبه الرّقيق، وألقته إلى حضني جريحا أضمّد نزفه فلا يكاد يتأسّى حتى يتردّى إلى مواجعه ثانية. لا يهمّ. سيكون قريبا حرّا يخفق جذلان في قفصي الذّهبيّ.
– عفوا من تقصدين..؟
دلف ناصر إلى رواق الانتظار. وقف عند ناصيته يفتّش عنّي في ثنيّات الزّحام.
اِنخلع جدار ما في بنائي العظميّ.. كان في بدلة باذخة لم يقتن مثلها منذ عقدين تحيي أناقتَه القديمة وهي رميم، وتحُدّ من سطوة حضوري عليه.. نضِرا كما لم أره منذ سنين، ينضح ماء عذب خفيّ من غضون الوجه يروي كلّ الجدب في جسمه ويُنذِر كلّ مخزوني المائيّ للجفاف فأراني أعوم على ضفّة عينه ضفدعة سمينة مترهّلة.. صغر سنينا عشرا وشِخْت في جسمي الذي كحبّة الملفوف عشرين أخرى.. سقط أمامي العمر برُمّته دفعة واحدة كما سقف نخر قد خرّ.. خمس وعشرون سنة كاملة تتالت على شاشة الوعي المشدوه مضغوطة التّفاصيل، مكثّفة الصّور، مزدحمة الأصوات..
في أيّ تفصيلة كنتُ؟
في الغسل، في الشّفط، في الفرك، في الطيّ، في الطّبخ، في التدريس خارج المنزل وداخله؟ في أكوام الغبار التي نضوْتها عبر السّنين عن الأثاث؟ في دلاء الماء الذي سفحت؟ في المال أسلّه من عظمه لتجديد الأثاث والسّتائر والفرش والمناشف الفاخرة أعلّقها يوما بعد يوم على حبل الغسيل إثارة لحسد الجارات المهملات..؟ في الوسائد تخنق النّواح والصراخ ونزق الخصام فلا ينسرب صوت من فم الجدار الأدرد إلى حيّ يتنصّت بعضه على بعض عبر الحيطان..؟ في مطبخي الأنظف في الحيّ، ومنزلي الأجمل في المدينة، وحكمتي الأندر في النّساء.. في عيني التي لا تغفل عنه، في قسوة الحبّ التي لا تلين عليه؟ في أيٍّ كنت حيّة أرزق؟ هل هو الذي على حقّ..؟
ناصر لم يجئ. ناصرها من جاء. وأنا من قضيتُ العمر أحيا على هامش الدّنيا، تحت وجهي، خلف جسمي، على جانب من الحبّ، عند منحدر أناي إلى اليوميّ الرّتيب. أسير متّكئة إلى سور اليوم صوب غدٍ يسلمني فورا ورأسا إلى غد يليه سنة عن سنة، شدّة عن صرامة عن جديّة عن نجاح عن استقرار عن سعادة أسريّة عن غصّة متورّمة.. مكنسة ميكانيكيّة تلاحق نثرة الغبار المتمرّدة، دلو ماء لا ينضب يسيح في كلّ ركن نيّر وخافية من بيتي، آلة حاسبة ألقط الملّيم المنفلت عن العدّ، زوجة صارمة الحبّ والنّظرة..
تقدّم نحوي ولم يدنُ. تصحّر خدّاي. اِحمرّ المشمش على خدّيْ الشّابّة. تخشّبتُ، ونثرتْ هي عليه في رصانة مخادعة ورد نظرتها الخجول فلم يجد من الرّبَك ما به يخصف على سرّه العاري ملء عينيّ.. كان يقف منّي قاب دهشة صفراء كفلاة تروّع حواسّي التي أُخِذت به الآن على غِرّة..
أكان جميلا أم الفقد يزيّن الأشياء في وقت بدل الضّائع للمباراة الخاسرة؟
كلاّ. لم يكن على حقّ.. وماذا يجدي الآن هذا؟ الحقيقة بيّنة لا لُبس فيها: ذهب ناصر معها، سقطت إثره في الغيبوبة، تسلّلتَ إلى خلوتي من حيث لا أعلم، تغيّرتُ معك ولأجلك ثمّ لم تأت.. أخلفت موعدك للّيلة الثالثة، ونُذِرتُ من جديد لوصلات الهجر المتكرّرة..
لمَ لمْ تجئ..؟
صرّت مفاصل السّرير تحت جسمها المتشنّج ينتفض أهوج مغمّسا في مائه والهاتف إلى جانبها يرنّ.. هرول إليها الطاقم الطبيّ. كانت بخير..
“ما الذي جدّ؟”
تزاحم على باب غرفتها كلّ الذين تردّدوا على أريكة سمعها متخفّفين من أوزار أسرارهم..
“هذه سكرات الموت”،
سمعت إحداهنّ تقول، ثمّ أجهشت بالعويل، وتعالت من جهات عدة زغاريد..
“هذا نهار مبارك..”
أشرعتْ عنوة عينيها..
كان الضّوء بهارا، والعوْد أحمد، والفرح أطباق حلوى مرصّفة على نحو شهيّ، والفوانيس المعلّقة إلى السّقف تأتلق رقصا وموسيقى..
مرهقة كمن يخرج من بئر غائرة غِبّ ليل أعمى، غادرتْ غرفتها. تأمّلت الفرحين بها نفَسا إثر نفَس تتحسّس الحفيف بأذنيها علّها تعرفه، فقد يكون جاء الآن على جناح العويل.. أو قد..
– تبدين مرهقة يا صغيرتي، هيّا عودي ونامي قليلا آخر. ينتظرك يوم حافل وطويل حبيبتي. ستكونين أجمل عروس.. وَرَرَرَيْ.. زغردن يا بنات..
كانت أمّها تأخذ بيدها إلى السّرير ثانية، وكانت بالكاد تستوعب أنّها رأت في المنام فيلما مقتبسا عن قصّة غدها التي بدت حقيقيّة، وأنّ هذا يوم زواجها من ناصر..