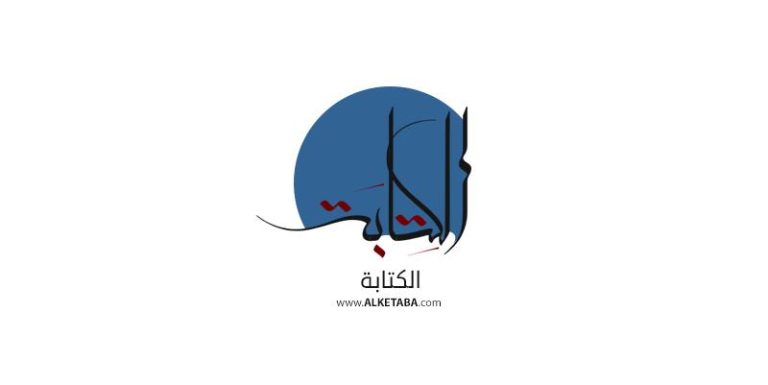كان بودلير قد حَلمَ – كما ورد ضمن إهدائه لقصائده النثريّة (ضجر باريس) لرئيس تحرير لابرس- بـ:’معجزة نثر شعريّ، موسيقى بلا وزن ولا قافية، طيّع ومتقطع بما يكفي ليتوافق مع الاختلاجات الغنائيّة للروح، وتموجات الأحلام، وقفزات الوعي المفاجئة’، أما إدجار آلان بو؛ فطالما حلم وحاول أن يجمع بين الفن والفلسفة والعلم في مذهب أدبيّ واحد، ويحقق ذكري الآن هذا المزيج الفريد بين هذين الحلمين، خصوصاً في إنتاجه الأخير؛ اليوميات بجزءيها الأول (على أطراف الأصابع ـ 2010)، والثاني (حطب معدة رأسي ـ 2012).
‘لأنني لا أذهب إلى هدفٍ معين من دون أن أعود إلى الذات، وبقدر ما تكون العودة مُفاجئة، بقدر ما تكون مؤلمة، إلا أن الهدف القريب أقل مُفاجأةً وألماً من الهدف البعيد، بسبب المسافة المتناهية في الصغر بين الهدف القريب والذات، وكأنَّ رفَّة عين كفيلة لاصطدامي بحاجز الذات الكريه، فأعرفُ سريعاً زيف الهدف، أو على الأقل استحالة فصله عن الذات’. (نظرة من حديد.)
مثل هذه الفقرة الرائعة تظهر كل التوترات والمفارقات التي تتخلل نصوص ذكري، فهي تقدم عدداً من الإيحاءات المثيرة في لغة مسيطرة، قادرة، قوية، لا تسمح بالفكاك من أسرها، ولا بأيّ نوع من الاعتراض.
‘رَعَفَ أنفي نزيفَ الوقت، فرفعتُ رأسي إلى السماء، النجم البعيد الثاقب، وروحي في الظلام. ليل أسود فيه كل الأبقار سوداء. الهَيولاني المنسوب إلي الهَيولي لا يزال في البداية، مادة تُصنع منها الأشياء، كالخشب للكرسي’. (الأشياء والكلمات).
عبارات ذكري ممشوقة القوام، أوليمبيّة القد؛ لا يوجد لديه شيء غير ضروريّ أو زائد عن الحاجة الجمالية، بما يكفي لأن يجعلني أتخيل أنه يحكي الفقرة لنفسه عدة مرات أثناء سيره الرائح والآتي في غرف بيته؛ يتذوق الفقرة بصوت مسموع، يستمتع بها، يختبر بنصف وعي موسيقيتها، وإيقاعها، يستبعد حروف الضجر الزائدة، سعياً للوصول لحالة من رضى الصياد عن فريسته.
‘مُنيتُ بهزيمة باردة أمام الملاكم الوهمي الذي جمع النقاط بضرباته المستقيمة بينما كنتُ أبحث عن ضربة قاضية’. (شوارد).
نصوص ذكري فيها تأكيد وبساطة النحت العظيم، وكل منها على الدوام يضيف شيئاً جديداً لمخيلة العالم، ويواجه الذهن بفجائيّة بكل ما هو أساسيّ وغير ممكن حله، كما يفعل كل فن عظيم، صانعاً بأقل الكلمات الممكنة الكآبة والشجن اللذين يجتاحان المرء في لحظات الانتصار، وهو التناقض الفريد الذي يحدث في اللحظات الاستثنائيّة التي يتساءل فيها المرء عن معنى وجدوى الحياة والعالم والوجود، فنصوص ذكري حافلة بالدلالات الفلسفيّة، رغم أنها ليست فلسفة، بل تبدو في بعض الأحيان معادية للفلسفة منتصرة للفن، وكأن الحقيقة لدى ذكري مقامها في الأساس جماليّ.
‘الحقيقة ليست نتاجاً لإرادة سابقة، بل نتيجة لعنف في الفكر، المغازي المكشوفة والتقليدية ليست عميقة أبداً، الشيء الوحيد العميق هو المعنى المغلف، الذي تتضمنه إشارة خارجية’. (الاختلاف والتكرار).
لنصوص ذكري طاقة شعرية عظيمة كامنة في كل مقطع تقريباً، والمفارقة، أن أسلوب وطقوس حياته الشخصيّة اليوميّة، المشيدة وراء أسوار العزلة الصارمة، والخالية من السخونة، حياة الضجر هذه لا تقدم أيّ مصدر مولد لتلك الطاقة الشعريّة الكامنة في نصوصه، وكأن أصالة عبقريته تخلق نفسها بنفسها، فذكري هو الوحيد الذي تتوقع منه دائماً شيئاً رائعاً وفائقاً رغم نمطية وصرامة حياته المنعزلة الخالية من الصدمات، إنه يخلق معنى أدبياً وجمالياً من حياته الضجرة، وكأنه يراكم الضجر حتى يبلغ حداً من القوة يُنتِج معه من اللامفيد جمالاً.
‘تخضع حياتي اليومية لتكرارات عقلية وجسدية، تدور التكرارات في حيز مكاني ضيق، وهي تحدث دائماً بصيغة الجمع، أي أنني لا أذكر للتكرار مرةً أولى أو ثانية، ولا أذكر أيضاً كيف تراكم فوق الكتفين’. (الاختلاف والتكرار).
عند ذكري كل شيء يسيح تحت الأسلوب، لا يوجد لديه شيء لا يخدم الأسلوب، لكن مع ذلك لا يمكن القول انه لا ثمة شيء غير الأسلوب، فرغم أن السياق السياسيّ، والاجتماعيّ ككل، عنده منفصل عن الإبداع الفنيّ، ورغم نفوره من السوقيّة الرخيصة للأدب السياسيّ، وللأدب الشعبويّ بصفة عامة؛ أدب ‘الوصفات الجاهزة’، بكل بؤسه التعبيريّ، وفقره الجماليّ المُنفِّر، ورغم تعامله في نصوصه مع مستوى أعلى عابر للسياسة وللاجتماع، وهو ما يحتاج إلى قوة جبّارة وعبقريّة في السيطرة وصناعة الشكل الأدبيّ الخاص الذي يعزل به عمله عن اللحظة التاريخيّة بكل ابتذالها، إلا أن المفارقة تظل، أن هذا العزل عن اليوميّ والمؤقت؛ عن التاريخ والسياسة، لا يفعل في الحقيقة سوى أن يشدد على انغماسه المُكثف في العالم؛ على وعيه العميق بالإنسان، بالعالم الحقيقيّ بعد نزع العابر والمؤقت والمزيف عنه، كما قال يوماً شوبنهاور عن دانتي: ‘من أين جاء دانتي بجحيمه، إن لم يكن من عالمنا الحقيقيّ؟!’.
‘وكانت الأسباب التي جعلتْ أبناء مهنتي يرضون عن مهنتهم وعن أنفسهم، هي نفسها الأسباب التي جعلتني في نفور من مهنتي أولاً ومن نفسي ثانياً ومنهم ثالثاً، وعلى هذا تركتُ لهم جيفة الأعمال الروائية المُطابِقة للمواصفات، وحفلات التوقيع، واصطياد ما هو اجتماعي أو سياسي أو تاريخي، ونجاحات البيست سيللر، وبؤس توجههم لكتلة دهماء لها اليد الطولي في تشكيل الذوق الفني، وفي وضع الكاتب على خازوق الشهرة’. (رمية من غير رام).
ويتجاوز ذكري المطلب العسير؛ ألا وهو اكتساب شخصية وأسلوب خاص مميز، ليتعداه إلى مطلب شبه – مستحيل؛ ألا وهو إضفاء الأسلوب على كل ما يفعله، هو بالمناسبة نفس مسعى بروست الذي نجح في إضفاء معنى وأسلوب على وجوده بتحويله إلى عمل فني بلغ حد الكمال، فمن يعرف ذكري عن قرب يعرف أنه هو نفسه عمل فني، فهو ينفق وقته وتأملاته وجهوده في خلق معنى أدبي من حياته المفتقرة للسخونة، حياته المفعمة بالقنوط والرتابة، والتي تشبه حياة الرهبان ذوي العقول الميتافيزيقية، الذين يوقنون بما هو آت ولكنهم ينتظرونه في ترقب شديد.
‘لم يبق لي شيء تقريباً، لا الشيء، ولا وجوده، ولا وجودي، ولا الغرض الصرف، لا اهتمام من أي نوع بأي شيء، ومع ذلك أبحثُ، وما زال هذا بلا ريب اهتماماً بالوجود، لا بحثا يثير اهتمامي، حتى الذي يساوي أهمية البحث عنه، المتعة التي آخذها من عملية البحث لا آخذها، بل أعيدها كما أخذتها، أتلقى ما أعيده، آخذ ما أتلقى، لا لكومة القش من دون إبرة، ولا للإبرة من دون كومة قش. كان سقوطه من على كورنيش شرفة عقله فضيحةً لكل مَنْ تسوّل له نفسه دراسة هيدجر ودريدا.’ (درس في السقوط)
ذكري مثله مثل كل كاتب كبير؛ مقاوم للتصنيف، ثقافته متروبوليتانية، ومدى قراءاته عميق وضيق في آن معاً، وهو متشبع بالأدب والسينما والفلسفة والموسيقى الأوروبيّة بشكل كبير، لكن علاقاته الثقافيّة يمكن القول انها تأثر لا يصل أبداً إلى حد الانغماس، وهي تشمل ضمن من تشملهم: جويس، كافكا، بروست، نيتشه، دوستويفسكي، دولوز، بيكيت، ديكارت، كانط، برجسون، هيدجر، دريدا، كاواباتا، تاركوفسكي، برجمان، أنطونيوني، تار بيللا، كوبريك، هيتشكوك، الويسترن سباجيتي (خاصةً ليوني)، باخ، بيتهوفن، موتسارت، لكن رغم تلك الثقافة المتروبوليتانيّة، يمتد الوريد المحليّ المصريّ بعمق في عمله، وأحياناً يظهر مرئيّاً على السطح.
‘قال بلوم بطل جويس، في سجل أدبيات محافظة حلوان، لستيفن ديدالوس، وهو يعرض عليه صورة زوجته البريمادونا مولي، وهي في البالطو الشموازيه النبيتي، محبْرَكَة ومشبْرَكَة: أقل ما فيها حتة من الأبدية، تاخد فكرة؟’ (الأشياء والكلمات).
ورغم تفضيله لشكل الفقرات المنفصلة عن بعضها البعض، إلا أن المرء يشعر بأن هناك سيولة كبيرة وارتباطا شديدا بين الفقرات، كارتباط الأجزاء المختلفة في العمل اليدويّ الحرفيّ، الذي هو نقيض نموذج خطوط التجميع الآليّة في المصنع، التي تكون إرادة العمل فيها مستقلة بشكل مطلق عن بعضها البعض، بل وعن إرادة العامل نفسه أيضاً وهو الأهم؛ حيث تدخل المادة إلى نطاق حركة العامل ثم تتحرك مبتعدة عنه بطريقة إجباريّة تعسفيّة، وهو ما دعا ماركس إلى القول: ‘ليس العامل هو من يستخدم أدوات الإنتاج، بل أدوات الإنتاج هي التي تستخدم العامل’.
فإذا ما استبدلنا ‘العمال’ بـ’الكتاب’، و’المصنع’ بـ’المجتمع’، وجدنا الأمر ينطبق أيضاً على الإنتاج الأدبيّ والفنيّ في العالم أجمع في عالمنا اليوم، باستثناءات نادرة، منها ذكري؛ الذي هو نقيض ذلك، إن حركته أثناء عمله هي نقيض حركة العمال في المصنع والإنتاج الكبير، إنه لا يتوافق مع الحركة المنتظمة والمتصلة لسير نقل الحركة والميكنة الصناعيّة في الإنتاج الكبير، إنه على النقيض، أسطى، صاحب حرفة يدويّة، هوايته تحويل الحديد الخردة إلى روائع من الحديد المشغول.
‘أضع لنفسي مقياساً عالياً في كل فقرة أكتبها، وأعلم أنني لا أحقق هذا إلا نادراً، ومع هذا أيضاً لا ينقطع الأمل المؤلم. وفي زمن الواقعية الصارخة التي تتمثل في القبض على كل ما نعيشه من أحداث كبيرة، فلا أمل أمام كتابة جمالية، وكأنَّ معركتي من طرف واحد، ولا وجود لطرف آخر’. (دعه يسقط)
وكما تطور عملية التصنيع التخصصات الأحادية الجانب فقط على حساب مجموع قدرات العمل لدى العامل، على خلاف الحرفيّ الماهر صاحب العمل اليدويّ، فإن حتى هذه التخصصات الأحادية سرعان ما تتدهور لافتقارها إلى مجال للتطور، وحافز للانتباه والتأمل، فممارسة العمل هنا معزولة عن الخبرة الشاملة بعملية صناعة السلعة، وبالتالي فإنها في الحقيقة ممارسة زائفة وخبرة لا قيمة لها، ومن هنا تبرز الأهمية العظيمة لما يبدعه ذكري ويعكف عليه في السنوات الأخيرة من عمله، وهو ليس في الحقيقة إلا قلب نموذج التخصص ونظام الإنتاج السلعي الكبير رأساً على عقب؛ أي إنتاج نصوص متعددة التخصصات (أدب فلسفة – فن – علم)، وبكل عناية العامل اليدويّ الماهر وتجويده في التفاصيل، منتصراً لشكل العمل الحرفيّ، ولأسلوب العامل اليدويّ الماهر في التمكن من كل أجزاء عمله وخبرته الشاملة بسلعته.
‘اليوم من السماء سقط شيء على أرضنا، ومن لغتنا العامرة بالمفردات سماه الجميع بتسرُّعٍ اسماً سقط قريباً من هذا الشيء. كنتُ أفضِّل أن أشير إلى هذا الشيء، فالإشارة تناله في مقتلٍ، بعكس الاسم الساقط قربه كما سقط هو من السماء. وبعد أيام كانت إشارة يدي إلى هذا الشيء خليطاً مشوشاً من إشارات عديدة تصلح لتحية أحد الرؤساء في عربة ليموزين مكشوفة لجمهور غفير مشقوق على جانبي الطريق، والاعتذار الهين لاصطدام كتفي بكتف شخص غريب في ازدحام سوق، والانحناءة المُهذَّبة لسيدة تحمل رضيعاً بأن لا تتقدم ناحيتي أكثر من هذا، والإشراق المُباغِت لإدراكي أن شعوراً بالنفور مر بي في حياتي من جراء أحداث كان لها أن تكون غير ما كانت عليه لو كانت استجابتي لها غير ما كانت عليه. كيف تختلط الإشارة إليه إلى هذا الحد، وهو الشيء الفريد.’ (إشارة إلى اليوميات.)
إذن من العبث الحديث لدى ذكري عن انتظامات، أو توافقات، أو معايير للقياس سابقة التجهيز والتحديد، سواء في سلوك الكتابة وطريقة إنتاجها، أو في المنتج الفنيّ النهائيّ، أو حتى في المادة الخام ابتداءً، وهو ما يجعل نصوص ذكري تحمل المفاجآت دائماً، كما يحملها العمل الفنيّ صنع اليد المبنيّ على أوج الخبرة والوعي بالشروط التقنية لإنتاجه.
‘في الليل، وبينما كنتُ فناناً كئيباً ألتهمُ بطرفٍ ما صنعته بالطرف الآخر، مُشرِّعاً ضد إبداعي، لأنني أُبدع ضد شريعتي’. (ربيب اللعنة)
إن عبقرية ذكري ناتجة إلى حد كبير من الرغبة في إيجاد ذلك التلاقي المثاليّ بين اللغة وما ينتمي إلى عالم التجربة الحسيّة، لذلك فهي تنتج إبداعاً فردياً خاصاً متفرداً، يتحطم قالبها مع كل محاولة جديدة، ولا تسمح ببناء تراكمي فوق إنجازات سابقة (سواء من نص إلى نص، أو من كتاب إلى آخر)، وهكذا يكون الفن عن ذكري على أبعد مسافة ممكنة من فكرة ‘المشروع’ المستمر المتصل المنتمي إلى عوالم العلم والفلسفة والنقد العقلانيّ (رغم أن فكرة ‘المشروع’ تظل حاضرة بقوة في إنتاج ذكري؛ لكن توجه طاقتها إلى ‘الأسلوب’ لا إلى شيء آخر)، وهو ما يُسبب في كثير من الأحيان أيضاً نوعاً من الإرباك مع الأشكال النقديّة المعتادة للخطاب الموضوعيّ أو التفسيريّ؛ للدرجة التي دُعي فيها ناقد سينمائيّ لمناقشة الجزء الأول من اليوميات في الندوة التي أقامتها دار النشر فور صدور الكتاب.
‘إذا كانت الكتابة لديهم تستدعي الاستراتيجيات، فقد جعلتها لدي تستدعي حروب العصابات، لا للأعمال المُتوازنة التي تتجاوز المئتي صفحة، لا للبطاقات الدرامية الخاصة بالشخصيات، لا للبحوث التاريخية، والتأريخات المكانية، فقط حروب الحرف والجملة والكلمة والأسلوب، حروب عدم الاكتمال والنقصان، نحو أدب قاصر، أدب الفقرات والشذرات، وليست هذه استراتيجية مُضادة، بل إنني بريء منها بعد قولها، مُتنصِّل من الدفاع عنها’. (رمية من غير رام).
ولا نملك، نحن المنتسبين للكتابة، أشباه ذكري، إلا أن نشعر شعوراً حاداً بأحزاننا ونحن نقرأ له نصاً كالتالي، ليس لأن صوت نواحه أعلى، بل لأن لسانه أكثر فصاحة.
‘وعندما أنظر إلى أصدقاء يكتبون يوميات، وينجزون في نفس الوقت عملاً حقيقياً، أشعر بخجلٍ شديد، وأقوم برد قدراتي الضعيفة إلى خلل عقلي، وأقول في نفسي إمعاناً في شطب الذات: وماذا كنت تفعل قبل جحيم السنوات الثلاث من عمر اليوميات؟ على الأقل أنتَ الآن ممسكُ بشعرةٍ في ذيل فرس الكتابة، ويكفيك الانتساب إلى المهنة كأماتور، ألم تكن تغني لروح الهواة المشردين، وتشعر بالتعالي على المحترفين الذين أخذوا الكتابة مداساً منتظماً، نجيب محفوظ، توماس مان. يكفيك البحث عن واحد من سلالتك كان مدعوماً بالكحول مثلك، ممروراً من الحياة، محباً لمملكة الحيوان، واضعاً على تاج المملكة حيوانه المُفضَّل، الضبع بضحكته المرعبة، قارئ كتب غير مُكتملة، باحثاً مُدققاً في مَشاهِد سينمائية، يكفيه رؤية جزيرة عليها ليف أولمان وبيبي أندرسون في فيلم برسونا حتى يشعر بهواء البحر على وجهه’. (إشارة إلى اليوميات).