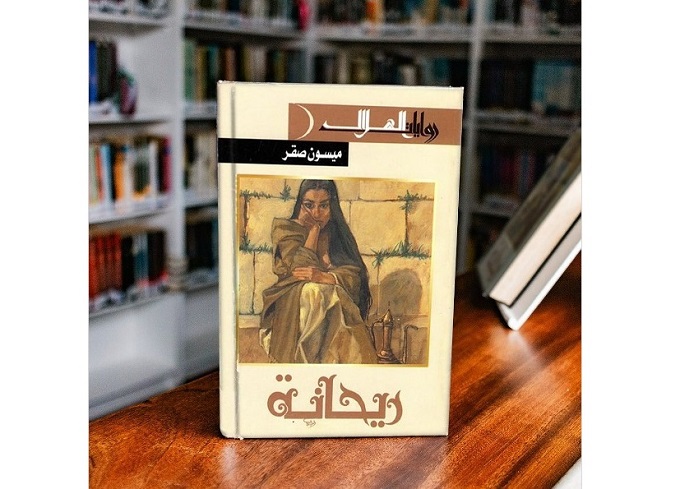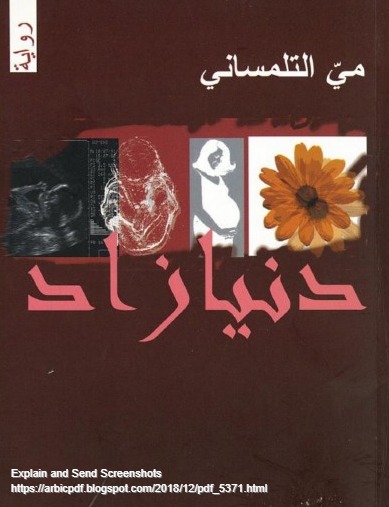بين أنثيين
الراوي حصل على ذلك القدر من السعادة حينما ظهرت سندس. الفتاة ذات الأفق المنفتح، التي تعرف ما يدور في ذهنه بدون أن يصرح به. صارت طرف الخيط الثاني الذي يشد الراوي بين مكانين، كل خيط تشده أنثى. الأم في شربين، وسندس في القاهرة. كلتاهما وجه للأخرى. الاثنتان تمثلان زورق النجاة في محيط عاصف. الأم تبدو مثل فنار يلوحُ لشخص كان يُواجه الأهوال في قلب البحر، وسندس تبدو مثل سفينة عملاقة ظهرت لنفس الشخص في قلب تلك العواصف وانتشلته منها.
ذلك التأرجح ظل غير محسوم بين الأنثيين حتى قبل النهاية بقليل، حينما أدرك الراوي أن القاهرة بكل مباهجها وإغوائها غير قادرة على تعويضه تلك الأنثى. لا. بالأدق فإن القاهرة حاولت بجبروتها إبعاد الأم عن محيطه، ولكنه في لحظة صدق قرر أن يترك كل شيء وراءه، مبحراً باتجاه الفنار، لقد حسمت الأم المعركة مرتين. في المرة التي انحاز فيها الراوي إليها، وأيضاً بلحظة موتها، فقد وجهته عمداً إلى سندس، وحتى حينما كانت تطل على الحياة من جديد.. كانت تفعلها في أحلام سندس لا أحلامها هي.
كان يشعر بالغيرة من سندس، ويمطرها بالأسئلة عن كل صغيرة وكبيرة عن تلك الأحلام، وهكذا تجسد المعنى الذي أحاط به في كل لحظة، أنه حبيس مرآة ذات وجهين، كل وجه تمثله امرأة، وحتى حينما صار لتلك المرآة وجه واحد أصبح ذلك الوجه تمثله امرأتان متداخلتان تنتميان إلى عالمين، الواقعي والماورائي، وأظن أن الفكرة الأكثر قسوة في الرواية أن الحياة لم تسمح لذلك الراوي حتى بوجه واحد، فقد مضت سندس إلى ذلك العالم الماورائي، بعد مرض قصير أجهز عليها سريعاً.
العاصمة تفتح أبوابها
ظلت نظرة الراوي إلى القاهرة طوال الوقت محكومة بعلاقته بالأم وبسندس. حينما اقترب من سندس بدا كأن العاصمة تفتح أبوابها، وكأنه يعيش بتوقيتها. يقول: “كنت تشعر في ليل القاهرة بشيء جديد هذه المرة، أليف ووديع ورحب، لم تعرفه منذ أتيت، وتحسّ بدبيب مشاعر تتحرّك على استحياء وبحذر بالغ، تحت طبقات من رماد وتجارب مؤلمة وعذابات لم تندمل، ورغم خوفك من ضعفك التقليدي أمام كل مَن تملك ابتسامة ساحرة، كنت تشعر بفرحة حقيقية”، بل إنه يقول بوضوح: “معرفتك بسندس كانت الحدث الأهم الذي غيّر من نظرتك للقاهرة، وأفسح بينكما مجالا لصداقة غير مشروطة، كنتَ تحب نفسك أكثر وأنت بصحبتها، وتستطيع أن تتسامح مع أخطائك، وتُعطي لنفسك فرصة أخرى، فترى فيها جمالا خفيًّا لا يُشرق في روحك إلا بصحبتها”!
ولكنه سرعان ما يصبح مشدوداً إلى الطرف الآخر البعيد، الذي يمارس معه دائماً لعبة التذكر، دائماً ما ترد مفردة التذكر في متن السرد وكأنما يخشى الراوي أن يترك نفسه أسيراً طوال الوقت في عالم واحد. هنا يرتد مائة وثمانين درجة إلى الناحية الأخرى، إلى الأم: “أخبرتها بكل شيء، وقلت لها إنك حتى الآن لم تستطع أن تحبُ القاهرة، فقط كنتَ تشعرُ بالدهشة كلما التفتَ حولك، ووجدتَ أنك قد أصبحت فيها بالفعل، ويوما بعد يوم تنغرسُ في تفاصيلها أكثر، وتتحوّلُ لجزء أصيل –وليس أصليًا- فيها”!
الأنثى مفتاح فهم العالم. والراوي لم يفهم القاهرة إلا من خلال أنثى، ولكنه اعترف لنفسه أخيراً “القاهرة لا تُصادق أحداً، ولا تساعد أحداً، ولا تُنصت لآهات أحد، فهي لا تحب الصوت المرتفع أكثر من اللازم، لا تحب الشكوى، ولا تحب أن تقضي وقتها في مواساة المحزونين والضائعين أو تضميد جراحهم، فلديها ما هو أهم!
القاهرة لا تمنح أسرارها لأحد، ولا تفتح قلبها للغرباء، فقط تتركه مواربا لمن تتوسم فيه القدرة على تمديد الهالة الأسطورية التي تنسجها حول نفسها باستمرار، لتُغريه بالاقتراب والمحاولة، لكنّه كلما اقترب، اكتشف أن المشوار لا يزال طويلاً”.
بين فكرتين
كان على الراوي، وهو المشتت طوال الوقت بين عالمين أو فكرتين، القاهرة وشربين، الموت والحياة، الفقد والامتلاك، الحزن والسعادة، أن يختار ضميراً يسمح له بمسافة مع العالم والشخصيات والأماكن، ليراقب بأقل مساحة من الدهشة، ليفهم بالأدق، ليفهم لماذا يموت أقرب الناس إليه، ولماذا تنتصر الفكرة المؤلمة دائماً في كل المعادلات التي كان طرفاً فيها، لماذا يفقد أحبته بهذا الشكل المرعب، دهساً تحت عجلات القطار، أو غرقاً، أو في مستشفى حكومي لا يحفظ آدمية الناس، كان يمكن أن تستمر الأم فترة، وكان يمكن أن تستمر سندس فتاة جميلة، أو حتى على الأقل تموت جميلة، ولكن عوضاً عن ذلك ينهشها الكيماوي، ويأكل ملامحها وخلاياها بسرعة ووحشية، ويحولها إلى شبح فتاة كانت تملأ الحياة يوماً بهجة، حتى “وسيم” صار مصيره غامضاً وقد تحدى مجتمعاً شديد القسوة بإصراره على الزواج من مسلمة.
وحتى يحافظ على تلك المسافة اختار ضمير المخاطب، وهو ضمير مؤذ جداً في الكتابة، ولا يحقق شرط المتعة، لأن القارئ عليه دائماً أن يفكر: الرواي هو من يخاطب نفسه، وعليه سريعاً أن يمارس اللعبة التي أرادها الكاتب، أن يحول ذلك الضمير إلى “أنا”، ولكن خبرة حسام نجحت في تمرير المسألة، فلم يحدث ذلك العائق في القراءة، وكانت هناك سهولة في التلقي، وربما اختار هذا الضمير ليقول إن الراوي أيضاً ميت مثلما مات كل الأبطال، وإن ذلك ديالوج كامل بينه وبين نفسه في عالم ساكن، لا يستطيع أحد فيه أن يستخدم ضمير “الأنا” أو الراوي “العليم”. ليست رواية كئيبة بقدر ما يراها البعض، لأنها رواية عن الحب والأمل والقدرة على تسلق الأسوار التي يفرضها علينا البشر القساة والمدن المتعالية والقدر الذي لا يمهل غالباً، ولا يمنحنا ما نريده. “بتوقيت القاهرة” رواية عن ذلك التحدي الأبدي الذي ينتصر فيه الإنسان لأفكاره في وجه كل السدود.
…………………….
“بتوقيت القاهرة”
رواية حسام مصطفى
دار “دوِّن”