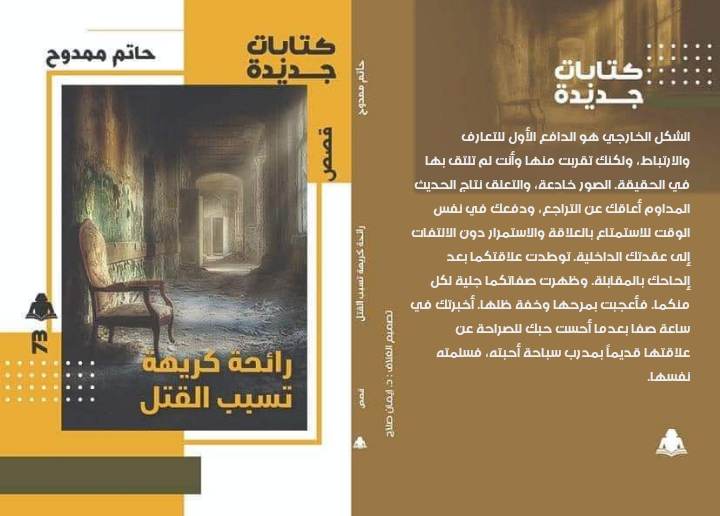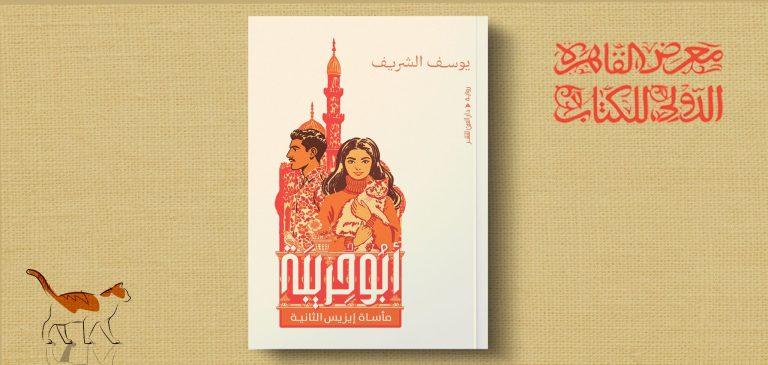حاتم ممدوح
أي قطن زائد عن الحاجة، كانت تخلق أمك منه وسادة، لم تر مكاناً مناسباً لها سوى سريرك الذي مر عليه الكثير من الوسائد والذكريات، ما أكثر وسائدك! وما أتعبهم! الطويلة منها بغير امتلاء كانت أول إدراك حقيقي لك بعالمهن. كان الجمال الدافع الأول في اختيارك لها. وتقربك لها كان قراراً فردياً لم تحب أن يشاركك فيه أحد. تحدثتما على”الإنترنت”. أرسلت لك صوراً لها، تعويضاً عن رفضها تطوير العلاقة بينكما بالخروج والمقابلة. أثارك طولها الذي تغير مع كل صورة أرسلتها لك بناءً على طلبك، لم يزدك اليقين بأنها أطول منك إلا تحطيماً لكل الحالة الحالمة التي رسمتها في خيالك للعاشقين، وتفتيتاً لرغبتك في امتلاك وسادة تناسب حجمك، فتحتويها كاملة بين أحضانك. من وجهة نظرك، الشكل الخارجي هو الدافع الأول للتعارف والارتباط، ولكنك تقربت منها وأنت لم تلتق بها في الحقيقة. الصور خادعة، والتعلق نتاج الحديث المداوم أعاقك عن التراجع، ودفعك في نفس الوقت للاستمتاع بالعلاقة والاستمرار دون الالتفات إلى عقدتك الداخلية. توطدت علاقتكما بعد إلحاحك بالمقابلة. وظهرت صفاتكما جلية لكل منكما. فأعجبت بمرحها وخفة ظلها. أخبرتك في ساعة صفا بعدما أحست حبك للصراحة عن علاقتها قديماً بمدرب سباحة أحبته، فسلمته نفسها. اصطنعت الثبات، واستمعت رغم التشتت الذي يهد بقايا صورك الحالمة، قالت:
– تزوجني بعد ذلك رسمياً، ثم طلقني ورحل.
أحسست أن أحلامك البسيطة في وسادة على قدر حلمك شيء بعيد المنال. لعنت الصراحة- المطلوبة في أي علاقة- حين علمت قوتها وتأثيرها عليك، وتأرجحك أمامها. تأرقت حين طالبتك أن تكون بجانبها بلا التزامات بعدما شعرتّ بوقع الصدمة عليك. أدركت لحظتها أنك تحبها لأنك لم تتخيل يوماً أن يعود الحديث بينكما إلى البدايات؛ قبل أن تلمس الصدق في حبك لها، فتحكى لك عن سرها، وقبل أن تشعر باتخاذ العلاقة شكلاً آخر، فتطلب منك الا تكونا سوى أصحاب. وقبل أن ترسل لها طلب الصداقة على” الفيس بوك” كبداية للتعارف. أعادتك الأفكار والجمل إلى عتبة سؤال يدق رأسك وبشدة:
لماذا؟!، لماذا حدث كل ذلك إذا لم تكن النهاية لا ترضي؟
احتضنت وسادتك وتشبثت بها حيناً، ونزعتها من أسفل رأسك لتسنده فوق راحتيك حيناً آخر. تقلبت من التفكير، ولم تعرف أن كثرة التفكير بُعد بلا إرادة، وإن الاستسلام والاستمتاع عشق. أمك الوحيدة التي شعرت بك، على الرغم من انطوائك على نفسك، وبرغم أنك لم تحك لها. فهي تعرف عن الوسائد أكثر منك وإن لم تخض تجارب مثلك، كما تعلم رغبة من بلغ مثلك على اختبار قدرته في الاختيار وحده. تابعتك عن بُعد وأنت تحاول اتخاذ قرارك. تأثرتّ لتأرقك وعدم قدرتك على التقرير والحزم، ولكنها أرادت أن يشتد عودك فئ مواجهة الحياة والمواقف. وحين أدركتك التوهة، حكيت لها، فاكتفت بجملة واحدة تعلم يقينا صداها الفاصل في صراعك:
– أفعل ما ترتاح له نفسك، وتميل بداخلك كفته.
****
عُدت تدريجياً إلى نوم العازب. تقرفص ساقيك، وتضع راحتيك أسفل رأسك ولكنك لم تذق راحة البال. قررت اعتزال تلك الوسائد التي تجذبك على” الإنترنت”، ولم تعد النظر في أي من تلك العابرات اللاتي يملأن سريرك. ولم تلتفت مطلقاً لتلك التي تضعها أمك بهدوء أسفل رأسك وأنت نائم لاعتقادها بأن فيها أمانك، وثقتها في قطنها الذي مز أمامها. ولم تهتم بتلك البيضاء التي أشار عليك زميل العمل اليائس للارتباط بها بدلاً من تلك الجديدة التي أعجبتك. الكل يرى راحتك من وجهة نظره، وأنت رأيتها في تلك “المدملجة” القمحاوية التي جمعك بها عمل ودور واحد. استرحت لتضاريس جسمها، وتناسبها مع طموحاتك. أحسست أن عالمها خاص، ولا تتحادث مع أحد. فربما هذا ما أكسبها عداوة من حولها، وازدياد إعجابك بها. لم تعرف كيفية التواصل معها، والتقرب لها. القدر أسرع من رغبتهم في إثنائك عنها، وأكبر من قدرتك على التدبير. في الوقت الذي هممت فيه بدخول الطرقة المؤدية إلى الحمام الرجالي، كانت تغادر الطرقة متجهة نحو نفس الباب للخروج منه. اصطدمتما صدفة، تلاصقتما لأقل من ثانية، ولكن ذلك لم يمنع إحساسك بسخونة أنفاسها، وطراوة ثدييها المتقاربين. فاختفت رهبة الموقف بعدما تملككما ضحك غير إرادي. ولم تنس تلك اللحظة التي تشبه انسحاب روحك حين تعلو الأرجوحة بك ثم تهبط للسكينة والأمان. قررت التحدث معها والتقرب إليها حين تراها مرة أخرى، ولكن حين لاحت لك عن بُعد، أدارت وجهها وكأنها لا تعرفك. تذكرت بساطة الطويلة وخفة ظلها كشيء من الحسرة. قررت مواجهتها بما في داخلك من غيظ، ولكنك تراجعت خوفاً من ردة فعلها. تمالكت أعصابك فأدركت أن بذرة الإعجاب تمخضت حباً. قلت في نفسك أن الوسائد التي تتمناها لشعورنا بمناسبتها لنا تحتاج للمحاربة من أجلها، ولكن بحرص. هذا أول الحب. في الحمام الحريمي الملاصق للحمام الرجالي الذي تفك فيه عن نفسك، سمعتها تتحادث في “الموبايل” إلى شخص ما بصوت خفيض. تترك قاعدتك، وتتنصت الجدار فلم تسمع سوى بكائها الذي أثارك وأربكك. كيف يتحكمن في نبرة أصواتهن إلى هذا الحد؟ ارتدت ملابسها، ولم تعرف ذلك إلا بعدما سمعت صوت”السافون”، وخرير مياه حنفية الحوض. استعدت للخروج فسبقتها بسرعة إلى الخارج. انتظرت وشكوكك الداخلية في سلوكها بناءً على تجربتك القديمة تختلط بمخاوفك عليها. تمنيت لو يخنك سمعك في تقدير صوتها. لو يتزعزع إحساسك بأنها لم تكن صاحبة الصوت، على الرغم من حفظك لنبرة صوتها. خرجتّ وكأنها لم تكن تلك التي كانت تبكي، فزادتك تأرجحاً مابين التعلق بها أو إعادة التفكير. مارست عادتها في التجاهل وكأن الموقف الذي هزك لم يؤثر بها. حاولتُ التأكد بأنها لم تكن وحدها بالحمام. سألت عاملة النظافة أن تتأكد إن كان هناك أحد بالداخل أم لا. أخبرتك بالإجابة التي لم ترد سماعها. دارت الأسئلة في رأسك واشتعلت، من الذي كانت تحادثه؟ ولماذا كانت تبكي؟! وكيف تستطيع إخفاء حزنها وكأن وجهها قابل للتكيف مع رغبتها؟!، وكيف لا تهتم بوجودك؟! تتوالى الأسئلة على عقلك بلا رحمة فتخر عبداً لها. تشعر بأن الوسائد لا تأتى “سالكة”، وأن هناك دائماً أسبابا للتعكير. على الرغم من كل ذلك، لم يثنك شيئ عن التعلق بها، والتقرب إليها ومعرفة قصتها. فلم تجد سوى ” الفيس بوك” وسيلة أخيرة حين تنقطع المعجزات. عدت إلى طريقة التعارف التي قررت من قبل عدم انتهاجها، ولكنك أقنعت نفسك بأن هذه العلاقة ليست كسابقتها. نكزتها، فأثارتها فعلتك، سألتك في اليوم التالي عن معنى تلك النكزة؟ فأخبرتها بأنها ” كالزغزغة”، وأنها منطقك في الحياة حين تستصعب الأمور وتتعقد. ضحكتّ، فأعادت بذهنك لقاء أول مرة. تحادثتما على “الإنترنت” بعدما قبلت إضافتك. أدركت حينها أن الوسائد التي تفقدك الثقة في ” الإنترنت” تعيدك له وسائد أخرى. رفضت وقوفك معها بالعمل، فأطلتما المحادثات حتى ساعات الليل المتأخرة في بعض الأيام، وأغلقت الاتصال بينكما فجأة والحديث في ذروته في أيام أخر. عاتبتها، فأخبرتك عن سوء شبكة الإنترنت عندها. على الرغم من الشك الذي أصابك تجاه أفعالها، إلا أن حبك لها جعلك دائم الاستعداد لقبول أعذارها. لم تستسلم لظنونك بطريقة أثارت استغرابك. ولم تركع تحت أقدام الأسئلة التي تملأ رأسك. قررت الاستمتاع بعدما تعلمت أن ليس كل ما نجهله يستحسن معرفته، فربما في الجهل به السلامة والمتعة. وقفتما بطرقة العمل- وقليلاً ما يحدث ذلك – فكانت فئ أوج ودها وكأنها لا تريد مغادرتك أبداً، وحين تحدثتما عبر” الشات” علقتك أحياناً ولم تجب، ثم تعود بعد ذلك لتعتذر ثم تغلق الاتصال حيناً آخر. تتضايق ويزداد شكك، فتعاتبها بتوتر، فتقول بحدة:
لا أهوى الأحاديث الكثيرة وأحب الخطوات والأفعال، فأنا بلغت الثلاثين.
أحسست بأنها تسابق الأيام لكي تصبح مداما دون الاهتمام بأهمية فترة التعارف بينكما. وأن رغبتك في الشعور بالاطمئنان ناحيتها لم يكن أمرا ذا بال بالنسبة لها تجاهك. وأن حبك لها أصبح حملا ثقيلا تحت وطأة متطلباتها التي فاقت قدرتك. وأن الخطوات السريعة التي دفعتك ناحيتها لم تزدك إلا تأكيداً بأنها لم تكن تحبك بقدر ما تريد أن تكون متزوجة. لم تعد تستمتع بالعلاقة العاطفية كما كنت تخطط، أصابك كل ذلك بالشك ناحيتها، اقتنعت بأن ليس كل ما لا نعرفه بلوغاً للراحة. سألتها عن أحداث يوم بكائها، قالت نافية:
لم أبك ولم أحادث أحداً، ولا تنس أن الحمام يحتمل وجود أكثر من شخص.
لم تخبرها بكذبها. ولم تستسلم لشعور داخلى باحتمالية سوء تقدير عاملة النظافة. ولم ترتح لطريقتها في إدارتها المتعجلة للأحداث بينكما. كما لم تعد تتقبل فرق المسافة العمرية والفكرية والطبيعة الشخصية بينكما. حينها تأكدت أنه مهما قالوا في محيطك أنك أكبر من عمرك، فإن هذا لا يعنى أن ترتبط بوسادة أكبر منك. أبدلتّ الحمام الذي سمعت فيه بكاءها وذلك بعد أن واجهتها بما في داخلك، لم تقبل مقابلتك خارج إطار العمل. شعرت بعدم الراحة حيال أفعالها الغريبة. عقلك لا يهدأ من السؤال، وقلبك تعلق ولا يتعلم. بدأت- بلا إرادة- في المقارنة بينها وبين من سبقتها، الصراحة المفرطة في مواجهة الضبابية والشك، تتحكم بك الكوابيس فتراها في أحضان غيرك بأماكن مختلفة، يقبلها ويجامعها. تستيقظ من القلق في عز نومك للتأكد من وجود الوسادة أسفل رأسك، ويستلمك الأرق حتى الصباح. الأمان كان في أمك التي قالت لك: الوسائد راحة واطمئنان وثقة، فإن لم تجدهم فاتركها.
****
للمرة الثانية تثبت سوء اختيارك. تتلاشى النظر إلى أمك حتى لا ترى ضعفك. على الرغم من وجود أبيك في حياتك وهيمنته على البيت، إلا أن أمك من تشعر بما في داخلك، فتقبل عليك بعدما تضيق بك السبل. أبوك ذو كبرياء، تعود أن يقترب منه الجميع، فحينما لا تقترب إليه لتحكى فأنت بالنسبة له غير مرئي. تبكى في الليل الذي لم تشعر بطوله إلا في تلك اللحظات. تعانى آلام التعافي والنسيان. تفكر في إعادة الصلة المقطوعة مع الوسائد القديمة والعابرة اللاتي مرت بحياتك على الرغم من إدراكك بأنها لا تناسبك، تبحث عن تلك الوسائد التي ظهرت وأنت في عمق علاقتك بالوسادة “المدملجة”، فلم تعثر على أي منهن. الوسائد التي تعجبك لا تظهر إلا حينما لا تكون خالياً. تبحث في ظلمتك عن ذر تضغطه فتمحى الآثار السيئة للعلاقات المنتهية. تتمنى لو تخرج من ظلام الليل إلى المنطقة الرمادية، تلك المنطقة التي يتبعها الخروج للنهار، وهذا أقصى طموحاتك. تحاول “المدملجة” إعادتك مرة أخرى لعمق العلاقة دون التنازل عن متطلباتها التي لم تستطع تحملها. تأكدت بأنها لا تحبك، وأنها تريد إغراقك في الظلمة. في عودتها إثارة للذاكرة وحزناً على اللحظات الجميلة والكلام المثير، وفي إجحاف شروطها العجز والضيق، وفي إحساسك بعدم مناسبتها لك بالصفاء الذي يزول حين يقتحم سلامك المؤقت حالة من التخبط. اكتفيت بها كحد فاصل بينك وبين الجدار مع تلك الوسائد القديمة. أحسست بمرارة الوحدة فلم تجد من يشاطرك أيام التقلبات النفسية والنحال الجسدي سوى أمك، وزميل العمل اليائس الذي كان أكثر خبرة وبصيرة منك. لم يمل- رغم بؤسه- في استمالة قلبك تجاه تلك البيضاء. الناس يرون ما لا تراه وأنت بعمق علاقتك. على الرغم من اقتناعك بذلك إلا إن قلبك مغلق وعقلك يرفض البيضاء دون فرصة للتفكير. قررت الاعتزال والعيش لنفسك وأنت لم تبلغ الثلاثين بعد. ولم تعرف- إلا حين طرقت باب التجربة- أن النوم بلا وسائد لفترة طويلة يسبب الألم، وأن المرتبة ليس لها معنى بلا وسائد ولا تكفى وحدها. جسدك يتلوى، وعقلك يرسم لك في ليالى الأرق والالم مواصفات الوسادة المناسبة لك بناءً على تجاربك السابقة. لم تعد تهتم بالجمال. كلما كبرت تشعر وكأنك تتنازل عن بعض مواصفاتك ويتحول كل شيء إلى نسبى. تفتح قلبك تلقائياً، تتقرب ولا تقرر من بعيد، تقتحمهن ولا تنتظر أن يقتحموك. فتظهر الوسائد من حيث لا تدري ليكتظ بها سريرك، تجربها وتجربك، فتكتشف مدى ملاءمتها لك من عدمه. تمر السنين ولم تنعم بنوم مريح. تشعر من طول الوحدة وعدم التلاقي بأنك منبوذ من عالمهن، وإنما كتب عليك فقط أن تراها وهي تحاوطك بكثرة على سريرك منذ أن كنت صغيراً ودون أن تحظى بواحدة تريحك طول العمر. الاحتياج مر. وبعض الوسطاء يمتنعون. وأمك كثفت بحثها داخل أفراح الجيران عن وسادة ذات قطن أصيل. سالتّ جارة خبيرة بفن الوسائد، توفق الوسائد مع المحتاجين لها. قالت حين علمت بأمرك بأنها لن تهدأ حتى تجد وسادة تشبهك. التقطت لك واحدة، كانت ترتدي فستاناً أحمر فأعجبتك، على الرغم أنك لم تحب تلك الطريقة إلا أنك ذهبت لتراها من الزن والزهق. في نفس الوقت الذي دفعك فيه زميل العمل اليائس للتقرب من البيضاء. تقربت إليها، وتحادثت معها، ولكنك لم تعرف لماذا رشحتها – ومن دون أن تعرفها عن قرب- لصديقك الذي يبحث عن واحدة تصلح له. تحادثا على “الإنترنت”، بينما تقربت من تلك التي أعجبتك. كانت مزيجاً ما بين كل المواصفات التي تخيلتها وأنت وحدك، وكانت بعيدة عن كل الأشياء التي وجدتها بالأخريات وأرقتك، هكذا كنت تعتقد. على الرغم من نعومتها، إلا أنك كنت تتذكر سخونة جسد “المدملجة”، وصدرها الذى لم تجد له مثيلا، وحديثك الجنسي معها. أحسست معها بأنك في المنطقة الآمنة، الوسادة طوعك في كل شيء، حتى إذا قررت وضعها بين ساقيك فلن تمانع، لا يوجد ما يقلقك. لكن الخلود لم يدم إلا حين أدركت أن الذي يطيعك طاعة عمياء يطيع غيرك ويصبح أسيرا له. أصبحت فجأة تسير عكس إرادتك، وكأن قوة أخرى قد عبثت بذر تحكمها، وسير حياتكما. أدركت أنها وسادة ذات عمر افتراضي قصير، صنعت للاستفادة من غارق الإعجاب بها. وسادة للعرض فقط. تستنزف الأموال والمشاعر الصادقة واللحظات الحلوة ثم يتحول حشوها اللين المزيف إلى مادة صلبة تقسم عضلات الظهر والرقبة. تحولت أحلامك معها إلى كوابيس. أخبرتها في يوم ما – بعد أحد الكوابيس – بأنها ستغادر العلاقة فجأة، بكت وقبلت يدك بعدما طالبتك الا تقول ذلك مرة أخرى. في كابوس آخر شعرت أنها تسحب منك بينما تجاهد في التمسك بها. لحظتها أدركت أن ماتتشبث به ما هو إلا وسادة كبيرة. الوسائد الكبيرة في الحلم رزق كبير. وكانت تلك الفتاة ذات الفستان الأحمر صغيرة في كل شيء. ظل يختفي ذكرها في نفسك حتى تلاشت نهائياً بينما ثبتت الوسادة الكبيرة نفسها أمام عينيك. تستيقظ لتراها بعيدة عن رأسك. لم تعد تفهم أحلامك، لكنها تعرف كثيراً كيف تخطو نحو الواقع لتصبح حقيقة. أنهتّ الوسادة العلاقة، وتركت بداخلك جرحا يعصرك. ولكنك أقنعت نفسك بوهم الاشتياق لمذاق العزوبية، ولم تعرف أنك ستغرق بظلمة جديدة سببها الصدق حين تتعلق بالوسائد المزيفة.
****
يقولون إن الإنسان الذي ينام وهو يعانق وسادته، فهو يفتقد لشخص ما. وها أنت تقرفص ساقك وتحتضن نفسك. لم تزل تتألم بعد كل علاقة، ولكن حدة الالم لم تقل إلا حينما جاءك أبوك في الحلم. أخبرك أن من يتالم أكثر هو من أحب بصدق، والذي ينبض قلبه بالحب يعيش إنسانا، ثم بشرك – وهو يقبل أصابعه المضمومة كالوردة- بوسادة جميلة. سنتان في انتظار أن تتحقق البشارة. حاولت خلالها إعادة العلاقات المقطوعة مرة أخرى مع الوسائد التي مرت بحياتك ليس إلا لسد شرخ الفراغ، حاولت الخروج من دائرتك المغلقة بالنزول إلى الشارع لعلك تصادف تلك التي ينطبق عليها ما قاله أبوك. ذهبت إلى صديقك، فعرفت ما دار بينه وبين البيضاء من مشكلات، انتهت بالابتعاد بعد يومين من التحدث. لم تستغرب لأنك شعرت يقيناً فيما بعد عدم مناسبتها له على الرغم من طيبته. وأن مثل تلك الوسائد تحتاج لمعاملة خاصة لا تصلح لشخصيته ولا يلائم انطلاقها قمقمه. تصاحبتما بعدما حاولتُ إصلاح ما أفسده صديقك دون مراعاة لك. في العمل، أعدت لك بنفسها فنجان قهوة بلا مناسبة، أخبرتك أنها تعشقها، وتعدها لمن تحبه، ولكنك لم تعلق مكتفيًا بما أحدثه فعلها من نشوة. حكيتما بلا توجس أو مشاعر زائفة عما فات. فتماست هيئتها مع حلم الوسادة الكبيرة. أخبرتك عن ذلك الحصان الأسود الجميل الذي جاءها بحلم ما، فتلاقت أفكاركما في تصديق أحلامكما. أغرقتك بلا ترتيب في الطمأنينة والثقة والصراحة. شعرت بلين حضنها، ونعومتها كحلوى غزل البنات. كانت جميلة للدرجة التي تجعلك تراها حلوة من كل الزوايا. وكانت طرية ساخنة فأمدتك بالدفء والإمتاع حين أرحت رأسك عليها، فشعرت بالراحة والإلهام. الوسائد الفائتة جعلتك تتذكر اللحظات الحلوة بالعلاقات السابقة، بينما لم تشعر يوماً في وجودها بالفقدان لأي شيء جميل وأنت بعمق علاقتك معها. سألت نفسك: كيف لم أتقرب لها من البداية؟ وكيف لم أعجب بها إلا بعدما اعتذرت لها عن أسلوب صديقك معها؟، لماذا نخوض الكثير من التجارب من أجل أن نصل إلى تلك النقطة؟ أقنعت نفسك بأن السنين والتجارب هما من شكلتكما وأعدتكما لتلك اللحظة. سألتها عما دفعها لإعداد قهوة لك؟! فسألتك عما دفعك لتقديمها لصديقك ودون أن تعرفها؟! أعجبك سرعة ردها، وشدتها حين يلزم الأمر في سبيل المحافظة على نفسها، ورغبتها في التعرف عليك، وإيجاد نقطة للتلاقي قبل أى خطوة جادة. لم تشعر لحظة بأن هناك من يوجهها، كما لم تشعر بأنها حمل ثقيل عليك. ولم تبخل بالمشاعر المتبادلة عملاً بأن الحياة كما تقول “خد وهات”. فكانت تتبادل الهدايا بينكما، ولا تنظر أبداً إلى حجمها بقدر الاهتمام بالتقدير، فكانت تعبيراً عن عمق العلاقة بينكما وصدقها. كانت تلك الوحيدة التي لم تتقرب لها إلا بعدما أعجبت بروحها قبل أن تهوى جسدها. على الرغم من كل ذلك، كانت إذا تضايقت منك، تقيم الدنيا ولا تقعدها. أخبرتها بصعوبة إرضائها عند الخناق، وأن ذلك قد يبعدها عنك. قالت:
– الزعل على قدر الغلاوة.
لولا ذلك لوصفتها بالكمال، على الرغم أنك تعلم أنه لا أحد كامل. ولكنك قبلت عيب، وحاولت تلاشيه من أجل المزايا. وهذا ما دفعك للتأكد بأن الوسائد تزيح بعضها بعضا، وتكشف عيوب من قبلها، وتظهر أيضاً قصر نظرك.ما أغرب الوسائد!،وما أحلاها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من مجموعة “رائحة كريهة تسبب القتل” .. صادرة مؤخرًا عن سلسلة كتابات جديدة ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب