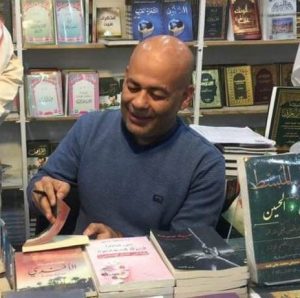فكري عمر
صديقي شاعر النثر صار شجرة وارفة الظلال في قصيدته الأخيرة. كان قد ملَّ من حِيل البشر، وطريقهم المقيت الفارغ؛ لذلك كانت مقولة “هوبز”: “الإنسان ذئب الإنسان” لا تغادر لسانه ليل نهار.
الغريب أنه صار شجرة في قصيدته؛ ليحنو على البشر من الهجير، ويؤنس وحدته بهمسات المحبين، ويستقبل تبدل الفصول بشجاعة فارس، يجهز لكل فصل منها طقوسه الخاصة؛ فليس الربيع وإن حلا بدائم، ولا الشتاء وإن أوحل بقائم.
لقد حافظ على أغصانه وأوراقه الخضراء؛ لأنه لا يريد أن يوحي بمعاني البؤس لمن ينظر إلى شجرة جرداء، أو أن يسمح لقاطع طريق بأن يستغل جدبه؛ ليستعير منه فرعًا غليظًا، أو أن يكون مرقدًا آمنا للتراب الذي تقذفه الأحذية الضجرة للأعلى.
قلت له: “هذا ليس حلمك وحدك. كثير من شعراء العالم حلموا بذلك، وإن اختلفت طرقهم ووسائلهم الفنية”.
وطرأ في ذهني سؤال حين عدت بقصيدته في يدى: لماذا تمنوا أن يصيروا أشجارًا خضراء دون ثمار؟
إذا فكرت بطريقة الهنود القدامى في مسألة تناسخ الأرواح، ونظرت للأشجار، لرأيتها بشرًا متحولًا بالفعل. بشرًا لم يستطيعوا المواجهة؛ فتصلبوا هكذا في أماكنهم التي دُفنت فيها أجسادهم، أو صوروا لنا أنهم أقوى مما نتخيل. أورقت أطرافهم كوسيلة ناجحة للتعاطف معهم.. لإعطاء الحياة شيئًا جميلًا، وسامقًا، ومتحديًا لم ينجحوا في نقله وهم في صورة بشرية من لحم ودم.
لم تمنحهم الظروف، حجّة الضعفاء، ولا طبيعة بعضهم الشريرة، كما تُصنِّفهم بعض نظريات علم النفس الحديثة، أن يعطوا شيئًا؛ فعادوا ليمنحوا الحياة شيئًا ما.
أليست البصمة هي فرادة الإنسان؛ لذلك وعد الله أن يعيد لكل إنسان بصمته في طريق العودة للخلود؟! البصمة بطاقة شخصية متفردة وموثوق بها لدى الله، وهي دليل إدانة أو براءة عند المباحث الجنائية. العرب لم تستخدم البصمة في شيء حين نزل القرآن؛ لكن لأننا استخدمناها أدخلناها في باب المعجزات الدينية. ما بالك بالبصمة الطيبة، أي الفعل المتفرد: نظرية علمية جديدة، رواية، قصيدة، لوحة فنية، عمل طيب!
ولماذا يعود شخص ليعطِي شيئًا وهو ضعيف، أو شرير بالطبيعة، أو أنه رأى في الشر وسيلة لتحقق أهدافه، أو لأنه عاد لينتقم ممن أوهموه بأن هناك حياة ما جميلة مُورقة بالمحبة والسعادة، لا تعب فيها ولا كد وراء هذه الحياة، لكنه لم يعثر على شىء من ذلك هناك؟
حين أتأمل الأشجار، أجد أن ذلك قد يكون صحيحًا، وأؤمن أن الهنود القدامى كانوا أقرب الناس إلى حقائق الفن لا حقائق الوجود، فكما آمنوا بأن الأرواح تُبعث في الحيوانات مرة أخرى؛ فالأشجار أيضًا بشر. هناك شجرة مثمرة، وشجرة جرداء. شجرة جميلة، وشجرة شريرة. شجرة تؤوي العصافير والبلابل، وشجرة تؤوي الثعابين والبوم. شجرة تستقبل الهواء فتغني، وشجرة تستقبل نفس الهواء لتطلق عواءً مرعبًا في الليل. شجرة مورقة تغري النمامين، وأصحاب المؤامرات بأخذ راحتهم تحتها، وواحدة عظيمة وجرداء تغري الحطابين بأن يقتلعوها ويبيعوها للنجارين الذين يصنعون منها كراسي، موائد، أسِّرة، مكاتب، أبواب، شبابيك؛ لتظل تراقب البشر في كل حركاتهم، كأنها تخزن ما تعرفه من أسرار لوقت ما. هناك شجرة على الطريق هائلة الجذع إذا سقطت صارت قاطع طريق. شجرة أخرى إذا سقطت انكشف الكنز المخبأ تحتها.
حين قابلته مرة أخرى صحت منتصرًا: “لن تخدعني يا صديقي هذه المرة، بتحوِّلك إلى شجرة مورقة وجميلة، على طريقٍ خالٍ من المارة. كيف تقنعي بالرغبة في الحنو والعطاء والألفة بعدما ذُقت مراراتهم؟ وكيف تُقدِّم لهم ما لم يقدموه لك كما تدعي، خصوصًا وأنت تتخذ من عبارة “الإنسان ذئب الإنسان” شعارًا لك!