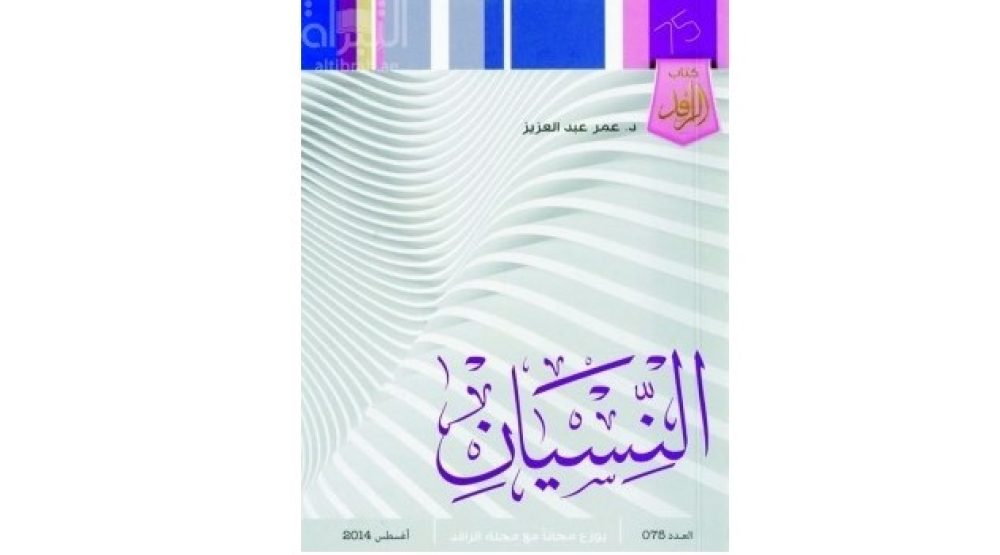د. حمزة قناوي
في معجم المصطلح السردي، يتأمل جيرالد برنس “السرد” من خلال النظر للعملية السردية ذاتها، حيثُ التأكيد على أهم عناصرها، وهو الإخبار، ولكن ليس الإخبار العادي، وإنما ذلك الذي يأتي كمُنتَج؛ أي نتاجٌ لعمليةٍ لها أهداف وفعلٌ وبنية وساردون. فثمة تمييز بين السرد، والوصف لوقائع وأحداث معينة.[[1]] والاختلاف حول الهدف والفعل والبنية هو مدار عمل مدارس النقد الأدبي المختلفة، بل مدارس الفلسفة والفكر أيضاً. ومن ثم فإن التعامل مع أي نصٍ أو معطى أدبي على أنه «رواية»، يستوجبُ مجموعةً من المفاهيم والشروط الإبداعية التي يجب فحصها في النص، خاصةً مع اقتناعي بنظرية “الملاءمة” بين أسلوب الكتابة، وبين ما يجدر بالمتلقي أن يصل إليه من تأويل عبر السياق [[2]]، وهنا نطرح سؤالاً جوهرياً: هل “النص” الذي صدر عن سلسلة كتاب “الرافد” ( عمر عبد العزيز هو رئيس تحرير السلسلة ومن يختار كتبها أيضاً! ) تحت عنوان: «النسيان»[[3]] يصلح أن يكون نصاً سردياً؟ هل تتحقق فيه أيٌ من الخصائصِ الجوهرية التي أشار إليها جيرالد برنس، والتي تمثل خلاصة جهود كثير من نقاد السرد الذين أسهمت جهودهم في إحداث نقلة كبيرة للنقد في مجال السرديات؟
توحي العتبةُ الأولى للعنونة السردية «النسيان» بأننا أمام نص طويل، يتحدث عن بعض الأحداث التي توالت في الماضي ثم انقطعت في الحاضر، وحالياً يعيش أبطال القصة الحالية على رغبة التبرؤ منها أبطالُ، وهكذا، نوع من الإبحار في أزمان وأماكن لأشخاص يعيشون الآن واقعاً منقلباً عن ذلك الذي كان، النسيان لا يأتي دائماً إلا مرتبطاً بالحزن، وبالندم الشديد، ثيمة من الثيمات المعنوية التي ربما لا تقبل التعديل والتغيير في الخبرة البشرية، وأقصى ما يمكن أن نضيفه من معانٍ مغايرةٍ على النسيان، باعتباره نعمة، تتمثل في الرحمة من استمرار تذكر ما يثير المشاعر السلبية، كتذكر إنسان راحل، أو حبيب مفارق، أو أحداث مؤلمة، وغيرها من أحداثٍ وذكريات، لكن العنوان يأتي هنا بشكلٍ مغايرٍ عما يستدعيه النص من سياق.
يقول السارد: «فراشة النسيان تنساب الهوينا محلقةً في عوالم المعاني لتنذر المقيمين في محنة الذاكرة: إياكم و عدم النسيان.. ولا تتنكبوا دروب الأيام .. واعلموا أن عدم النسيان لا يُعوّل عليه، والنسيان يعوّل عليه، وفي الدهر صور متناثرة، وأحوال متغيرة.. وهذه الصور الأحوال لا يعول عليها إلا بوصفها طيوراً مسافرة كالسحب العابرة.» ص60
ربما تبدو هذه أكثر صورة واضحة عن توظيف النسيان كعنصر فاعل داخل النص، كرمزٍ معنوي له وظيفة سردية يمكن استخدامها، لا يمكن اعتبار «النسيان» كعتبةٍ لها معطياتها الدلالية، قد نجح في أن يتحول إلى «بنيةٍ» داخل العمل الأدبي، بنية كتلك التي يُعرّفها غريماس بأنها: «…شبكة من العلائق المحايثة للتمظهر، تصبح الفضاء الوحيد الذي يتحدد داخله التفكير حول شروط انبثاق الدلالة.»[[4]]، فلا يبدو أن الكاتب قد استطاع أن يصنع من «النسيان» شبكة من العلائق المؤثرة في مسيرة الحكي، لا يبدو النسيان -أو عدم النسيان- بحسب ما يردان بصفتيهِما، وجهين لعملة واحدة هنا، لا يبدوان كأنهما يعملان على تحقيق متعة جمالية ما للقارئ.
عند إضافة ذلك إلى ملاحظة جيرار جينيت التي توصل إليها في كتابه «عودة إلى خطاب الحكاية» من أن الحكاية بالأساس لا تقوم على خطاب واحد وإنما تقوم على عدة خطابات[[5]]، فإننا هنا لا نجد حداً أدنى من الخطاب الواحد، حتى ننطلق إلى خطابٍ ثانٍ، إننا لا نشعر بأننا إزاءَ وقائع سردية، أو عملية سرد، حتى إذا ما عدنا لتعريفات أبسط لأوليات العملية الحكائية، كتلك التي نجدها في نموذج كلود بريموند، والتي تتكون من واقعة تقبل التحقق أو عدمه، ثم يحدث عدم تحقق، لكي ننطلق إلى واقعة أخرى وهكذا، وهي أبسط وحدات السرد الأولى، التي تبنى خطاباً سردياً حسب ما يصفُ جيرالد برنس [[6]]، فإننا لا نجد هنا خطاباً سردياً، وإنما نجد نصاً حائرَ الانتماء الأدبي من ناحية، ومفتقداً للتأصيل الجمالي من ناحية أخرى.
أعرض هنا مقطعاً كان يمكن استغلاله بحيث ينمو النص لكي يصل لمرحلة الخطاب السردي، ففي الصفة التاسعة يقول: «أهل حارته كانوا عكسه تماماً، فقد أضناهم النسيان، حتى إنهم كانوا ينسون ما كتبوه، وما قالوه، وما فعلوه قبل حين، ولم يجدوا بداً والأمر كذلك من اللجوء إلى فوفو الذي كان يعلمهم كيف يتعلمون فنون عدم النسيان، باعتماد التصوير الفوتوغرافي، كوسيلةٍ حاسمة في استذكار ساعات الليل والنهار، وكانت تلك النصيحة من الأهمية بحيث إن كل عاقل راشد في الحارة كان يحمل معه كاميرا فوتوغرافية، ليسجل عليها تفاصيل حياته اليومية، وتتحول تلك المدونة البصرية الكبيرة إلى وسيلة لضبط إيقاع الحياة في مجتمع عانى ويعاني النسيان المزمن.» ص 9
هل نلمح هنا إسقاطاً لخاتمةِ رواية «أولاد حارتنا» لـ (نجيب محفوظ)، عندما يقول: «ولولا أن آفة حارتنا النسيان ما انتكس بها مثال طيب. لكن آفة حارتنا النسيان.»؟ إذ يبدو أن كل ما في العمل مبنيٌّ على هذه الخاتمة العبقرية لنجيب محفوظ التي تمثلت عبقريتها في أنها تأتي بعد إبراز القدرة الجمالية النادرة والفريدة لمحفوظ في وصف القمع والقهر اللذينِ تعرضت لهما الحارة المصرية، وبعد كل ما بذلته من جهد في مناوئة ومجابهة الظلم ومحاولة إسقاطه، إذ بها تركن إلى النسيان لكي يعم ويعود الطغيان من جديد، كانت كلمته معبرة في خاتمة روايته، تحولت معها لثيمة يتم ترديدُها في كثيرٍ من المناسبات، أما اعتقاد عمر عبد العزيز أن مجرد استحضار ثيمة خاصة بكاتب كبير، والبناء عليها بتنميقات لغوية “غامضة وأقرب للطلاسم”، يجعل من ذلك عملاً أدبياً إبداعياً، فهو أمرٌ لا يعتمده إلا المبتدئون!
فالنسيان بالمعنى المحفوظي تعبيرٌ عريضٌ عن إعادةِ استنساخ الاستبداد والطغيان لنفسه مراتٍ ومراتٍ بأساليب جديدة، هو تعبيرٌ ليس عن النسيان في معناه الخاص، وإنما عن عدم تعلم العقل العربي عامةً أو استفادته مما مضى، وكنايةً عن استمرار الأوضاع بذات الوضع السيئ عبر الأزمان، رغم استمرار الكفاح والنضال.
عند محاولة التناص مع ثيمات شهيرة لكتّاب كبار ومجيدين، فإن ذلك يضع على الكاتب مسئوليةً إضافية، تتمثل في محاولة بذل مزيدٍ من الجهد، لكي يوظف هذه القيمة الإبداعية على النحو الذي يليق بها، كتلك الحالة التي صنعها إبراهيم فرغلي في روايته: «أبناء الجبلاوي»، وفي جزء من «معبد أنامل الحرير»، ولكن ما الذي أضافه هنا التناص مع مفهوم النسيان المحفوظي بالإشارة إلى أهل حارة «فوفو»، الذين أضناهم النسيان؟
بتحليل النص سنجد أن ما يشير إليه من قيام كل شخص ناضج بحمل آلة تصوير، هو إشارة للهاتف المحمول الذي يمتلك خصائص التصوير، ومن ثم يصبح «فوفو» رمزاً للشاب العربي الحديث، الذي تتخطفه التكنولوجيا، ونسي تاريخه وميراثه الحضاري، ومن ثم فإن محاولة استحضار «الخليل بن أحمد الفراهيدي» هي مجرد إشارة للماضي المشرق لهذه الأمة، ومن الخليل إلى فوفو يبدو البون شاسعاً، (ولا أعرف ما العلاقة بين الخليل بن أحمد الفراهيدي واسم ك” فوفو” يحمل من الليونة وتفاهة الدلالة ما لا يخوله ليكون بطلاً لعمل) وربما لو كان العلم الذي توارثناه ليس علماً لغوياً فقط، كالعروض وموسيقى الشعر اللذين أوجدهما الخليل – ولا أعلم لم يتجاهل الكاتب أنه عالمُ لغة وواضعٌ للمعجم أيضاً؟- ومن ثم فإن الحارة بدلاً من القيامِ بمهمتها الكلاسيكية في مواجهة الطغيان، فإنها اكتفت بالتوثيق ورفع الأمر على المدوّنة البصريةِ الكبرى، التي هي رمز لمواقع التواصل الاجتماعي.
غير أن النص لم يقم بتسويق هذه الفكرة جمالياً، ولم يقدم العناصر الكافية: لا يوجد ساردٌ للنص، ولا تفاعلٌ مع الشخصيات، ولا صراعٌ ولا حَدَث! لا يوجد ما يلخصه عبد الملك مرتاض بقوله: «الشخصية! هذا العالم المعقد الشديد التركيب، المتباين التنوع … تتعدد الشخصية الروائية بتعدد الأهواء والمذاهب والأيديولوجيات والثقافات والحضارات والهواجس والطبائع البشرية التي ليس لتنوعها ولا لاختلافها من حدود»[[7]]، هذا الزخم الكبير حول الشخصية الروائية وأهميتها، والتي تعد الميزة التي أعطت لأدب نجيب محفوظ متعته الجمالية، أين نجد الزخم في وصف الشخصية وفي فاعليتها وعمقها وخصائصها في ثنايا السرد المقدم هنا؟
إن الأمثلة على تسطيح الشخصية التي من المفترض أنها الشخصية المحورية الرئيسية في النص – شخصية فوفو – كثيرة جداً، فلا يبدو أن الكاتب قادرٌ على الإمساك بريشة الوصف عبر السرد، ليقدم لنا عمقاً وتجسيداً للشخصية، فلا نشعر بوجود حقيقي لهذا الشخص، ولا نشعر أيضاً بوجود رؤية تشير إلى تسطيح الشخصية وتفريغها، وإنما نشعر بعجز المؤلف عن الوصف، وبتبدد الفكرة من بين يديه، وبتصنعه الشديد في المعالجة، وتخبط الرؤية، حتى إذا ما بدأ بخطٍ سرديٍّ فإنه يفقدُ التركيز ويتشتت عنه، انظر لوصفه شخصية (فوفو) بأنها: «فوفو من مواليد برج القرد الصيني، وهو من الأبراج الهوائية بامتياز، وعن مثابة هذا البرج سنتحدث بعد أن نتعرف إلى رقم فوفو الفلكي الذي يترنج بين فكي الفاء والواو، وهما حرفان غير متحابين، ذلك أن الفاء يخرج من ارتطام الشفة السفلى بحروف الأسنان العلوية، فيما الواو نابع من الجوف. والعلاقة بين الشفتين والجوف علاقة متوترة دوماً، لأن الحروف الجوفية تأتي في اسم فوفو بعد الحروف الشفوية ((نسبة إلى الشفتين))، ولأن الشفتين دالتان مطلقتان على المزاج الغرائزي، لكنهما مصدر القبلات الحارة، والارتطامات الكلامية الفارغة، فإن أسبقيتهما في اسم فوفو كانت لصالح العقل المحدود لا الوجدان المتورحن المقرون بحرفي الواو المكرورين في اسمه. وقد أثبتت التجربة أن فوفو كان أكثر الناس قدرة على استخدام حجارة العقل في رجم الآخرين، وأولهم في مسار الاستخدام المريب للأزمنة العابرة.» ص10
وهذا المقطع الذي أورده بكامله هنا، يدلل على ما أشرت إليه من عدم قدرة المؤلف على خلق التماسك النصي، وعدم وجود خطة واضحة لإرساء كيفية الحكي، فيبدو أن هناك “مجرد فكرة”، ولكن الكاتب لم يجد لها الأسلوب الأمثل، ولا التخطيط البنائي لكي يقدمها للقارئ، مجرد تداعٍ حُرٍ للأفكار، وتواليها بدون ترتيب مسبق، وبدون تخطيط لأحداث، فلا حبكة ولا حكاية موجودة هنا، ويمكن القول إن كامل النص الممتد على نحو بضع وخمسين صفحة، كان يمكن اختزاله- بلا مبالغة- في نصٍ من خمسِ أو ستِّ صفحات، كان يمكن لها أن تكون قصة قصيرة عن النسيان، والمقارنة بين ذلك الذي ينسى وذلك الذي لا ينسى، أو كان يمكن لها أن تكون قصيدة نثر، تتباكى على الأمجاد التي كانت، وتتأمل حال الشباب الغارق في عزلة إلكترونية، لكن الكثير من المقاطع والفقرات لو حُذِفَ من النص فلن يؤثر فيه شيئاً! صفحات كاملة لا تقدم ولا تؤخر، بل ربما لو حُذِفت لقلَّ التشويشُ السرديُ القائم، خاصة المقطع الذي يقول فيه (فوفو): «ثم فتح الباب على وجل وهو خائف .. يهتز سيفه الخشبي بيد مرعوبة، فإذا بالمعتدي كلب، فتنفس أبو حنيفة الصعداء .. قائلاً: الحمد لله الذي مسخك كلبا، وكفانا حربا.»ص20، ولا نجد أي علاقة سردية بين ما قبله وما بعده، وليس ذلك ببعيدٍ عن حال كثيرٍ من المقاطع التي يمكن حذفها بالكامل دون أن يحدث أي تأثير على المساق السردي!
يمكنني القول إذاً من منطلق مبرهن عليه، إننا أمام “حالة فكرية” حاول مؤلفها أن يقدمها سرداً، لكن هذا السرد الضعيف والمتهافت لم تكتمل له عناصر السردية، ولم يقترب بحال من الجمالِ الفني، والتحقق الإبداعي، وكان الأفضل لعمر عبد العزيز- باعتباره رئيساً لتحرير السلسلة التاي أصدرت الكتاب- أن يكتفي بتقديم الروائيين الحقيقيين فيها من أصحاب الرؤية والتماسك النصي وتقنيات السرد المُحكم، لا أن يزاحمهم فيها بعمل يحمل كل هذا الضعف والتهافت.
………………………………………..
[1] – جيرالد برنس: المصطلح السردي، ترجمة: عابد حزندار، مراجعة وتقديم: محمد بريري، المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، 2003م، القاهرة ، ص 145-148
[2] – راجع: د.سعيد جبار: من السردية إلى التخيلية: بحث في بعض الأنساق الدلالية في السرد العربي، منشورات ضفاف – الاختلاف، 2012م، الجزائر – بيروت، ص 193
[3] – د.عمر عبد العزيز: النسيان، كتاب الرافد، عدد 75، أغسطس، 2014م، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة.
[4] – أ.ج جريماس: سيميائيات السرد، ترجمة وتقديم: عبد الحميد نوسي، المركز الثقافي العربي، 2018م، الدار البيضاء، ص 38
[5] – جيرار جينيت: عودة إلى خطاب الحكاية، ترجمة: محمد المعتصم، المركز الثقافي العربي، 2000م، بيروت – الدار البيضاء ، ص 9
[6] – جيرالد برنس: علم السرد، ضمن كتاب: موسوعة كامبريدج للنقد الأدبي، الجزء الثامن: من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية، تحرير: رامان سلدن، مراجعة واشراف: ماري تريز عبد المسيح، المشرف العام،: جابر عصفور، المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، 2006م ا لقاهرة، ص 196
[7] – عبد الملك مرتاض : في نظرية السرد: بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة، عدد 240، ديسمير 1998م، الكويت، ص 73