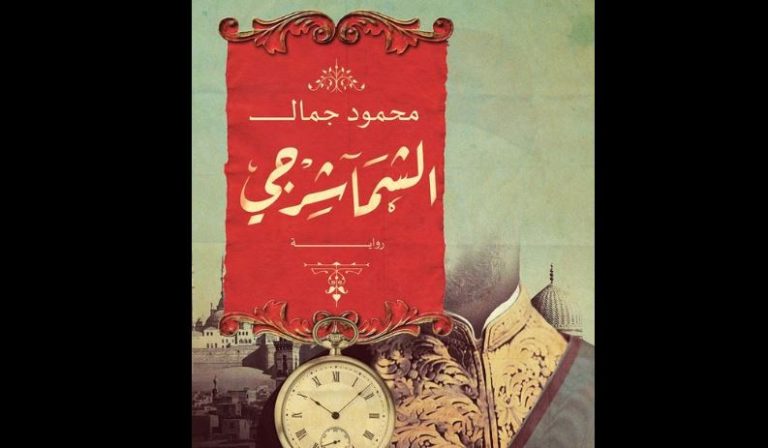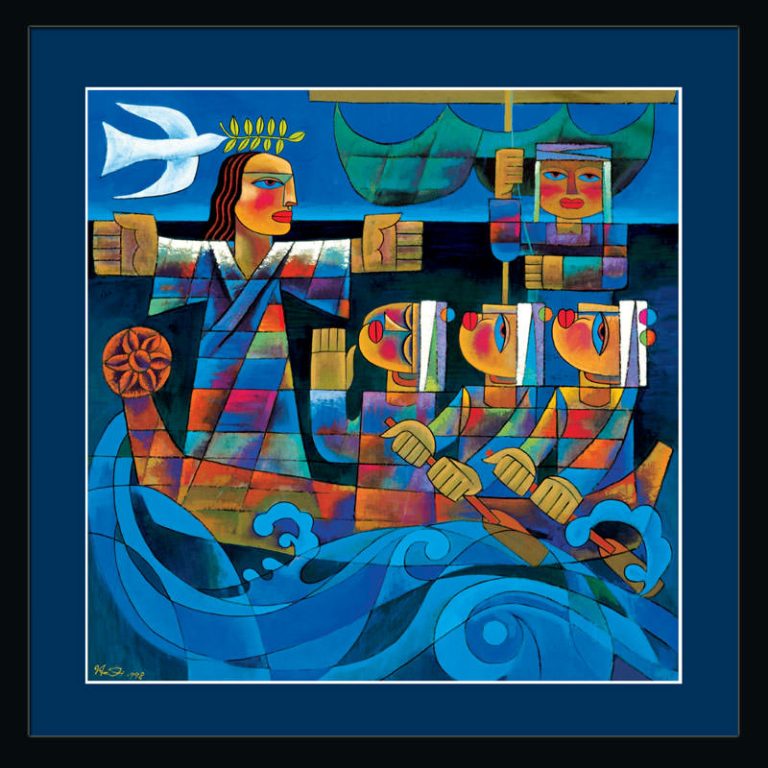د. سُميّة عزّام
لا يحيا الإنسان في حدود «هُنا» و«الآن»، بل يجاهد كي يترك علامة دالّة على وجوده. والتاريخ غالبًا ما يكون نبع المعاني، نستخلص منه خلاصة خِبراتنا في توقنا المستديم إلى المعنى. البحث عن الأصل، وعن العلاقات بين الأشياء، وما خفي منها على وجه الخصوص، طريق للكشف، بل هو «فنّ الفهم». خير تجسيد لهذه الرحلة صوب المعنى كتاب «الكتابة على جلدة الرأس» الصادر عن دار جرّوس برس، طرابلس، لبنان عام 2018، للّبناني المتخصّص في علم اللغة الحديث، والمهتمّ باللغتين الصّينيّة والعِبريّة، بلال عبد الهادي.
الحديث عن هذا الإنجاز اللغوي -الأدبي لا ينفصل عن كتابه الأوّل «لعنة بابل»(مركز محمود الأدهمي، طبعة أولى 2013)، بمقدّمة سكّ فيها منهجه الفكري الذي أوضح مسار فصول الكتاب. قائلًا إنّه مولع بـ «واو» العطف، وهي الواو العاطفة والواصلة بين عالمين، وإنّ وظيفة الكتابة تسليط الضوء على الصّلات المتينة والخفيّة بين الأشياء، موردًا خبرًا عن حكيم هندي، يقتبس منه ردّه على سائله عن سرّ الفلسفة، قائلًا: «الفلسفة هي أن تحسن استخدام واو العطف». ويصحّ القول إنّ الكتاب الثاني هو محطّة ثانية من محطّات رحلة الكشف عن حكايات اللغة وعالمها البهيّ. أوليست اللغة لعبة، وللعبة أصول، وقيمة الكلمة تبرز من خلال موقعها، وشبكة علاقاتها في الجملة، فيتّضح المعنى؟! واكتشاف أهمّيّة السياق وعلاقة الكلمات بعضها ببعضها الآخر داخل الجملة يعود فضله إلى مؤسّس علم اللغة الحديث فرديناند دي سوسير المتعلّق بالتشبيهات لإيصال المعنى، وقد شبّه الكلمة، في دورها وقيمتها، بالبيدق في لعبة الشطرنج؛ ذلك تحت عنوان: «ولادة كتاب دي سوسير» (الكتابة على جلدة الرأس)، وهذا ما أخذه عبد الهادي عنه، عشقه للتشبيهات التمثيليّة.
في تقنيّات حبك النّصوص المنفصلة- المتّصلة، جاء الكتابان إجابة عن سؤال مفاده: كيف تتحوّل دروس الصرف والاشتقاق واللسانيّات، إلى حكايات ممتعة وتشبيهات تجذب المنصرف عنها لجفافها، ولصعوبات يلقاها في سبيل تعلّمها؟ وكيف تُقدّم تاليًا، اللغة طازجة، وقد خرجت من بين دفّتي المعجم، على مائدة تعمر بتشكيلات تغدو مجال خبرة حيّة لحواسنا؛ فلا نتذوّق صنوفها وحسب، بل نسمع ونشمّ ونلمس ونبصر جماليّاتها؟ ألم تخرج كلمتا «أدب» و«مأدبة» من الرحم/ الجذر اللغوي نفسه؟ أوليس اللسان أداة نطق وتذوّق أيضًا؟ يسأل الكاتب تحت عنوان: «مآكل لغويّة» (لعنة بابل)، مقتبسًا كلامًا لأحد النحويّين العرب القدامى «إنّ النحو في الكلام كالملح في الطعام»؛ فحسن الاستخدام ينجّي «طبخة» النّص من أن تفسد. وفي حديثه عن اللسان أيضًا، يعقد صلات القربى اللغويّة والصّوتيّة بين فعلَي «قَطب» و«كتب»، بوصف الكتابة، لغويًّا، رتق الذاكرة المفتوقة، وهي خياطة وتطريز، ونقول نسيج النصّ. كما يشير، في نصّه المعَنوَن: «رتق الذاكرة وفحولة اللسان» (لعنة بابل)، إلى العلاقة بين الكتابة والجنس؛ «فاللغة لها رحم، وعُضوا النَسل واللَّسْن متشابهان، وما الكتابة إلّا وسيلة لحفظ نسل الأفكار».
خمسون نصًّا في«الكتابة على جلدة الرأس» يُضاف إلى ستين مماثلًا في السياق والأسلوب والرّؤية في «لعنة بابل»، بعناوين مدهشة من معجم الحياة اليوميّة للإنسان، وعلى صلة بحواسه وذاكرته، ومأكله ومعتقداته الدينيّة، ومحيطه الجغرافيّ وأدواته، وموروثه الثّقافي، ومن غير إغفال لما يزكي اللغة العربيّة من توليد ونحت، لمواكبة مستحدثات العصر. هي حكايا الإنسان في مطبخ اللغة! فقد نبش صاحب النّصوص في أمّهات الكتب من تراثنا العربيّ، بحثًا عن حكايا اللغة، فضلًا عن روافد غربيّة معاصرة؛ ذلك يعني أنّ ما وُضع بين أيدينا معين ثقافيّ عميق في التاريخ، وممتدّ في الجغرافيا.
يتناول الكاتب في نَصّي «الحرف الّلاتيني في عصره الذّهبيّ» و«دفتر الفَسبَكة ومَعشَر الفسابِكة» قضايا راهنة، تعود إلى مشكلة الحرف العربي إزاء الحرف اللاتيني، في استخدام التطبيقات الإلكترونيّة، والحاجة إلى إطلاق التسميات على المسمّيات. ومنكرًا على الكاتب المصري سلامة موسى (1887-1958) قوله: «لن تُستَعرَب العلوم إلّا إذا استَلتَن الهجاء العربيّ (أي صار لاتينيَّا)»، ليعلن موقفه بأنّه في فترات المحن تتزعزع الثقة باللغة وبحروفها، فيعقد مقارنة مع اللغتين الصينيّة واليابانيّة، وكيفيّة تجاوزهما محنة التعامل مع الكمبيوتر ومتطلّباته. «فالأبجديّات تنتعش وتذبل كما الحضارات»، قائلًا إنّ من سيحدّد مصائر الكلمات هي الانترنت [مقترحًا إطلاق تسمية” الشابك”، بالتذكير، على شبكة المعلومات الدوليّة] لا مجامع اللغة إلّا إذا انصاعت لأمر الانترنت.
هكذا، يبدو الكاتب شديد المرونة والواقعيّة والانفتاح على علوم العصر، فموقفه منها يبتعد عن التشاؤميّة والرّفض غير المبرّر لدى البعض، ويعبّر تحت هذا العنوان: «لا تلعن الانترنت» (لعنة بابل)، قائلًا: «إنّ من يفضّل القراءة الورقيّة على القراءة الرّقميّة كمن يفضّل السّيّارة على الطّيّارة، ولكنّ حياة العالم، اليوم، لا تكتفي بالطيّارة ولا تستغني، حكمًا، عن السيّارة». ويورد مثالًا طريفًا في سياق إظهار علاقة أحداث التاريخ المتوتّرة مع كل جديد، فيحّرف بعض الرّافضين لفظ “تلفزيون” إلى “مُفسِدْيون” لإبداء رأي سلبي فيه. وعن براغماتيّة اللغة، يقول في نصّه: «قاموس» (لعنة بابل) إنّ الكلمة تملك سيرة حياة حافلة، تغيّر مسارها أو تتمرّد على معنى ارتبط بها فتخلعه كما تخلع الأفعى جلدها وتلبس جلدًا آخر- معنى جديدًا. لذا، تبدو الحاجة ملحّة إلى معجم عربيّ «يحفظ للأمّة أَمْنها اللغوي»، مقتبسًا من مقدّمة «لسان العرب» لابن منظور قوله، بما يشبه الإنذار إلى أمّته، السّفينة أو الطوفان: «جمعت هذا الكتاب في زمن أهله بغير العربيّة يفخرون، كما صنع نوح الفلك وقومه منه يسخرون».
ربما يكون من سوءات الإنسان، في مرحلة من مراحل تطوّر حضارته، فصل العلوم فصلًا قارًّا، ومن سبل استنارته، مقابل ذلك، عودته إلى فهم أيّ علم ومصطلحاته في ضوء علم آخر. هذا المفهوم يوجد له تجلّيات وإشارات عديدة على مدار النّصوص، لا سيّما في «كرواسان» و«مطبخ ابن الرومي» (لعنة بابل) و«البيولوجيا والحكاية»(الكتابة على جلدة الرأس). ولعلّ أبرزها حديثه عن جهود العالم الأنثروبولوجي الفرنسي كلود ليفي ستروس، قائلًا إنّه من أطرف الدراسات تلك التي تدلف إلى الحضارات الإنسانيّة عبر دراسة الموائد العامرة بأطايب القصص. وقد قام بذلك ستروس، باحثًا في أكل الناس وطرائق وضع الأطباق على الموائد، مستخرجًا من ملاحظاته «المثلّث الغذائيّ»، النّيّء والمطبوخ والمعفّن، بوصفه العمدة في تباين الحضارات والثقافات. متابعًا بأنّ الأكل يصبغ الحضارات؛ فالحضارة التي نعيشها يطلق البعض عليها تسمية «حضارة الفاست فوود».
إذا كان ابن الرّومي شهيرًا بحبّه لمعدته، ويتلذّذ بوصف الأطعمة في قصائده، باعتباره الطعام نصًّا فنّيًّا يجب إتقان كتابته ووضع النقاط والحركات على مفرداته، فإنّ بلال عبد الهادي يصحّ فيه ما جاء من نقد ابن رشيق للشاعر المذكور، إذ قال في كتابه «العمدة»: «إنّه يقلّب المعنى ظهرًا لبطن فلا يترك زيادة لمستزيد». وباستعارة الكاتب نفسه، فهو «يقحّط صحنه على الأخير»، ذلك لولعه بالتفاصيل.
الاستمتاع بقصصِ اللغة – لغتنا واللغات بشكل عام- هو مغزى هذين المنجزين. وقصصُها هي حكايانا، وما يَمسّنا في وجداننا وطرق عيشنا، ويُضفي أبعادًا أخرى على معنى حيواتنا، ويجعل اللغة نفسها، نابضة بالحياة، تتنفّس ذاكرتها بصور ذات دلالة على وجودها وبقائها. هذا المغزى يحيلني إلى الاستدلال من العهد الجديد على أهمّية القصة والمَثل، علّنا نعتبر ونفهم. فقد جاء في «إنجيل متى» أنّ يسوع المسيح، حين سأله تلاميذه:«لماذا تكلّمهم بأمثال؟»(متى13: 10)، أجاب، وقال لهم: «من أجل هذا أكلّمهم بأمثال، لأنّهم مبصرين لا يبصرون، وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون» (متى13: 13) .. «لأنّ قلب هذا الشعب قد غلظ، وآذانهم قد ثقل سماعها» (متى 13: 15).
يبدو لنا أنّ دلالة العنونة لكتاب «الكتابة على جلدة الرأس» قد جاءت في سبيل الجزع الاستباقيّ، بعد مفهوم «بَلبلة اللغات» والخشية منها في دلالة عنوان «لعنة بابل»، بالتماهي مع قصة المملوك جابر الذي دفع رأسه ثمن عدم قراءة رسالة حفرت على جلدته، وقد كان ساعي بريد أعمى لا يرى ما يحمل، بتعبير صاحب الكتاب، حين أدّى الرأس دور الورقة، وهو جزء عضويّ من المملوك. هي خشية على أمّة تحمل طيّ لغتها إرثًا ثقافيًّا وجماليًّا وتاريخًا من القصص والأخبار، ولا تبصرها، الأمر الذي قد يودي بهما، الأمّة واللغة معًا، إلى مصير مماثل لمصير رأس جابر ناقل رسالة ابن االعلقميّ، وزير الخليفة المستعصم، إلى المغول لتسهيل أمر دخولهم مدينة بغداد- مدينته… وعسى ألّا «تتبلبل» لغتنا.