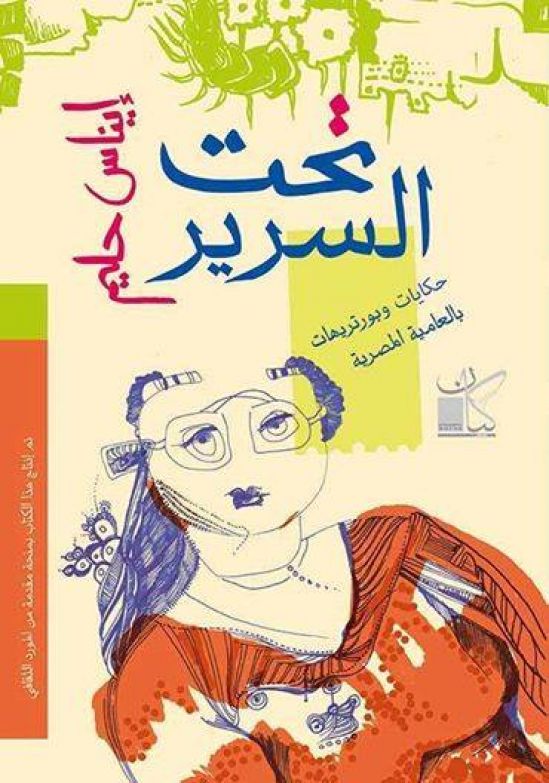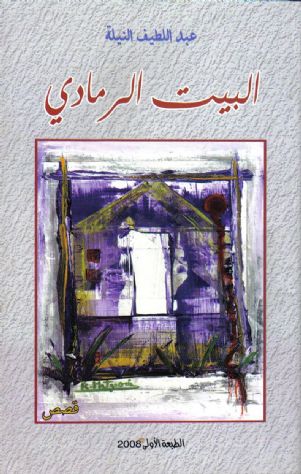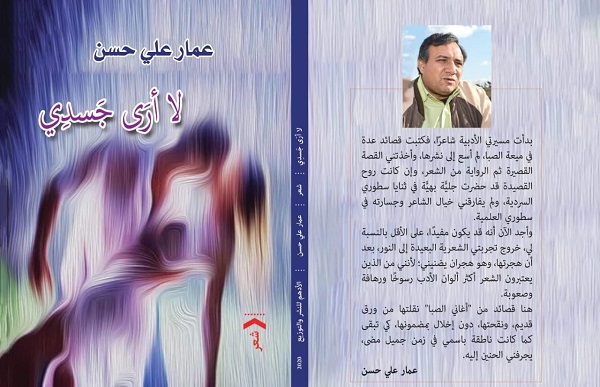كان ياسر في مروره المباغت يرسم على وجهه ملمحا مشتركا من الجدية واللامبالاة، وابتسمت لمرآه كما هي العادة حين أراه دوما. لاحقا أدركت أن ياسر عبد اللطيف هو الذي قام بكتابة سيناريو هذا الفيلم، وبدا مروره في تلك اللقطة العابرة كأنه توقيعه الضمني، الموثق بالصورة، على إبداع الفيلم.
أظن أن نصوص ياسر عبد اللطيف، نثرا وسردا وشعرا، فيها هذا الملمح. الكاتب الشبح، الذي تظهر صورته كطيف شبحي يومض خافتا خلف السطور، أو ربما تُسمع نبرة صوته أحيانا. ليس لأن أغلب نصوصه تشكل مزيجا من سيرة ذاتية تخييلية فقط، وتمتح من مادة الواقع عبر الذاكرة في غالبيتها. بل وأيضا وربما أساسا لأن الأسلوب الفني الذي يستخدمه له علاقة ما بشخصيته، في اختيار المفردات اللغوية الخاصة جدا، وفي وصفه لبعض الشخصيات والمواقف بطرافة. وفي الكوميديا التي يفجرها أحيانا وكأنه يقول نكتة يبتسم ابتسامة خافتة وهو يلقيها، ولكنه لن يطلق ضحكته الرنانة التي تشبه السعلات المتقطعة إلا أن بعد أن تدوي ضحكات مستمعيه.
كان لافتا بالنسبة لي في رواية ياسر الأولى؛ قانون الوراثة، الغياب المريب للأنثى في نص يبدو فيه الراوي متتبعا لجذوره، على نحو أو آخر، مشاكسا التاريخ والذاكرة، تاريخ العائلة، وذاكرته الشخصية.
ويبدو أن نصه القصصي الراهن، جاء ليرد، على نحو أو آخر، على تلك الثغرة من خلال تتبع الذاكرة لنماذج من الفتيات اللائي خلدتهن ذاكرة الصبا والمراهقة. نماذج مختارة بعناية، لفتيات قابعات في ركن ما من أركان الذاكرة، حيث تتغلف ذكراهن إما بضباب الرومانسية، أو بغبار عواصف الشبق.
لكن الفن هنا يتمثل في أن اختيارات ياسر أو التقاطات ذاكرته تبدو مختارة بعناية، لأنها ليست مجرد حالات من الحنين الرومانسي إلى الماضي، أو النوستالجيا لزمن يبدأ أحيانا مع بدء عمل الذاكرة في الطفولة البعيدة، ونفض الغبار عنه، بقدر ما تبدو التقاطات تكشف كيف تكون كلمة قيلت بعفوية من طفلة في عمر الخامسة، مثلاً، لطفل في عمرها، لها من السطوة تأثير يمتد على عمر العقل الواعي في نضوجه بحثا عن معنى الكلمة المبهمة. وأحيانا تتحمل الالتفاتة المختارة من مخزن الذاكرة بدلالة قوية عن العلاقة الغامضة التي تربط المشاعر العاطفية بالشفقة، والاكتمال العاطفي بالنقص أو العجز الجسدي.
الوصف لدى ياسر به مزيج فاتن من الكلاسيكية والحداثة، بمعنى أنه يبدو وصفا تفصيليا يدقق في التفاصيل، لكنه لا يستخدم جملا طويلة، بل يستبدلها بجمل صغيرة محملة بالدلالات البصرية والمضمونية معا. ربما لذلك علاقة بالشعر من حيث القدرة على الاختزال أو التكثيف. لكنه في نفس الوقت يحافظ على قدرة السرد في فك البصري وتحويله بالكلمات أبنية وعمارة وألوان.
لكن عودة للاختزال والتكثيف البديع أذكر على سبيل المثال أنه في “قانون الوراثة” كان يصف مشهدا لمظاهرة في الجامعة في الثمانينات موضحا “الذقون غالبة”، وهكذا ببراعة رسم التواجد الإخواني المسيّس الغالب في الجامعات المصرية بهاتين الكلمتين.
في كتاب “يونس في أحشاء الحوت” يعود لحيلته ربما بشكل أكثر تمكنا كما يفعل مثلا في نص “حلم ليلة حرب” إذ يصف المشهد في بداية النص قائلا:” في زحام كأنه الخروج الكبير؛ خروج اليهود من مصر. المنازل جنة العسل واللبن، والمدارس بقسوتها صحراء سيناء اللاهبة. تدافع بالمناكب، راكبو دراجات وأغلبية من المشاة، وفي قلب المعمعة لمحتها، كانت تتعثر في عاهتها وفي خجلها منها؛ زهرة يانعة في الثالثة أو الرابعة عشرة على الأكثر، تظلع من عيب خلقي بساقها اليمنى أحالها إلى قصبة نحيلة ضامرة”.
أحيانا يمتد الوصف إلى تشريح نفسي وكاشف لحالة ذهنية تعبر عن هوية محددة كما في قصة يونس في أحشاء الحوت ويأتي فيها :”ثمة عبارة أخرى مكتوبة بخط مرح تقول (غُص في الأعماق دون أن تبتل ملابسك). قلت هذه هي لعبتي؛ الغوص في الأعماق (على الناشف) يناسب متسكع من الشرق على شاكلتي بروح سقيمة ومزاج قلوي ينحو باتجاه النزوع الأبولوني حتى في قلب الكرنفال”.
والنتيجة أن الوصف في أغلب نصوص المجموعة يبدو لي ناصعا، وساطعا، وشديد الدلالة.
مما يلفت الانتباه أن استخدامه للذاكرة الشخصية يبدو أحيانا متكئا لإضاءة سير أخرى، أماكن، بل وحتى كائنات غير بشرية، ونماذج من الشخصيات، بينهن سيدات مسنات غريبات الأطوار، قارئات المستقبل، او بالأحرى المتبصرات به، أو المجذوبات، واللائي تمتد أماكن اللقاء بهن إلى ساحات الصدف الشرعة في الحياة؛ في المدرسة أو الجامعة أو الشوارع أو حفلات البيوت، في القاهرة غالبا، وفي المعادي خصوصا. وأحيانا في بلدة أخرى. وهنا، وعبر هذه النماذج الغرائبية المقتطعة من لوحة الواقع بسكين الفن، يبرع عبداللطيف في إضفاء مسحة غرائبية تمنح النص الواقعي سمتا حداثيا بجعل الواقع غرائبيا فجأة.
من بين تلك النماذج اللافتة، على سبيل المثال؛ زيارة الراوي تحت ضغط صديق من أصدقائه لجدة ذلك الصديق، واصفا غرابة أطوارها ممهدا لدخول النص في مساحة الغرائبي من خلال وصف الشقة الخالية إلا من بيانو عتيق مكسو بقماشة بيضاء، ثم: “لاحظتُ شيئاً يتحرك في أقصى ركن بالصالة الخاوية إلا من البيانو المغطى، فإذا به حمامة بيضاء تسير بحجلة الحمام المعهودة تلتقط حباً من الواضح إنه نُثر لها خصيصاً. لا حظت السيدة أن انتباهنا أنا وشريف قد انصرف إلى ذلك الطائر المسكين، فقالت: دي تبارك أختي. وجدتُ شريف يؤمن على كلامها كمن يعرف تلك الحقيقة مسبقاً. نادت السيدة على الحمامة وقالت: تعالي يا تبارك سلمي على الضيوف. ولدهشتي جاءت الحمامة سعياً من أقصى الغرفة كمن استجاب للنداء، وقفزت إلى كف ها الذي مدته لها قرب الأرضية المتربة”.
هذه اللقطة الفنية واحدة من المشاهد السردية الفاتنة، ليس لفرط الانتقالة الحادة من الواقع للغرائبي فقط، بل وللأسلوب الذي يبدو كمن يلقي مزحة صارخة بوجه بالغ الجدية أيضا. ودليل دامغ على براعة لعبة ياسر عبداللطيف في منح الواقع سمته الأدبي الحداثي، بعلوه عليه وتقديم ما يوازيه مستخدما خامة من خامات الواقع ذاته.
تلقي النصوص الضوء على نماذج عابرة تمثل قطاعات من الهامش، ومن سكان المواقع أو الأحياء الفقيرة، والذين قد يبدون للوهلة الأولى، عبر ظهورهم في النص، كأنهم يخدمون هدفا سرديا وفنيا فقط، لكني أظن أن عدة نماذج من فئات الهامش يقدمون على نحو أو آخر بدور ضمني لا يذكره السرد بشكل مباشر قطعا، لكنه حتما يحيلنا، وربما يدفعنا، إلى رصد مفارقات مدينة القاهرة، كمدينة عالمية تجمع المفارقات وتفسح لأنماط طبقية وفئوية التعايش، حيث تتجاور فيها الطبقات الموسرة بجوار أحياء بالغة الفقر، كملمح رئيس، تفرضه الروح الشعبية والاحتياج المستمر من الطبقات الثرية في توفير احتياجاتها من الطبقات الأكثر فقرا، إضافة إلى أن القاهرة هي المدينة الوحيدة تقريبا التي عاشت المرحلة الكولونيالية من دون أن تقوم فيها الطبقة الاستعمارية الأجنبية بالسكن في مناطق مسورة ومعزولة ذات طابع ارستقراطي، بل استقرت في أحياء موسرة في وسط المدينة غالبا. ولعل هذه الالتفاتات الفنية الى تقاطعات الهامش الفقير بالأحياء الارستقراطية هي التعبير الأدبي عما فصله جمال حمدان في كتابه عن القاهرة.
نص أمثولة الكلب الأبيض هو واحد من أجمل ما قرأت من نصوص، لأنه نص حديث يجمع الحكاية التقليدية من حيث المضمون ويمزجها بحكايات الحيوانات، أو وللتحديد لعصابات الكلاب، كما يسميها السارد، بحيث تصبح هذه الكلاب هي أبطال النص الذي يرصد قدومهم من الأحياء المجاورة . وهو نص ما بعد حداثي لقدرته على أن يحمل إمكانات عديدة، فيمكن أن يقبل كسيناريو لفيلم من أفلام الرسوم المتحركة، كما يشير المؤلف نفسه تحت عنوان القصة، ويصلح قصة سردية بليغة ومحكمة لا تخلو من الطرافة. وهو أيضا أمثولة تعود ربما في جذرها لقصص ابن المقفع، لكنها في الوقت ذاته عصرية وحديثة بامتياز.
الكتاب يقدم المفارقة الإنسانية بحس ساخر، ويمزج الواقع بالحلم أو الخيال حتى يختلطان، وببراعة كبيرة كما في نص “ترتيب الأرفف” الذي تنتهي به المجموعة فيما القارئ لا يعرف أن يرتب رفوف ما قرأه بين الحلم وبين الواقع. وأخيرا وليس آخرا، تبدو أشخاص وأبطال ونماذج الذاكرة وكأنها تنتفض من سباتها لكي تؤدي تلك المشاهد المستحضرة من أزمنة غابرة، لتلتقي مرة ومرات، رغم تباعد المصائر، كأنها دلالة أخرى من دلالات هذه النصوص على أن ذاكرة المكان وذاكرة البشر مهما اتسعتا فهما يعبران عن عالم صغير، تتقاطع فيه مصائر البشر بالصدفة حينا وبالقصد والتعمد أحيانا أخرى، ومهما اتسعت عوالم البشر تظل أسئلتهم الوجودية قريبة وربما متماثلة، لكن الاختلاف فقط في كيفية كل نموذج بشري في التعبير عنها بطريقته التي قد لا يشاركه في بصمتها أحد.