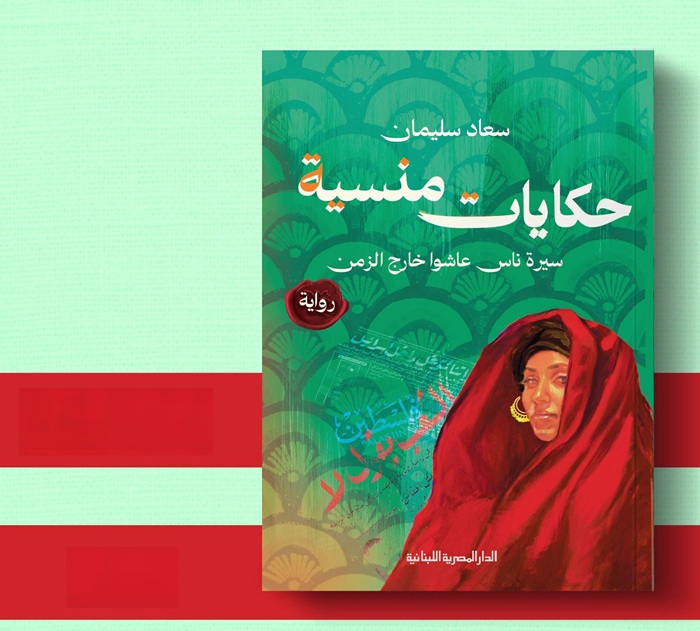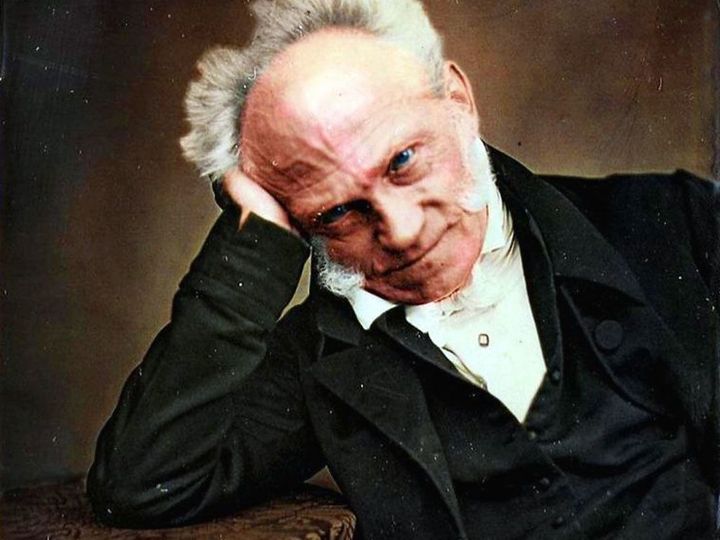ممدوح رزق
يمكننا تحديد قائمة من الأداءات “التخييلية” التي تضمنتها مجموعة “العالق في يوم أحد” للكاتب عبد الله ناصر الصادرة حديثًا عن دار التنوير، من حيث كونها تتسم بنوع من الثبات المتعمّد والتكراري، وهو ما يكاد يمثّل استراتيجية سردية عامة لقصص المجموعة .. ستشتمل هذه القائمة على: إضاءة التماثل .. التحريف البنيوي .. التبادل .. تغيير الوظائف .. تثبيت المتناقضات .. كسر التراتبية .. تعطيل المنطق.
“ما عدت آمن كل الأخشاب في بيتي: الطاولة، والكراسي، والمكتبة، والخزانة، حتى السرير، أحلم أنه ينطبق عليّ فأختنق وأصحو من الهلع حتى صرت أنام مؤخرًا على السيراميك، قد يكون باردًا ولكنه آمن. عندما أخرج إلى العمل صباح الغد، سأقفل الباب مرتين، ولن تنجو تلك الأخشاب من النار التي سأضرمها في البيت”.
هذا على سبيل المثال، ولكن ما أراه جديرًا بالتمعّن عند مقاربة هذه الأداءات يتلخص في ثلاث أفكار: الأولى أن هذه الأداءات لا تمنح ما نعتبره “العادي” طبيعة مختلفة، أي لا تكسبه غرابة مستقلة لم تكن تنتمي إليه، وإنما تكشف عن وجوه “ضمنية” أخرى تساهم في تكوين ما يُنظر لها كحقائق للموجودات، ملامح كامنة في المألوف وليست إضافات خارقة له.
الفكرة الثانية أن الظواهر الناجمة عن هذه الأداءات، والمتعلقة بما هو خارج الذات ليست انعكاسًا للوعي الذي يمارسها، أي أنها غير خاضعة لإرادة متعالية تخص الجسد المنتج لهذه الأداءات، وإنما امتثالًا لجوهر الأشياء الذي يسبق تجسّدها، وبالتالي تمتلك حقائقها الخاصة التي تتجاوز توقعات الذهن الذي يتصوّرها على نحو معيّن .. بمعنى آخر تتخطى الكيانات غير البشرية كل ما يمكن أن يكشفه “التخييل” من إمكانات مخبوءة في حضورها التقليدي.
الفكرة الثالثة أن هذه الأداءات لا تسعى إلى إعطاء الرسوخ للذوات والأشياء المكتشفة، أي إلى دعم الاستقرار لصور الوجود التي تتخذها وإنما إلى تبديدها، إلى ملامسة الفراغ المفترض وراء حضورها الذي يتعدّى دائمًا ما يبدو عليه .. الحضور الذي يمكنه أن يتحوّل إلى خلاف ما نعهده باستمرار .. كأن الأداءات تسعى لتفتيت المراوغة طمعًا في الوصول إلى نوع آخر من المرايا .. مرآة كفيلة بأن تعكس ذلك الغموض الذي لا يُرى أو يُدرك، ومن ثمّ جعل هذه الذوات والأشياء تنوب عنه .. المرآة الكلية التي لن تعكس أصلًا مطلقًا إلا لو كانت فراغًا.
“ولأن الذبابة كانت تطير بسرعتها القصوى لم تستطع تفادي تلك الجمجمة، التي قضت عليها لحظة الارتطام. وعندما التفتت الرصاصة، راعها ذلك المشهد، وقررت أن تكون من الآن فصاعدًا أكثر حيطة وحذرًا فلا تبتعد كثيرًا عن النفايات”.
ما الذي يعنيه “التخييل” إذن وفقًا لهذا؟ .. إنه أشبه بالحدس المضمون، الذي لا يخترع الأعاجيب ـ أو كما تبدو هكذا ـ وإنما يحدد مواضعها في ما هو بديهي .. لا يؤلف الاستثناء كحالة منفصلة عن الطبائع النمطية بل يظهره كجزء متداخل في تركيبها .. التخييل هنا هو توسيع متواصل لمساحة الصواب التي لا يمكن دحضها لمجرد أنها عاشت حياة سابقة من التواري المحكم .. لكنه الصواب الذي كلما تمدد، كلما امتلكت تفاصيله القدرة على التودد إلى غيابها، أي استثمار قابليتها لأن تكون أي شيء غير ما هي عليه بالتعبير الهيدجري، كي تحاول إزاحة العتمة عن الشيء الوحيد “الغيبي” الذي يضمن لها أن تظل كذلك، في مقابل أن هذا الشيء الوحيد المبهم لا يمكنه أن يكون إلا نفسه.
“بدا أن هؤلاء البشر لن يتوقفوا عن قتل بعضهم البعض، إذ لا مناص من أن يكون أحدهم قابيلًا آخر أو هابيلًا آخر. كانت الغربان المذعورة تتناقص بينما يتضاعف عدد النوارس حتى ما عاد القتل يُفزع أحدًا، بل لقد صارت الغربان تتلذذ بالتهام القتلى. لو نظرت الآن إلى أي غراب لوجدته يشتهي أن ينقر عينيك الطازجتين”.
ما يتم تداوله كفروق مؤكدة بين الموجودات يحوّله عبد الله ناصر إلى إثباتات للتطابق، وبالتالي يكون الاختلاف هو هيمنة من الادعّاءت المتغيرة التي تحاول الكينونة بواسطتها أن تتحرر خارج ورطة التشابه .. لكن هذا يؤكد أيضًا أن الذات لا تمتلك ما يُشكّلها، أي لا تحصل على اليقين استنادًا إليه، بما أن الأشلاء التي تكوّن بنيتها تمزج بين المتضادات، وتنطوي على النقائض لتُجسّد تماثلها الحتمي مع الآخرين العالقين في الضرورات نفسها .. لهذا تتناول قصص المجموعة هذه الأشلاء كاحتمالات طائشة في لعبة ترتكز “إعجازيتها” على الانفلات المؤبد للماهية مع كل لحظة من الخلق الظاهراتي البريء، أو العفوي مثلما أبصر غاستون باشلار بالتأمل الشارد شاعرية العالم .. الحفر في جميع الظنون المحقة طوال الوقت مهما كان تنافرها مع “المعقول”، لبلوغ الأشياء في نقائها السري .. كأن عبد الله ناصر يحوّل الأجساد والأماكن والأزمنة ـ كرهان فينومينولوجي ـ إلى صور شعرية تكشف عناصرها الأولى، أو منطلقاتها الأساسية ـ كما أراد باشلار إعادة خلقها ـ خارج عماء المفهوم، أو القمع الاختزالي للسياق الذي يستهلكها.
“ساقي اليسرى سليمة تمامًا ولكنها ليست لي هي أيضًا، حتى هذا الوجه المستطيل الحاد، جسدي كله ليس لي، حتى الاسم والعمر والوظيفة والحالة الاجتماعية كذلك، كلها تخص أخي الذي يصغرني بعشرة أعوام”.
على جانب آخر يمكننا التفكير في أن الأداءات التخييلية تكشف أثناء قيامها بالمهام السردية السابقة؛ تكشف عن نوع من التشابك فيما بينها .. إنها تجعل من التماثل أو الطمس القدري للفردية في قصة “متواليات” كأنما يحلم بالحب الذي لا يشبهه آخر في قصة “تكامل” مثلًا .. كذلك صفعات الأبواب في قصة “اللذان لا يستطيعان الخروج” كأنها توصيف أو تشريح للتوأمة بين هابيل وقابيل في قصة “التوأم” أيضًا .. إنه كنسيج داخلي للعالم، أو التاريخ يبوح بالمزيد من ملامحه الفعلية، وتناسلاتها، حيث العالق في يوم أحد يختبر هذا حقًا كزمن الباطن، الواقعي، لا المجازي، دون مبالاة بتمنّعه المؤقت عن الإدراك في وعي الآخر .. في تصوّر الغريب عن التجربة الذي لا يمكنه أن يلحظ مثلا خوفك من النظر إلى المرآة، كما في قصة “الآخر”، قبل أن يصل بنفسه إلى هذه اللحظة التي يخاف فيها من أن يلتقي بـ “الرجل الذي خرّب حياته” .. بالكيفية ذاتها سيكون الإبصار من الخلف أمنية لذلك الذي يخاف من النظر في المرآة؛ فذلك الذي يسير إلى الوراء في قصة “الذي يبصر من الخلف” ربما يكافح لفهم المسار الذي قاده نحو الخوف من لقاء الرجل الذي خرّب حياته، وهذه القصة تذكرني بقصة “ماريا نكوبولوس” من مجموعتي القصصية “مكان جيد لسلحفاة محنطة” 2013، حيث الشابة التي أظهرت في طفولتها القدرة على المشي بظهرها دون أدنى مشكلة، ودون مساعدة من أحد حتى في الأماكن الغريبة عنها التي لم تذهب إليها من قبل لدرجة أنها اشتهرت بلقب “الفتاة ذات العينين الخلفيتين”، فضلا عن استطاعتها صعود السلالم ونزولها وعبور الطرق المزدحمة والقفز والجري بسرعة كبيرة على هذا النحو .. في قصة “الذي يبصر من الخلف” ـ المغايرة عن قصة ماريا في التفاصيل والأحداث واللغة ـ يتفق بطلها “المبصر من الخلف”، الذي كأنما يسير في الماضي مع ماريا نكوبولوس “التي كانت يعتمد نجاحها في المشي بهذه الطريقة على إحساسها الخاص”، حيث “كان يعتبرنا أسوأ حالًا من العميان، إذ ما قيمة العيش حين لا نستطيع رؤية ما خلفنا”، بينما كانت “ماريا” تقول في القصة “بأن الحياة كان من الممكن أن تكون جميلة حقًا لو أتيحت لكل إنسان القدرة على التفحص الدائم للنقطة التي ينطلق منها تحركه داخل العالم، وأن المشي بالظهر حينما يعتبر معجزة، فهذا دليل على بشاعة النوايا التي وقفت وراء الوجود البشري لأن الغيب لو كان يريد بنا خيرًا لجعلنا جميعًا قادرين على المشي بظهورنا”.
بالعودة إلى غاستون باشلار؛ يحتل “التقمّص” مكانة رئيسية في تناول الصورة الشعرية لديه، أي استدعاء حالة “المبدع” لكي تصبح هذه الصورة خاصة به، لها جذور في داخله، وبالضرورة تصبح وجودًا جديدًا في لغته .. فإذا كان عبد الله ناصر ـ كما سبق وأشرت ـ يحوّل الأجساد والأماكن والأزمنة إلى صور شعرية؛ وجب التفكير في ذلك الذي “يتقمّصه” بينما يقوم بذلك .. الفراغ الذي يطغى وراء الذوات والأشياء .. المرآة التي تعكس الغموض .. الأصل المطلق الذي جعل هذا الحضور المراوغ للعالم ينوب عنه .. هذا التقمّص تحديدًا هو ما يفسر “المرح” السائد في المجموعة، الذي يتجاوز الحس الفكاهي في عدد من قصصها .. المرح المعادل للذة الخلق الديناميكي للأجساد والأماكن والأزمنة مثلما يكون عليه الأمر تمامًا للصور الشعرية .. لكن المرح لا يتعلق بالخلق فحسب، وإنما أيضًا ـ وربما بشكل أقوى ـ بالوعي بغياب الفروق بين الموجودات، وعدم امتلاك الذات لما يُشكلها، والانفلات المؤبّد للماهية، والرغبة في تبديد ما يتم اكتشافه كمحاولة لإبصار الشيء الوحيد المبهم الذي لا يمكنه أن يكون إلا نفسه.