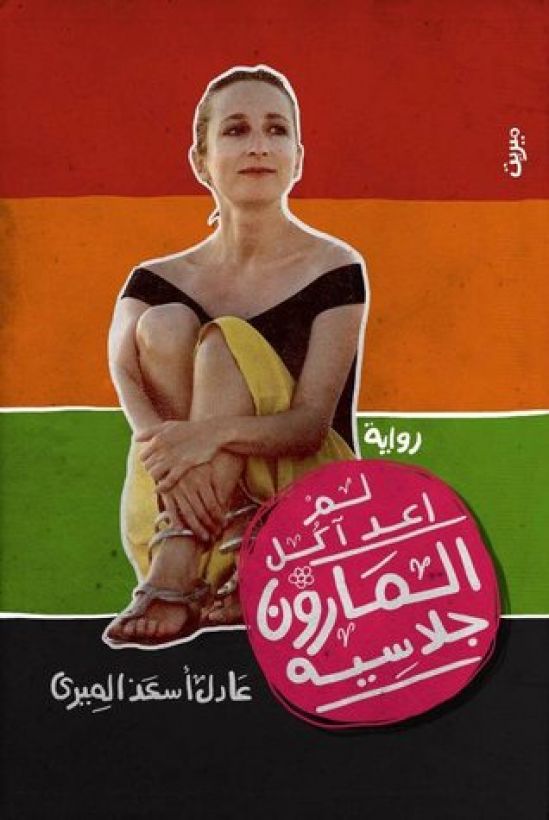محمد عبد النبي
سِكّير متشرد يقاوم إدمانه الخمر، مرةً بعد أخرى، في محاولة يائسة للوفاء بنَدر ديني نحو قدّيسة تعهدَ به لرجل طيب أعطاه بعد المال. وناظر محطة ربّ أسرة صالح يُفتَن بسيدة روسية رآها بالمصا دفة بعد حادثة قطار في محطته فيهجر حياته الهانئة بكل ما فيها ومَن فيها ليتطوّع في الحرب العالمية الأولى ضد روسيا ويفعل المستحيل إلى أن يصل إليها ويكسب قلبها. هذان هما بطلا الروايتين القصيرتين اللتين صدرتا مؤخرًا عن دار المحروسة، في كتاب صغير وجميل، وبترجمة جيدة للأستاذ حسن الحديدي؛ وهو كتاب سَردي يستعيد انتباهنا إلى شكل النوفيلا المغبون الحق وسط اكتساح وهيمنة الروايات الطويلة، كما قد يكون أوَّل ما يُنشَر لكاتب مُهم لا نكاد نعلم عنه شيئًا، وقبل هذا كله يمجد الإنسان العادي في ضعفه وهشاشته وأشواق روحه.
جوزيف روث، (أم على الأصح: يوزِف روث؟)، روائي وكاتب صحافي نمساوي (1894-1939)، وُلدَ في مدينة صغيرة تُدعى برودي [أوكرانيا حاليًا]، وكانت ضمن الحدود الشرقية للإمبراطورية النمساوية المجرية قبل تفككها. لعبت الثقافة اليهودية دورًا كبيرًا في تكوينه نظرًا لأعدد السكان اليهود الكبيرة في هذه المدينة، وقد عُرفَ بكتاباته الأدبية عن حياة العائلات اليهودية، وهجراتهم مِن أوروبا الشرقية إلى أوروبا الغربية، في أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى والثورة الروسية. لم تَخلُ حياته مِن انعطافات درامية مشوّقة وانتقالات بين النمسا وألمانيا وفرنسا، وقد تخلَّى في عام 1914 عن مواصلة تعليمه الجامعي، في جامعة فيينا، حيث كان يدرس الفلسفة والأدب الألماني، من أجل أن يتطوَّع في الحرب لخدمة جيش الإمبراطورية النمساوية-المجرية، وإن لم يتعدَ موقعه حسب بعض المصادر المراسِل الصحفي الحربي، لكن تلك التجربة تركت أثرًا مستديمًا على حياته، بنفس قدر انهيار الإمبراطورية التي انتمى إليها ودافعَ عنها، وهي اللحظة التي وسمت بداية حياته شريدًا منتقلًا، ذلك التشرد الذي ظلَّ نغمة أساسية في أعماله اللاحقة، وقد كتب عن ذلك ذات مرة: “كانت أقوى تجربة عشتها هي الحرب والدمار الذي حلَّ بأرض آبائي، الأرض الوحيدة التي كانت لدي…”. ولعلَّ ترجمة بعض أعماله الأدبية والصحفية إلى اللغة الإنجليزية ونشرها مطلع القرن الحالي سببًا في إعادة الاهتمام به مِن جديد.
صدرت نوفيلا أسطورة السكّير المقدّس عام 1939، أي نفس سنة وفاة كاتبها، الذي يُقال إنه عاش ظروفًا شبيهة بتلك التي كان يعيشها أندرياس بطل العَمل، التشرد وإدمان الخمر والنوم تحت جسور نهر السين في باريس، لكن المؤكد أنه توفي بسبب الإفراط في تناول الكحوليات، لكن ليس قبل أن يبدع أسطورة صغيرة لرجلٍ هش وضعيف، يلتقي ذات مرة بمَن يمنحه مبلغًا محترمًا، من غير أي مقابل، سوى أن يرد الدَين ذات يوم حينما يستطيع ولكن كهِبة دينية في كنيسة باسم القديسة الصغيرة تيريزا دو ليزيو. وكما هو متوقَّع يندفع أندرياس ليشرب، لكنه وقد توفَّر لديه أكثر قليلًا من نفقاته اليومية المباشرة، يبدأ في الالتفات إلى حاله، فيغتسل مثلًا ثم يحلق لحيته، وينتبه إليه رجلٌ ما في مشرب ويكلفه بمهمة المساعدة في نقل أثاثه من منزل إلى آخر، وهكذا يمشي الحال قليلًا، وتتواصل مصادفات لقاءاته بمعارف سابقين ويصاحب فتاة ليوم أو أو يومين، وينفد المال، ثم تتكرر المعجزة، بطريقةٍ أو بأخرى، وهكذا في دورات صغيرة متشابكة، وفي كل مرة يذهب إلى الكنيسة وينتظر انتهاء القدَّاس في البار المواجه لها حتى يستطيع أن يفي بدَينه، لكنه إمَّا يلتقي بسكّير صديق أو يحدث له ما يمنعه من الوفاء بوَعده حتَّى النهاية المباغتة. وصفَ العنوان أندرياس بالسكّير المقدس ليس لأنه اجترح أي معجزة أو نجح في السمو والتعالي على إدمانه وضعفه، بل ربما فقط لأنه لم ييأس مِن باب الرحمة وظلَّ مرابطًا أمامه ولو في بار، وظلَّ يحاول مرة بعد أخرى أن يفيق لنفسه ويفي بوعده للقديسة الصغيرة تيريزا التي تجسَّدت له في مشهد النهاية الجميل.
في الرواية الصغيرة الثانية، مصير ناظر المحطة، قصة حب مِن أعذب وأرق ما يكون، وبطلاها ليسا فتى وفتاة على طريقة روميو وجولييت، بل رجل وامرأة في منتصف العُمر، ولكلٍ منهما حياته وأسرته وبلده ولغته وسياقه، أي أن الحواجز التي بينهما لا سبيل لتجاوزها حرفيًا. بعد حادثة قطار مأساوية، تنقلب حياة ناظر المحطة النمساوي آدم فالميراير، ليس بسبب مسؤوليته عن الحادثة، بل لرؤيته تلك السيدة الروسية التي كانت من بين الضحايا والناجين وقد عرضَ استضافتها تحت سقفه بين أفراد أسرته في البيت الذي يقع بداخل المحطة نفسها. مِن اللحظة الأولى التي رأى فيها يديها البيضاوين الطويلتان ترقدان فوق الفراء، بلا حراك، جثتين رائعتين، نشعر أن مصيره قد ارتبط بها. وحينما تنتهي أيام نقاهتها وتغادر بيته، يشعر أنَّ شيئًا كبيرًا فقدَ في حياته، ثم ترسل إليه رسالة شكر رسمية ومقتضبة، لكن تذكر فيها اسمها كاملًا (آنيا فاليفسكا)، “هكذا كان التوقيع. لطالما كان يتشوَّق إلى معرفة الاسم الأول للمرأة الغريبة الذي لم يجرؤ أن يسألها عنه أبدًا، كما لو كان اسمها الأوَّل هو أحد مفاتنها الجسدية المستورة. والآن، بعد أن عرفه، بدا له لبعض الوقت كما لو أنها قد أهدت إليه سِرًا جميلًا.” كان هذا العاشق الحزين بحاجة لنشوب حربٍ عالمية كبرى حتَّى يشق سبيله إلى معشوقته التي لا يكاد يعرف عنها شيئًا، فبوركت الحرب التي أهدته هذا السبيل.
لا داعي لإفساد مُتعة قراءة الروايتين القصيرتين بسرد نهايتهما هُنا، لكن المؤكَّد أنَّ المتعة التي تتسرب من بين سطورهما لا تقتصر فقط على الحبكة البسيطة أو فرادة الشخصية، بقدر ما تنبع مِن أسلوب هذا الكاتب الرقيق الآسر، وتجنبه الثرثرة والإفاضة وتركيزه على الضروري سواء في الحركة الدرامية أو باطن الشخصيات. خذ مثلًا هذه السطور القليلة عن سكّيره المقدس بعد أن قابل الفتاة إيَّاها وفرغا من مضاجعة متلهفة عَجلى، ثم خرجا للحياة يبحثان عن شيءٍ يمكن أن يفعلاه:
“قضيا وقتًا طويلًا في الأكل والشُرب، ثم انطلقا بالتاكسي مرةً أخرى عائدين إلى باريس، ومرة واحدة رأيا أمامهما مساء باريس المتألق. وما كان يعرفان بماذا يبدآن هذا المساء، شأنَ أناسٍ لا يعرف أحدهم الآخَر ولكن الصدفة جمعتهم فجأة. الليل يمتد أمامهما كصحراء تعج بالأنوار. وهما لا يعرفان بعد، ماذا يفعلان معًا بعد الآن، بعدما تهوَّرا وأهدرا بطيشٍ الشيء الجوهري الذي يمكن أن يجمعَ رجلًا وامرأة.”