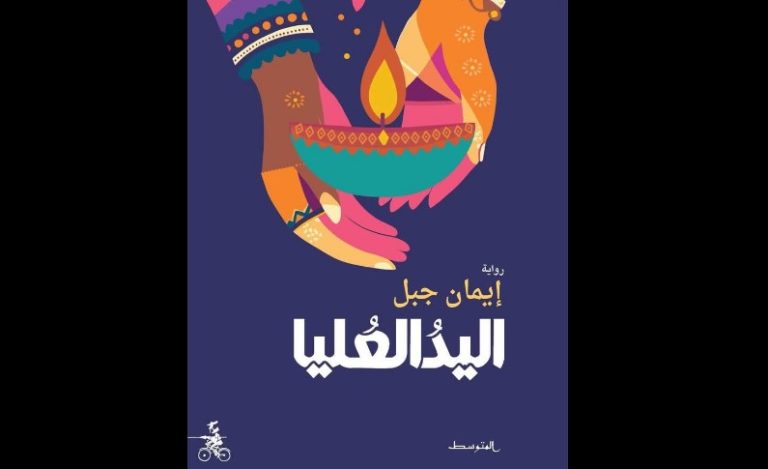آمال فلاح
عندما صدرت رواية “الكاتب” عام 2001 ، اكتشف القراء أن الذي يختفي وراء الاسم المستعار لكاتبهم المفضل-الأكثر قراءة عالميا (عشرة ملايين أو أكثر) – هو ضابط في الجيش الوطني الشعبي الجزائري اسمه محمد مولسهول، وقع رواياته باسم زوجته وبقي مصرا على الاحتفاظ به: “لقد بقيت الجزائر واقفة زمن الإرهاب لأن نساءها وقفن في وجهه، وأكبر شرف لي هو حمل اسم امرأة، فتلك طريقتي الوحيدة لحفظ ماء وجهي والنظر في عيني زوجتي دون خجل.. ثم إنه اسم أحب الناس لدي.”
حكاية هذا الضابط مع الكتابة كانت أكثر من مغامرة كما يحلو له أن يردد. مسار طويل سعى فيه للحاق بقدر سرقه منه الأب (كان ضابطا) ومصير حدده خيار الأب وحده، وحياة ضاعت منه و يعمل جاهدا على استعادتها عبر الكتابة الحلم.
فمن مدينة وهران، إلى تلمسان، إلى المدرسة العسكرية. ومن فقدان عالم الطفولة اللامبالي إلى انهيار الأمان حين تخلى ذلك الأب عن الأم وإخوته السبعة ليلقي بهم في غياهب العوز والحاجة. ومن هجر مدينته وهران “المشعة بالأنوار”، وحيه الهادئ وأشجار الليمون التي طالما ظللته صغيرا إلى احتجاز براءته والقذف به في عالم الكبار الشرس، داخل أسوار ثكنة أو في لجة المسؤوليات العائلية التي أوكلت إليه بعد رحيل الأب.
بيد أن مدرسة “الأشبال” ضمت أيضا ذكريات التضامن، صداقة الرجال وأنغام الأبيات الشعرية التي شكلت الأرضية التي انطلق منها ليكتشف أنه جاء لهذا العالم ليصبح كاتبا، وحسب.
مدرسة “القليعة” العسكرية مثلت أيضا –بفضل بعض أساتذتها- الطريق الجميل للأدب الحقيقي: “لقد انتظرت طوال ست وثلاثون عاما حتى أعيد تشكيل حياتي من جديد عبر الكتابة وحدها، انتظرت منذ أن اختار القدر أن أنتمي لمن يكيلون الضرب للآخرين، لا الذين يقع عليهم الضرب.”
ظلت موهبة الكتابة مختفية في ركن قصي من حياة العسكري الذي شب وشاب في أحضان الجيش الوطني، يكتب في الخفاء ويخشى على نفسه لأن اللازمة الاخضاعية التي كان الضباط يرددونها على مسامع الجنود أن لهم رؤوسا لكي يضعون فوقها خوذة عسكرية، في حين كان هو يردد: “أردد بيني وبين نفسي أن لي رأسا لكي أفكر به”. ومن أجل الحفاظ على الرأس- قبل أن ينقضي العمر- اختار خضرا المنفى الذي قاده لأرض الميعاد، أرض الكتب والكتاب.
 من الثكنة إلى المنفى
من الثكنة إلى المنفى
غادر الضابط ثكنته والموت المعشش على بلده ليذهب بعيدا.. إلى المكسيك عام 2000، ومنها إلى فرنسا. اعتمد على شهرته الوليدة الناتجة عن نجاح رواياته البوليسية ليشق طريقه إلى ما أسماه بالأدب الحقيقي. روايات بوليسية أصدرها الكاتب حين كان ضابطا في الجيش، أهمها “موريتوري”، سبقتها روايات بوليسية أخرى، تمحورت حول الجريمة والعنف وكلها تحت اسم مستعار، اسم امرأة.
نوع غريب عن القارئ الجزائري الذي كان يتساءل وهو يلتهم الروايات التهاما، عن هوية تلك المرأة التي تكتب بتشويق وبلغة فرنسية أنيقة عن الرعب اليومي الذي يعيشه الشعب: “جئت إلى الرواية البوليسية لأتمتع بالحرية التي يمنحني إياها العمل في الخفاء”. سمح له هذا النوع من الكتابة باستكشاف شروح المجتمع الجزائري وهو يغرق في الإرهاب الوحشي، خاصة وأنه كان على احتكاك بميدان الحروب.
ومن”قطيع الإله” إلى “بماذا يحلم الذئاب”(1999)، ظل الكاتب يراوغ محاولا الإفلات من رقابة العسكر وهو يصارع الجماعات الإسلامية في الميدان.
كانت هذه الروايات بسيطة، لا تملك أية ادعاءات، لكنها تحدثت عن شعب كان على حافة الحياة لسنوات، وعن وحشية لم تكن لها سابقة ارتكبتها الجماعات المتطرفة بمساندة أطراف دولية كثيرة. تلك الروايات كان لها، أيضا، مزية خرق الصمت الذي ولده الخوف. كما أنها أصبحت تعتبر شهادات حية عن الأحداث التي عاشها البلد.
في فرنسا، ومع رواية “الكاتب” التي أعلنت عن ميلاده كروائي حقيقي، وبعد معارك إعلامية كثيرة تمخضت بدورها عن إصدار”زيف الكلمات”، توقف خضرا عن الكتابة عن بلده. اتسع أفقه ليكتب –ويجيد الكتابة- عن مجتمعات غريبة عنه.. عن أفغانستان في “سنونوات كابول” لأن “كابول حزينة”، عن العراق في “صفارات إنذار بغداد”، عن فلسطين في “الاعتداء” ثم “فضل الليل على النهار” وغيرها “ليس لهافانا رب يحميها”، “ليلة الدكتاتور الأخيرة”، “المعادلة الافريقية”، روايات تحولت جميعها إلى أفلام.
من فرنسا إلى استيديوهات هوليوود
وكما ساهمت رواية “الكاتب” في الكشف عن هويته: “كانت واجبا وعرفانا بالجميل لأناس قدروني وأحبوا كتابتي وشجعوني على الخروج من الظل”، جاءت رواية “زيف الكلمات” لتصفي حساباته مع الأوهام التي انهارت: “كتبتها لأثبت نزاهتي واستقامتي، والآن وقد فعلت ذلك فإن طموحاتي الأدبية تطالبني بالمزيد من التحفظ لأهدي لقرائي روايات حقيقية”. طموح تحقق مع كتابته لـ”سنونوات كابول” الذي كان بإقراره: “عمل روائي بحت”. تجربة كتابية جديدة، وحديث عن شجون بلد آخر غير الجزائر، وحكاية جميلة لكنها جد حزينة: “ربما لأن المقام لم يكن يتسع للفرح”.
حظيت الرواية باستقبال كبير وتم شراؤها من طرف الولايات المتحدة قبل أن تصدر في فرنسا (دوبل داي)، ومن طرف(هاينمان) ببريطانيا العظمى، ومن (اوفبو) بألمانيا، أي أن حقوق الترجمة لهذه اللغات قد بيعت قبل توزيع الرواية في المكتبات. يقول الكاتب إن عالميته لم تأت عبثا. هي نتاج لجهده ومثابرته واكتمال لعمله المتواصل: “تتشكل الكتابة عندي من 90 بالمائة من الجهد، والعشرة الباقية من الإلهام”.
لكن يبقى من الغريب أن الكاتب الذي حاز على عدة جوائز وعلى اعتراف قراء العالم أجمع… يظل مجهولا عند القارئ العربي. يقول خضرا: “يهاجمني الصحفيون العرب دوما، ويتهموني بالخيانة لمجرد أنني أكتب باللغة الفرنسية”.. لكن الجامعة العربية حين طالبت بمنع عرض فيلم” الاعتداء” المقتبس من روايته، لم يكن ذلك بسبب لغة الرواية بل بسبب موضوعها.
مهما كان الذي قيل ويقال، فإنها لم تكن المعركة الأولى لياسمينة خضرا، فقد خاض من قبل معركة إعلامية عنيفة مع القراء الجزائريين حينما أعلن أثناء العشرية السوداء وبعد مجزرة “بن طلحة”-حيث لم يتدخل الجيش في إنقاذ المواطنين من براثن المجموعات الإرهابية- أن الجيش الجزائري ليس هو الذي يقتل. تصريح جعل الوسط الأدبي الفرنسي يقاطعه وكذا وسائل الإعلام الفرنسية.
على الرغم من ذلك، يصر ياسمينة خضرا أن كتبه تحقق نجاحا عالميا وتضع الروح الإنسانية والحياة نفسها فوق الإيديولوجيات:
“أنا كاتب إنساني ولا حق لأحد أن ينفي وجودي، هذا الكتاب أبهر الناس الصادقين بينما أثار عقيرة البلهاء”. وأضاف: “لأول مرة يتفق العالم العربي على أمر وهو عدم السماح بعرض الفيلم في أية دولة عربية رغم نيله عدة جوائز”.