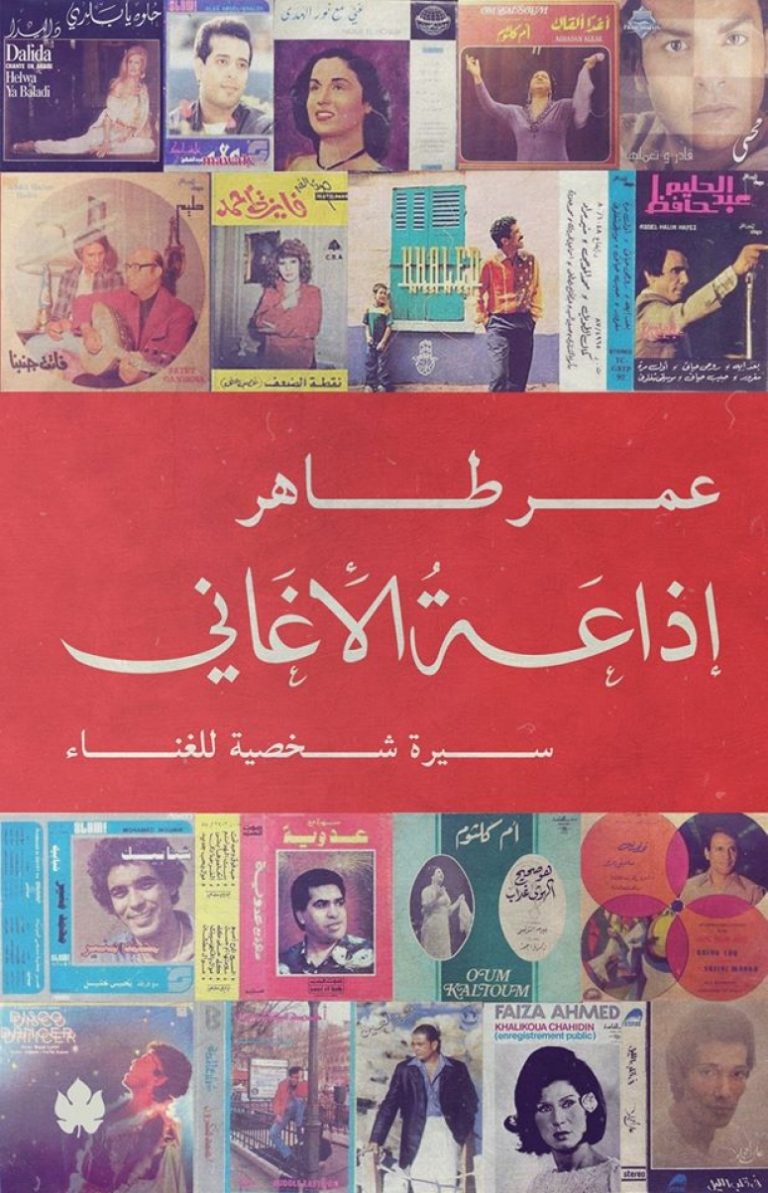نهى محمود
مثل البصل المكرمل فوق طبق شوربة البصل الفرنسية، شريحتي توست محمص بالزبدة والزعتر أو الباجيت بلمسة من الجبن الذائب فوقها.
بصوت قضمة يشبه كرمشة ورقة دونت عليها وصفة طعام بمقادير خاطئة أو فكرة كتابة بدت براقة حتى ذبلت عند تحويلها لحروف.
كالسير في ممر طويل جدا مغطي بأوراق شجر جافة، الصوت ذاته الذي يهمس به قلبي كلما تأذي، أسمعه وحدي وأبتسم، لأني كما أخبرني الطبيب لا يمكنني البكاء بما يكفي وفي الأوقات المناسبة للحزن.
أبتسم، تطفو ابتسامة فوق شفتي، كما يطفو البصل المكرمل في طبق الحساء، تتصاعد أبخرته ويحيطني ضباب شتوي.
كل ذلك يمس قلبي فيحرره، يخرج طاقات الرتابة والموت، تتبدل ليدخل هواء طازج، يكنس أوراق الشجر الجافة لأن العالم طالما استقبل الربيع.
تمتزج ذكريات قديمة سعيدة بدفقة الهواء..
أفكر في “الصدف” والقدر الذي جعلني أفلت يد أمي في معرض الكتاب حين كنت في السادسة، أنتقي لنفسي كتابا، فيكون عن البنت التي تعرف أرنبا وتسقط في حفرة العجائب، وتقابل الرجل ذا القبعة وملكة الكوتشينة.
تصاحبني تلك القصة سنوات طويلة حتى أني احتفظت بها سليمة حتى =سلمتها لصغيرتي، تلك كانت إحدي تعويذات أمومتي، أن أهدي الصغيرة كتابي الأول الذي انتقيته لنفسي، احتفظت به لأجلي ولها ثلاثين عاما، تسبب ذلك وبفطرة الصغيرة لتطاولها المبهج على عالمي وأشيائي، تحمل كراسة وصفاتي وتسألني بمكر متي سأمنحها لها!
وأنا أبتسم ولا أجد إجابة، الصغيرة التي ضبطت ابتسامتي ذات صباح، اعتدت أن أستيقظ قبلها وأراقبها في نومها، أشاهدها كل يوم كأني أراها للمرة الأولى، معجزتي الصغيرة وهي تنام بسلام وسعادة أشعر بها من ابتسامات صغيرة متفرقة تمنحها لي في نومها، فتحت عينها فجأة كنت أتأملها وأبتسم، سألتني بصوت ناعس “بتضحكي ليه يا ماما”. ربّت كتفها ولم أجب.
عندما كنت صغيرة شاهدت مع أمي فيلما – شاهدت كل الأفلام مع أمي، كنا نحصل على خمس جنيهات كل ليلة، نذهب في موكب من الأطفال لمحل تأجير شرائط الفيديو القريب، كل يوم طوال إجازة الصيف نؤجر الفيلم بجنيه واحد واثنين أو ثلاثة للفيلم الجديد، كل يوم نعود بأربعة أو خمسة شرائط نبدأ المشاهدة منذ نهاية فيلم السهرة بالتلفاز وحتى الصباح، مهما اختبرت من متعة في حياتي لن يقترب ذلك أبدا من تلك الذكرى الطويلة الممتدة في قلبي، موسيقى الأفلام، أسماء الممثلين الأجانب وأنا أحاول تعلمها منها تعليقها على الأفلام بعد نهايتها، طريقتها في قص الأفلام والحكايات.. أمي الباقية في قلبي تحمل رايات خضراء للبهجة والسعادة، كرايات أخرى كثيرة تعلمت أن أرفعها وأسمح لها بالتمايل مع دفقات الهواء الذي يكفي أن أوارب له شباك بيتي المطل على حديقة تسكنها الضفادع وتغني لأجلي طوال مساءات الخريف، الحديقة التي زرع لي “أبي” فيها شجرة صغيرة فور انتقالنا للبيت الجديد، شجرة صغيرة أصبحت كبيرة وقوية تخفيني عن عيون المتلصصين وتشعرني أن العالم لي وحدي.
أتذكر اليوم فيلما من مئات الأفلام التي شاهدناها معا عن رجل يحاول أن يخترع جهازا يمكننا من خلاله الإحساس بما يشعر به الآخرين، يضع طرفه على رأس من يختره وطرفا آخر على رأسه، الرجل كان يريد أن يجرب إحساس الموت، لكنه كلما وضع الجهاز في طرف يحتضر، وعلى الناحية الأخرى متطوع، يموت المتطوع هو الآخر.
لا يعود أحد من التجربة حيا ليخبره كيف بدا الموت، ولا انسحاب الروح من الجسد.. أتذكر هذا الفيلم كثيرا كلما قرأت كتابة سيرة ذاتية جيد، أشعر أن الكلمات الجيدة الحقيقية منحتني لمحة جادة عن كل ما شعر به الكاتب، عن الألم الذي يخصه والخذلان، أعيش حياة أخرى وغيرها وغيرها وأفكر أنه بينما حاول بطل الفيلم أن يعرف كيف هو الموت، حاول الكاتب أن يخبرنا كيف هي الحياة.
عاد الفيلم لذاكرتي بقوة بعد قراءة مذكرات أسامة الدناصوري “كلبي الهرم كلبي الحبيب” مؤخرا، احتفظ الكاتب في الكتاب بذاته كاملة وحاضرة ومتألمة، احتفظ لنا بالإبر الطبيبة غرزها في أرواحنا بخفة، نظر في عيوننا وأخبرنا: انظروا كم تألمت، قال كل ذلك بلا ذرة أسي أو رفض بل بشجاعة وتقبل.
احتفظ بنفسه باقية مصانة من المرض والألم والموت. أربت الآن على يد الكتابة وأمتن لها، هي الشجاعة المحبة التي يمكنها أن تنقل كل ما نشعر به ويوجعنا، كل مخاوفنا وأحزاننا وأحلامنا البلهاء، تمنحنا لذة وحيوات كثيرة وفرص جادة لإعادة اختبار كل الاشياء، لإعادة الإحساس بمذاق الذكريات الحلوة، والتفاهم مع لا يمكن حله بالمزيد من التورط في الواقع.
أفكر في كل ذلك وأنا أغرس المزيد من الرايات الخضراء في قلبي، وأدون الوصفات في كراستي التي تنتظر صغيرتي أن تحصل عليها يوما وأكتب حتى تمتلئ الصفحات فتشرق الشمس وأتعلم أن أبتسم هذه المرة ابتسامات حقيقية رائقة منضبطة الإيقاع مع خفق دقات السعادة في قلبي.