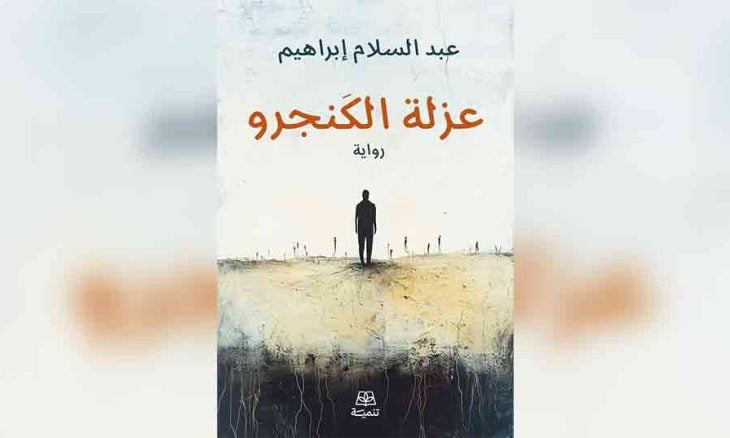شوقي عبد الحميد يحيى
لاشك أن التكنولوجيا، وما قدمته للإنسان من خدمات، تُيَسر له الحياة، إلا أنها أيضا قد زادت من انعزاليته، ووحدانيته التى –غالبا- ما تقوده إلى المرض النفسى، فتكثر الأحلام والهواجس والكوابيس، التى تطارد ذاك الإنسان، فى نومه، وفى يقظته، فكانت أرضا خصبة للمبدع كى تنبت فيها بذرة إبداعه، حيث تُيسر له، تخطى حاجزى الزمان والمكان. وهو ما لجأ له الكاتب “ممدوح رزق”، الذى توحى عديد ممارساته فى القصة القصيرة والرواية والمسرحية والشعر والسينما والمقال النقدى، برغبته فى التجريب، فمارس العديد من الأشكال داخل النوع الواحد، مسلحا بلغة إنجليزية، مكنته أيضا من الترجمة، مستعينا بعديد القراءات، ومختلف الثقافات. الأمر الذى فرض التصور بأن كل ساعات هذا الكاتب، كانت بين القراءة والكتابة، أى أنه يعيش مع نفسه، أكثر مما يعيشه مع الآخرين، وهو ما انعكس على أعماله- خاصة فى مجموعة “مكان جيد لسلحفاة محنطة” والتى استدعى فيها الكثير من رموز الإبداع السينمائى والتليفزيونى والتشكيلى والموسيقى والشعرى والسردى، حيث اصبحوا هم عالمه. حيث جاء الكثير من القصص، تحمل البوح، وتتوجه إلى شخص غير موجود، وتعيش فى الماضى. لذا، وإن كانت لا تحتوى عنصر الحكاية، إلا انها تحمل حركية الزمن حيث تخلق المقارنة بين الماضى والحاضر، بين الطفولة، والشيخوخة، بين الإحساس الذى كان، والإحساس الكائن. أى ان هناك دائما حركية، أو ديناميكية، تسرى بين السطور، تُشعر القارئ بتلك الحركية، التى هى عنصر رئيس فى القصة القصيرة.
فإذا ما بدأنا بقراءة أولى قصص مجموعته “مكان جيد لسلحفاة محنطة”[1]، التى تنوعت فيها التجارب، وتباينت المعالجات –الشكلية- وإن ظلت الرؤية واحدة، فى أغلبها، إن لم تكن فيها جميعا، والتى نستطيع أن نتبين تلك المعالجات فى القصة المركبة، والقصة المقالية، والقصة الرسالة، حيث تباينت بينها المساحات الكتابية، لأغراض توصيل الرؤية، والحفاظ على ماهية القصة القصيرة، والتى تعتمد الزمن عنصرا هاما فى كتابتها.
فإذا ما تأملنا أولى قصص المجموعة، والتى عنونها باللغة الإنجليزية (FACEBOOK). سنجده قد استعان بفن “الكولاج”، الذى يعتمد قصاصات متباعدة، ليشكل منها فى النهاية رؤية. رغم تباعدها –الظاهرى- ورغم أنها لا تعتمد (الحكاية) المتصاعدة، إلا أنها فى النهاية تعبر عن رؤية للحياة العصرية، تقوم على المواجهة، بين الماضى والحاضر، لينظر القارئ حوله، ويتحسس موقعه. حيث نعيش ونتعايش مع تلك الوِحْدة – المتسلطة على معظم قصص المجموعة- فيركب على جناح الخيال طاويا المسافات، والحواجز (الزمنية) التى تباعد بين البشر، حيث يسترجع تلك الأيام التى كان يشعر فيها بالدفء، والحنان، فيستدعى الجدة -من الزمن الماضى- التى يرى وجهها مماثلا لوجه السيارة الفولكس –فى الزمن الحاضر-. ويستدعى وجه “مجدى وهبة” فى فيلم “حنفى الأبهة” بما يمثله من شر، غير انه يسمو به ليصبح شبيها ل”سلفادور دالى”، بدوره – فى الفيلم- فى تغيير الرؤية، والوسيلة للتعبير عن الحياة، وكأننا أمام مواجهة بين طرفى التكنولوجيا. ثم يستدعى –من الماضى- وجه إسماعيل ياسين، ليقول عنه {المشهد الذى لم تره أبدا لإسماعيل ياسين. اللحظة التى لايريد فيها أن يكون عاديا أو حكيما أو مضحكا. ولا يريد كذلك أن يُخبر أحدا بطريقة ما أن وراء ضحكاته تعاسة هائلة. النقطة التى تقع خارج الزمن ويريد أن يعطى عندها إشارة غير ملحوظة ربما بأنه يتمنى فقط أن يتبخر دون أن يموت}. وهو ما يعكس رؤية المجموعة، أن الظاهر ليس كافيا للحكم على الباطن، وأن هناك دائما ماهو ظاهر، وما هو خفى فى الأعماق. حيث إنسان (الفيسبوك) يتعامل وكأنه (موجود) غير أنه غير محسوس، لذا يلغى –الكاتب- حاجز المكان، لنرى أنه يقيم علاقة مع كاتبة –عربية- للقصة القصيرة، وهو يُضمر أن يجتمع معها فى سرير واحد، غير انه يصطدم بها تسأله أن يرسل رسالة لحبيبها يخبره فيها أنها تريد مقابلته حالا، وكأنه يفاجأ بأن الاتصال، نظرى، غير محسوس، وأن العلاقة (الفيسبوكية) علاقة تسمو على المادى، وتنزع إلى السمو لعالم (باخ) –أحد عباقرة الموسيقى الكلاسيكية- {الشعور التقليدى بالعجز والفشل الذى كنت على يقين بأن آلامه المعتادة تتجهز لتعذيبى من جديد فى جميع الأحوال، سواء طال الوقت دون أن أصل لجسد القاصة العربية- كما حدث مع جميع من حاولت الوصول إلى أجسادهن-… وأننى سأكتم صوت فيلم البرنو لأستمع إلى (كونشرتو براندنبورغ)ل(باخ) أثناء الفرجة والاستنماء. لم أخبرها بأننى سأكون سعيدا جدا}. ليعود السارد إلى وحدته، ويكتشف أنه يعيش الخيال، لتكرار الفشل فى إقامة العلاقة (المادية). وليجد أنه يتحدث إلى نفسه، حيث يتصور أن أحدا كتب قصة قصيرة، وترك صفحات بيضاء ليكتب القارئ فيها عن حياته. وأنه استخدم تلك الوسيلة، لإقامة التواصل، والبقاء. ورغم أن السارد، انتقد تلك الوسيلة، إلا اننا نفاجأ فى النهاية بأن كاتب القصة –الافتراضية- ليس إلا كاتب قصتنا (الفيسبوكية)، أى تطابق كل من الكاتب والسارد {لم يكن يريد أن أرى وجهه. وأيضا لم يكن يريد أن يرى وجهى. ربما ليس لأن لدينا نفس الوجه….لا يستغرق ال sing out أكثرمن لحظة واحدة. لكنها كانت كافية لأن أتذكر أننى الذى كتبت القصة القصيرة ذات الصفحات الفارغة ولم أنشرها أبدأ}. ويكتمل الشعور بالإحباط عندما يكتشف أن وسيلة الصفحات الفارغة، أو اللاوجود المادى، لا يحقق إنسانية الإنسان، الذى يسعى لتحقيق ذاته، وما يتم ذلك إلا بوجود الآخرين {كاتب القصة لم يذكر شيئا عن نفسه. كل ما فعله أنه ترك صفحات فارغة دون أى اثر لملامحه. أنا كنت أريده أن يرانى بأى شكل، واعتبرت عدم رغبته فى ذلك إهانة تتطلب الانتقام ولو بكلمات لن يقرأها أبدا.إعتداء على حقى فى الألوهية، والذى لن أحصل عليه إلا بتثبيت ملامحى فى ملامح أخرى}. فهنا نعيش مآساة العصر، فعلى الرغم من أن الوسائل الحديثة، قد قربت المسافات، إن لم تكن قد ألغتها، إلا أنها –بذلك- منعت التواصل الإنسانى، والدفء الروحى، وقذفت به إلى برودة عالم الانعزالية، وتركته مع نفسه، ليُنشأ عالمه الخيالى وحده.
ويظل الفيسبوك حاضرا فى قصة “هومر سيمبسون”. وفى شكوى الفساد والازدواجية، مع الوهم، أو مع شخص ليس له وجود، معتمدا –أيضا- على أخد خواص الفيسبوك، أن أكلم من لا أراه، وغالبا من لا أعرفه. متسلحا بالوحدة والتأمل، والذى، غالبا ما يجد الإنسان فيه يبحث عمن يفضى إليه بمتاعبه. فتتمثل الوحدة فى قصة “هومر سمبسون” فيما يفضى به عن نفسه، لتلك الشخصية الكرتونية{ أنا مع كل مرة أغلق فيها الباب على نفسى، وافكر فى الماضى، يتحول الإذلال إلى أقوى داعم لوجودى… ولكن على أى حال –على أساس أنكِ لم تجدى أحدا بلا شكوى- ما أقوله الآن أريدك أن تعتبريه مجرد حكى لأزمة شخصية بسيطة، أو هو نوع من كتم الصراخ بكف البوح}. – ولا نغفل ما فى التعبير من جمالية تفيض بالإيحاء لشدة الضغط الداخلى (الصراخ) وأن (البوح) هو المخرج الآمن لتفريغ شحنات الغضب. والتى كما تصلح للتعبير عن الفرد، فإنها.ز أيضل.ز تصلح للمجموع-. فنحن إذن أمام عملية بوح وتنفيس نفسى، يلجأ بها الكاتب للتعبير عن ذاته المتوحدة، والمنطوية على ذاتها، مما يمارسه المجتمع، ويرفضه الكاتب –ممثلا فى شخص السارد-. ثم يضرب السارد مثلا لذلك الخداع، والازدواجية التى يعانيها المجتمع، بالحكى للمتحدَث إليها، عن شخص يعلق، مهاجما، على قصيدة نثر نشرها السارد، غير أنه وجد صورة ذلك الشخص تبين عن شخص أنيق على الطريقة الأوروبية، فوجد فى ذلك تناقضا، فأخذ السارد صورته، ووضعها بروفايل لنفسه، وتلقت عشرات الإعجاب على (صورته) الجديدة. {انتظرت حتى انتهيت من كتابة كل كلمات الفرح والإعجاب بوسامتى. كنت مستعدا لأن أرد على هذه الكلمات بقسوة، بعنف لفظى بالغ يهين أنوثتك، لمجرد أنك جميلة جدا كأحلامى التى لا يعرفها أحد، ولأنك لن تكونى قريبة منى أكثر من هذا الحد. كنت فى نهاية صفعاتى ولطماتى الكلامية ساخبرك بأن اسمى الذى يختبئ وراء short story هو فلان الفلانى/ اسم الشخص الذى هاجم قصيدة النثر}.ولا نغفل هنا أيضا {انتظرت حتى انتهيت من كتابة كل كلمات الفرح والإعجاب بوسامتى} وما بها من تعبير إنسانى جوهرى، حيث تنطق العبارة بسلوك إنسانى، يفرح بكلمات المدح، حتى أنه يسجلها(يكتبها). وهو السلوك الفردى، الذى يمكن أيضا أن يعبر عن السلوك الجمعى، حين يؤدى إلى إفساد، أى مسؤول. وهو ما يشير إلى خاصية تسرى فى أوصال المجموعة، الخروج من التعبير الفردى، إلى الجمعى، دون فواصل، أو خطابية، أو تصريح. وهى إحدى صفات الشعرية- فى السرد- التى تبوح، دون أن تُصرح. وبصيغة أكثر دقة.. القابلية للتأويل.
وتتقاطع قصة “اللعب بالفقاعات” مع قصة “هومر سمبسون” فى رفض الزيف، وكل ما هو مرفوض. حيث نطالع هنا تحايل الكاتب ضعيف الموهبة. فإذا كنا قد رأينا القصة التى تحمل مستويين للحلم، فإننا نواجه هنا، القصة داخل القصة. وهو ما يمكن تسميته ب“القصة المركبة”، وحيث أن كتابة القصة –فى عمومها- تحمل الكثير من شخص الكاتب، من ذاته. حيث يخاطب السارد نفسه، فى قصة “اللعب بالفقاعات” –كما غيرها من القصص كثيرا- وهو يحاول كتابة قصة، عن أخته التى تصرخ فيه كثيرا، وتقذف (بقصص الأطفال) التى يقتنيها، وهو لا يستطيع مجاراتها، فيغلق عليه بابه، حتى يعترف لنفسه، وكأنه يبرر لنفسه {لا يمكنك أن تنكر أنك فكرت أكثر من مرة فى قتلها، ولكن الذى منعك ليس رفضك أن تدفع روحك ثمنا للتخلص من حنجرة فحسب، وإنما كان يعنيك أيضا بقاء هذه الحنجرة فى الحياة لتكون دليلا حيا وحاضرا دائما أمام عينيك على صحة الكوميديا الكامنة فى كراهيتك للفناء}.ونلاحظ هنا الرؤى المتفجرة من استخدام (الكوميديا) التى تحمل العبثية، والتناقض بين رغبة السارد فى مقاومة الفناء، الذى هو مصيره الحتمي، طالما أنه لا يملك الموهبة، أو حتى الشخصية، التى لا يعتمد بها على الآخرين. وحيث نشعر معها بحساسية الكلمة، وفاعليتها فى بث الإيحاءات، والإشعاعات.
ثم يتصور-السارد- أن خطيبته توقع مجموعتها القصصية، في قصته المزعومة التى يحاول كتابتها{فى حفل توقيع خطيبته لمجموعتها القصصية كان الخط السحرى الفاصل بين ثدييها كريما فى ظهوره من ملابسها المفتوحة} و كان{ كل واحد تمنى لو زادت كلمات التوقيع ليطول وقت وقوفه أمام كنزها المهيب، وحينما تأتى لحظة انسحابه ممسكا بنسخته موقعة يحرص على توديع ذلك الكنز بنظرة طويلة مركزة وبإحساس قاتل باليتم}. حيث تترجم {الإحساس القاتل باليتم} إحساس الكاتب بأن أحدا لا يسأل فيه أو فى وجوده. ثم يتصور كاتب القصة (الداخلية) أنه تزوج، وأن زوجته لها صوت الضفدع، ولم يكن شكلها، بأقل قبحا من صوتها، لكنا نعلم أنها تعايره، لتُبرز الجانب الآخر، أو وضع هذا الزوج (المتَصور) {معايرتها لك على جلوسك فى البيت بدون عمل وإعتمادك على المساعدات الخارجية من أهلها، وأحيانا من أهلك}.
ويسترجع ذلك السارد الداخلى، أنه يجلس على الكورنيش مع خطيبته، فيمر واحد ويطلب منه ولاعة، ثم ينقض عل ثدى خطيبته بيده، تحت ملابسها، ويهرب لتصير مطاردة بين السارد، وهذا المُغتصب، لحق يراها حصريا. { لكن كان فى داخله شئ خافت وغريب يجبره على الامتنان لهذا الاعتداء. لذة تشبه كثيرا تلك التى يحصل عليها الخارج منتصرا من معركة ما}. وكأن الفعلة رغبة دفينة عند السارد، عجز عن تحقيقها، وأشبعها له هذا الاعتداء. لنبدأ فى تلمس الرغبة الداخلية –المادية- للكاتب (المزعوم). وبعد الغيظ من ذلك الشخص.. شعر فجأة بإحساس متغير، بل {شعر مصدوما أن عينيها لم يكن فيهما نظرة فزع أو ذهول، بل على العكس، كان فيهما ما يشبه السرور الشهوانى رغم صرخاتها الباكية}. فينسى ذلك المغتصب الهارب، ويمد يده –السارد- ليستحلم. لتتكشف لنا عن شخصية، غير سوية، شخصية متوهمة، وهى لا تملك القدرة على التواجد الحقيقى. ولندرك أن العملية برمتها، ليست إلا حلم، أو رغبة مدفونة عند السارد، وأن شيئا من ذلك على أرض الواقع، لم يحدث. وقد نلاحظ أستخدام الكاتب – ممدوح- لضمير المخاطب (أنت). وكأنها المواجهة. وكأنه يواجهه بعيوبه، مباشرة، مستخدما تلك الصيغة فى كتابة الكاتب الضمنى، وكأنها –أيضا- عملية مواجهة الذات، أو البوح الداخلى، بالحقيقة –المُرة-. ولنصبح فى ذات الآن أمام قصة نفسية، وأن السارد – لزال- فى حالة فردانية، يعيش الداخل، ويواجه مقاومة الواقع – الذى لا يستطيع أن يعيشه- والرغبة –التى لا يستطيع تحقيقها. ولينفتح النص إلى الرؤية العامة، إنسانيا، ومجتمعيا، على الرغم من ظاهرها.. الفردى.
ويبدأ الكاتب فى الخروج من الذات، إلى النظرة الكلية، الجمعية، فى قصة “ماريا نكوبولوس”. والتى استخدم فيها الكاتب التواريخ، والمراجع التى تحيلنا إلى الواقع المعيش، وكأنه يقتطع جزءً منها، ليغرسنا فى وحل التجربة الحية. فيعرض لنا حياة تلك الفتاة التى مُنحت القدرة على السير بظهرها، بل وتجرى، وتمارس الحياة بظهرها، ولا تستطيع ذلك عندما يتم تغمية عينيها، أى انها تستخدم عينيها بالفعل، ولكنها تسير للخلف – لتبرز مباشرة الرؤية الرمزية، التى تُخرجها من الرؤية الفردية إلى الرؤية الجمعية-، وكأنها تسعى للعودة إلى الطفولة – فى الرؤية الفردية، أو البراءة، التى ترى فيها الخلاص من العلم الآنى بكل شروره، ودمويته. حيث رفضت ماريا استغلال موهبتها –السير للخلف – فى أى عمل تجارى أو دعائى، ولكنها وافقت فقط فى أحد الأفلام {حيث اقتصر دورها على المشى الصامت بظهرها لثوان قليلة فى مشهد النهاية الذى جمع بين النجمين وهما عريانان وسط نافورة فى ميدان عام ويتبادلان قذف أشلاء وعظام بشرية على بعضهما بفرح}. وكأنها وافقت على الاشتراك، رفضا لذلك المنظر الدموى، وكأنها دعوة للعودة إلى البراءة والطهر. والحالة الثانية كان فى قصة فيلم كارتون. حيث جسد الفيلم قصة حياة الطفلة (كارولين) التى تعانى من الوحدة والاضطهاد الأسرى والمجتمعى بسبب إصرارها المتواصل على تقمص شخصيات الحكايات الخيالية القديمة}. وهو ما يفهم منه –أضا- رفض تلك المعاملة، والدعوة للعودة إلى الإنسانية. وهو ما يعنى الرفض فى كلا الحالين، خاصة وأن رفضها المطلق لاستغلال ما وهبها الله فيما يضر البشرية.
وقد عينت “ماريا” كسفيرة لللأمم المتحدة وهى لا تزال طفلة، فزارت مصر حيث إلتقت {بالرئيس (جمال عبد الناصر) وبالمستشار (حسن الهضيبى) المرشد العام للإخوان المسلمين، وبالبابا (كيرلس السادس) بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأنها اصطحبتهم إلى طريق مصر اسكندرية الصحراوى} ليجربوا المشى بظهورهم، لكنهم فشلوا. كما جربت نفس التجربة مع الرئيس الأمريكى نيكسون، والسوفيتى بودجورنى، والفرنسى بومبيدو، وفيصل ملك السعودية، لكنهم –أيضا- فشلوا. وبتأمل تلك الأسماء، والمناصب، نعلم أنهم جميعا من سعوا إلى الحروب والدمار، والقتل. كما أنهم –تقريبا- من يسيطرون على مجريات الحياة على ظهر الكوكب. لذا فإنها صرحت لصديقتها المقربة قبل وفاتها و-دون مبرر واضح- وكأنها الرسالة إلى البشرية. بالكشف عن سر الحياة على الأرض {بأن الحياة كان من الممكن أن تكون جميلة حقا لو أتيحت لكل إنسان القدرة على التفحص الدائم للنقطة التى ينطلق منها تحركه داخل العالم، وأن المشى بالظهر حينما يعتبر معجزة، فهذا دليل على مدى بشاعة النوايا التى وقفت وراء الوجود البشرى، لأن الغيب لو كان يريد بنا خيرا لجعلنا جميعا قادرين على المشى بظهورنا}. وكأن الحروب والقتل والدماء، قدر مُقدر على الإنسان على الأرض، منذ أن قتل قابيل أخاه هابيل، عند بدء الحياة على الأرض. حيث نرى أن المشى على الأرض، يعادل أن يعطى الإنسان ظهره لكل ما يحمل الضمار للبشرية.
وتأتى قصة “ظهور الأسنان” لتضيف إلى قصة “ماريا نكوبولوس” بعدا حاضرا على أرض الواقع، وكأنها استكمال لها، حيث تظل ثورة الخامس والعشرين من يناير باقية فى الذاكرة حية، مهما حاول البعض طمس معالمها، إلا أن كاتبنا يسترجع تلك الفترة فى قصة “ظهور الأسنان”. وإذا كانت المجموعة قد ظهرت فى العام 2013، ما يعنى أن القصة ولدت قبل ذلك التاريخ، اى أنها ولدت فى سخونة الحدث، لذا جاء التعبير عنها سهل المنال، حيث تتحدث عن السارد الذى يجلس على المقهى مع صديقه الذى يرى أن ثوار يناير ليسوا إلا بلطجية مدفوع لهم لنشر الخراب والفوضى فى البلد}. ثم يحكى الصديق عن ابنته الرافضة للزواج(التقليدى) أو زواج الصالونات، فيسأله السارد {لكننى سألته عن الدافع الأعمق للغضب بداخله الذى قد لا يكون له أى علاقة بمظاهرات إسقاط المجلس العسكرى} وهو ما يلقى بظلاله على تحولات تلك المرحلة. ثم يفاجأ -السارد- بأن الصديق قد اصطحب ابنته إلى الميدان، ربما لتجد هناك –من بين البطجية- من تختاره عريسا لها، {خصوصا مع ثقته فى قدرة ابنته على الاختيار السليم، وعلى حماية نفسها من أى تجاوز أخلاقى يمكن أن تتعرض له}. ليحدث الإسقاط بين الحياة (المدنية) وبين ما يجرى من أمور عسكرية بالميدان. وهو ما يخشى معه –السارد- أن يحدث الصدام، فليست القوتان متساويتان {قلت له إن أهم شئ، وهو لم يكن فى حاجة للتأكيد عليه، هو ألا يحاول إجبارها على أى أمر، وأن يحرص على عدم بلوغ المناقشة بينهما إلى مستوى الحدة والصدام}. ثم يعود السارد إلى بيته، {فى هذه الليلة كانت ابنتى نائمة حين رجعت من الخارج. وقفت أتمعن فى وجهها متحاشيا النظر إلى ذلك الشئ الأبيض الصغير جدا الذى بدأ يبرز داخل فمها}. لتصل رسالته التى ترى فيما يحدث إنبثاق الأسنان التى تستطيع مضغ الطعام، وإختياره، وبداية القدرة عل الاختيار، وأن النظرة إلى تلك الثورة المغدورة، كان بداية البداية.
وقد نتلمس الإيحاء بمصير تلك الثورة –الخامس والعشرين من يناير – فى قصة “نهاية العالم” والتى لم يغادر فيها- الكاتب- عالمه الداخلى الأثير. فقد عمد فيها الكاتب إلى الإيحاء، خاصة ما جاء بنهاية القصة، حيث أنه لم يصرح بسقوط الإبنة. فهنا نرى الزوجة، وممارسة الحياة معها، والإبنة التى صنع لها سفينة من المكعبات، وكأنه يصنع لها سفينة نوح، غير أنها لم تكن كإبن نوح- فى المصير-(فكان من المُغرقين). حيث أنها لم ترفض ركوب السفينة، لكنها سقطت من الدور السابع، وكان لسقوطها دوى هائل، وإن كان السارد ينفى أن هذا لم يكن نهاية العالم، إلا أن ذلك كان نهايته بالنسبة للأسرة –على المستوى الفردى-، رغم استمرار الحياة على الأرض. وأن الدوى الكبير الذى أيقظ (الشارع والعمارة)، لم يكن إلا فى الأثر النفسى للسارد، وهو ما لم يبتعد به –الكاتب- كثيرا عن عالمه النفسى الداخلى. كما لم يبتعد عن تلك الرؤية الكلية، والتى تؤكد مقدرته على خلق العام، من الخاص، حيث تعتبر القصة إمتدادا، وتحديدا لمصير الإبنة، التى رآى أسنانها تنبت… ولكن…….
وقد لا تبعتد قصة “بالإصبع الصغير لقدم أعمى” عن تلك الرؤية. حيث يستمر الكاتب فى ظل الأجواء السارية فى المجموعة- بصيغة مباشرة أو غير مباشرة- فى هذه القصة التى يثير عنوانها – كغيره من العناوين، الكثير من التساؤل والدهشة، حيث يبحث القارئ خلال القصة عن ترجمة للعنوان، أو إشارة إليه، فلا يجد. الأمر الذى يدعونا لمتابعة القصة، لعل شيئا يدلنا على دلالة للعنوان.
فتبدأ القصة بالفيسبوك –أيضا-، والحلم {حلمت بأننى قضيت ليلة فى بيت إحدى الصديقات على فيسبوك. كان كل ما أعرفه عنها أنها جميلة وشاعرة وخفيفة الدم وثورية}. فإذا كانت تلك هى الصفات التى أثارت حفيظة الكاتب، وجعلت تلك الصديقة، محط فكره. حيث ينبع الحلم من الواقع، أو أن الحلم يكشف عن أجواء الحالم وتفكيره، قبل النوم. خاصة إذا ما تأملنا نهاية القصة التى استيقظ فيها الحالم من حلمه، على صوت إيمان البحر درويش يغنى:{ فى البحر سمكة. بتزق سمكة. على الشط واقف. صياد بشبكة. ونونة تضحك. وتقول يا بابا هات لى بسكوت ونوجة). وليستيقظ الحالم من نومه {لحظتها أدركت أننى أحلم، وقررت الاستفادة من ذلك لتحقيق أمنيتى القديمة: الطيران وسط الغيوم وقت الغروب بصحبة أغنية “فرانك سيناترا” noon river. رفعت ذراعى وأنا فى السرير محاولا البدء فى التحليق لكن صوت أغنية “إيمان البحر درويش” ظل يعلو دون توقف حتى فتحت عينى مستيقظا من الحلم. فالتَفْتُ إلى السرير الآخر حيث طفلتى ما زالت نائمة وبيديها الصغيرتين باكو بسكوت وقطعة نوجة}. فإذا كانت رغبة الحالم القديمة، هى الطيران وسط الغيوم وقت الغروب، فهو ما يعنى، الرغبة فى الهروب، من واقع غير محبب( الغيوم ووقت الغروب) أو وقت الأفول… فما هى تلك الأجواء؟
تبدأ تلك الأجواء، حين نام الحالم مع صديقته الفيسبوكية، وبعد أن انتهيا، كتب، كل على صفحته بالفيسبوك “ستاتوس” بذات الشكل، وبعد الاستيقاظ- بينما ظل هو فى الحلم-.- حيث نعيش أيضا هنا الحلم المركب- وجد ألا لايك واحد على صفحته، ووجد عشرات اللايكات على ذات الاستاتوس على صفحتها، مما اغضبه كثيرا. فاستمر فى الحلم ليجد الشقة قد مُلئت بالأصدقاء الذين يعرفهم، وقد ناموا جميعا فى الحجرات والصالة وفى كل مكان، وكان يحمل مسدس صوت، وجهه إليهم جميعا، حتى أماتهم عن آخرهم. ورغم أن الصديقة أخذته إلى الحجرة إلا انها أبلغته بأنها ستلغى صداقتهم على الفيسبوك، ليسألها {وأظن كمان هتعمليلى بلوك}. فيستنتج من نظرات عينيها الهاربة أنها ستفعل ذلك.. إذن فقد حدث شقاق بين الصديقين، أو الحبيبن. وحدث فراق. فإذا عدنا إلى وصف السارد أو الحالم بوصفه لها ب { أنها جميلة وشاعرة وخفيفة الدم وثورية}. ثم استكمال السارد عنها {لم أر فى الحلم أى مشهد جنسى بيننا. رايتنى فقط مسترخيا فى سريرها، ومستمتعا بإشباع ما بعد الممارسة}. حيث تخرج الصديقة، أو الحبيبة من الوجود المادى، إلى الوجود الرمزى، أو الوجود الروحى، والذى قد لانكون مبالغين إن تصورناها المعادل الموضوعى لمصر، وليخرج منه السارد إلى الهم العام، هم الوطن، وهو ما نتصور معه أن السارد أطلق الرصاص على الزيف، أو الانحراف عن السلوك السوى، الذى رفضه السارد. وهو الفعل الذى قررت معه الصديقة إنهاء الصداقة {أنا هفضل معاك على طول، وهنفضل ننام مع بعض لغاية ما نموت بس بعد اللى انت عملته النهارده أنا مضطرة أحذفك من قائمة أصدقائى على فيسبوك}، حيث ينتقل الحالم من حلم أول إلى الحلم الآخر، أو مستوى آخر من الحالة الحلمية، وكأننا أمام مستويين من الرؤيا {لم أدر إلا وأنا أمد كفى نحو رقبتها محاولا خنقها، لكننى وجدت نفسى أستيقظ من هذا الحلم عائدا إلى الحلم الأول، كان نفس السرير الذى أخذت فيه صديقة فيسبوك بين ذراعى واستغرقنا فى النوم، لكن تحولت الحجرة إلى زنزانة داخل سجن طره أثناء الحقبة الناصرية}. ولا تختلف تلك الرؤية عن المشهد الذى رآه السارد فى الزنانة، والتى فيها كان يجلس عضوان من جماعة الإخوان المسلمين. يقول أحدهما للآخر: { اتصلت بمدير أعمال (أوكا وأورتيجا؟) فرد عليه الآخر: ايوه الهضيبى إداله كلمات المهرجان واتفق معاه على كل حاجة}. ولينطق أحدهما –السنانيرى- مغنيا{الإسلام معايا وروحى فيه. شايله معايا وبحكم بيه}. ولنرى الوجه الثانى للمعادلة، أو الطرف الثانى الساعى للحكم {وبحكم بيه}، حيث تبينا الطرف الأول يحبس فى –سجن طره- كل معارضيه، والذى أصبح السارد واحدا منهم. وليصبح السارد، بإلإصبع الصغير لقدم أعمى ضائع بين جناحى الاقتتال، وكأنه القدر الأعمى، أو الأحمق الخطى، سحقت هامته خطاه[2]. وهكذا نجد أن العنوان، تم نثره فى ثنايا القصة بطولها، فكان مُعَبِراً، وكان مَعَبَراً، إلى الرؤية المستترة بين ثنايا الحلم الضائع. فى الوقت الذى استكر الكاتب فيه، يخترق أعماق سارديه، ووحدتهم، التى تُنشئ الأفكار ليحولها إلى إبداع.
القصة المقالية
كما ذكرنا، تنوعت صيغ الكتابة فى المجمعة، بين القصة المركبة، التى عايشنا بعضها، لنجد صيغة أخرى، وشكلا آخر لكتابته، وهى القصة المقالية، التى تدفعنا مباشرة إلى أشهر من كتب تلك القصة “بورخس”، والذى يقول د. محمد أبو العطا فى مقدكته ل(كتاب) الألف لبورخس[3]، حيث يقول عن المؤلف :{وهو من نخبة مفكرى هذا القرن ومبدعيه نظرا إلى ثقافته الموسوعية واطلاعه على ثقافات الشرق والغرب. وقيل أنه لو لم يتجه إلى الإبداع الأدبى لكان من كبار المفكرين المنهجيين فى العالم} كما يذكر د أبو العطا، أن بورخس كان يعانى من ضعف البصر، الأمر الذى أدى إلى حياة العزلة فى المنزل. وهو ما يدعو لاستشعار الشبه بينه، وبين كاتبنا “ممدوح رزق” الذى عنون إحدى قصصه ب”بورخس”، رغم أن ذكر بورخس مباشرة لم يأت ذكره، وإنما استغل الكاتب الإسم –العنوان- لعملية الإيحاء. وكأنه يكتب عن نفسه. خاصة إذا ما قرأنا رؤية أبو العطا لقصص بورخس {وتظهر بدايات بعض قصصه كما لو كانت دراسة علمية خالصة، وأحيانا، على شكل فكرة فلسفية أو طرح جدلى، وفى أحيان أخرى، على شكل إعتراف بضمير المتكلم}[4]. خاصة أننا نرى السارد- فى قصتنا-، يتحدث بضمير المتكلم، كما وأنه اختار صيغة الحلم – وهى الشكل الذى يبقيها فى القالب القصصى- ليعبر به عن إنقسام الذات، الواقعة تحت تأثير الأفكار والقراءات المتعددة والمتنوعة مثل “مى التلمسانى” و “فرانك أوكنورو” مؤلف “الصوت المنفرد” وشبنهاور ونيتشة وكيركيجارد وفوكو وبارت ودريدا وليوتار و رورتىن وغيرهم، ممن كتبوا عن النظرية النقدية، أو الفكر النظرى. الأمر الذى معه تحول القصة إلى ما يشبه المقال، أو المحاورة النظرية. وهو ما يتطابق مع استمرار قراءة المقدمة – المشار إليها- {جاءت أعمال خورخى لويس بورخس القصصية متأخرة، وتجريبية أولا، برغم أنها أهم ما يميز أعماله عامة، حيث نلاحظ هيمنة إسلوب المقال الأدبى على قصصه القصيرة}. والتى يمكن أيضا أن نقرأ عليها مقالات “محمد مستجاب” فى عدد من المجلات المصرية، فضلا عن مقالاته –القصصية- فى مجلة “العربى”. ونرى قناعة الكاتب ممدوح رزق، ووعيه بما يفعل، فى قول أحد طرفى النفس فى المحاورة بينها وبين الأخرى فى قصة “بورخس” {توقفك عن كتابة برامج الحياة والكتابة والعلاقات. يا ريت كل بنى آدم يتحول مثلك إلى شخصين، واحدة تعيش والأخرى تتفرج طوال الوقت بمتعة واطمئنان على الفيديو كليب الخاص بالأولى. أليس هذا حلمى الذى ما زلت أعيد كتابته مرارا وتكرارا بأشكال مختلفة وحققته أنت أخيرا؟}. حيث ينحصر الحلم فى مراقبة الذات والكتابة عنها، وهو ما يؤكده فى القصة نفسها {ولكن يبدو أن المسافة الذهنية التى تصورتها قائمة بينى وبينه لم تكن بالحدة التى تظهر عليها، الأمر الذى لم يجعلنى غريبا عنه}. فتطابقت نظرة الطرفين، فى الرؤية النظرية، لا العملية. وفى النهاية،يتبخر الحلم، ولا يتبقى منه إلا المادة الأولية، التى يحاول القاص أن يخلق منها قصة، لتدعو القارئ أن يتأمل أحوال الحلم، واثر الخارج عليه، واثره على الخارج {أنت غالبا تنسى الأحلام-كعادتك-، وهذا الحلم أنت لن تتذكر سوى تفاصيل مبتورة وشاحبة منه، ولن تمتلك تأكيدا على وجودها. مثل كل مرة خيالك هو الذى سيكتب هذا اللقاء}.فتنحصر القصة- الحلم- إلى تصور شخصى، يجرى فيه السارد حوارا نظريا، بينه وبين نفسه فنقرأ القصة وكأننا نقرا مقالا. وهو ما نستيطع أن ندرج فيه أبضا، القصة الرسالة، والتى تفيض بما تحمله الذات للآخر، وإن كان هنا، شخص معلوم. مثلما فى “تاريخ الأدب” إلى أشرف أبو زينة و “العود الأدبى” إلى مجدى رزق.
القصة ولعبة الزمن
لا يتطلب الأمر كثير بحث لإدراك لعب الزمن، بصفة عامة، والماضى، بصفة خاصة، دورا رئيسا فى المجموعة ككل، حيث نجد أن الحنين للماضى، أو فتح خزائنه، والاستفادة من مواده فى صنع عصب لقصصه. حيث تجلى ذلك – بصورة مباشر- فى قصة “سرير” ذلك الذى يشهد مسيرة الأجيال، حيث يتحول السرير إلى آلة الزمنـ تشهد عمليات بدء الخلق ” المعاشرة الجنسية”، ويشهد تتابع الأجيال عليه { بينما الطفل الذى قابلها صدفة بعد عشرين سنة تعود مراقبتها دون أن تشعر، عرفت اليوم أن الطفل صار زوجا وأبا وملحدا، وأن الطفلة صارت زوجة وأم ومومس ومنقبة}. والسرير يضحك لتصور الجميع، أن الحياة ممتدة، وبلا نهاية، ولكن ينتهى فيلم “إخفاء العالم”. فالأشخاص يختفون، لكن الحياة باقية، فيضحك الزمن منهم، وعليهم، المتجسد فى السرير، الصامت، الباقى عبر الأجيال {وإلى أى مدى نجحت شيخوختى فى جعل الحياةعبئا قاسيا على. لكنه بعد أيام وبينما كان يشاهد الفيلم أدرك أننى خدعتكم جميعا، النجار وأنت وزوجتك والممثل، رآنى فى الفيلم أكتم ضحكاتى بشغف طفل يراقب من مخبأه السرى حيلة دبرها لكبار غافلين. الحقيقة أنه رآنى ميتا أكثر مما كان يتوقع}.
وقصة هروب أخرى من الحاضر، وسعيا نحو الماضى، نقرأ فى قصة “أشياء الزمن” ما يُجسد الزمن. موجودا، ورامزا لذلك الماضى الذى يخشاه كل المتجمعين بلا عدد فى الحجرة الضيقة، وكأنها الحياة، باتساعها، وكلهم يخشى الماضى.
وأيضا نجده حاضرا بقوة فى قصص:
رسم الهوا، المرض، تخفيف العمى، عيد الأم، وردة، لاشئ بعد الموت، البحث عن كوخ
وحكاية الرجل الذى كتب قصة قصيرة. حيث نرى لعبة الزمن، ونتعايش معها فى الوحدة التى تؤدى –غالبا- للمرض النفسى، لذا لم تخلو المجموعة من معالجة بعض تلك الأمراض.
القصة والمرض النفسى
وكأنها النتيجة الطبيعية لكل تلك الحالات، الانعزالية، والحديث مع النفس، وكأن شخصا وهميا يحادثه، فكان المرض النفسى، هو النتيجة، والذى هو أيضا لا يبتعد كثيرا عن الشعور الداخلى. وهنا أيضا نستطيع القول بغياب (الحكاية). إلا أننا ندخل إلى العالم الداخلى، فنرى إنسانا يحمل “الحقد على الآخرين، خاصة من يملكون مواصفات، لم يحظ بمثلها. فأصبحت متعة السارد أن يراقب الجميلات وهن ينتظرن التاكسى بكبرياء الجمال الذى يحملنه، و{ما زالت متعته تزداد كلما زادت صلابة الكبرياء الذى يغلف جمالها بثقة، وكلما زادت ملامح السائق قبحا وشقاء، بالطبع تبلغ لذته أقصى مدى حينما يرفض الجالس خلف عجلة القيادة أن تركب البنت الجميلة معه ويتركها مواصلا طريقه. لو سمحت الظروف بالاستمرار فى مراقبتها، فإن سروره يتضاعف كلما استمر وقوفها المذل فترة طويلة، وتحول طلبها لكل سائق يمر عليها إلى ما يشبه التوسل لأن تستقل سيارته}. وكأنه يستلذ بمعاناة الآخرين. ثم يتصور أنه تزوج إحدى هذه الجميلات، وكيف ستستمر ساديته معها {لكن أضيفت إلى حياته متعة جديدة حينما يتصور شجارا يحدث بينهما وهما متزوجان، وكيف سيرميها على السلالم بملابس البيت، ومعها علبة مكياجها فقط}.
ويتبدد التساؤل عن سر تلك الحالة، عندما نعلم –بعد زواجه (الوهمى) من إحداهن {غير قادر على تصديق كيف أحبته، رغم الكلام المتلجلج المثير للتهكم والشفقة التى كان يقوله لها، ورغم الأنف الكبير الذى ورثه عن أبيه، لا يعرف كيف قبلت العيش معه}.
كما نستطيع تلمس حالة المرض النفسى فى قصة “إعادة التدوير”. حيث نرى المرض النفسى، يكمن فى اختيار لقطتى التصوير التى أصر السارد على أخذهما لزوجته، مستحضرا الماضى {لأنها أرادت أن ترضيه، وافقت أن يصورها وهى معصوبة العينين ويداها مقيدتان وراء ظهرها إلى لوحة رمبرانت (هندريكا تخوض ماء الجدول). وافقت أيضا على أن يصورها وهى ترتدى السواد، وفى يدها باقة زهور، بينما تنظر من النافذة إلى البيوت والشوارع. سمى الصورة الأولى خطيئة رمبرانت، والثانية مقبرة جماعية. كان يعرف أنها لا تشعر بأى خطيئة، ولا ترى أى مقبرة، وأن كل ما أفهمته لها السنوات أنه عدو لأحلامها}. ونستطيع تصور هذه الأحلام فى أنها –كفتاة، وكزوجة- تنظر للغد، للمستقبل، وتأمل فيه الفرحة والتفاؤل. بينما هو ينظر للماضى وللمقبرة والخطيئة، ويحاول إحياء الماضى، أو تدويره لإعادة إنتاجه، بمحاولة إحياء “رامبرانت” ولوحته من جديد. الأمر الذى يستدعى رؤية الصراع القائم بينهما، وهى التى تسعى لإرضائه، تقبل ما لم تكن ترضاه، إلا لذلك. ولم يخرج من تلك الحالة إلا عندما جاءت ابنته إلى الحياة، وابتسمت فى وجهه للمرة الأولى، حيث نعيش مراحل الزمن الثلاث: الماضى (رامبرانت)، والحاضر(الزوجة)، والمستقبل (الطفلة). حيث يصبح المستقبل هو الأمل الباقى، والحالة الوحيدة التى أخرجت السارد من تلك الحالة. وهنا أيضا تفتح القصة وتخرج من الحالة الفردية، إلى الحالة المجتمعية، بكل ظلالها، وعوائقها، الحالة دون ذلك الأمل.
العناوين
“مكان جيد لسلحافة محنطة”، هو العنوان الرئيس للمجموعة، رغم أن المجموعة لا تحمل أى قصة فيها، بذات العنوان، – وهى الصيغة التى تُتبع كثيرا فى عنونة المجموعات القصصية، والتى غالبا مالا يحمل الكاتب فيها رؤية كلية للمجموعة، وإنما هى تجميع لعدد من القصصية، أراد نشرها فقط- ولكنا هنا، يمكن القول بأن العنوان يحمل روح القصة، وهى الطريقة – وهى الوسيلة التى يلجأ إليها الكاتب عندما يسرى فى صلب المجموعة رؤية كليه، أو يسيطر عليه فيها روح واحدة، أو هم واحد، وهو ما نجده بصورة واضحة فى هذه المجموعة-. ولنتخذ من قصة “بالأصبع الصغير لقدم أعمى” نبراسا نتحسس فيه الطريق. حيث الرؤية المستترة، للتعبير عن الهم العام، المغلف بالهم الخاص، والذى قاد السارد، إلى تلك العزلة –النفسية- التى جعلته لا يتآلف مع الواقع المعيش، حيث أصبح الوطن فى إحساس السارد، ورؤيته “مكان جيد لسلحفاة”..تلك التى تميزت بالبطء الشديد، والعجز عن الحركة السريعة، بل ليتها سلحفاة تمشى، فمهما كان البطء، إلا أنها يوما ستصل، غير أن السلحفاة “محنظة” أى ميتة، وكأن الكاتب يزيد من شحنة الوقع لكلمة “ميتة”، وما تحمله من سكون، قد يمثل حالة السارد السارية فى القصص، وأيضا حالة المجتمع، الذى رأى فيه الثورة، او الإبنة، تهوى من حالق، ليسمع دويها كل سكان العمارة، والشارع، فانعدمت الحركة، أو انسد طريق الأمل، فحق على السارد أن يعتزل هذا الموات، وأن يهجر العالم المرفوض، فقد يجد فى الحوار مع النفس، أو فى الحلم، ما قد يعوضه عن ذلك الفقد.. وهى نفس الطريقة التى إتبعها الكاتب فى العديد من القصص التى لايوجد للعنوان ذكر مباشر بالقصة، وإنما هى قد تكون دللالة فى مثل “ظهور الأسنان”، أو الإيحاء فى مثل “”بورخيس”.
وما نستطيع قوله بعد قراءة هذه المجموعة، المرهقة فى تجريبها، وتغريبها – فى بعض الأحيان- تنوعت فيها الصيغ، وتحول بعضا منها إلى صورة أو لوحة، وإن لم تشمل الحركة، فإن الزمن وتغيراته ومروره، يخلق الحركية الداخلية فتتحول الصورة إلى فعل. وحيث تبدأ القصص جميعا من تأمل تقدم البشرية، المدمر، والقاتل، ماديا ومعنويا، فإنه إن كان الشكل القصصى قد تنوع، إلا أن الرؤية سرت بين سطورها، ناطقة برفض الواقع، الحاضر، والبحث عن الخلاص بالعودة إلى الفطرة، التى تعنى البراءة. ودعوة الوطن للخلاص من الماضى، ليبدأ المستقبل بروح ملؤها البسمة والأمل. وقد نستثنى من المجموعة، وجود قصة مترجمة للكاتب نفسه، ومجموعة القصص القصيرة جدا. ليكون لها حديث آخر. مع إبداعات ممدوح رزق.
…………………………………………..
[1] – ممدوح رزق – مكان جيد لسلحفاة محنطة – الهيئة العامة لقصور الثقافة- ط1 2013
[2] – وحيث كانت الأغانى حاضرة فى القصة، فكان منطقيا العودة إلى كلمات كامل الشناوى والتى غناها عبد الحليم حافظ (قدر أحمق الخطى سحقت هامتى خطاه).
[3] – بورخيس – الألف – ترجمة د. محمد أبو العطا – سلسلة كتاب شرقيات للجميه (51) – ط1 1998.
[4] – بورخس – المصدر السابق.