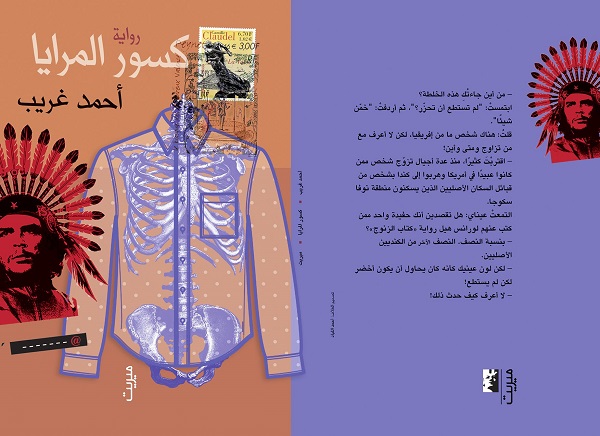هلال البادي
كل الاحتمالات واردة في حياة هارون الرشيد
احتمال أن تمطر سحابته في “الموالح” مثلا، فيأتيه خيرها وهو قابع في صالة شقته الصغيرة بـ”روي”، أو احتمال أن يصحو في فراشه صباحا ليجد رسالة من مستثمر خليجي، تبلغه الموافقة على البيع بالسعر الذي اقترحه، وحتما سيكون هو المستفيد من هذه الصفقة، رغم أن استفادة آخرين يعرفهم جيدا ستكون أكبر من استفادته. لا يهم ذلك، فهو هارون الرشيد الذي يملك ما لا يملكه غيره.
احتمال آخر أن يكسب الحرب، حربه التي لا يعلم الآخرون أنها حرب، هو احتمال وارد أيضا، احتمالٌ نسبته عالية جدا. لقد أجاد الحسابات، أجاد معرفة كل الأبواب المفتوحة والنوافذ المشرعة، ولا يستطيع أحد أن يفتح بابا أو نافذة دون أن يعلم بذلك. كان يراقب من بعيد، يراقب الكل، ويلعب مع الكل، ويخطط كيف يجعلهم جميعا سحابة ممطرة! ولن يتهاون مع أي أحد يحاول أن يجعله صغيرا، أو يقلل من قيمة ذكائه وقدرته على الربح، حتى السائق الذي تجاوزه قبل برهة في طريق السلطان قابوس، من اليمين، فإنه لن يفوز بتجاوزه ذلك. سيضغط على بنزين سيارته الـ”نيسان باترول” ويرد الصاع صاعين لهذا الأهوج الذي سبقه قبل برهة من اليمين. حتما سيتجاوزه من اليمين أيضا، وفوق ذلك، وحالما تجاور سيارته سيارة المعتدي، سيتمهل قليلا، ثم فجأة يضغط على دواسة البنزين ضغطة شديدة، فتصدر إطارات سيارته صوتا مألوفا يسمعه سائق السيارة العدوة، المذهول، الواقع في صدمته لحظتها، ثم تبتعد سيارته بعيدا.
لكن تلك حرب سهلة يمكن لسائق سيارة صغيرة من نوع “كيا” أن يفوز فيها، إذا ما كان ذلك السائق هو أيضا يحب مثل هذه الحروب. الحروب الحقيقية التي يضطر أن يدخلها هارون الرشيد، أو التي يريد أن يدخلها، لم تكن شارعا مسفلتا، لم تكن مع أشخاص مجهولين، بل كانت على الدوام، مع أناس يعرفهم تمام المعرفة، أناس بينه وبينهم ما قد يسميه البعض صداقة أو زمالة أو حبا! تلك الحروب التي يمكن لها أن تكون قاسية على روحه، ويمكن أن تفقده الكثير مما لا يريد أن يفقده.
لكنه ظل يردد في أعماقه أنها لم تكن حروبا عادلة، وأن خسارته فيها ليس لأنه لم يدرك ويحسب احتمالاته بشكل مستفيض ومتأن، بل لأنها كانت مباغتة وتحمل كثيرا من الخيانة وقلة الشرف!
في المقابل يدرك هارون الرشيد أنه لم يعد الخليفة الذي عليه ألا يقلق، أو يفكر في احتمالات خاسرة، يدرك أن الحياة الجديدة التي وجد نفسه فيها، هي ليست تلك الحياة التي كانت قبل أكثر من ألف عام! على النقيض من ذلك عليه، حتما، ألا يستغرب أو يحزن أو حتى يغضب عندما لا تأتي الاحتمالات لصالحه على الدوام، فحتى السحاب المثقل بالماء قد لا يهطل، قد يتبدد في أي لحظة، فيظل هو ذلك العطش الذي لم يجد ما يروي ظمأه.
ها هو الآن يترجل من سيارته التي أوقفها أسفل البناية التي يسكن فيها. يرفع رأسه فيطالع السماء الفارغة من زرقة أو سحاب، كم بدت قريبة هذه السماء! لكنه لا يصل إليها.
يخطو كما تعود بثقة تامة أن كل شيء لا يمكن إلا أن يكون ضمن احتمالاته السعيدة. يدخل البناية. يقف قبالة المصعد البطيء.
قال له صديق قديم كان يزوره في نهايات كل أسبوع: عليك أن تغير مكان إقامتك. مثلك ينبغي ألا يسكن هذا المكان المتهالك. يدرك هارون الرشيد أن هذه البناية التي تقع على ضفة شارع الفراهيدي قبالة مسجد السلطان قابوس في روي، بأنها ما عادت تتحمل أمثاله. إنها بناية تئن تحت وطأة الروائح الزنخة القادمة من وراء البحار، يدرك أن لديه القدرة الآن على أن يختار المكان المناسب الذي يريد، لكن المكان المناسب هو هذا المكان، فشقته هذه تذكره بأن احتمالاته ما زالت غير مضمونة تماما، كما أنها تحمل ذكريات لا يريد الاستغناء عنها، ذكريات صاخبة جدا، ذكريات أغلبها حلو لا مرارة فيه.
قبل عدة سنوات فقط كان جرس الباب سيصدر نغمة مألوفة له، سيبتسم حينها، ويفتح الباب. ها هي غرايس تطل من خلف الباب، تطل بهية نضِرة، مملوءة بالحياة. ستقول له: آي ميس يو! سترتمي في حضنه قليلا، وتهديه قبلة عاشقة، قبل أن تعاتبه لأنه لم يتصل منذ يومين.
منذ أن تعرف عليها، وهو يعيش حالة من الغرابة. لم يعتد هارون الرشيد أن يشعر بالحب هكذا، لم يعتد أن تكون علاقته مع النساء إلا في شكل واحد فقط: جسدان عاريان يتماوجان تارة فوق الكنبة الصغيرة، وتارة أخرى على سريره في غرفة نومه غير المرتبة على الإطلاق.
مع غرايس تغير، ما عاد الخليفة الوقور الذي لا يفكر في المرأة إلا كجارية ترضيه وحسب. ما عادت نوازع الرغبات هي ما يحركه معها، بل كان ذلك الشعور بالدفء كلما كانت معه.
سيحدث أن يمارسا هوس الرغبات المتفجرة كلاهما، لكنه وبعد أن ينتشيا، سيفكر في أن يذهبا سوية إلى مطعم ما للعشاء أو جولة عند شاطئ البحر، أو يحجزا تذكرتين لحضور فيلم في سينما الشاطئ.
كان يحب هذا الأمر، يحب الشعور بأن هناك امرأة ما لا تفكر فيه كرغبة، أو كمحفظة مال، وغرايس ما كانت كذلك قط، كانت أحبته، منذ ليلتهما الأولى في شقتها بالخوير. سألت نفسها مرارا عن ذلك الاستسلام الذي وجدت نفسها فيه، كيف وقعت في شباكه هكذا؟ إلا أنها بعد أيام بدأت تكتشف أنها تفكر فيه على الدوام، وبأنها كلما تذكرته كان قلبها يخفق. كانت مشتتة في عملها ولا تفكر إلا في وجهه، ذلك الوجه المفعم بالغموض، ولم تكن نزوة جنسية تلك التي تلح عليها، إنما كل تفكيرها كان منصبا في حضوره، وبأن تحتضن يداها يديه. كانت تشعر بسعادة غامرة وهي تفكر فيه على ذلك النحو، وكم اختبرت أعماقها بعده عنها، لتسارع في الاتصال به. تتحجج بأي شيء كي تسمع صوته، تطلب منه أن يحضر لها شيئا من المحل، مع أنها لم تكن بحاجة له، بل قد لا تتذكر بعد برهة ما الذي طلبته!
وهارون الرشيد كان يفرح أول الأمر بأنه استطاع أن ينجح، كالمعتاد، في صيده الجديد. إلا أنه بعد حين اكتشف هو الآخر أن الأمر بدأ يتجاوز مجرد النزوات العابرة، وبأن غرايس ليست كأي واحدة عرفها من قبل، ولم يدرك أنه لم يفكر جيدا تجاه غرايس، ظل تفكيره ناقصا وغير كامل، إذ في اللحظة التي اكتشف أنها تعني له الكثير في حياته، كانت هي تغادره بكل بساطة.
مشكلة هارون الرشيد أنه يفكر في نفسه وحسب، مشكلته أنه قد لا يعير الآخرين أي اهتمام، كل ما يعنيه أن ينتصر، إذ كانت الحياة بالنسبة له حروبًا واحتمالات، حروبًا إما ناجحة أو خاسرة، واحتمالات متعددة، ولا يهم أي شيء آخر.
هذا بالضبط ما حدث مع غرايس.
هي تولهت به، وكانت تمنحه وتمنح نفسها كل الحب الذي كانت مقتنعة به، أما هو فالحب أمر غامض لم يألفه بعد، وعندما يكتشف أنه أحب، سيكون الأمر فات، سيكون كل شيء انتهى.
كلما ترددت كلمة “أحبك” على مسامعه، كان يظن أنها الكلمة التي تعني بأنها تريد مزيدا من الجنس. كان هذا أمرا دائما ما يشعره بالتفوق، فالأخريات كن يصرخن بهذه الكلمة تحديدا تحت وطأة ضرباته المتتالية فوقهن. إنها كلمة مخاتلة بالنسبة له، ولا تعني شيئا سوى الرضا والسعادة بما كان يفعله معهن. كان يرى كل ذلك الجموح يتصاعد عندما تطلق إحداهن آهتها: حبيبي، أنت حبيبي، أحبك! كلهن أطلقن الكلمة، حتى العابرات اللائي لم يعرف أسماءهن الحقيقية، بل لم يقلن شيئا سوى تلك الكلمة وحسب، ثم مضين بعيدا ولم يرهن بعد ذلك.
لم يكن للكلمة معنى آخر.
لم يكن لها أي احتمال آخر.
سألته غرايس مرة: هل تحبني؟ فكر طويلا، فكر إن كان هناك ما يشي بمعنى آخر غير ما ترسب في أعماقه. ابتسم لها، وكانت ابتسامة حائرة. هل تحبني؟ كررت سؤالها عندما رأت الشك في عينيه. لكنه ضمها إلى صدره ومسد على رأسها، أراد أن يخاتل كعادته، كمحارب متمرس يدرك أن الوضع القائم أمامه محير تماما.
ولأنه ظل في حيرته تلك يمارس ما تعوده، وما ألفه من قبل؛ كان عليه أن يخسر!
حدث أن اتصلت به فيوليتا، طلبت منه أن يسافرا نهاية الأسبوع إلى دبي، سيقيمان في غرفة واحدة، هكذا أخبرته، وأنهما سيعيدان تجديد علاقتهما التي بردت في الآونة الأخيرة.
فيوليتا كانت تعرف هارون الرشيد منذ زمن، كان يفعل ما لا يستطيعه أي رجل آخر تعرفت عليه، وكانت تشتهيه دائما، لدرجة أنها في أحايين كانت تستأذن من عملها كي تذهب إليه. لم يكن مهما المكان الذي يلتقيان فيه.
ومنذ أن عرفته بغرايس ما عادت تلتقي به كثيرا، وكانت ترى كيف أن غرايس تتغير، كيف أنها تعيش حالة من الحبور، بل إن غرايس ما عادت تتواصل معها كما كانتا من قبل. لقد فهمت أن الأمر بينهما تنامى، ولا مانع لديها، لكنها كانت لا تريد أن تفقد هارون الرشيد.
هكذا اتصلت به وأخبرته بخطتها.
هارون الرشيد لم يفكر في أن ما ينمو بينه وبين غرايس يمكن أن يكون حاميا، يمكن أن يكون خطيرا، وأن يفجر أشياء لم يتوقعها، أن يفجر، على سبيل المثال، مشاعر الحزن التي لم تكن تخطر بباله إلا نادرا، أن يحدث له أن يأرق ولا يستطيع النوم أو يفكر في أمر إلا فيها. سيحدث هذا عندما يفقدها، وساعتها يتأكد له أن احتمالات السعادة أقل من القليل الذي كان يسعى إليه!
عادا من دبي، وكان يظن أن الأشياء يمكن أن تظل كما هي، لا وارد في فكره الآن أن يحدث ما يكدر صفو البال بعد رحلة يانعة. مارس حياته على النحو المعتاد، وكان يستعد لخطوة مهمة جديدة، خطوة تجعله في المقدمة، وتجعل سحابته تمتد أكثر فأكثر. كان في هذا الأسبوع على موعد لبدء عمل جديد، في شركة مقاولات كبرى. فرصة ترصّدها بشكل جيد حتى اقتربت منه وآن له أن يقطفها.
إلا أن الأمور ليست كلها في دائرة احتمالاته السخية، فبعد يوم واحد فقط، اتصلت به غرايس، كان صوتها متحشرجا وهي تطلب أن تراه، لكنه لم ينتبه لذلك، كل الذي انتبه إليه أنها تريده، حتما سيقضي ليلة جميلة، لكن الأهم أنه كان أكثر حماسة لرؤيتها، وأحس أنه مشتاق لرؤيتها لا لشيء إلا لأن حضورها الشفيف يسعده. لم يكن يفكر في فحولته تلك اللحظة، رغم أنه يعرف أن نهاية الليلة هي ملذات وتفجير رغبات عميقة.
في الحقيقة أن هارون الرشيد لم يكن يعلم بعد، أنه سقط في هوة الحب، كما حدث مع غرايس التي كانت تقف لحظتها أمام المرآة تبكي بحرقة. كانت شبه منهارة، تصرخ في ذاتها التي في المرآة: أيتها البلهاء كيف صدقته؟ كيف آمنت أنه أحبك كما أحببته؟ كيف لك الآن أن تكوني أنت هي التي تعرفينها؟ لقد خذلك، رمى بك في وادٍ سحيق بعد أن أحرق أعماقك، ودمرك تماما.
كانت مسحوقة في تلك اللحظة التي سمعت فيها صوت جرس الباب. كان هارون الرشيد يستعد لحظتها لأقسى صدمات حياته. لملمت نفسها ومسحت دموعها، ثم مضت لتفتح الباب. كان وجهها الذي يطل الآن أشبه بتفاحة تلقت قذيفة!
تغيرت تعابير وجه هارون الرشيد وهو يرى ذلك الدمار.
- ماذا حدث؟
سألها ولم ترد. كانت بركانا يوشك على الانفجار. عقد حاجبيه مستفسرا، ولم ترد مجددا.
- هل أنت بخير؟
دخل إلى داخل الشقة، لكنه ظل في حيز قريب من الباب، أراد أن يحضنها، لكنها صدته. ساعتها أيقن أن في الأمر شيئا ما لا يعرفه.
- ما بك؟
استفسر، إلا أنها ظلت تنظر إليه بعينين غاضبتين ومملوءتين بالحزن في آن. كانت تتأمله، وفي الحقيقة كانت لا تعرف ماذا عليها أن تفعل أو تقول حينها، إلا أن ما تدركه هو أن هذا الرجل الواقف أمامها الآن لا يكن لها الحب الذي تكنه هي. وفجأة، وفي برهة الصمت الذي كانا فيه تلك اللحظة، قالت له بكل وضوح: لقد انتهى كل شيء! اذهب، لا أريد رؤيتك بعد اليوم!
ظن هارون الرشيد أن ما يسمعه هو صوت آخر غير صوت غرايس، بالأحرى ظن أن هذا الأمر لا يحدث، وأنه لا يقف أمام غرايس، غرايس التي مذ عرفته كانت مملوءة بالفرح والتوهج، تتصل دوما به كي تقول له مثلا: اليوم غداؤنا معا. ومهما كانت انشغالاته تلك اللحظة فإنه وعكس ما كان يفعل من الأخريات، يبتسم ابتسامة لا يراها أو يدركاها، ويسألها أين؟ لم يكن يعرف لماذا يتصرف على ذلك النحو كلما كلمته غرايس؟
يلتقيان، يتبادلان الضحك والابتسام، يتأملان وجهي بعضهما البعض، لا يفكران إلا في أنهما سعيدان تلك اللحظة. غرايس تدرك أنها واقعة في حب هذا الرجل، ولكنها غير متأكدة منه.
- ماذا؟
ألم تسمع يا هارون الرشيد؟ لقد انتهى كل شيء، ما عادت غرايس تريدك بعد اليوم، وعليك أن تنصرف! فلتنصرف! وهارون الرشيد ساعتها كان واقعا في ذهوله، غير قادر على فهم ما يجري. إنها المرة الأولى التي يقف فيها أمام امرأة لتقول له أن يرحل من أمامها، وبأنها لا تريده. هذا أمر لم يحدث من قبل، بل إن المحاولات الخاسرة السابقة كانت تنتهي في البداية، لا في منتصف الطريق. الأمر هنا مختلف تماما، فغرايس التي لطالما رددت على مسامعه كلمة “أحبك”، و”أنت حبيبي”! ليست هي ذاتها التي تقف الآن أمامه.
ظل ساهما لوهلة، قبل أن تكرر ما قالته من قبل، ولأول مرة يشعر أن ما يحدث غريب عليه، وبأنه لم يكن مستعدا لمثله على الإطلاق. عندما وجدها تكلمه بكل جدية، لم يقل أي شيء، بل اختار الانصراف، وكان ذلك واحدا من أخطائه التي ما عاد يعدها الآن.
لو أنه أصر أن يعرف ماذا يحدث، ولماذا كانت هي في ذلك الوضع السيء البائس، وذلك الغضب الذب لا يفهمه، لو أنه بعدما فهم ما حدث، وهو أمر سيحدث بعد حين، اعتذر لها، بادرها بكل الكلام الذي حفظه من القصص والأشعار التي كان يطالعها في المكتبة الإسلامية بروي، لربما لم تفرط من يده.
لكنه في كل مرة يتذكر تلك الأيام ينظر لنفسه من الداخل، ويقول إنه حاول مرارا وتكرارا معها، اتصل بها عدة مرات، بعدما اكتشف أن فيوليتا كانت حكت لها ما دار بينهما في دبي، وفي كل مرة تغلق الهاتف في وجهه، حتى عندما أصر ألا تفعل ذلك وتسمعه، لم تسمع منه إلا ما يجعلها أكثر إصرارا على إغلاق الخط. أرسل لها بعد ذلك رسائل بريدية عديدة، وفي كل مرة لا يصله أي رد.
كان يعتذر في كل مرة، لكن اعتذاراته كانت غبية، وساذجة، بل مملوءة بالغرور أيضا، فلا أحد يحاول أن يعتذر لامرأة أهانها، أنه على علاقة بغيرها، وهن كثيرات، وبأنه كان يشعر أن هذا الأمر اعتيادي!
لكنه في أعماقه يدرك أنه كان مخطئا، في الوقت الذي كان يحبها، لكن اكتشاف الحب يأتي بعد الخسارة المؤلمة، يأتي في اللحظة التي لا يمكن للزمن فيها أن يعود للوراء، ويأتي بلا احتمالات، فالحب لا يأبه للاحتمالات على الإطلاق!
كان ينظر إلى الشارع من نافذة غرفته، متذكرا كل ذلك، ومشتاقا لرؤية وجهها. هل تبدل وجهها الآن؟ سأل نفسه وهو يحاول أن يرسم الصورة الأبهى لها في ذاكرته، وجهها المبتسم وهي تنهي قبلة عميقة فاجأته بها. يبتسم بدوره، يحاول أن يقبض على تلك الملامح التي بدأت تغوص بعيدا في الذاكرة. ثم ينتفص فجأة، يعقد حاجبيه، ويسأل: ماذا كنت ستخسر لو أنك ذهبت لتراها عندما زرت لندن أول مرة؟
كان ذلك بعد عدة سنوات من رحيلها، وكان هو ما عاد ذلك الفتى الذي عرفته قبل سنوات. لقد تغيرت الحياة، تغيرت روي، تغيرت كل مسقط، وما عادت هي تلك البلاد الهادئة كما تظن، وكما كانت تقول له في لياليهما الحميمة.
وأما هارون الرشيد فإنه الآن تحرر من سطوة الآخرين، أو هكذا يظن، تخلص من أشياء كثيرة، ولم يعد شخصا يعيش في الظل. ليتها تعرف أنه الآن هنا في بلادها يشارك في ورشة عمل عن الحقوق المدنية، تلك الأشياء التي لم تكن تخطر له من قبل على بال، فمنذ أن رحلت هي، كان عليه أن يتخلص من الحزن الذي تركته في حياته، من الفراغ، من وجع الهزيمة.
هكذا أخذته الحياة إلى مناطق جديدة، تعلم فيها أن يشكل إنسانا آخر غير الذي عرفته، معقد بشكل لافت، كأنه لوحة من لوحات دالي! سوريالية وخيالية وكل شيء فيها ذائب أو على وشك الذوبان.
كان ينظر إلى واجهة حانة في أحد شوارع لندن، يتأمل تلك اللوحة التي تطل من واجهة الحانة الزجاجية، وكأنها تقول للعابرين: هنا لا حدود للوقت! هنا كل شيء مقلوب! وكان بوده لو أنه قادر على أن يمسك الوقت، يمسكه من ذيله أو عنقه أو من أي جزء من جسده، يصفعه على وجهه، ويقول له: أكرهك عندما تفعل ذلك! أكرهك عندما لا تتوقف أو تعود للوراء قليلا! لماذا لا تفعل ذلك؟ أنا هارون الرشيد الذي يمتلك كل الاحتمالات، فلماذا أسقط أمامك؟! لماذا تسقط احتمالاتي معك؟
سيتعلم لاحقا أن الوقت لا يمتلكه أحد، وبأن عليه أن يقفز فوقه إذا ما أراد النجاة.
…………………….
[1] قاص وكاتب مسرحي عُماني