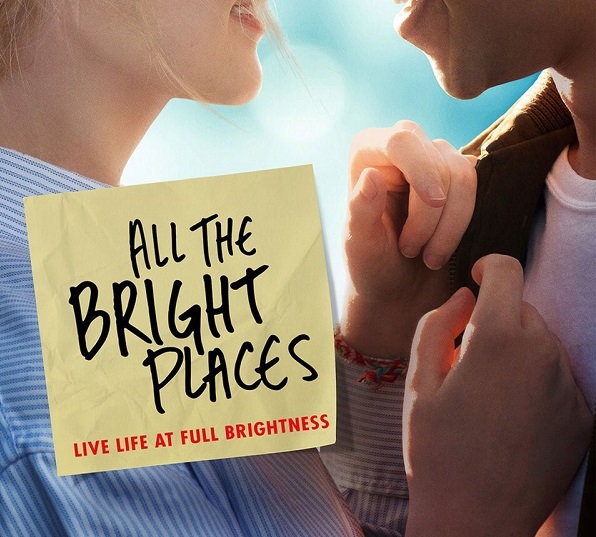أحـمد عبد الرحـيم
مجمل المسيرة السينمائية للمخرج الأمريكى أوليڤر ستون تجبرنى أن أشبّهه بشخصية الشبح مقطوع الرأس فى الفيلم الأمريكى Sleepy Hollow أو سليبى هولو (1999)؛ فارس تمت خيانته، وفُصل رأسه عن جسده، لكن دفْن رأسه بعيدًا عنه جعل روحه قلقة، فتدب فيه الحياة، وينطلق شرسًا على جواده، ليحصد رءوس قاتليه من مبجلى المدينة، وهى عينها رءوس الفساد فى هذه المدينة، ويظل الشبح يقطع الرأس تلو الآخر، لعل أرقه الرهيب يهدأ، ويجد رأسه فى النهاية.
ليس أوليڤر ستون إلا المُعادِل الفنى لهذا الشبح؛ فهو فارس سينمائى متمكن، جواده التقنية المتميزة، صاحب رسالة تؤرقه طوال الوقت، يحمل سيف فكره، وينطلق عبر فن السينما، ليحصد رءوس الفساد فى المؤسسات الحاكمة لأمريكا، باحثًا عمن سرق رأسه، وأطاح بوعيه، وشوّه مصيره؛ فإن خيانته القديمة كانت فى حرب فيتنام (1955: 1975)، عندما ظن أن تدخل أمريكا هناك حرب مقدسة لابد أن يخوضها بشجاعة وفروسية، وإذا بها مستنقع يغرق فيه الضمير الأمريكى، ليغوص وسط دماء وأشلاء بشر لا ذنب لهم، ويصبح جزءً من قضية كان فيها، وآلاف الشباب الأمريكى، الجانى والمجنى عليه. يعود الفارس، مُكرّمًا بأوسمة عدة، لكن مهزومًا من الداخل، ليفقد رأس صوابه (أدمن ستون المخدرات لفترة ليست بالقصيرة)، ويثور فى وجه مجتمعه، مُدركًا أن هذا المجتمع ليس إلا دمية فى قبضة مؤسسات كبرى تحرّكه فى خبث وقسوة صمّم أن يكشفها فى أفلامه مخرجًا.
تظهر بوضوح أفكار الانفصال عن المجتمع، وإراقة دمه انتقامًا، والتمرد على السلبية واللامبالاة، فى ثانى أفلامه الطويلة مخرجًا، وثالثها مؤلفًا؛ The Hand أو اليد (1981)، حيث يد رسام تنفصل عنه وعن براءته، لتنفذ جرائم قتل متعددة، مُحقّقة ثأرًا كانت تعجز عنه، و”يد” ستون مخرجًا لا تمتد إلا للرءوس الكبيرة فى عالم أمريكا الحديثة، فهو لا يغفر أبدًا خطيئة فيتنام، مؤرّخًا هذه الحرب، وآثارها المدمرة، ونيرانها العكسية على نفسية الشعب الأمريكى فى أفلام Platoon أو فصيلة (1986)، وBorn on the Fourth of July أو مولود فى الرابع من يوليو (1989)، وHeaven & Earth أو السماء والأرض (1993)، ويريق دم السياسة الخارجية، خفية الأصابع، للولايات المتحدة فى Salvador أو سلڤادرو (1986)، ويضرب بسيفه الذى أصبح بتارًا عالم البورصة، وتايكونات المال، وسياسة الطمع فى Wall Street أو شارع المال (1987) وWall Street: Money Never Sleeps أو شارع المال: المال لا ينام أبدًا (2010)، ويوجّه ضربة فى الظلام لهولاء المسئولين عن قتل الرئيس چون كينيدى فى JFK أو چى.إف.كيه (1991)، ثم أخرى لسلبيات الرئيس ريتشارد نيكسون فى Nixon أو نيكسون (1995)، كذلك للرئيس چورچ دبليو بوش، ساخرًا من عقليته وقراراته فى W. أو دبليو (2008)، بل لم تفلت منه المؤسسة الرياضية الأمريكية، بكل ما يحيط بها من رءوس فساد، فى Any Given Sunday أو كل شىء وارد (1999).
أما فى Natural Born Killers أو قتلة بالفطرة (1994)، فيطيح سيف الفارس المهتاج، فى صراحة وعنف، برأس الإعلام الأمريكى، والذى يربطه باتجاه الشباب إلى الإجرام، فى علاقة تبدو أشبه بعلاقة مفيستو بفاوست، فى مسرحية فاوست (1808) للمؤلف الألمانى جوته، التى يغوى فيها مفيستو (الشيطان) فاوست (الإنسان)، كى يبيع روحه، ويستمتع بحياته الدنيوية، مقابل خلوده فى الجحيم. فشيطان اليوم، الإعلام، يغوى الشباب بالشهرة إذا ما تحولوا للإجرام، وهو ما يؤدى إلى نعيم مؤقت فى هذا العالم، يوازيه جحيم أبدى فى العالم الآخر.
وكأن ستون آتى بأليكس، بطل فيلم A Clockwork Orange أو برتقالة آلية (1971) لستانلى كوبريك، ذلك السفاح البريطانى اللامبالى الذى يعيش ضد المجتمع، ولا يشبع من الجريمة، ليجعله يُولد فى أمريكا، مُسميًا إياه ميكى نوكس، وعلى عكس أليكس، الذى لم يعشق سوى فنون فساده، يقع ميكى فى عشق فتاة، مالورى ويلسون، هى ثمرة الحياة الاستهلاكية المرعبة للطبقة الوسطى الأمريكية. كلٌّ يجد نفسه، أو بالأحرى ضياعه، فى الآخر، ويجتمع تمردهما وغضبهما ليعيثا فسادًا فى مجتمع كان ذنبه أنه أفرز مثل هذه النماذج، وأشرف على مراحل ترعرعها. ثم يصبح أليكس هذه المرة نجمًا، ويتحوّل ورفيقته إلى نماذج مُحبّبة على صفحات المجلات وشاشات التلفزيون، لنتابع ما يمكن أن يفعله سيرك الإعلام بهذا الشر المطلق؛ عندما يذكى النار، كى يحقِّق مزيدًا من المكاسب، ويحوّل العنف إلى تجارة؛ صحيح مُدمِّرة لكنها مُربِحة!
لا يكتفى الفارس بضرب رأس الإعلام، ولكنه يخلع رأس إدارات السجون أيضًا، الأعجز – فى نظره – من تأهيل آدميين صالحين فى شىء اللهم إلا مزيدًا من تحطيم مجتمعهم، مُدينًا جهاز الشرطة فى فجاجة شنيعة؛ فضابط الشرطة النشط، مؤلف الكتب، ليس إلا قاتلًا ساديًا، يتخذ ميكى قدوة، ومالورى ربة لنشوته الحسية!
لكن ستون فى النهاية ينتصر لميكى ومالورى، حينما تذهب كل هذه الشخصيات الجانبية فى كرنڤال دموى مخبول إلى الجحيم. ربما لأن هذين السفاحين أكثر براءة، وأقل وحشية، من كل هذه الرءوس الفاسدة، لذلك لا يستحقان مصيرهم. أو ربما لأن الواقع الأمريكى عند ستون على هذه الدرجة من الاختلال التى تجعل اندماج ميكى ومالورى فى ثناياه أمرًا عاديًا، ووضعًا متناغمًا! يتكامل مع ذلك لقطة خلال تترات النهاية تقدمهما كزوجين يعيشان وسط أطفالهما فى عربة مجهزة كمنزل، فى سخرية مريرة تبدى المجتمع الأمريكى مستوعبًا لهذين السفاحين كمواطنين عاديين، وكأن ستون صار هو ميكى ومالورى، مستخدمًا إياهما فى قطع رءوس الإعلام، والسجون، والشرطة، باعتبارهم الأشرار الحقيقيين فى عالم الفيلم والواقع.

فى طموح فنى جامح صنع ستون الفيلم – بالكامل – من وجهة نظر القاتلين، مُخترِقًا عقلهما، فاضحًا مكونات ثقافتهما من عوامل الرخص والتفاهة التى تُغرق الثقافة الشعبية الأمريكية، فيتجلى خيالهما المشبَّع بصور هذه الثقافة فى مشاهد متفردة، كمشهد لقاء الشخصيتين لأول مرة فى عودة إلى الماضى تحيل الذكرى لحلقة سيتكوم قصيرة؛ تنتقم من استهلاكية والدى البطلة، وتعرض نوعية الثقافة التى توجِّه خيالها. يتكرّر الأمر فى مشهد المطعم، حيث كانت أولى مذابح الفيلم، عندما يتصيد ميكى صاحبة المكان بمسدسه على طريقة First-person shooter أو رؤية الأحداث من وجهة نظر مُطلق النيران؛ وهى تقنية لصيقة بألعاب العنف فى الكومبيوتر، والتى حاكاها المشهد بصريًا وصوتيًا. كما استغل ستون فكرة اللقطات الأبيض والأسود وسط اللقطات الملونة كلقطات “داخلية” تقدِّم وجهة نظر الشخصيات فيما يعيشونه من واقع.
وبينما كان أليكس البرتقالة الآلية مجردًا من الندم، نجد ميكى يندم مرة لأنه قتل هنديًّا أحمر آواه وزوجته، ليكون هذا، بالنسبة له، القتل الوحيد الخطأ الذى ارتكبه. فى الواقع، هذا الهندى العجوز، سليل تاريخ القهر الأمريكى القديم، وصاحب الأرض الذى تحوّل لمنبوذ، يجسّد هنا ضمير ضياع البطل، لذلك قتله خطأ كان أشبه بقتل ميكى لنفسه. إن هذا المشهد يشير إلى تحوّل ميكى إلى “راعى بقر” رغم أنفه، ليكتشف لأول مرة أن سمعته كضحية انهارت، منقلبًا أمام ذاته إلى قاتل أثيم، بينما كان راضيًا عن كل جرائمه السابقة لكونها تتم لسبب أو لآخر. كما ينجح الفيلم فى صياغة شخصية مختلفة لمذيع التلفزيون، واين جيل، الذى يظهر كالشيطان، موسوسًا للعالم كله بالجريمة، مغنيًا وراقصًا للعنف، مخبئًا داخله حيوانًا مفترسًا يقدِّس ميكى، ويعتز بجرائمه، ومن ثم فى ظروف هائجة، كشغب السجن، ومحاولة الهرب، أُثير الحيوان بداخله، فخلع تنكره الطويل، ومارس شره المكبوت، مُعلنًا عن هويته الأصلية كميكى آخر، وإن كان أضعف بكثير من الأصل لذا ينتهى ضحية له. فى ضمير يقظ، لا يستثنى ستون نفسه من الفكر الذى يهاجمه، ويبرز انخراطه فى ممارسة العنف كتجارة، عندما يورد لقطة من فيلمه ككاتب سيناريو؛ Scarface أو الوجه ذو الندبة (1983)، وذلك فى المشهد الذى تطل فيه صور العنف القبيحة، فى التاريخ والإعلام والفنون، من وراء زجاج غرفة فندق فقير يجتمع فيها البطلان ليمارسا الجنس بعيدًا عن ضجيج العالم!
على الجانب الآخر، يخطئ ستون أخطاء مروّعة، لا تسىء لفيلمه، وإنما تكاد تقتله فعليًا.
نفخ ستون فى النار حتى أحرقته، فصناعة الفيلم – بالكامل – من وجهة نظر بطليه، المختلين، المُخدَّرين، المجانين بالعنف، مع المبالغة فى ذلك لما بعد التخمة، أنتج قنبلة ضخمة تنفجر فى وجهك، بدلًا من فيلم يخاطبك. إن ستون استخدم عددًا هائلًا من العدسات، والفلترات، والمؤثرات الخاصة، وأنواع الفيلم الخام، مع كاميرا لا تتخذ وضعًا تقليديًا أو أفقيًا على الدوام، كل ذلك مضروب فى إيقاع جنونى لاهث مكوّن من 3000 لقطة (الفيلم العادى يكون بين 600 و700 لقطة)، وكابوس من العنف المتأجج على الشاشة بلا انقطاع. إنها ليست إذًا “ستون استخدم”، وإنما “أفرط فى الاستخدام”!
شخصيات كمدير السجن، أو ضابط الشرطة، ظهرت متمادية الهزلية، على نحو يناسب كوميديا سوداء صارخة، ناهيك عن قصر حجم دورها. زخم السباب والجنس والعنف أغرق الفيلم، ليصبح شبيهًا بأبطاله على نحو مزر. ومع حالة الفيلم كشلال ساخن من الدماء، وهلوسة جبارة التلاطم، صرت أمام فيلم عنيف آخر، من هذه النوعية التى ينتقدها ستون، ليصبح الرجل مصابًا بالمرض الذى يشخِّصه!
بغض النظر عن صراع نسخ الفيلم مع الرقابة، فى دول مثل بريطانيا وإيرلندا، حدثت بعد عرض الفيلم سلسلة جرائم قتل وحشية اعترف مرتكبوها بفعلها تأثرًا بالفيلم. من هذه الجرائم بالولايات المتحدة: واقعة سنة 1995 فى أوكلاهاما، عندما شاهد ولد وبنت مراهقان الفيلم لأكثر من مرة، تحت تأثير المُخدِّر، ثم انطلقا لقتل موظف فى متجر، ومدير محلج قطن. مجزرة مدرسة كولومباين الثانوية سنة 1999 فى كولورادو، التى راح ضحيتها 12 طالبًا ومدرسًا، أدلى واحد من التلميذين اللذين ارتكاباها قبل انتحاره أنه رغب فى التحول إلى “قاتل بالفطرة”. جريمة سنة 2006 فى ألبرتا، عندما قتل شاب وحبيبته كلًا من والديها الرافضين لعلاقتهما، وشقيقها الأصغر، وذلك بعد أن شاهد الشاب الفيلم، وأخبر أصدقاءه أنه سيصبح “قاتلًا بالفطرة” مع والدى حبيبته. جريمة سبتمبر 1994 فى تكساس، عندما قطع ولد فى الرابعة عشرة رأس بنت فى الثالثة عشرة، معترفًا أنه أراد أن يصبح مشهورًا كـ”القتلة بالفطرة”. جريمة أكتوبر 1994 فى يوتا، والتى قتل فيها فتى فى السابعة عشرة زوجة أبيه وأخته الصغرى، بعد أن شاهد الفيلم 10 مرات، وحلق رأسه كـ”ميكى”، مرتديًا نظارة شمسية دائرية العدسات مثله!
أضف إلى ذلك دعاوى قضائية رُفعت ضد شركة الإنتاج، وستون نفسه، كمشاركين فى هذه الجرائم بالتحريض، إحداها كان لكاتب الروايات الأشهر چون جريشام، لكونه صديق مدير محلج القطن الذى قُتل سنة 1995، وهى دعاوى انتهت جميعًا بتبرئة صناع الفيلم؛ بناءً على التعديل الأول فى الدستور الأمريكى، والذى يحمى حرية الفن. رأيى فى ارتباط هذه الجرائم بالفيلم من عدمه سيتراوح ما بين أمرين؛ إما أن محاولة ستون لرسم تلك اللوحة الكاريكاتيرية الدموية التى تكشف شرور الإعلام، وتتهكم على سفاحى العصر الحديث، تحوّلت – بسبب الصياغة التى اختارها – إلى شر جديد، وتمجيد لهؤلاء السفاحين، وهو ما أغوى بعض المختلين باقتراف جرائمهم. أو أن هذا يؤكد وجهة نظر ستون من أن عناصر الثقافة فى أمريكا تنتج الكثير من ميكى ومالورى، وأن الفيلم لم يعرض إلا قمة جبل الجليد فحسب.
يظل الفيلم متوحش بصريًا وإيقاعيًا، وإن لدرجة مُرهِقة أحيانًا، تتضاعف فيها الأسلوبية، ويتضاءل المغزى. كما أنه يحذِّر من العنف، ويحتفى به فى الوقت ذاته، وكأن ستون فى طريقه لإظهار ضرر السم، أطعمه لنا. لذلك ليس غريبًا أن تختار مجلة Entertainment Weekly الفيلم كواحد من أكثر الأفلام المثيرة للجدل فى تاريخ السينما، وتضعه مجلة Premiere فى قائمتها لأكثر الأفلام خطرًا على الإطلاق!
إن أوليڤر ستون لم ينتبه إلى أن الإفراط فى الشىء يفسده، وكان تعامله مع الجنون جنونيًا؛ وهو ما أنتج فى النهاية أكثر أعماله طموحًا وجموحًا، فنيّة ومغامرة، و – أيضًا – إسرافًا وتشوُّشًا. على أى حال، علينا أن نشكر الظروف التى حوّلته إلى قاطع لرءوس الفساد فى المجتمع الأمريكى، ونرجو أن يطول بحثه عن رأسه المفقود، وتقل محاولاته المضطربة، وضرباته المتهوّرة.. كهذا الفيلم.
……………….
*نُشرت فى مجلة أبيض وأسود / العدد 32 / أغسطس 2014.