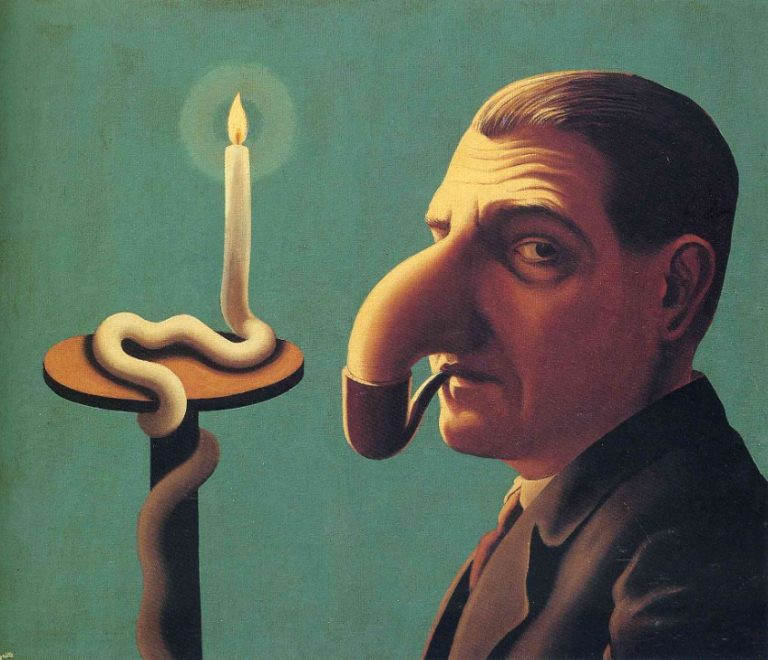حسين عبد العليم
أغنية:
قمتُ بضغط زرّ المُسجِّل، تصاعد صوت ماجدة الرومي: كل شئ عم يخلص/ وجوه الأصحاب/ ضحكات الأحباب.
مُتفرِّقات:
أروقة الأزهر، مجاذيب الحسين، مقهى الفيشاوي، المساجد القديمة، المشربيات، موسيقي الملايّة اللفّ، الشوارع ذات البلاط الأسود المضلع، باب زويلة والسلطان الشاب طومان باي، بائعو السبح، رائحة البخور، الكنائس المهيبة، ميدان سليمان باشا ومكتبة مدبولي ومقهى ريش وسوق الحميدية، باب اللوق، أفيشات الإعلانات وحتى سوق الجمعة بإمبابة.
فتور:
دخلتُ إلى شقتي بارداً، هللت طفلتي فعانقتها فاتراً، طالبتني بالمصاصة والفول السوداني وأن أقلد لها القرد، لم آبه لها فقالت: بابا وحشْ. تجنبتني لفترة من الوقت ثم بدأت تقترب مني بالتدريج في كبرياء، أخيراً قبّلتني وجَلست على حجري وقالت: بابا حلو. كانت زوجتي تتحدث إليّ من الحمّام بصوت مرتفع وهي منهمكة في الغسيل، قالت عنها “تحتاج إلى علقة، بالت في ثيابها وسكبت الشاي فوق السرير.
مساءات قربية:
تقول أمي: أتمنى أن أعرف كيف يعلمون بوصولك من القاهرة؟، بمجرد مجيئك يتوافدون وكأنهم يشمون رائحتك. وتأخذنا الجلسات الطويلة، نتحدث في كل شئ ويتكرر عمل الشاي والقهوة. تبتسم أمى رغم الإنهاك، ورغم إسرافنا في السجائر والمشروبات: أبقاك الله، كُلما أتيت تأخذ صوتنا وتفتح لنا البيت عوضاً عن أبيك وتجعلنا نشعر بالحياة أنت وأصحابك.
مٌقطّرات:
جلستُ إلى المكتب، قربت أنفي وتشممت خشبه العتيق ذا الرائحة المميزة، إذا رجعت إلى الخلف قليلاً في جلستي فسوف يوخزني في مؤخرتي ذلك المسمار في الكرسي، والذي أنوي دقه منذ ثلاث سنوات، وإذا فتحت الدرج الأيمن العلوي ستطالعني شرائط فيروز وتفوح رائحة كولونيا انسكبت فيه منذ مدّة.
إنني الآن جالس، وإذا مددت رجلي فسوف تلتصق أقدامي بظهر السرير الإيديال المعدني البارد، في مواجهتي إلى أعلى كانت الجيوكندا داخل الإطار تبتسم في وداعة، وأسفلها كانت خرفشات طفلتي تملأ الحائط بألوان الشمع في محاولات لرسم قطة ونخلة، في الناحية اليمنى كانت لوحات الأصدقاء التشكيلية مثبتة بدبابيس الرسم، في فراغ الحجرة شممت الهواء، الهواء الداخل من وإلى رئاتنا أنا وزوجتي وطفلتي.
تأملتُ ملاءة السرير، ملأى بالدوائر الغمقة بفعل بول الطفلة، كذلك رائحة الفراش مُميزة أعرف فيها منزلي ورائحته. إن الكتب الفائضة تصنع تلا فوق المكتبة، في مقدمة الكتب يقبع التلفزيون الصغير، يوم أن اشتريته كنت أحمله بصعوبة وكان قلبي يتقافز فرحاً يسبقني إلى أسرتي فوق السلم.
اكتشافات:
كانت زوجتي تنام نوماً عميقاً، رقبتها النحيلة تظهر من تحت جلدها بعض العروق الزرقاء، إن أصابع يديها متنفشة ومكرمشة من جراء الغسيل، لقد بهت المنيوكير ولم يبق له سوى في مؤخرة الظفر مكان التقائه باللحم. كانت فقيرة مجهدة طيبة وبسيطة.
وكانت طفلتي تنام في عمق أيضاً، سال لعابها من شدقها وكوّن دائرة مبللة فوق الوسادة، كانت كالملاك الأبيض، استرعى انتباهي صندلها الأحمر الصغير في زواية السرير، بجواره علبة صلصة فارغة وأغطية زجاجات مثلجات وبعض البلي وحمار خشبي مكسور الساق، تناولتُ الصندل وقبلته، وفاحت منه رائحة الصنان.
حنين:
ككل صباح ارتديت ملابسي، هبطت إلى الشارع، كانت أم أشرف لم تجلس بعد لتفرغ الأنابيب الكبيرة فتملأ بها الأنابيب الصغيرة، لذلك فقد افتقدت رائحة غاز البوتاجاز رغم روعة الصباح, كانت الأرض مبللة بالندى والرائحة البكر، الشوارع شبه خالية من الناس، ملامح راكبي ميكروباص الكيت كات مألوفة لديَّ وبالطبع أنا مألوف لهم. نزلتُ أمام المحكمة، احتواني المكان الذي كان أشبه بخلية نحل، بادر عم مصطفى الحاجب إلى تحيتي. شعرت برغبة في الانتماء إلى هذا العالم مرة أخرى بضجيجه وزحامه ومضايقاته وسخفه.
يقين:
أخذت زوجتي تتخابث لكي تحصل على موافقتي، قالت إن سكان البيت قد عزموها معهم وأنها تجربة لطيفة، اهتمت بأن توضح لي أن النساء سوف يلبسن ملابس طويلة وسوف يجلسن بجوار بعضهن فوق العربة الكارو، وأن الصغار سوف يأخذون في الطبل والتصفيق والرقص، وقالت بشكل عابر: إن مولد أبو روّاش مشهور جداً وأن هذا الرجل له كرامات وأكّدت على رغبتها في شراء غوايش بلاستيك، وقد بان أنها في مستوى منخفض من باب الشقة تنبّأتُ أنها الصغيرة إيمان، فتحتُ الباب فكانت هى واقفة تحمل صينية عليها طبق من الأرز وربع دجاجة وطبق من الملوخية الخضراء من ورائها جاء صوت أمها: كل سنة وأنتم طيبين، أول مرة تعمل الملوخية الخضراء هذه السنة. أجابتها زوجتي من الداخل: وأنتم طيبين .. استني يا إيمان خدي طبق رز بلبن. بعد ذلك جاءت عطيات ابنة فاطمة تحمل ثلاثة أرغفة من العيش المخبوز وأصرت زوجتي على أن تعطيها برتقالتين.
أثناء شرودي قالت زوجتي أن شهر رمضان سوف يأتي بعد أسبوع، أفقتُ من الشرود وأنا أتذكر مسحراتي الحي يدق على طبلته وينادي على طفلتي بإسمها ويقول وحدوا الله –أيضاً تذكرتُ صديقي الشاعر الذي قال مصر لا تبدأ من مصر القريبة، إنها تبدأ من أحجار طيبة.
حكاية رواها أحد المصريين العائدين إلى أرض الوطن في الإجازة الصيفية:
… وكانوا يمدون أيديهم إلى الأرز وهو ملتهب فوق الصينيّة الفضية، يكورون بعضه في راحة اليد ثم يقذفون بما كّوروه إلى أفواههم، يمدون أيديهم إلى الخروف المشوي الموضوع بكامل هيئته فوق الأرز ويستخدمون كلاّ من باقي إصبعي السبابة والإبهام بقسوة ودربة عالية فيفسِّخون اللحم من باقي الجسد، يستأصلونه ويقذفون به إلى أفواههم ولا تمضي ساعة إلا ويكون الخروف هيكلاً عظمياً..
يقين 2:
خرجتُ متوجهاً إلى مكتبي، عندما اقتربت منه لمحت اليافطة، كانت مكتوبة بخط خجول تُعلن عن اسمي وأنُني محام. فتحتُ باب المكتب، هبت على وجهي وأنفي رائحتي، رائحة أنفاسي وسجائري ورائحة انتظاري للموكلين. نظرتُ إلى كتب القانون طويلاً وأخذت أتأمل الحوائط، حرّكتُ مفتحا الراديو الترانزستور فانبعثت موسيقى كلاسيكية من البرنامج الثاني، فكّرت قطعاً للوقت أن أقوم بإعادة تنظيم الكتب والملفات، فعلتُ ذلك ببطء وحب وثقة. في الحادية عشر أغلقتُ مكتبي، قررتُ أن أمَّر عليه قبل العودة لمنزلي.
ارتياح:
دخلتُ إلى شقتي فهللت الطفلة، عانقتها وقبّلتها وأعطيتها ما اشتريته لها من فول سوداني ومصاصة وقلّدت لها القرد، فضحكت في سعادة، وعدتها بالذهاب إلى حديقة الحيوان في الغد. سألت زوجتي عن أخبار الجيران فجلست تحكي، فجأة توقفت وسألتني عمّا بي، أجبتها إنني رجعت, تساءلت ثانيةً : من أين ؟ أجبتها: لن أسافر معه.. اعتذرت وحسمت الأمر- تسافر فين واعتذرت لمين يا محمود؟ – كانت حكاية كده وانتهت يا سوسن, تصعبت زوجتي ولم تُعر الأمر اهتماماً. قمتُ، أخذت حماماً ساخناً ونمت، كانت الدنيا من حولي صامتة وهادئة تماماً.
…………………
*من مجموعة “الرجل الذي حاول جمع شتات نفسه”